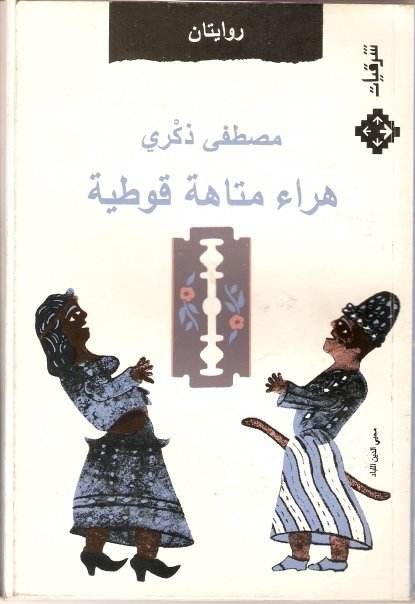رأيتها أول مرّة في مستشفى حلوان الجامعي، كنت محمولًا على كتفَي ننة وعادل ريتا والدماء تسيل على صفحة وجهي غزيرة قاتمة، فقد مُنيت بضربة مدية عميقة على طول خدي بعد مشاجرة ساخنة في موقف الميكروباص بميدان المحطة. الشيء الغريب أنّني لم أكن طرفًا في المشاجرة التي وقعت بين نُنة وبين بوسي صاحب عربة الكبدة والمخ بجوار مقهى البرازيل في وسط المحطة. كانت شقيقته وفدية، التي ترافق نُنة في الحرام، هي السبب في المشاجرة، وفي مشاجرات كثيرة جلبتها لأخيها بسبب فجورها. حتّى بعد زواجها من عمّ دياب الفران الذي يفوقُها مرتينِ في العمر، ولم تتوقّف عن شيطان يغويها بعشق الرجال. هذه المرّة، وفي مرّات سابقة لا تُعدّ، نزع أخوها بوسي قميصه الحريري المشجّر عن جسده المفتول المتناسق بطريقة منذِرة بشَرٍّ لا يعلمه أحد. بدا جسورًا، الناس يحجزونه وهو يقبض في يده على عتلة حديدية يحرّكها في الهواء كأنّها من خشب، وينفلت جسده العاري من بين الأذرع والأكتاف القوية وتظهر في الحال على لحم صدره وكتفَيه ورقبته وظهره علاماتٌ ولطخاتٌ حمراءُ من أثر الأيدي التي تدفعه.
أذكر أنّني رأيت في إحدى الليالي الشتوية الباردة طوقًا ملتهبًا شديد الاحمرار حول رقبة بوسي، وكان الصباح قد تنفّس والضباب الخفيف يشاكس لمبة عمود النور الأسمنتي التي ما زال ضوؤها الضعيف ينفي الصباح السافر. فكرت كثيرًا وأنا صغير أن عمودًا من الأسمنت بهذا الوقار والرسوخ والارتفاع الرهيب كيف تكون له في النهاية لمبة صغيرة ضئيلة لا تتناسب مع ارتفاعه؟
وكنت عائدًا مع ننة من سرادق فرح لأحد القصّابين وأمام مدخل البيت المتهالك القديم اندفع بوسي عاريًا إلّا من البنطلون الجينز وفي يده مُدية قرن غزال مؤتلقة وكانت وفدِيّة متعلّقة برقبته من الخلف من الطابق الثالث وعبر السلالم الكثير المتآكلة من الوسط، كانت ترتدي قميصًا رفيعًا على اللحم منخفض التقويرة وصوتها المشروح يفضح هدوء الصباح. كانت الساقان الهاربتان تتقلّبان هناك في عمق الشارع، هل هو عشيق مجهول ضُبط في الفراش؟ لا أعرف فكلّ ما ينطبع في ذاكرتي عن هذا العشيق خفّة الساقين الهاربتين. وقعَت أخيرًا أمام مدخل البيت، وتعرَّت ساقاها، وظهر فخذاها، وكانت تلطم خدَّيها وتصرخ والبخار الرقيق يخرج مهولًا متقبضًا من فمها وأنفها بفعل ضوء العمود الأسمنتى. نعم هذا مناسب لأنّ اللمبّة الصغيرة الضئيلة هي الآن تضاهي وتضارع العمود الأسمنتي السمق بل تفوقه في الأهمية برغم حجمها الصغير.
أشارت وفديّة إلى ننة مستندةً بأن يدرك بوسي فانطلق بحماس الخمر التي تشعشع في رأسه. كانت تخاف على أخيها من رهق السلاح المؤتلق يده أو ربّما تخاف عليه من مواجهة قد لا يطيقها لاسيّما وهو أخوها الوحيد الذي كانت تقول عنه في أوقاته صفائها «ده أخويا الوحيد، ده حيتي ميتي من الدنيا». أمّا عن العشاق العابرين فكانت تقول إنّهم كثيرون بعدد شعر الدغلة الكثيفة بين ساقيها وتمدّ يدَها بحركة ماجنة بين وركيها وتخرج بشعيرات خشنة ملتوية متخثرة ما تلبث أن تنثرها في الهواء، فيضحك عادل ريتا، ويقول والشخرة تتاخم عبارته «مش قوي كده» فتنظر له والشرّ يتأبّط عينيها وتقول «تحب تشوف». فيضحك ويقول محاذرًا من غضبها وهو يضمّ رأسها إلى صدره بحركة عنيفة وحميمية «صادق يا كدّاب».
عاد ننة ظافرًا، فقد كان بوسي تحت ذراعه القوي الذي يحوط رقبته يشدّ عليها بين الحين والآخر، والكلمات الساخنة المبتورة التي تختلط بالسبّ الحانق تخرج مكتومة مبهمةً؛ لأنّ فمه يكاد يلتصق بالجاكيت الجلديّ الأسود الذي يرتديه ننة. اقتربا من مدخل البيت. ورأيت لمعة اللعاب على الجاكيت الجلدي منحرفًا قليلًا ناحية الإبط ورأيت أيضًا الطوق الملتهب حول رقبة بوسي وقد ازداد احمرارًا.
لم أكن أتصوّر حدوث مشاجرة في يوم ما بين بوسي وننّة وأكون أنا كبش الفداء وتهبط المدية خطأ على وجهى. لكنّني عزيَّت نفسي عندما هبطت صفعة قوية على وجه بوسي لتهدئة سورة غضبه، كانت مثل ماء بارد يصبّ على حديد ساخن. لم يكن يسمح بتلك الصفعة إلا من الأصدقاء المقرّبين، فهنيئًا لمَن كان مقدرها في الوقت المناسب. أليس هو بوسي نفسه قد أطار سِنَّتين أماميتين كبيرتين من واجهة فم عادل ريتا في مشاجرة مماثلة. كان عادل ريتا ليس له طاقة بكم السنج والمطاوي والخنازير في الناحية الأخرى من المحطّة لاسيّما وهو مبرشم وسكران طينة. شخرت وفدِيّة شخرة عميقة ارتعشت لها أرنبة أنفها، وتوتّرت الطاقتان بذبذبة غريبة فور معرفتها أنّ أخاها نالته صفعة قوية على وجهه من عادل ريتا، وقالت بغمز ولمز «ما بقاش إلا النسوان». كانت تشير في قولها إلى شذوذ عادل ريتا الجنسي وسخِرَت كثيرًا من أخيها في الذهاب والإياب بكلام موجع مرٍّ؛ كلام مثل الجمال الهادرة التي تستطيع أن تنفذ من ثقب إبرة وهي مجتمعة دفعة واحدة، فكيف الحال ببوسي الذي هو من لحم ودم.
تركني ننة وعادل ريتا غارقًا في دمائي ومغشيًّا عليَّ وفرّا هاربينِ خوفًا من محضر الإثبات الذي يطلبه الطبيب النوبتشي عادة في المشاجرات الدامية التي تنتهي بعاهة مستديمة أو بأثرٍ لا يمحوه الزمن.
انتبهتُ فوجدتُ نفسي على دكّة خشبيّة طويلة وكئيبة ليس لها طلاء غير تلك اللّمعة السوداء الدسمة التي غطت نسيج الخشب بمرور السنين ومن كثرة الجلوس عليها ومسح الأيدي والأقدام. فالفلّاحون الذين يأتون من كفور مجاورة لحلوان الحمامات يجلسون عليها بوسخهم ونسوانهم. وجوههم كابية ومسحوبة في سمرة غامقة وأطرافهم سوداء طويلة ومعروقة وهم متقرفصون على الدكّة الخشبية، مطأطئو الرءُوس يدخنون في صمت ويتعوذون بأصواتٍ خفيضة وهم ينظرون إلى بؤس أطفالهم ممصوصي الوجوه بنار الحمّيات المعوية وموجات القيء والإسهال، النسوان يمسحن بخرق بالية القيء والخراء عن جسوم ضاوية متغضنة ثم يخفين الخرق خوفًا من زجر التمورجيّات اللائي يدعين تنظيف شرفة الاستقبال الطويلة كل يوم بالماء والصابون.
كانت الشرفة في عمق الليل موشحة ومقبضة، تمتدّ حتّى تطوق مبنى المستشفي القديم وتنفتح عليها عقود معمارية عالية لها أنصاف دوائر علوية تهبط في استقامة ورسوخ. كان عقد واحد في نهاية الشرفة يرمي بظلٍّ ضعيفٍ على البلاط فتنعكس دائرة العُقد العلوية مائلة قليلًا ومقتربة من سور الشرفة.
كنت ممدّدًا على الدكّة الخشبية، أشرع بهبوطٍ شديدٍ وخوف، وفجأة رأيت نهرًا غزيرًا من الماء الممزوج بالصابون يغبش بلاط الشرفة ويجرف معه حذائي الوثيق ماركة دانلوب، تلّفتُّ فلم أرَ أحدًا وعاودتني في الحال ذكرياتٌ من القصص القديمة التي سمعتها وأنا صغير عن مستشفى حلوان العام التي يسمونها «المستعصية».
كانت تلك القصص مفعّمة بالجان والعفاريت لكثرة مَن ماتوا بها، والغريب أنّ أغلبها لم تخلُ من شيء يتعلّق من قريب أو بعيد بالماء والصابون أو بالنظافة عمومًا، كأنّ أرواح الميتين تأبى إلّا أن تعود نظيفة يانعة من كثرة ما شهدت من المرض والجوع والقذارة وكأنّها تأثرت من الذين لم يموتوا بعدُ وتحفزهم على الموت كي يكونوا يانعين مثلها.
ومن تلك القصص قصةٌ حكاها لي عمّ دياب الفرّان، وهي أنه قد رأى في حديقة المستشفى، المهجورة إلّا من شجرتين باسقتين، «عفريتة نفريتة» تستحم تحت حنفية غليظة الفوّهة من النحاس الأصفر، ولمّا كانت الحنفية في أسفل الجدار كانت العفريتة تميل براحتيها لأخذ الماء الصافي ثم تعود واقفة وتُهرق من الراحتين المترعتين على رأسها، كانت عارية مثل كلمة حقّ، وكان عمّ دياب واقفًا في الشرفة نفسها بقامته الدقيقة.
أحسست بحدس مفاجئ أنّه كان يقف في نهاية الشرفة عند العقد المضيء، ونظرت بتوترٍ وخفقان قلبٍ ناحية الحديقة فوجدت أنّ الرؤية من هنا وأنا ممدد على الدكّة الخشبية كانت مستحيلة؛ لأنّ الشجرتينِ الباسقتين تحجبان أسفل الجدار الذي به الحنفية النحاسية الصفراء. كانت الشجرتانِ الباسقتانِ مترنحتينِ بهواءٍ بارد قارس. قال لي عمّ دياب بيقينٍ صارمٍ إنّها عفريتة نفريتة لأنّ الوقت شتاء.
عدت بعينينِ خائبتينِ؛ لأنّ حدسي قد أصاب ونسيت تمامًا دمي المراق على صفحة وجهي وقلتُ ضاحكًا لتخفيف حدّة التوتر والقشعريرة التي تأخذ جلدي كلّه «هِيه ليلة كوبيا». ثم مشيت وراء الحذاء وجوقة الماء والصابون المحتفية به ولم أزل أتعلّق بأملٍ واهٍ أن تنحرف الجوقة إلى عقد آخر غير هذا الملعون بضوء ضعيف في نهاية الشرفة حتّى لو كان الآخر مظلمًا عاتمًا مثل جدث، لكنّها هيهات أن تفعل.
كانت المُوَيجات الخفيفة تباعد بين فردتَي الحذاء قليلًا وتجعل إحداهما تدور نصف دورة أو دورة كاملة حول نفسها بنزق رصين غير ناسية مسيرتها الأساسية وهدفها الأخير. ابتلّ الجورب وطرف البنطلون بماء دافق تعلوه رغوة الزبد الأبيض كالحليب. لعنت أكثر من مرّة بوسي وننة وعادل ريتا ورميتهم جميعًا بحقدٍ أسودَ ينبع من القلب.
كانت العقود المظلمة تتتابع على جانبِي الأيسر لا تحمل ريبة. قلت العقود المظلمة ظلمتها نور والعقد المضيء ضوؤه عتمة حتى ينخرط المستثنى والمستثنى منه شيئًا واحدًا فينفكّ الاستثناء، أنا الآن عند نهاية الشرفة، لم أستطع منع نفسي من النظر إلى يميني هناك أسفل الجدار ناحية الحنفية الغليظة الفوهة. كانت الحنفية تلتمع بضوء أصفر محمر، لعله يأتي من أعمدة الحديقة اليابانية. الحنفية عاطلة من الماء والتي كان رداؤها ينسدل عليها بماء منهمر لم تكن هناك. ها أنا ذا أدخل وراء الحذاء مجتازًا عتبة العقد المعقوف فوقي.
أفعمتنى، منذُ الوهلة الأولى، رائحة السافلون والديتول والكلور والفنيك والبنج، رائحة قوية نفاذة، منعشة في البداية ثم لا تلبث أن تصبح مقبضة وكئيبة. الغرفة عظيمة الاتساع وكأن كلمة غرفة لا تتناسب مع رهبتها وجلالها وارتفاع سقفها، فهي أقرب إلى البهو الفسيح لكاتدرائية قديمة، الحوائط مدهونة بزيت لامع أملس، نصفها السفلي له لون أخضر قاتم والنصف الأعلى بلونٍ أخرَ فاتح وباهت، لمبات النيون الطويلة الأسطوانية المثبتة في أنحاء السقف الشاهق تشع ضوءًا أبيض له عتامة هاربة تخايل العين، الضوء الواهن يتفيأ على الحوائط ليترك بقعًا ضوئية لامعة غير حادّة الحدود، مواسير الغاز الطبيعي مثبتة أسفل الجدران لتلفّ حوائط الغرفة الأربعة، في بعض الأماكن المتفرقة تخرج المواسير المزدوجة من الحائط في شكل مربع له ضلع ناقص هو الحائط نفسه. توجد حول المربّعات الموزعة بشكل منتظم حوامل حديدية، فوق الحوامل الحديدية طناجر كبيرة من الألومنيوم أسطوانية الشكل، يتصاعد منها بخار رقيق، تحت كلّ حامل حديديّ وفي مواسير الغاز المزدوجة يوجد ثقبان دائريان ليسا على استقامة واحدة، يخرج من الثقبين الدائريين لهب ضعيف، لاحظتُ أنّ اللّهب لا يخرج مباشرة من الثقب، بل بعد مسافة قصيرة منه، وعلى استقامته ينفتح اللّهب كأنّه معدوم المصدر، ويزداد الإحساس بعدم مصدرية اللّهب عند هبات الهواء الخفيف الذي يأتي عبر الشرفة فيتأرجح اللهب تحت الطنجرة يمينًا وشمالًا دون قيدٍ.
في وسط الغرفة تلالٌ مكومة على الأرض الخشبية من ملاءات الأسرّة وأكياس المراتب والنمارق وكانت كلّها بلونٍ أصفرَ متقرّح ولم تخلُ أيضًا من بقعِ دماءٍ وقيء وصديد، وساعة الحدود وباهتة في المنتصف بحمرة ودكنة خفيفة، قد يحسبها المرء من النظرة الأولى أنها البقع المعروفة للشاي أو القهوة بعد محاولة إزالتها بالماء العاجل.
كان الحذاء قد توقّف عن المسير في منتصف الغرفة بعد تسرّب والصابون في شقوق الباركيه، خشب الباركيه حائل اللّون كالح وطري، تأكله عفونة ورطوبة وقد بدا أنه يُسهم في الرائحة الغريبة التي تلفّ الغرفة.
من الباب المقابل لعقد الشرفة دخلت رجاوات التمورجية وفي يدها عصا يافعة ثخينة وفي اليد الأخرى آنيةٌ بها صابون مبشورة ومبشرة طعام. كانت ترتدي جلابية بسفرة من الجباردين السميك، لون الجلابية فيما يبدو كان أبيض وهو الآن يميل إلى صفرة سمنية حائلة.
القذارة في هيئتها أبعدت عن رأسي أخيلة العفاريت والجانّ. قلتُ في نفسي أرجو أن تكون إنسيّة وليست جنيّة، ثم بدأ التفكير الأوتوماتيكي التقليدي والشرقي حين ينفرد رجل وامرأة في مكان خالٍ، ومنّيتُ نفسي بمضاجعة وأنا أفكّر في مَثلٍ ركيك مبتذل هو أنّك تِلاقي الخرابة ماتلاقيش الخو.. تلاقى… ماتلقاش الخرابة. كان هذا المَثل يقال بلسان شعبي ماجنٍ وليس المقصود منه التعبير عن اللواط والشذوذ الجنسي، بل المقصود منه هو الحظّ العاثر الذي يقف بالمرصاد لشخصٍ يتمتّع بالواء الجنسي والرغبة المضطرمة الملتاثة فلا يجد مناصًّا من التفكير وبشيء من الأنفة في نوع المضاجعة الآخر، وهذا أيضًا ليس شرطًا نهائيًّا لبقاء الأنفة فقد تزول بحكم العادة المنحرفة، التي لا تلبث حتّى تصبح غير منحرفة، والأنفة الأخرى التي هي أشدُّ شراسة وعدائية وهي شعور الشخص بالرثاء والعطف من قِبل الذين يملكون ظروفًا فيزياقيّة مترفة وكأنّ التفكير في امرأة جميلة ومكان أنيق ترف وبذخ لا يحلم به الشرقيّون الغارقون في سوداوية ساخرة مفادها أنّ الجسدينِ ملتقيانِ عن حاجة فسيولوجية محضة وإن كان هناك بدٌّ من شيء كريه اسمه العواطف أو المشاعر الإنسانية، ففي مكان آخر عذري وطاهر، وكأن الجسدانية والطهرانية ليس هناك وساطة بينهما.
ألفاظ وكلمات تائهة بين مشكاة منزليّة تريد الجلي والتلميع وبين صديقة عانس تأتي للزيارة بعد الظهيرة. فكّر الرجل والمرأة أنّ الصديقة الوقور المؤدّبة الرصينة انقطعت عنها الدورة الشهرية وما زالت تُلمح بين أترابها على حياة بآلام المعدة والغثيان الخفيف وشحوب الوجه، تلك العادات التي تنتابها إبّان طمثها، الأتراب يعرفون ويداهنون وهي تعرف أنهم يعرفون ولكنّها لا تستطيع التوقّف ـ لكنّهما لم يستطيعا التحدث واقتصرا على الإشارة إلى الكعك والشاي واحتمال تقديمهما إلى الصديقة واعتذار رقيق عن عدم الاتصال والسؤال، بسبب التلف الذي أصاب الرقم الثامن في قرص التليفون. ولمّا كان الهاتف لدى الصديقة يحمل 788080 فقد تعذّر السؤال بعض الوقت.
ستقول أيها القارئ إنّني كاتب مراوغ وإنّ لي قدمَ تِيه وزيغ، أقول لك نعم، أنا مولع بالمتاهات والدهاليز العميقة المعقّدة التي لا تفضي إلى شيء، سأقص عليك الآن قصة كنت قد كتبتها منذ زمن وهي تتعلّق بأمر المتاهات، ولأنّني أرى دائمًا أنّ صيد عصفورين بحجر واحد حذق ومهارة، فما بالك بصيد العصافير كلّها بحجر واحد.