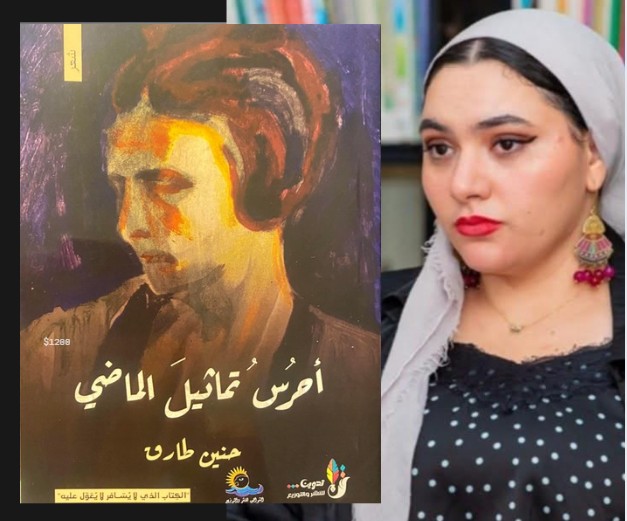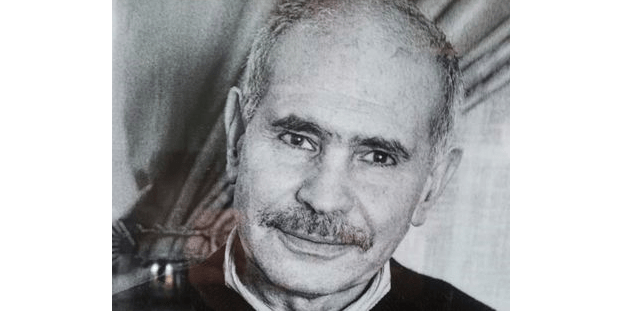2
لأنك كنت تغسل وجهك وقدميك
بقبضة واحدة من المياه
وتبول فوق رؤوس الخنافس
دون أن يبتل حذاؤك
الذي يرقد بين طعامك وكتبك
إذن فقد كان لك وطن حقيقي.
3
لأنك كنت تملك قطة مليئة بالبراغيث
وصديقة يخلو شعرها من القمل
ويلمع بحبات الكيروسين
ومدرسة تحمل عصاها
رائحة أصابعك
إذن
فقد كان لك وطن حقيقي.
4
لأنك كنت تلبس مريلة من الدمور
بها بقعتان من الحبر الباهت
وعدة خطوط تتقاطع كلها في الصدر
لكنها لا تشبه تلك الخريطة
التي كنت تحفظها عن ظهر قلب
إذن
فقد كان لك وطن حقيقي.
5
لأنك كنت تجيد قذف حجارتك على الأعداء
من المدرسين وعيال المدرسة المجاورة
وكنت تتسلل إلى حديقة الرجل الغني
دون أن يصفع قفاك
سوى مرة واحدة
إذن
فقد كان لك وطن حقيقي.
6
لأنك كنت لا تحفظ سوى الفاتحة
و”قل هو الله أحد“
وتترك صلاتك
وقد بعثرتهما على سجادة الجامع
قبل أن يعرف الله أنك لم تتوضأ منذ جمعتين
إذن
فقط كان لك وطن حقيقي.
…………..
*من ديوان “امبراطورية الحوائط”