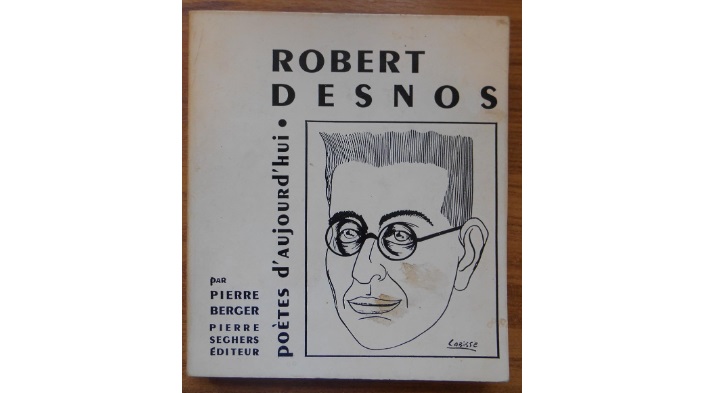كاساندرا*
كَاسَاندرَا المِسكِينَة
كَانَت الوَحِيدَةُ التِي اسْتَشعَرتِ الأمْر
هِي وَحْدهَا: كلّ هَذا، كانَت تَقولَ، سَينْتهِي
نِهَايَة سيّئة. بالطَّبعِ
لَم يُصَدِّقهَا أحَد.
حَدثَ هَذَا مُنْذ زَمَن بَعِيد. ولكِن مذَّاك
والجَمِيعُ يَقُولُ ذَلك. تكْفِي نَظْرَة
عَلَى سُوقِ البُورصَة، عَلَى اختنَاقَات المُرور
وآخِرِ الآخْبَار. يَبقَى فَقَط
ما الذِي يَعْنِيهِ “كُلُ هَذَا”، وَمَتى ؟
وَبالطَّبْع إلَى ذَلِكَ الحِين لَنْ يُصَدِّق
أحَدٌ مَا يَقُولُه الجَمِيع.
تَكْفِي نَظْرَة علَى السّيَارَات ذَات المَقعَدَين
عَلَى حَدَائِقِ البِيرَة وإعْلاَنات الزّواج
…………………….
* كًانت أميرة طروادة كَاساندرا الوحيدة التي توقعت هزيمة مدينتها في حربها مع الإغريق. لكن لا أحد حمل تحذيراتها محمل الجد. ومنذ ذلك الوقت صار عبارة ” نداء كاساندرا ” تحيل على التحذيرات غير المجدية . توازيها في ثقافتنا زرقاء اليمامة…
*شاعر ومترجم مغربي مقيم بألمانيا