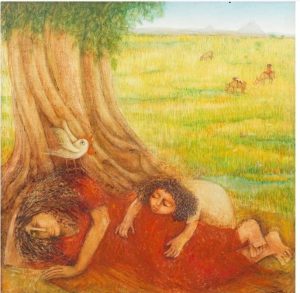كنتُ كتبتُ لِي علَى ورقةٍ رطبةٍ، بالَ علَيْها تلميذٌ نَزِقٌ قبلَ أَن يُستشهدَ وهوَ فِي طريقهِ إِلى مدرستهِ المُرمَّمةِ، كانَ نزعَها مِن دفترِه المدرسيِّ، وأَقرؤهُ الآنَ بصوتِ نَزقهِ:
هُم فِي أَبراجِ الذَّهب../ ونحنُ فِي حدائقِ الحَطب../ وَ.. كفَى يَا قَلب!
فِي إِحدَى زِياراتي، أَيُّها البهيُّ النَّقيُّ، (أَعتقدُ أَنَّها كانتْ فِي الذِّكرى الخمسينِ للنَّكبةِ) للشَّاعرةِ فَدوى طُوقان (رحمَها اللهُ)، كنتُ سأَلتُها: مَن حفظَ الوطنَ أَكثرَ؛ الثَّقافةُ أَمِ البندقيَّةُ؟ فسارعَتْ بالقولِ تكادُ تنهضُ مِن مقعدِها، وهيَ المشهورةُ، بعدَ إِنسانيَّتِها الثَّريَّةِ، بهدوئِها الشَّاسعِ، وإِنصاتِها الطَّويلِ: الثَّقافةُ طبعًا، معَ أَنَّه لاَ يجوزُ ترْكُ البندقيَّةِ، فلِلْمقاومةِ أَشكالٌ مختلفةٌ، والشَّعبُ الفلسطينيُّ لمْ يزلْ تحتَ الاحتلالِ. أَردفْتُ ساخرًا: وأُسلُو يَا خالَتي الفلَّةُ؟ (كنتُ أُحبُّ أَن أُنادِيها هكذَا، وكانتْ هيَ تستعذِبُ ذلكَ منِّي). فقالتْ: أَخشى علَى الثَّقافةِ مِنها بعدَ أَن جرَّدتْنا منَ البندقيَّةِ. قلتُ: ومَنْ يحفظِ الثَّقافةَ يَا خالَتي؟ أَليسَ المثقَّفونَ الفلسطينيُّونَ؟ ابتسمَتْ ابتسامةً لمْ أَرَ علَى شفتَيْها مثلَها مِن قَبلُ، كأَنَّها أَعادتْ رسمَ ابتِسامةِ “الموناليزا” المُحيِّرةِ، ثمَّ قالتْ بكلِّ هدوءٍ ساخرٍ: لمْ يحتفِظوا بأَيِّ شيءٍ! حتَّى أَنَّ أَدبَ المقاومةِ اختفَى إِلى زوالٍ، وحتَّى أَنَّ الصَّديقَ الشَّاعرَ محمُود دَرويش، عندَما سأَلْتهُ عنْ أَدبِ المقاومةِ، بعدَ أَن صارَ يكتبُ شعرًا شخصيًّا، قالَ لِي: لاَ بدَّ أَنَّ يعودَ الشَّاعرُ إِلى كتابةِ ذاتهِ، فهذَا هوَ الشِّعرُ الَّذي يبقَى.
والحقيقةُ أَنَّنا، كمَا نعرِفُ ونؤمِنُ، ويَا ليتَنا لمْ نؤمِّنْ، أَيُّها القدِّيسُ الثَّقافيُّ، لمْ نكُنْ نحلمُ/ نتمنَّى/ نريدُ أَكثرَ تُرابًا لنَا ممتدًّا منَ الماءِ الأَبيضِ المتوسِّطِ إِلى الماءِ الميِّتِ الحيِّ. لكنَّ التُّرابَ ضَاقَ علَينا بِما رَحُبَ، كمَا ضاقَ علَى شجرةٍ مهجورةٍ بعدَ تهجيرِ زارعِها، ونبتةٍ يتيمةٍ بعدَ أَن استُشهدَ غارسُها، وزهرةٍ برِّيَّةٍ عطشَى سُلِبَ مَاؤها مِن تحتِها، ومُنِعَ عاشقٌ أَن يُهديَها لمحبُوبتهِ المريضَةِ بالانتظارِ، والمريضِ بِها، فِي مَشفى الوطنِ الَّذي لاَ يتوفَّرُ فيهِ سِوى العشَّاقِ المرضَى!
حتَّى أَنَّه (الآخرُ البغيضُ) الَّذي خرجَ مِن غرفةِ نومِنا، واستلقَى علَى الأَريكةِ الوحيدةِ فِي صالونِنا (كمَا قالَ شاعرٌ)، يداهمُ الغرفةَ متَى شاءَ، ويفتِّشُ حتَّى مَا تحتَ سراويلِنا وأَضغاثِ أَحلامِنا، ويمنعُ، أَو يسمحُ لنَا بعبورِ الصَّالونِ، إِذا أَردْنا الذَّهابَ إِلى الحمَّامِ، وكمْ مِن مرَّةٍ فعَلناها فِي لباسِنا الدَّاخليِّ إِذ يؤخِّرُنا عمْدًا، وكمْ مِن جَنينٍ آثرَ البقاءَ فِي رَحمِ أُمِّهِ، كيْ لاَ يَراهُم ويَراهُم، حينَ أَوقَفها (الآخرُ) طويلاً فِي الصَّالونِ، ولمْ يُمكِّنُها منَ الذَّهابَ إِلى مشفَى الوطنِ!
(2)
ولاَ أَدري كيفَ أَستمرُّ إِليكَ؟
مَا زالتِ الذَّاكرةُ تُطلِعُ لِي مَا قلتَهُ ذاتَ يومٍ بَعيدٍ بِعيدٍ: “الكتابةُ فرحٌ”. لكنَّكَ، أَيُّها المثقَّفُ فِينا/ المتأَلِّمُ مِنْهم، لمْ تَقلْ: أَينَ؟ ولاَ أُريدُ: كيفَ؟ ومَتى؟ ومَنْ؟
إِذا كانتِ الكتابةُ سببَ فرحٍ، فهلِ القراءةُ عكسُهُ؟ إِنَّها كذلكَ لأَحدِ سبَبْينِ، أَو كلاهُما معًا؛ الأَوَّلُ: لأَنَّ القراءةَ باتتْ مهجورةً جدًّا عندَ أُمَّةِ “اقْرَأْ”. والثَّاني: لأَنَّ القراءةَ فِعلٌ تنويريٌّ/ تثقيفيٌّ/ كاشفٌ/ فاضحٌ لاَ تُغطَّى فضيحتُهُ بورقةٍ مِن كتابٍ.
نصحتَني أَن أَقرأَ كثيرًا ففعَلتُ أَكثرَ، وأَنا صِرتُ مثلَكَ، أَيُّها المعلِّمُ الخارجُ مِن “قَصبةِ الياسَمينةِ” والْمازالَ يتَّكئُ علَى كتفَيْكَ جبلاَ “جرزيمَ” و”عيبالَ”، أَبحثُ فِي قِراءاتي، وفِي كِتاباتي أَيضًا، عنْ خسَاراتي فِي رحلةِ التَّعبِ/ الأَدبِ. أَلمْ يقُلْ جدُّكَ/جدِّي، وهوَ يسحبُ مِن صدرِهِ سعالَهُ الخانقَ بنارجيلةٍ جالسًا بِـ”شِرْوالهِ” علَى كرسيٍّ صَغيرٍ مِن قشٍّ متهرِّئٍ فِي مَقهى “البَرلمانِ” النَّابُلسيِّ الَّذي تعرِفهُ جيِّدًا (ثَمَّ لافتةٌ مكتوبةٌ بالفحمِ: ممنوعٌ دخولُ الأَعضاءِ لمنْ هُم تحتَ السَّبعين) قالَ: “فِي المالِ ولاَ فِي العيالِ”. ليتَها كانتْ كذلكَ يَا معلِّمي الْعلَّمْتَني اجتيازَ حرفِ الشِّعرِ إِلى حرفتهِ. ليتَها توقَّفتْ هناكْ، ولمْ تأْخذِ البدنَ اجترارًا، والعمرَ انكسارًا، والرُّوحَ انشطارًا. أَعتذرُ منكَ لِقَسوتي الحانيةِ، فالكتابةُ الفَرِحةُ مثلَ الماءِ ينسابُ إِلى غيرِ أَرضٍ فَرِحةٍ، والكتابةُ تنسابُ مِن بينِ الأَصابعِ إِلى غيرِ موضوعٍ دونَ وعيِ الكاتبِ. ليسَ هذَا مِن بابِ التَّشويقِ (الجاحظيِّ)، لكنَّها الكتابةُ الَّتي تتشعَّبُ فِي شجرتِها الواحدةِ.
“الكتابةُ فرحٌ”.. نعمْ.. كانتْ! أَذكُرها تُفرِحني بعدَ عناءِ/ انتهاءِ كلِّ كتابةِ قصيدةٍ، كمَا لَو أَنَّها كتابةٌ للكتابةِ، وفرصةٌ للأَنا الشَّاعرةِ/ النَّافرةِ كيْ تبدوَ مغايرةً عنِ الآخرينَ، خصوصًا عندَما يتكرَّرُ فرحُ الكتابةِ فيَّ بعدَ أَن تُنشرَ فِي صحيفةٍ أَو مجلَّةٍ، وحتَّى لَو لمْ أَكنْ أَسمعُ صدًى لَها مِن آخرينَ. (كانتْ حينَها، فقطْ، مجلَّةُ “الفجرِ الأَدبيِّ” الَّتي حوَّلتَها، بكلِّ إِخلاصٍ وانحيازٍ إِلى الأَدبِ الفلسطينيِّ أَوَّلاً، مِن صفحةٍ فِي صحيفةٍ، إِلى صحيفةٍ مستقلَّةٍ، فمجلَّةٍ، ومجلَّةُ “البيادرِ” الَّتي كانتْ أَدبيَّةً فقطْ).
وأَراكَ تتنقَّلُ دؤوبًا، مثلَ نحلةٍ طافحةٍ/ عارمةٍ/ مظلِّلةٍ، منَ القصيدةِ، إِلى المقالةِ، إِلى الدِّراسةِ، إِلى البحثِ، إِلى النَّقدِ، إِلى الرُّوايةِ، إِلى التُّراثِ، فالكتابةِ للأَطفالِ (أَكثرَ مِن خمسةٍ وأَربعينَ سِفرًا، فِي سَفرٍ طويلٍ)… معَ أَنَّ عملَكَ فِي الصَّحافةِ (عربيًّا وإِنجليزيًّا) كانَ يُرهقكَ جدًّا، كمَا كنتُ أَراكَ كلَّ مرَّةٍ حينَ أَزورُكَ فِي مكتبِ صحيفةِ “الفجرِ” فِي القدسِ المحتلَّةِ، قبلَ حرمانِنا الكلِّي مِنها، وفِي يدِي قصيدةٌ جديدةٌ لِي للنَّشرِ.
لمناسبةِ الكلامِ عنْ كَلْمِكَ الكبيرِ/ الكثيرِ/ الغزيرِ مثلَ أَمطارٍ تعانِدُ كلَّ الفصولِ؛ أَذكرُ فِي لقاءٍ بينَنا حديثَكَ عنْ أَن فِي بيتِكَ، العامرِ بكَ وبأَهلِهِ، آلافَ النُّصوصِ والمقالاتِ والكتاباتِ المتنوِّعةِ والموزَّعةِ فِي غيرِ جهةٍ ومكانٍ. حينَها قلتُ لكَ علَى سبيلِ استخراجِ بسمةٍ بعدَ حديثِ الحزنِ غيرِ النَّبيلِ: إِذا استمرَّيتَ فِي الكتابةِ هكذَا، ستضطرُّ لأَن تباتَ علَى عتبةِ البيتِ! فكانتْ بسمةٌ اختلطتْ بوميضِ العينينِ، لمْ أَنسَها، ولنْ أَنساها مَا حيِيتُ، إِذ لمْ أَرَ مثلَها حينَ تعرَّفتُ إِليكَ صُدفةً فِي صَدَفتِكَ “مكتبةِ الوطنِ” فِي مدينتِنا “نابُلسَ” (تغيَّرتِ المكتبةُ بعدَكَ مِن حالٍ إِلى حالٍ، أَمَّا الوطنُ فلَمْ يتغيَّرْ؛ لقدْ بقيَ صامدًا علَى.. حالةِ الضَّياعِ).
(3)
ولاَ أَدري كيفَ أَنتهي إِليكَ؟
أَتدري، أَيُّها العصيُّ علَى أَصابعِي لتشكُرَكَ، كأَنَّكَ مانِعُها بامْتنانٍ! كيفَ أُشكِّلُ “شُكرًا” مغايرةً تليقُ بلقائِكَ السَّخيِّ؟ هَا أَنا أَفشلُ مرَّةً أُخرى وأُخرى، فأَمقتُني بحنانٍ، كيْ لاَ أَجرحَكَ بعقابِ ذَنبي.
كيفَ أَفشلُ، وأَنتَ الَّذي حينَ حكيتُ لكَ عنْ معلِّمِ التَّربيةِ الدِّينيَّةِ (كنتُ طالبًا فِي الصَّفِ الثَّالثِ الإِعداديِّ) الَّذي أَخرجَني ستَّ حصصٍ متتاليةٍ، بعدَ أَن كانَ قرأَ “أُولى قصائدِي” ومَا هيَ بقصيدةٍ طبعًا، غزلاً، وقد نُشرتْ فِي جريدةٍ أَحضرَها إِلى الصَّفِّ، كيفَ علَّمتَني، بكلِّ أَبويَّةِ المعلِّمِ، أَنَّ الشِّعرَ عدوُّ المباشرَةِ، وأَنَّ لهُ لغةً لاَ يعرفُها إِلاَّ الشُّعراءُ، وأَنَّه يجبُ أَن يُكتبَ بِها مهمَا كانتْ عاديَّةُ الموضوعِ أَو كانَ ذَا قداسةٍ،وضربتَ لِي أَمثالاً عدَّةً أَبرزتَ لِي فِيها أَن لاَ منطقَ فِي الشِّعرِ، وأَنَّ الحقائقَ يمكنُ إِعادةُ صياغتِها بمخيلةِ الشَّاعرِ بلغتهِ الشِّعريَّةٍ الَّتي يبتكرُها لهُ. وقدْ عدتُكَ بعدَ عدَّةِ أَيَّامٍ بقصيدةٍ جديدةٍ بعدَ أَن استوعبتُ كلامَكَ، ونشرتَها لِي صفحةِ “الفجرِ الأَدبيِّ” بعدَ أَن كُنتَ تنشرُ لِي تشجيعًا فِي زاويةِ “الضَّوءِ الأَخضرِ”، وإِيذانًا بالعبُورِ. مِن يومِها وأَنا أَهتمُّ بلغتِي الشِّعريَّةِ عبرَ إِثراءِ ابتكارِها، علَى الرَّغمِ منَ اتِّهامي بالغموضِ والإِبهامِ، و”الشِّعرِ الزِّئبقيِّ” مِن أَصدقاءَ كتَّابٍ أَنتَ تعرفُهم مِثلي.
والآنَ.. لِمَ هذهِ اللُّغةُ لاَ تُسعفُني فِي تشكيلِ شُكرِكَ، وقدْ كُنتَ أَشرتَ إِليها عبرَ قراءتَيْكَ النَّقديَّتينِ لمجمُوعتينِ مِن مجمُوعاتي الشِّعريَّةِ، وتحديدًا عبارتكَ: “اللُّغةُ لعبةُ هذَا الشِّاعرِ بامتيازٍ، فِي تجليَّاتٍ عاليةٍ غيرِ مسبُوقةٍ”. للمناسبةِ: لقدْ مَنحتني فِي قراءتَيْكَ لقبَ” “شَاعر”، ووصَفْتني بـ”الصَّديقِ الشَّاعرِ”، فَفرِحتُ جدًّا؛ كهديَّةٍ مِنكَ إِلى تلميذِكَ منذُ العامِ (1976) وإِلى مَا بعدَ (2013). إِذًا؛ الكتابةُ ليستْ فرحًا فقطْ، بلْ ثَمَّ مَا هوَ أَوسعُ مِنها ومِنهُ. ولكنْ.. أَلاَ يجبُ أَن تعودَ لتفتحَ “مكتبةَ الوطنِ”، وتُعيدَ عليَّ الدَّرسَ الأَوَّلَ؟ كتبتُ هذهِ العبارةَ وأَنا ابتسِمُ، فابتسِمْ ضدَّ حزنِكَ، وضدَّ مرضِكَ، وضدَّ عزلتِكَ علَى الرَّغمِ مِن أَنَّها مِن مزاجِ الإِبداعِ.. أَيُّها النَّقيُّ مثلَ ثوبٍ أَبيضَ لمْ يُنسَجْ بعدُ، وأَيُّها البهيُّ مثلَ بلبلٌ بحجمِ الشِّعرِ كلِّهِ.”
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصورة تجمع الشاعر علي الخليلي والشاعر محمد حلمي الريشة