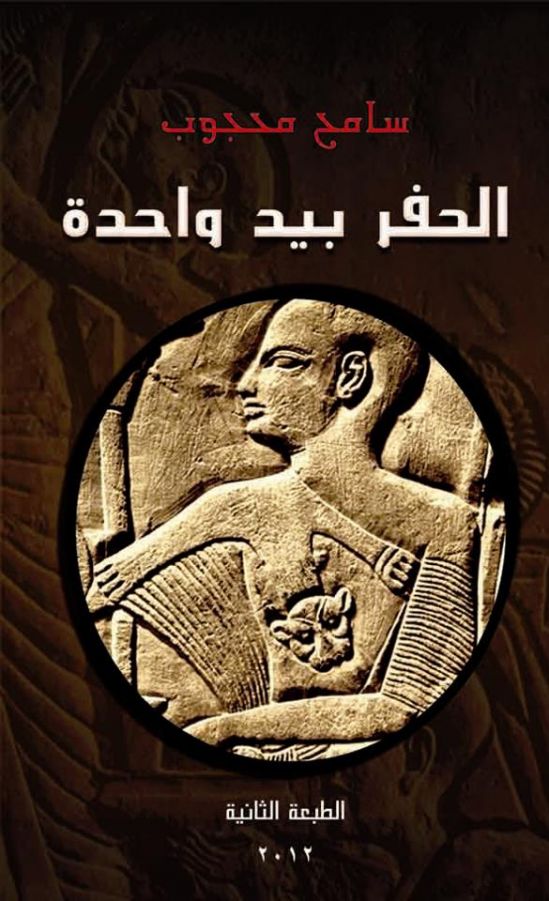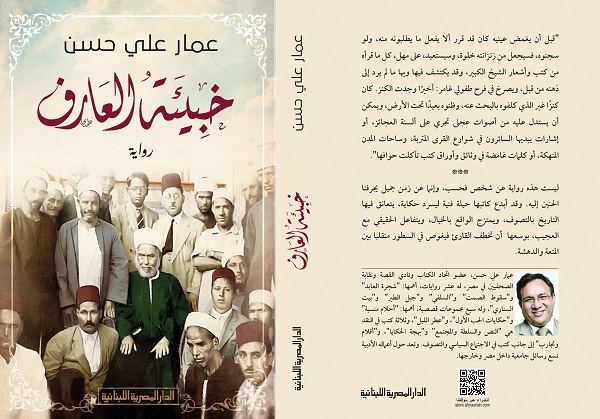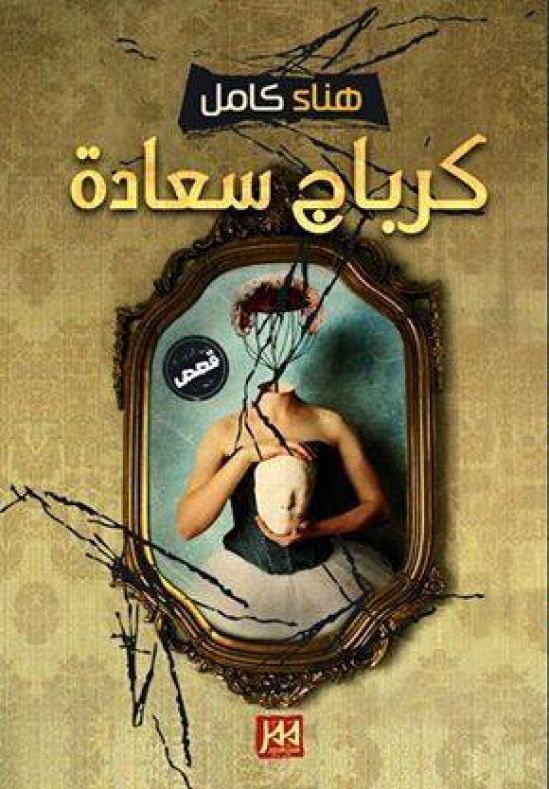هل يبدو الوضع مقلوباً، كما يكتب ياسر عبد اللطيف في قصته (الرُسُل)، وفي مقلوبيته تكمن قسوة الصراحة: أن تُعيد القصة القصيرة، على قصرها واكتفائها، بناء العالم عبر إعادة بناء علاقتنا به؟
إنها فكرة (ترتيب الأرفف)، وهي واحدة من الأفكار المركزية في حقل ياسر القصصي، التي تدعو للانتباه لعالم قديم من أجل تصحيح علاقة ما من علاقاته تتمكن القصة بموجبها من النظر إلى مستقبل جديد، وهو العالم الذي تشكّل المدرسةُ علامته الفارقة، فثمة، على الدوام، نداء يتخلل مجمل القصص يُطلق من مدارسنا القديمة ليدعونا بنبرته الحميمة للالتفات. إنه المكان الذي تصعب من دونه إعادة النظر في حياتنا وإعلان رغبتنا بتصحيح مساراتها التي ستظلُّ على الرغم من محاولاتنا ماضيةً في طريقها. إنهما، معاً، يوجّهان القصة على نحو دؤوب: نداء الماضي والنظر الشغوف نحو المستقبل. لن تكون العودة إلى مكان قديم نتاج شعور بالتورّط في حدث سابق، كما تقول الدكتورة سلوان في قصة (ترتيب الأرفف)، آخر قصص المجموعة، أو شعور عميق بالذنب تجاه أمر مجهول، كما تذهب في تفسيراتها، إنما هي، فيما أظن، محاولة للانفلات من مجهولية العالم وهو يجري على هواه بعيداً عن رغباتنا وخارج امكاناتنا على الفهم والتفسير، لكنها محاولة تقترحها القصة وهي تدعونا على نحو منطقي لمعارضة العالم بالعالم نفسه ونحن نستعين ببعض من تقنياته ولوازمه لإنتاج مشهد جديد.
ستقدّم القصة وهي تواصل المضي على طريق حداثتها خلاصتها العميقة لمثل هذا التعارض وهي تُقصي نفسها من ربقة البحث عن الحلول، لتعمل على تقديم أفضل ما لديها: تجديد الدهشة في مواجهة عالم عصي على الفهم، عبر إعادة روايته كلِّ مرَّة على نحو جديد.
عالم ذو طبقات، ذلك ماتقدّمه قصة ياسر القصيرة، كلُّ طبقة منه تنطوي على مجهوليتها وهي تتفحّص زمنيتها وتتلمس حدودها، المجهولية التي لا تبددها الألفة ولا يكشفها الاعتياد، ففي صُلبها، على الدوام، تكمن دهشة غريبة غير مُفسرة تستلّها القصة مثل خيط من نسيج حياتي، تنفخ فيها وتتركها محلّقةً في سماء الشعور. إنها الخلاصة مرّة أخرى وقد أُعيد ترتيبها في مجرى الألفة ضمن شريط من الوقائع والتفاصيل: “وفي لحظة، بدت لي تلك المسيرة التي قطعها من نهاية الشارع لأوله بين أنقاض المخازن، تمثيلاً رمزياً لمسيرته الأدبية. كأنه لم يكتب “رامة والتنين” و “الزمن الآخر” و” يقين العطش” و “حجارة بوبيلو” وآلاف الصفحات إلا كي تلتقطه عدسة بهذه الهيئة، وعلى هذه الخلفية”، لن تَستحضر خطواتُ إدوار الخراط في قصة (أربع دراسات لضوء النهار) مسيرته، ولن تُستحضر بديلاً عنها، إنما هي تمثيلٌ لها وقد أضاءتها لحظة شعور عميقة أقرب إلى الحلم والتوهّم وانكشافات اليقين، لتبدو القصة، بدورها، تمثيلاً لما هو أشدّ سعة وأكثر تعقيداً، الأمر الذي يمكنه الاجابة عن حضور القصة ذات الأجزاء، كلُّ جزء منها يُضيء طبقة تنفرد بعنوان. ستقدّم قصة (أربع دراسات لضوء النهار) أنموذجاً مناسباً للعالم ذي الطبقات في تجزأته وانفصاله وتعدد منظوراته، فلن تكون بين طبقات القصة علاقة صريحة ظاهرة، إنما هي خيوط مستلة من نُسج، قوّة الاسم ورسوخه في (اسماء سميتموها)، دقة التفاصل وحيويتها في (حدائق الحيوان بالجيزة)، بداهة اللحظة وانكسارها في (إدوار)، ولوعة المشهد وسماحته في (شجرة السرو القديمة). ستكون القصة نفسها بقدرتها على الترتيب والمؤالفة المسوّغ الأكثر تأثيراً في الجمع بين الطبقات، إنها علاقتها الصريحة الظاهرة التي تحرّك مياهاً جوفية تواصل جريانها من طبقة إلى أخرى ومن قصة إلى قصة لاحقة، وهي الصورة التي تُستعاد ملاعبة وحدات السرد، مع العناية بمكونات القصص وعوالمها التي تصفو وتشفّ بفعل التذكّر والحلم وهما يوهماننا بمواجهة أفعال الزمان، لكنها أفعال لا تواجَه، أبداً، ولا تُستعاد، ذلك ماتقدّمه (حلم ليلة حرب) أولى قصص المجموعة وأوضحها مناورة في البحث عن “مزيج عميق من الشفقة والعشق المثالي”، لينتهي العشق مع القفزات الفسيحة في الزمان وتظل الشفقة ترنُّ في أفق “رمادي مع وميض يضوي ثم يخفق كبرق دون رعد”.