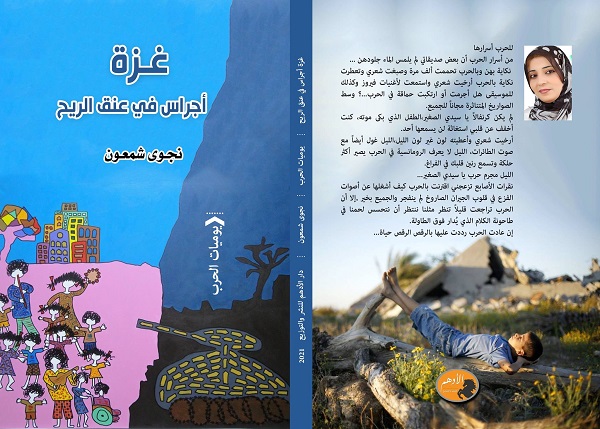الشغف، إحساس رقيق، ليس كما يبدو فى أول انطباع عنه من العنف، لا علاقة له بالطمع أو الأخذ أو التملك مثلما يمكن أن يُتوهم عنه، يمكنك حتى أن تكون شغوفًا بالترك، العطاء، والاستغناء، هو لا يحب التملك أو الاستحواذ، يرضى بأشياء قليلة، تكون بالأساس مشاعًا فى العالم، لا ينتزعها لنفسه، وإنما يتعامل معها ويحبها على طريقته، الشغف، أن يكون لك فى العالم ما يخصك، تصطفى لنفسك فكرة، كيانًا، معنى، روحًا، هو لك، لكنك لا تملكه، ولا أحد يمكنه أن ينتزعه منك، لأنه لا يمكن أن يكون ملك أحد، هو متاح للجميع غالبًا، لكنك تعرفه وتحبه على طريقتك، يصير شخصيًا جدًا لك، شغف، أن ترى ما لا يراه الآخرون، وترى ما يرونه بطريقة مختلفة، أن تصل إلى السر فى شىء متاح طوال الوقت، ويبدو لغيرك عاديًا، ترى الجمال فى تلك العادية والبساطة، تصنع لنفسك مجموعة من التفاصيل، والاصطفاءات، الشغف، لا يُسأل عن أسبابه، أنت لا تتوقف لتسأل نفسك وتتراجع، أنت تتمادى دومًا، لا تنتهى.
الشغف، ليس أن يتملكك شىء بحبك له، وإنما حبك له هو أحد أسباب حريتك، أنت حر فيه وبه بحبك له، الشغف روح من البراح، الصداقة، والراحة، ما أنت شغوف به هو صديقك وصاحبك بالدرجة الأولى، وقبل أىّ شىء يمنحك حريتك، أنت شغوف به لأنك تجد فيه ما لا تجده فى أىّ مكان آخر، تشعر معه بما لا يمكن أن تشعر به مع غيره، ببساطة، لأنك لا يمكن أن تكون شغوفًا إلا بأشياء قليلة جدًا فى هذا العالم، قد لا تتعدّى فى كثير من الأحيان أصابع اليد الواحدة، أو أقل، وهذه الأشياء القليلة تحرك بقية عالمك، تمنحه طاقته، وحريته، ربما تكون شغوفًا حتى بفكرة العالم والكون كله، أو الإنسان، لكنك ستكون معنىّ بتفاصيل داخل هذه الفكرة الكبيرة، لأنه إحساس انتقائى بالأساس، اصطفائى، له خصوصيته ورؤيته الخاصة.
نظرة الشغف من أجمل النظرات فى الوجود، حانية، لطيفة، كلها حياة، بها تلك اللهفة الطفولية، وذلك الشجن الرهيف، وشىء يتجاوز الحب، هى بريق فى الروح، لمعة فى العيون، وشهقة فى القلب، تقفز روح الشغوف إلى عينيه وتنظر، فيظهر ذلك البريق، الذى يتعجب الآخرون منه، من أين له به؟ كيف يمكنه أن ينظر بهذه الطريقة، وما الذى يشعر به الآن كى تظهر تلك النظرة فى عينيه، لماذا ننظر وتتلاقى العيون إن لم يكن هناك شغف؟
الشغف، أورجازم الروح، لهفتها، ونشوتها، شهقة تسحب بها كل العالم إلى روحك وجسمك، شعور يجمع بين لذة روحية وحسية معًا، يجعل الأشياء شخصية وخاصة جدًا، شغف، أن ترتجف الروح كأنما خُلقت لتوّها، يهطل المطر فجأة، تسطع الشمس دون توقّع، يغمرك البرد، يسخن قلبك، تشعر بالمرض فجأة، بأنك فى أحسن أحوالك، أن تشقك السكين نصفين قبل حتى أن تدرك ماذا حدث لك، أن تلتئم كل أجزائك الهاربة منك فى هذا الكون الشاسع الجميل، وتتعرف على بعضها بعضًا، تصدمك الريح فجأة، أن تمسك أنت بالريح من شعرها، وتطوّحها حولك حتى تدوّخها، ثم تُطلقها، فتتفكك إلى نسائم حلوة، وأنفاسًا تنبت منها حيوات أحلى.
القادرون على الشغف يمنحون العالم طاقته، وحماسته، يدفعون فى العالم حرارته ورغبته فى الحياة، هم من يمنح الأرض، هذه العظيمة، القدرة على التحليق، يمنحونها تلك الطاقة لتبقى قادرة على الحياة والفرح، بوجودهم يعرف الكون أن هناك المزيد من المتعة والجمال، هم أصحاب روح حرة، محلّقة، وقلوب شفافة، قوية، معجونة بألوان وبهارات، قلوب متحركة، لا تقبع ساكنة فى الجهة اليسرى أو اليمنى من الصدر، إنما تنتقل إلى العين، الأذن، اليد، فى كل مكان، تغادر إلى الشوارع والهواء والكون بكل ما فيه.
هو، ليس أن تفنى فيما تحبه، رغم أنك مستعد لذلك، لكنك تفضّل أن تحيا فيه، وتحييه فيك، ليس أن تصير أنت وهو كيانًا واحدًا، أنت مستعد لذلك، لكنك تفضّل أن تشعر بكل ذرة فيه، يحتفظ كل منكما بكامل كيانه، تتحسسه بروحك وجسمك، يُفرحك كل شىء يخصه، يضىء العالم بأىّ حضور له أو منه، يرتعش الكون كأنما هزّته يد لطيفة، وتطير فى سماءه ألعاب، ألوان، وموسيقا، شغف، أن يتبادل الروح والجسد طريقتهما فى التعبير عن الحب لبعض الوقت، كى يُجرّب كلٌ منهما مشاعر الآخر وطريقته، ثم يمزجان طريقتهما معًا، ليحصلا على دفقة تدفع فى القلب بهجة الروح، وتدفع فى الروح نبض القلب، تلك الشهقة الطويلة العميقة، التى تُخرج بها الأرض كل مشاعرها وتكون مستعدة للطيران.
الشغف، أحد القوى العظيمة التى تحرك الكون، هو لهفة دافئة، تلقائى، متلطّف، ولأنه عفوىّ دائمًا فهو يرتبك أحيانًا، ذلك الارتباك المرح المحبوب، لا يخفى مشاعره، يفرح ويحزن لأهون سبب، حسّاس لأبعد حد، هو سر، لن يفهمك أحد، لماذا أنت شغوف بشىء ما، لن يمكنك أن تشرح حتى لنفسك، تحاول أن تفهم، لكنك لن تكون مُقنعًا، سيظل بداخلك شىء أكبر من أن تعبر عنه، يبقى السر هناك، عندما تتحدث عن ذلك، ستشعر بروحك تحلّق، وبجسدك يعلو، فتعرف من جديد أن شغفك أكبر من أن تقبض عليه، وتحبسه فى كلام، تبتسم له، ولنفسك، تتركه، أنت لا تريد أن تفهم، ولا يعنيك أن يفهم الآخرون، هذا شغفك أنت.
لولا الشغف لكانت روح العالم فى مأزق كبير، لولاه لخمدت هذه الروح، وصارت بليدة، بطيئة حد التعاسة، بدونه يضمر العالم، ينطفئ، تضيع ألوانه، ويفقد رغبته فى الحياة، لا تبقى لديه أية رغبة، حتى فى مجرد المشى أو النظر للأشياء من حوله، كل ما هو راكد، مملّ، وحزين فى هذا العالم، لا يحتاج غير قطرة واحدة من الشغف ليشع نورًا وحياة.
خاص الكتابة