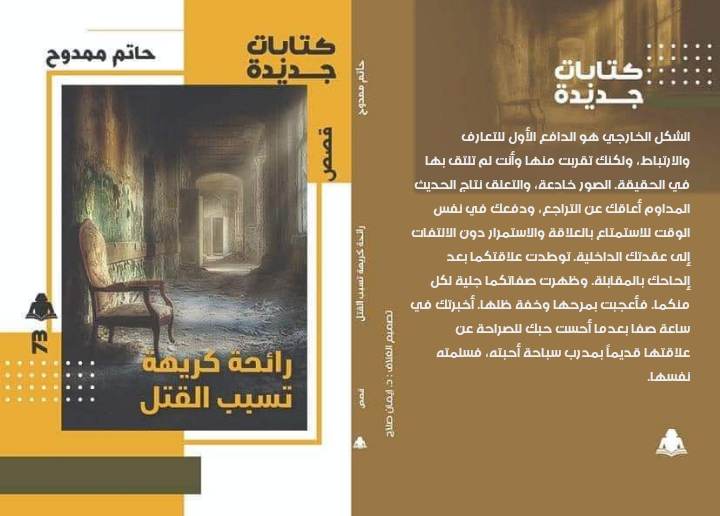يخونها الصوتُ، كما خانها اللونُ، أي روعةٍ لحكاية لا صوتَ للراوي فيها، وليسَ ثمةَ صدى يرتدُّ عنْ كاهلِ تضاريسها؟! ولا لونَ يطرز الكلمات المتناثرة عبر منعطفات عابرة تغيِّرُ شكلَ الخاتمة ِلتبدوَ أكثر استحالة؟ تستفحل في رأسها أسئلة عقيمة، تنبت في أوردة الخوف فيها دون هوادة:
هل الصدى جسدٌ لأصواتنا؟ أم الظل صدى لأجسادنا؟ أيهما الحقيقة؟ وأيهما الوهم؟ من يبررُ الآخر؟..الحقيقة أم الوهم؟ من يسبقُ الآخر..الواقع أم الحلم؟؟
تختنقُ العبرةُ في عينيها البنيتين، وحيدة هي كنجمٍ في سماءِ ليلةٍ شتويةٍ، تسترقُ النظرَ عبر شبابيكِ الحكاية، الشاطرُ حسن ملقى في السجن بتهمةٍ مجهولة، أخذهُ رجالُ الأمن ورموا به في غياهبِ الزنزانة، ولم يفكروا حتى في إخبارهِ عن التهمةِ الموجهةِ إليه، وما زالَ يرقِّـعُ جدرانَ الزنزانةِ بصوتهِ المثقل بالأسئلة العقيمة، ويحصي الذنوبَ التي يمكنُ أنْ تكونَ قدْ أوصلته إلى هذا المكان الموحش، دونَ أنْ يدركَ بشكلٍ مؤكدٍ لمن يدين في حجزِ سنواتهِ المتبقية بينَ قضبان أدمنتْ جحودَ الوجع.
علي بابا لم يعدْ معجباً بأميرته ياسمينة، فقد صادفَ وأن رأى زوجة أخيه، فتمايستْ الأخيرةُ أمامه وتكسَّر صوتُها بغنجٍ مبتذل، كانت تريد أن تثبتَ لنفسها أنَّ بمقدورها أنْ تنافسَ امرأةً رائعةً كياسمينة، فالغيرةُ توغرُ صدرها كلما سمعت الناس يتحدثونَ عن تلكَ بانبهار، ورغمَ أن زوجة أخيه تافهة كدمية صينية قديمة مكسوة بالطلاء، إلا أنه تركَ ياسمينتهُ معلقةً على خدِّ حكايةٍ مارقة، وراحَ يصففُ كلمات الغزل للدمية الحمقاء، لم يعدْ بمقدورِ ياسمينة أنْ تسامحهُ هذه المرة، فقد كان الجرحُ قد غارَعميقاً، وتكدستْ الشروخُ في قلبها معلنةً هزيمةً نكراء لامرأة عزلاء لا تجيدُ فنونَ القتال، بعدها تلاشت روائحُ الياسمين عن جدرانِ المنزلِ القديم، إذ أنَّ الدموع التي لم تهطلْ كانت تتحولُ تلقائياً إلى ريحٍ تسرقُ الروائحَ الطيبةَ، وتجهزُ عليها بصمت، هل يهمُ بعدها إن كان أخوه حياً أم ميتاً؟ هل سيبحثُ عنه في البئر؟ أم سيتركهُ معلقاً هناكَ بينما أميرُ الجنِّ يسألهُ ذاتَ السؤال الأحمق: أيهما أجمل؟ ويحارُ الرجلُ فلا يجدُ جواباً ينقذهُ منَ الموتِ على تخومِ قصرٍ شاهقٍ بُنيتْ جدرانهُ من جماجمِ رجال آخرين، استعبدتهم الغواية، ففاتهم سحرُ الوهمِ المعلـّقِ بشغافِ أغنيةٍ تداعبُ قلبَ عاشقٍ.
الأميرة قوتُ القلوب المعروفة بجمالِ إطلالتها وعمقِ تفكيرها، وثقافتها وطيبِ معشرها، لم تعدْ القلوب ترغبُ بها قوتاً يومياً، فقدْ استعمرها المللُ، القلوبُ الآن تسبحُ في بحرٍ من الدهون، فالهامبورغر والكولا فعلا فعليهما في تلك القلوب، وهكذا أصبحتْ قلوباً صلبة قاسية..كل ما فيها يرشحُ بالسموم، “من أين يمكنُ للحبِ أن يتسللَ إلى قلوبٍ كهذه؟!” : قال الحبُ في نفسهِ، وانطلقَ حاملاً وردته الحمراء، وقيثارته، بعد أن قصَّ جناحَ الحلمِ ليصبحَ عصرياً بما فيه الكفاية، وصنعَ له قبعة تقيه جنون المطر..ولكن هل تمطر العيون بعد؟ لم يشغلْ باله كثيرا بهذا السؤال، اكتفى بغرسِ القبعة على رأسِ الحلم، وتسللَ مودعاً قلوباً متخمة بالشحوم والسموم والكره..ولم يرَ أحد الحبَّ بعد ذلك، قيلَ أنه رحلَ إلى كوكبٍ آخرَ، وقيلَ أنه قتل نفسه برميها عن جبلٍ عالٍ..وقيل أنه بكى حتى فقدَ بصره.. .وقيل..وقيل..الإشاعاتُ كثيرةٌ، بعضها لا تليقُ بمخلوقٍ رقيقٍ مثله، لكن من يأبه؟!..الحقيقةُ الواضحة والأهم أنَّ الحبَ لم يعدْ موجوداً هنا، ولا حتى هناك.
وأما شيخُ التجارِ، فقد أفلسَ منذ شهور، إذْ أنـَّه لم يطقْ أن يرى أبناء مدينته جائعين، فباعَ لهم أصنافَ الطعام بأقلِ من سعرِ التكلفة، كان العسسُ عندها يقصفونَ أنحاء المدينة، بأمرٍ من سلطانٍ أحمقَ لا يجيدُ التحدثُ بعيداً عن لغةِ السيفِ والدم، شعرَ شيخُ التجار بالأسف، كيف يمكنُ للجوع والموت أن يلتقيا معاً في مدينة كهذه؟ وعاهدَ نفسه إن لم يستطعْ أن يهزمَ الموتَ فسيهزم الجوع على الأقل، لكنه أعلنَ افلاسه قبلَ أن يعلن انتصاره على الجوع، وانضمَ إلى قائمة الجائعين في بلده.
ولم تطقْ ابنةُ شيخِ التجار أنْ ترى أباها في هذه الحال المؤسف، فتزوجتْ أحد الوزراء المعروفين بتورطهم في ملفاتِ الفساد لتنقذَ سمعة أبيها، لكن أبوها فارقَ الحياةَ فوراً بعد العرس إثرَ ذبحةٍ قلبيةٍ مفاجئة، إذ تناهى إلى سمعهِ أن الناس يتناقلون عنه إشاعةً مفادها أنه باعَ ابنته لينقذ مكانته الاقتصادية.
ومن شباكٍ أخر من شبابيكِ الحكايا، كان سندباد قد تركَ السفر، وتقدمَ إلى وظيفةٍ رسميةٍ تطعمه خبزاً،عملاً بالمثل القائل:” ساقية جارية ولا نهر مقطوع”، ومنَّ اللهُ عليه بوظيفةٍ في دائرةِ النفوس، ففرضَ أتاوةً على الناس لقاءَ كل ورقةٍ يحتاجون إليها، وأصبحَ من أغنى أغنياء البلد خلال أقل من سنتين، وتسابقت الجميلاتُ تطلبنَ وده، فتزوجَ أجملهن، وكان مهرها بيت وسيارة موديل سنتها..عدا الألماس والمجوهرات، وأقام عرساً تحدثَ عنه القاصي والداني، وعاشوا في سباتٍ ونبات وخلفوا صبياناً وبنات، لكنه لم يكتفِ بها زوجة، فتزوجَ أخرى وثالثة، وعاد فطلق الثانية، فأصبحت الثالثة تدعى الثانية، ثم أنه تزوجَ ثالثة..وكل هذا وأولاده وبناته يرتدون أجملَ الحلل، ويرصعون كفوفهم بالياقوت والذهب والفضة، وتخدمهم الجواري والخادمات، لكنهم يفتقرون لأدنى تربية واحترام، ولم يفلحْ أحد منهم في تجاوز المرحلة الثانوية، ولم يُجدْ أحدٌ منهم سوى تحريكِ فكهِ اجتراراً لأطايبِ الطعام أو لخبائثِ الكلام.
أما الصياد، فقد تركَ الصيد التقليدي، وصارَ يستخدمُ الديناميت بالصيد، مما وفرَ له صيداً وفيراً واستغنى عن جهودِ الجنية التي كان ينتظرُ قدومها على تخومِ الحكايةِ لتساعده في الصيد، ولهذا فقد أصيبتْ الجنية بانهيارٍ عصبي، بعد أن علمتْ أنه لم يعدْ لها مكانٌ في عالم الحكايا، وأنها فقدتْ وظيفتها إلى الأبد.
وعندما استدارتْ شهرزاد إلى شباكٍ آخر، وأزاحتْ الستارةَ الباهتةَ عنها، وجدتْ العفريت وقد تحولَ إلى اقتصادي كبيرٍ في وطنه، فأخبرها أنه صاهرَ حاكم ذلك البلد، وصار مسؤولاً عن جميع الصفقات المشبوهة التي لا يستطيعُ الحاكم أن يوسخ فيها اسمه بشكل علني، لكنه يستطيعُ بكلِّ تأكيدٍ أنْ يضعَ كل أموال الخزينة في تلك الصفقات على أن يبقى اسمه مختفياً عن الأنظار..وصارتْ جميع الصفقات باسم العفريت المذكور، والربح يذهب إلى جيبِ الحاكم وأخيه.
وعندما نظرتْ شهرزاد إلى أقصى يمينِ شباكِ الحكايا، كان الحكيم رويان هناك، يضرمُ النارَ في الكتبِ اليونانية والفارسية والعربية والسريانية التي جمعها وحفظها، لاعناً حظه الذي جعله يضيعُ عمره في حفظِ العلوم وتجميعها، بينما يأتي الآن حفيدهُ ليضع الحكيم غوغل في مقارنةٍ معه، والأنكى من ذلك أن الحكيم غوغل يربحُ المقارنة كل مرة..رغم أنه لم يقضِ عمره في جمع تلك الكتبِ وحفظ العلوم واستذكارها.
وعندما نظرتْ إلى شباكٍ آخر فاجأها الملكُ العادل فبينما كانت تعتقدُ أن الملك عادل حليم، وأنه عالم متعلم، رأته وقد تدلتْ كرشه وخاصرته أمامه، وهو لا يفتأ يأكلُ مالَ الناسِ بالباطل، ويظلمهم، ويوقعُ البغضاء بين الشعوب، ويضرمُ نارَ الفتنةِ الطائفية هنا وهناك، ليبقى متربعاً وحده على ذلك الكرسي اللعين، كان لا يكتفي بذبيحةٍ واحدةٍ على الغداء، كما لا يكتفي بامرأة واحدة على السرير، فبأي حال لم يكنْ في مقدورهِ أن يتباهى إلا بهذين الأمرين، وعلى إحدى الزوايا انتبهتْ فجأةً إلى أن النواة التي رماها المسافرُ بعد أن أكلَ التمرة، فقتلتْ ابن ملك الجن، وخرجَ أبوه غاضباً يريد أن يقتصَ لوحيده، أصبحتْ سلاحاً نووياً بامكانهِ أنْ يقتلعَ مدينةَ الجنِ من مكانها ولا يبقي فيها من يخبر بما حصل، فارتعدتْ خوفاً وتركتْ هذا الشباك بأسرع ما يمكنها، متجهةً إلى غيرهِ، وهناك رأتْ مرجانة ونزهة الزمان، وقد أصبحتا من أشهرِ مطرباتِ العصر، بعد أن ربحتْ إحداهما المركزَ الأول في ستار أكاديمي، بينما قامتْ الثانية بإخراجِ فيديو كليب فاضحٍ لأغنية لها، تتعرى فيه وترقص بحركات مثيرة، وصارتا من ألدِّ الأعداء ضراوةً لبعضهما، فهذه تطلقُ الشائعات على تلك، وتردُّ الأخرى عليها باعلان فضائحها المستورة، حتى التقتا يوماً عند طبيبِ التجميل الذي تعود أن يضخِّم بمبضعهِ كل شيء فيهما إلا الدماغ، واكتشفتا أن هناك أسراراً مشتركة بينهما لا يمكن أن يفضحاها، كعدد عملياتِ التجميل التي قامتا بعملها، وكم السيليكون المغروس في صدرِ هذه، وشفاهِ تلك، فتحولتا منذ ذلك اليوم إلى صديقتين ظاهرياً، وأخفيتا العداوة والغيرة في قلبيهما، وأعلنتا في جميعِ وسائلِ الإعلام أنهما أصبحتا صديقتين لصالحِ فنهما وجمهورهما، ورغمَ ذلكَ لم يستفدْ الجمهورُ شيئاً من معاهدةِ الصلحِ التي تمت بينهما، عدا تقلصِ عدد الإشاعات المتناقلة عن هذه وتلك.
لم تطقْ شهرزاد الحكايا الداكنة غير الملونة، والسيدات اللواتي يشبهنَ بعضهن، وكل شيءٍ فيهن منتفخ من الوجنات حتى…، ولم يعجبها أن تتحدثَ عن ناسٍ دون ملامح، يزدردونَ أحداثَ يومهم بوجهٍ لا يقولُ شيئاً، فانكفأتْ تبحثُ عن مسرور، وشهريار، لعلها تخبرهما أنه لم يعدْ ثمةَ حكايةٍ في جعبتها ترويها ليبقيها الملك حيةً لأجلها، وأنهُ بامكانهِ أن يقتلها في الحال والتو.
لكن الملك كان بدوره منشغلا بمتابعةِ دوري كرة القدم، يقيمُ الدنيا ويقعدها بصراخهِ المدوي لأجلِ كرة دخلتْ في المرمى، تساءلت في سرِّها: هل يمكن أن يصبحَ شهريار بهذا السخف؟ وانتبهتْ إلى مسرور وهو جالسٌ عن يمينِ مليكها يقصُّ بسيفهِ البرتقالَ والتفاحَ له، وقد علا الصدأ حوافَ السيفِ الذي كان يرهبُ أكثرَ الرجالِ قوةً، فاستدارتْ عائدةً إلى غرفةِ نومها، محاولةً أن تتناسى طعمَ المرارةِ الذي انتشرَ في حلقها كسرطانٍ خبيث، وأسدلتْ الستائرَ التي لا لونَ لها على شبابيكِ الحكايا التي فقدتْ صوتَها، واندستْ في فراشها، آملةً بحلمٍ ملون بعد أن افتقدتْ الألوان طويلاً، وفيما هي تغطُّ في نومها، كانتْ إحدى جواريها وتدعى ميمونة، تضعُ حيـَّةً سامةً في فراشِ سيدتها، لعلها تموتُ فتستطيع الاختلاءَ بالملك، لتصبحَ ملكة الحكاية بدلاً من شهرزاد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
لبنى ياسين
قاصة وفنانة تشكيلية – سوريا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللوحة لـ: لبنى ياسين
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
خاص الكتابة