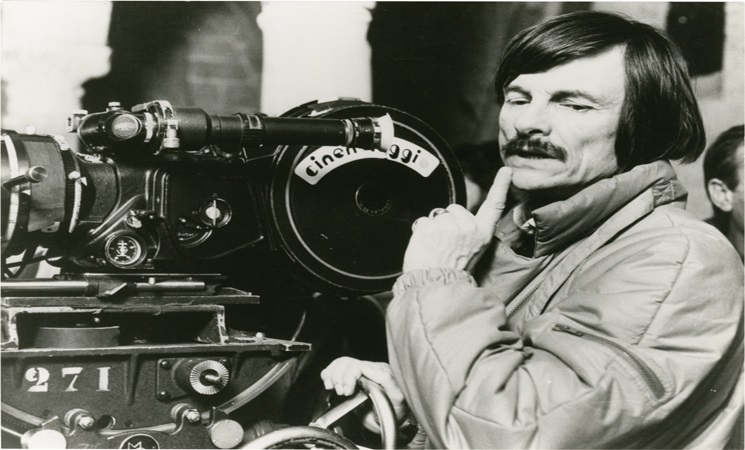وإذا ما استبعدنا إتهام كاملة ومريم بتقديم عمل نسوي بإعتبارهن تؤاماً ملتصقاً منذ تجربتهن السينمائية في فيلم “واحد صفر”مستندين الي التصنفات العقيمة التي تجعل الجنس مرادفاً للإبداع او موازياً له فلن نستبعد نسوية الطرح في دراما “سجن النسا” نظراً لطبيعة الموضوع الذي يضع النساء في صدارة المشهد الدرامي في حين يعمل الرجل كعامل محفز لتركيبة كاملة ومريم الدرامية بالإضافة لوجهة النظر المتعاطفة مع كثير من النماذج الانسانية التي قدمت ببراعة ومصداقية ولكنها تؤكد أيضاً علي ذكورية مجتمع ينكل بالمرأة ويمتهن إنسانيتها في سلسلة متتابعة من القهر الذي يلقي بهن خلف القضبان أو يضعهن علي منصة الاعدام ليقدمن أنفسهن قرباناً لذكورة المجتمع قبل أن يقدمن أرواحهن ليكفرن عن خطاياهن.
الدفقات الابداعية التي تخللت الأحداث المتتالية ارتكنت علي مجتمع سجن النساء وعبرت عنه من خلال وجهتي نظر مختلفتين لنيلي كريم السجانة التي تلقي بها الظروف من أمام القضبان لتستلقي خلفه كسجينة قبل ان تحملنا الاحداث عبر رحلة تبدأ بميراث لمهنة حارسة سجن النساء تقبلها البطلة لمجرد البقاء في منزل متواضع في عزبة السجن خوفاً من التشرد والبقاء بلا مأوي ليستعرض العمل هذا العالم الخفي علي كثير من الناس والذي لم يطرح إلا من خلال أعمال وثائقية محدودة في الطرح والعدد وهو ما يثبت الجهد الذي بذلته المخرجة وكاتبة السيناريو في البحث وهو الجانب الذي يفتقده كثير من كتاب السيناريو والمخرجين الذين يتعاملون مع الدراما بمنطق “السبوبة“.
هذا العالم القاسي في مظهره قد يحمل في طياته الكثير من الوداعة التي نلمحها في شخصية “إحسان” سلوي عثمان وغيرها من الحارسات وعلي النقيض منها تأتي ابنتها “نوارة” ريهام حجاج التي لم تمارس هذه المهنة ولكنها تحمل من القسوة والحقد الكثير ، ورغم استحواذ نيلي كريم علي إهتمام المشاهد بإعتبارها بطلة الاحداث التي برعت في التحكم في أدق تفاصيل الشخصية وانفعالاتها المختلفة لتثبت وجودها كنجمة تستحق الاحترام تفرد المخرجة كاملة ابو ذكري مساحة من الاختلاف لسلوي عثمان المخضرمة وريهام حجاج التي برعت في تجسيد حالة من الشر المبرر الذي يسير علي قدمين فهي تحاول انتزاع حقها في الحياة ولو علي حساب اقرب الناس اليها.
فنيلي كريم هنا لا تتعامل مع دورها بالمتر كغيرها من بطلات دراما رمضان اللاتي يردن لمشاهدهن ان تكن من “الجلدة للجلدة” ضاربين بما يعرف بالسيناريو عرض الحائط لمجرد ارضاء غرورهن ، فرغم غياب نيلي عن بعض حلقات المسلسل إلا ان حضورها في مشهد عابر كفيل بتسيدها لهذا العمل بما قدمته من أداء جاد ومختلف عن الكلاشيهات المتعارف عليها خاصة وأن العمل يحمل جرعة كبيرة من الميلودراما دفعت البطلة للإنهيار لمرات ومرات ولكنها في كل مره تجتهد وتبهرنا بردود أفعال مختلفة في كل مرة لتؤكد قدرتها علي تقمص الشخصية والتحكم في درجات انفعالها حتي ان المشاهد تقبل النهاية الدموية التي اختارتها واختلفت ايضاً في تعاملها مع غريميها في تتويج أخير لأداء نيلي كريم في “سجن النسا“.
ورغم تراجع مساحة دور أحمد داوود هذا الشاب الوديع الذي انطلق مع مغامرة آل العدل في فيلم “ولد وبنت” الأهم بين تجاربهم السينمائية في السنوات الاخيرة إلا انه إحتفظ برصيد من الكره لدي الجمهور من خلال تقديمه نموذجاً صيغ بعناية فائقة مع ما يحمله من تناقضات بين حبه لـ”غالية” وحبة للحياة فهو يهجرها ويتزوج من غيرها ولكنه يدرك انه يحبها وحين يفقد زوجته لا يجد اقرب من حضنها ليرتمي فيه ويبكي فهو يعترف انه “واطي” ولكنه يتمسك بهذه الصفة لأنه يراها العامل المحفز لتركيبة الحياة التي يعيشها داخل هذا المجتمع الذي نهشته المادية فشوهت تركيبة البشر ليتحولوا تدريجياً إلي مصاصي دماء.
ويقدم سيناريو مريم نعوم شخصية “حياة” التي جسدتها دنيا ماهر في اطلالتها الثانية علي الجمهور بعد تجربتها السينمائية الأولي في “الخروج للنهار” مع المخرجة هالة لطفي والتي تعتبر النقيض لشخصية “صابر”وتحاول التعايش مع مجتمع ينهش بعضه بعضاً بوداعه لا تتناسب مع شراسة من يحيطون بها وتزداد تحولات الشخصية مع اصابتها بوساوس مما تعيشه من عنف يدفعها لتجاهل “الهنجرانية” التي تسرقها داخل السوق او السكوت علي شخص يتحرش بها في احدي وسائل المواصلات وتتكشف الشخصية شيئاً فشيئا خلال الحلقات في مقدمات محكمة تؤدى الي نتيجة مأساوية فهي الام التي ترفض إطعام اطفالها فاكهة تشك في كونها مسرطنة مع ما تحمله الصحف من اخبار تشير الي الفساد الذي استشري او منع طفليها من الذهاب للمدرسة خوفاً عليهما من وحشية ما يربض خارج المنزل من اخطار وعنف يمارس ضد الأطفال لتقرر في النهاية التخلص من حياتها ومن تحب بعد اتهامها بانها غير طبيعية وكأن الحياة العبثية التي تعيشها طبيعية للغاية حتي يبرر هذا لزوجها السماح لشخص ما ان يلمسها بحجة اخراج الجن منها وهو ما ترفضه لانها تري فيه تحرشاً.
ومع توالي موجات القسوة والامتهان تقرر جمع من تحبهم في رحله الي العالم الاخر ولكن المأساة التي تعيشها تجعلها تفقدهم لتبقي في هذا العالم القبيح وتتمني أن تعدم لتلحق باطفالها وزوجها في عالم أفضل حتي انها تستقبل خبر وفاة والدتها بابتسامة عريضة لأنها تري في رحيلها عن هذا العالم غاية ما يتمناه كل شخص ما زال يحمل انسانيته التي غدت قيداً يدميه مع وحشية هذا العالم.
وتقديم هذه الشخصية بتفاصيلها الموجعة وصراعاتها النفسية العديدة ضمن عمل يحمل كماً كبيراً من الأحداث يؤكد علي أن مخيلة مبدعها بمثابة منجم من شخصيات لا تنضب خاصة وانها تتحمل تصدر عمل درامي منفصل عن “سجن النسا” فتتابع مشاهد “حياة” بمعزل عن المسلسل يصنع فيلماً روائياً ينتهي بالمشهد الأجمل والأكثر ابداعاً للعشاء الاخير الذي قدمت كاملة ابو زكري من خلاله تشكيلاً بصرياً رائعاً معتمدة علي اللقطات القريبة والضيقة لتمزج بين مفردات المشهد بما يحمله من دلالات تسهم في صنعها دموية “الصلصة” وبخارها الابيض الذي يصعد للسماء لتوجه بوصلتها بعيداً عن هذه الارض وما تحمله من عفن.
وتثبت روبي تفوقها بإمتياز لتؤكد تجاوزها لتقدير مقبول الذي حصلت عليه كممثلة بعد تجربتيها في فيلمي “الوعد” لوحيد حامد ومحمد ياسين و”الشوق” لسيد رجب وخالد الحجر وتحفر إسمها كممثلة علي حائط بطولات “سجن النسا” من خلال شخصية “رضا” التي برعت في تجسيدها بل وتألقت كممثلة وهو ما يحسب لكاملة ابو زكري التي وفقت في اختيار كتيبتها من المشخصاتية فروبي لم تعد فتاة “العجلة” التي أثارت سخط البعض ولكنها اصبحت ممثلة تستحق الالتفات اليها وتوظيفها في أدوار أكثر أهمية من تجربتها مع شريف صبري الذي حرمنا بدراجته الاحتكارية ممثلة موهوبة.
وترتبط روبي أو “رضا” بشخصية “دليلة” التي جسدتها ثراء جبيل في اطلالة ليست الاولي ولكنها الاهم في بداية مشوارها مع تميزها في تقديم شخصية مركبة تمر بثلاثة مراحل مختلفة تدفع تدفق الدراما فهي تلك الفتاة المرحة وهي القاسية المتجبرة هي العطوفة المحبة وهي الغيورة حتي من خادمتها وهذه التناقضات التي تبرزها المشاهد المتتالية تضعنا أمام نموذج حقيقي يعرفة كثير منا ليؤكد علي انسانية شخصيات مريم نعوم بعيداً عن الافتعال الدرامي الذي يستلهم نموذج “نحن لا نزرع الشوك” في كثير من الاعمال فثراء جبيل كتبت شهادة ميلادها كممثلة مع توقيع كاملة ابو زكري ومريم نعوم لشهادة وفاة “دليلة“.
ورغم صعود درة وتصدرها تترات أعمال درامية مختلفة الا انها قدمت اهم ادوارها علي الاطلاق في “سجن النسا” فشخصية “دلال” وضعت درة في أكثر من اختبار مع كل نقلة درامية تمر بها الشخصية ومع كل اختبار حصلت درة علي الدرجة النهائية في الأداء التمثيلي فشخصية دلال في الحلقات العشر الاولي ليست هي في الحلقات العشر التي تليها وفي نهاية المسلسل اختلفت عن المرحلتين السابقتين.
وتحلق الرائعة سلوي خطاب لتتجاوز قضبان “سجن النسا” وتخترق فضاءات الاداء بعفويتها وتمكنها رغم ادائها لشخصيات قريبة من طبيعة شخصية “عزيزة” الا انها استشعرت التركيبة المختلفة لهذه المرأة الوفية المحبة رغم قوتها وسطوتها المتسامحة رغم الخيانة والمنتقمة لكرامتها فهي نموذج فريد صيغت مشاهده بعناية وقدمته سلوي خطاب بسهولة تمتنع علي الكثيرات من ممثلات هذا الجيل.
ولا شك أن هذا العمل قدم سيمفونية انسانية تعبر عن الواقع المصري عزفتها مجموعة من ربات الاداء التمثيلي واذا ما تناولنا كل شخصية علي حدة فلن يتسع الوقت ولن تكفي السطور لمجرد ذكرهن ومن بينهن نسرين أمين التي خرجت من مخيلة يسري نصر الله في “احكي يا شهرزاد” وها نحن نراها أكثر نضجاً مع كاملة ابو زكري في تجسيد شخصية “زينات” أو “شفيقة” فهي تقدم شخصية مزدوجة تتطور قبل أن يلتئم جزئيها وتموت داخل اسوار سجن تسعي للعودة اليه كلما خرجت منه حفاظاً علي حياتها كما تمنحنا كاملة ابو زكري وجهاً جديداً لنهي العمروسي التي برعت في تجسيد شخصية هذه الام التي تضحي من اجل ولدها قبل ان يهجرها ليسافر.
وفي نفس المنطقة تقف ليلي عز العرب لتقدم شخصية ارستقراطية خلف قضبان سجن القناطر “بالشوكة والسكين” ولكنها تتألق مع حضور سلوي خطاب خاصة مع التضاد الذي خلف الكثير من الكوميديا التي تنبثق من التصادم الطبقي بين من يقفون اعلي السلم الاجتماعي ومن يجلسون أسفله وتؤكد سناء يوسف علي حضورها في شخصية القوادة التي لا تخجل من استدراج ابنة شقيقتها للعمل في الدعارة وتتالق مع الحوارات التي كتبتها مريم نعوم وهالة الزغندي بعناية وابتكار الي جانب ألاء نور التي تخبطت بين التمثيل وتقديم البرامج لتعيد كاملة ابو زكري اكتشافها مجدداً في دور ساهم في اضفاء شيئ من البهجة علي الشاشة كما تبرع هبة عبد الغني في تجسيد شخصية الام التي تتمزق بين قضبان السجن وبين ابنتها التي تقف خارجه قبل ان ترتدي البدلة الحمراء وتنتظر مصيرها الذي يتحول لشبح يدفعها وزميلاتها في عنبر 8 المخصوص لعدم النوم قبل طلوع النهار خوفاً من جرهن لمنصة الاعدام في اي لحظة لتبدو هبة في اطلالتها الاخيرة تستجدي الحراس الذين يصطحبون روبي او “رضا” لتنفيذ حكم الاعدام لتخبرهم انها جائت الي هذا المكان قبلها.
وتؤكد فاطمة عادل وجودها بحضور واضح في شخصية “هنادي” الفتاة الصغيرة التي تنتقل من خدمة نهي العمروسي مع وصول سلوي خطاب او “عزيزة” ربة السجن في انتهازية تستغل من خلالها امومة “عزيزة” وتلقي بشباكها حول زوجها قبل ان تعيدها “عزيزة” للسجن وتنتقم منها بحرمانها من حلم الامومة في مشهد قصد أن يقترب من مشهد الاغتصاب الذي تعرضت له “هنادي” من السيدة الشاذه قبل أن تنقذها عزيزة وها هي الان تغتصبها في انتقام قاسي القي بها خارج الأحداث.
خلاصة القول اننا أمام عمل يحمل مقومات البقاء لا النجاح فقط لانه غزل علي الورق بعناية شديدة منحت كل شخصية حقها في البطولة ونفذ بحرفية وتكنيك سينمائي عالي يحمل الكثير من الجماليات بداية من حوار مريم وهالة ثم صورة نانسي عبد الفتاح الضلع الثالث لمثلث كاملة ومريم ومروراً بديكور شيرين فرغل وملابس ريم العدل وانتهاء بموسيقي تامر كروان التي عبرت عن ملايين المشاعر المتضاربة وحملت تيمتها الرئيسية الكثير من الوداعة والشجن لتسهم وتريات تامر كروان وأنات العود التي تعزف علي أوردة وشرايين قلوب ما زالت تنبض ودقات البيانو الموجعة التي تستحث انسانيتنا في كل مشهد بداية من التتر الرائع لحائط تملأه الشقوق حتي تتر النهاية الذي يداعب ارواحنا بوداعته في بكائية تعكس الوجه القبيح لمجتمع “سجن النسا” الذي تجاوز منطقة سجون القناطر وامتد قضبانه ليحيط بهذا الوطن.