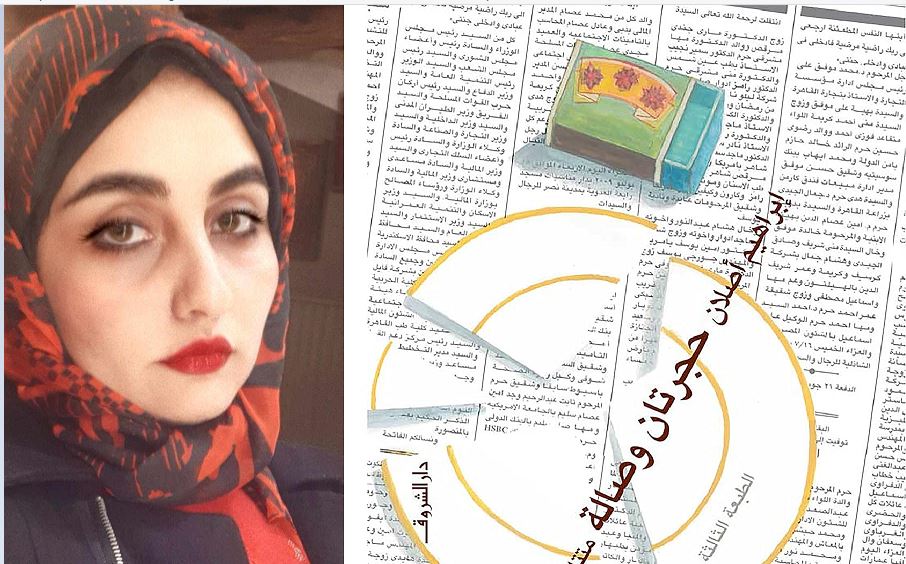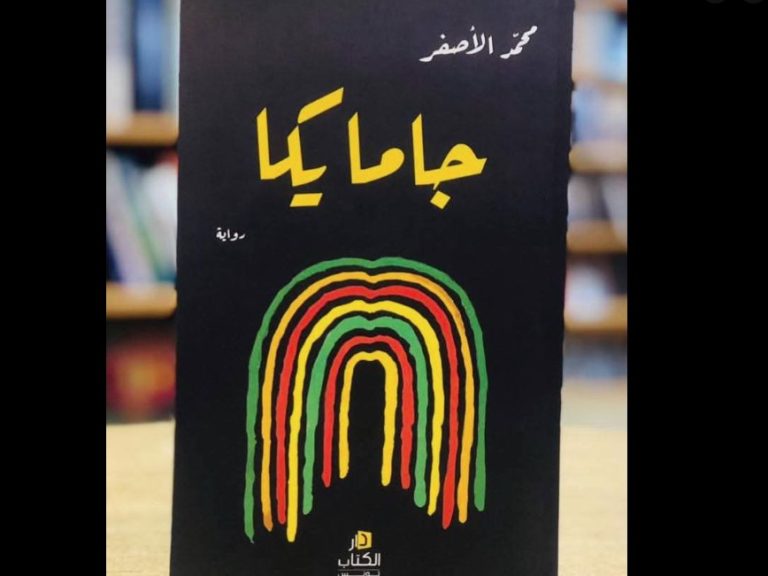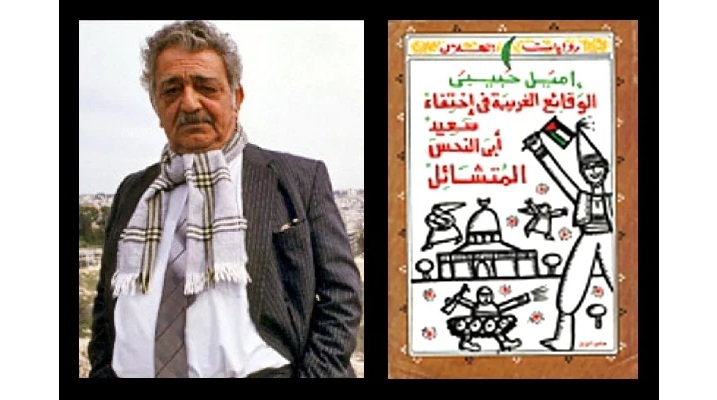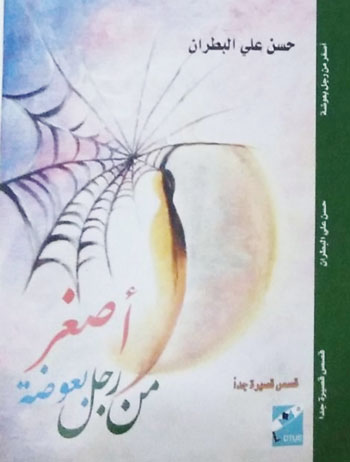سارة القصبي
كيف يكتب إبراهيم أصلان؟
هذا السؤال لطالما دار في خاطري أثناء قراءتي لهذا الكاتب المميز. ما توصلت إليه هو أنه لا يكتب، بل يبث كمذياعٍ ينقل الحدث بدقة وحرفية شديدة. يغرقك فيما حدث وما سيحدث بين خطوط يديه.
إنه نوع من الأدب البسيط، لكنه ليس سهل الكتابة. يكتب دون أن يغرق القارئ في الملل أو متاهة السرد، ودون صراع مع التفاصيل الدقيقة التي تملأ الأحداث.
أحدثكم من أمام باب ثلاجة الست إحسان، المزين بقطع فاكهة بلاستيكية تلتصق بمغناطيس، لتظل ثابتة على أبواب الثلاجات. تسقط القطع تحت قدم أستاذ خليل فيشوطها بقدمه ويخفيها تحت الثلاجة، تضايقًا من استمرار وقوعها. وهنا، في هذا المشهد البسيط، يبحث عن أكثر زجاجة ماء باردة، وبالأخص زجاجته غير المغطاة، حيث تكون أكثر برودة وصاحبة أفضل مذاق. كان يخشى أن تكتشف الست إحسان إخفاءه لأغطية بعض الزجاجات، لأنه يحبها هكذا! أو ليلًا، عندما تبحث الست إحسان عن قطع الفاكهة لتلصقها بباب الثلاجة، ويشعر بالأسى لأنه يخفيها بطرف قدمه. أول ما تبادر إلى ذهني هو ثلاجة صغيرة موضوعة بمنتصف المطبخ، وفوقها قطع الزينة بلون أخضر فاتح، من باب واحد، على الأرجح من مصانع الإنتاج القديم. أرففها الحديدية الواسعة تحتفظ برونقها، وقدرتها على التجميد والتبريد. وبنفس خفة يد الأستاذ أصلان، يضيف إلى القلب شعورًا بالدفء عبر رائحة الفول المدمس الذي تقوم الست إحسان بتحضيره كل ليلة فوق الفوالة الكهربائية أو سخان الكهرباء.
“كل يوم في الليل، كانت تضع كمية صغيرة من الفول في قدرة التدميس الألومنيوم ببطنها المنفوخ، ثم تنقلها إلى البوتاجاز. وبعدما تغليه مرة واحدة، تطفئ النار وتنقل القدرة إلى السخان المستدير المسود، وتضيف إليها حفنة من الأرز وتوصل الفيشة.”
يتسرب فورًا شعور دافئ حقيقي، رغم ظُلمة المعنى وفراغ الحياة. يختفي العالم من حولهم، ولا تبقى إلا أوجاع الظهر ومعالم برودة النسيان وغفلة الزمن.
في هذه المجموعة، يناقش أصلان وحشة الشيخوخة والتقاعد والنهايات التي نحاول جاهدين تجنبها، لكنه لم يغفل عن إضافة رائحة الونس ونَفَس البشر. رائحة الملابس المكوية، وشراشف الأسِرة النظيفة، تُبهج الشعور وتنعش ذاكرتك التي أخفتها ضغوط الحياة. تلك الذكريات والتفاصيل الرقيقة التي تمر هباءً في حياتنا اليومية تعود لتعيش مرة أخرى في كتاباته.
فكيف كتب أصلان؟
كتب الحكايات بطعم البيوت والأنس. في مجموعته القصصية “حجرتان وصالة”، اعتمد بشكل متجانس وسلس على الانقسام الواضح بين قصص المجموعة، مع وجود الزوجة الست إحسان في الجزء الأول، ثم الجزء الثاني بعد فقدانها. وكأنه يزرع المشاهد الأولية في عقل القارئ من تفاصيل يومية قد لا يلتفت إليها أحد، لكنها كانت ذريعة لفهم الترابط الداخلي وحبكة المعنى المتضمن للبطل ومشاعره المختلفة.
- قصة البراد العجيب:
يظل أبو سليمان يحرق البراد الألومنيوم على النار، وينسى وجوده هناك دومًا. عندما تشتري له زوجة ابنه برادًا جديدًا يصدر صوت صفير عند غليان الماء، لا يعجبه ذلك. يعود إلى براده القديم، حيث كانت رائحة الشياط توقظ ذاكرته وتنعشها. بالنسبة له، كانت هذه الرائحة وفاءً لزوجته الراحلة، الست إحسان. هذا هو برادها ولن يستبدله أبدًا، حتى لو كان ذلك يعني استمرار الاحتراق لإنعاش حوسه بوجود أثار ونيسته المفقودة، لم يرد أن يستسلم لفكرة غيابها أو حقيقة موتها، فكانت هذه الرائحة هي رابطه بعالم يرفض إنهاءه.
- قصة إبرة الخياطة:
يتفحص دومًا الملابس القديمة المعلقة بالخزانة. تنطلق رائحة النفتالين وتخنق صدره. كلما تسربت هذه الرائحة إلى حواسه، تذكر قصة أشقائه وخلافهم القديم. حين ينتهي من تفحص ملابسه الممزقة، يُقرب الإبرة ويجاهد في لضم الخيط، متأففًا. في كل مرة يفشل في إدخال الخيط عبر الثقب، فيضع علبة الإبر أمامه يائسًا، بعد محاولات فاشلة استمرت من الظهر حتى صلاة العصر. حتى عندما وجد فتقًا في بنطال قديم وحاول خياطته، لم تسعفه عيناه وضعف بصره وشيخوخته في إعادة وصل الخيط بالنسيج المقطوع.في هذه الحالة، كان أبو سليمان أمام حالة من الحنين، وإسقاط من داخله على ضعف، بل عدم جدوى، تصليح ما تم قطعه من صلات بينه وبين أشقائه. يغالبه الحنين والشوق، وتهزمه الشيخوخة لفعل ما تم هزمه وقطعه في شبابه. لم تعد هناك فرصة ولا جهد كافٍ لأي نزاع أو حتى صفقة هدنة نهائية. ينتهي به الحال بإغلاق الخزانة وعدم تصليح الملابس الممزقة. كان الدولاب هنا نافذة لبطلنا، أبو سليمان، لأشقائه، وأيضًا رمزًا للحنين والشوق للغائبين من أولاده وزوجته الراحلة.
في “أبيض وأسود، أول النهار آخر النهار”، ظل يردد حكاية الزوجة التي غابت عن الحياة وكلماتها الأخيرة: “حد يرد على التليفون يا ولاد”. فدخل الزوج مسرعًا ليبلغها أن صوت الرنة كان في الفيلم القديم، وأن الممثل بالفعل رفع الهاتف ورد داخل الفيلم. فيطلع السر الإلهي وهو ملقيًا عليها الدعابة. في سرادق العزاء، ظل يحكي القصة ويرددها. تارة يبتسم وتارة يدمع، ولا أحد في الزحام يستمع لقصته. الاستمرار في سرد اللقاء الأخير أو المشهد الأخير قبل فراق زوجته، وكأنه إعادة إحياء لها وللحدث، وتخليدًا لذكراها يبقيها حاضرة ويستأثر بوجودها عن طريق الذاكرة. الراحلون تعيقهم الذاكرة، تبقيهم عالقين، وتعيق حتى الموت. وهذا الاستبقاء الفعلي للذاكرة يطيل من وجود الحبيبة أو الونيسة – الزوجة الراحلة.
لحظات من التمني لاستراق جزء من الماضي ومعايشته مرة أخرى، أو حتى تعديل بعض السلوكيات. كما كان يرثي ويؤنب نفسه في أنه يُضيع عن قصد أغطية الزجاجات ويخفيها بعيدًا، أو يوقع قطع الزينة التي تزين الثلاجة القديمة للست إحسان أثناء فتحه الثلاجة، ثم يدفعها بقدمه أسفل الثلاجة. فيقول: “كانت تسهر في مطبخها تبحث عنها وتعيد تزيين الثلاجة”.
في قصته الأخيرة، يرفض أبو سليمان التخلي عن ونسه الوحيد في العالم، ورفيقة حياته، الست إحسان. يظل شبح الخوف من فقدان الصلة بالماضي يراوده حتى آخر لحظاته. ظل يشتري الفول في الكوب المعدني القديم، وعندما فارق الحياة، لم تكن روحه قد غادرت تمامًا. كانت روحه شاهدة على أحداث المنزل، ورحلت ببطء إلى مكان آخر. غلبه النوم في مكان يعرفه، ثم غادر إلى مكان غريب لا يعرفه.
هكذا كان الأنس والوفاء والحب الذي لا يموت. وهكذا يكتب أصلان، بأسلوبه البسيط، يمزج بين دفء الحنين ومرارة الفقد، تاركًا أثرًا لا يُمحى في ذاكرة القارئ.