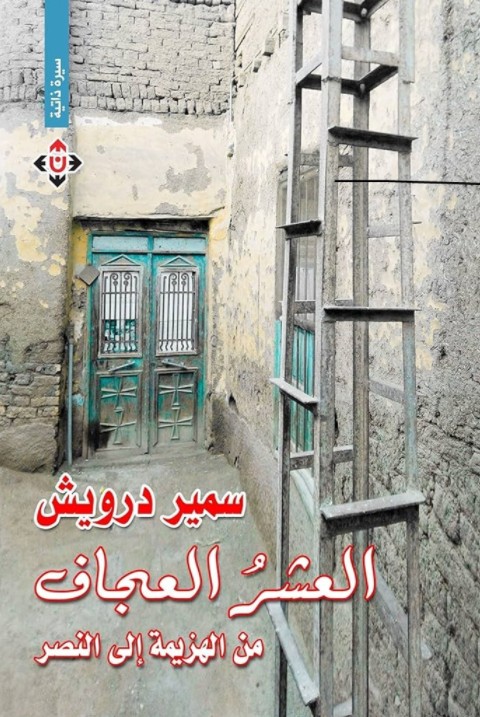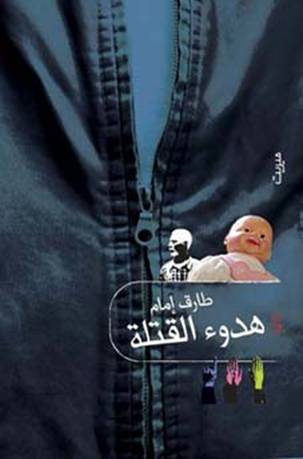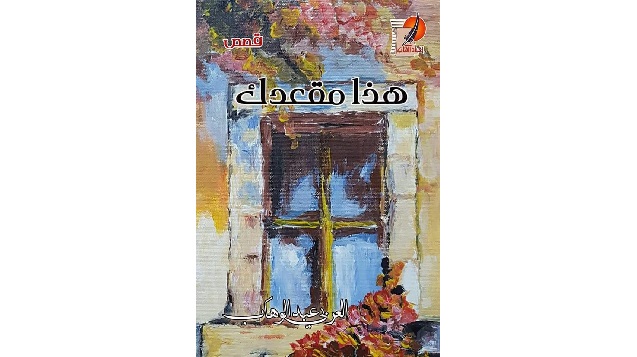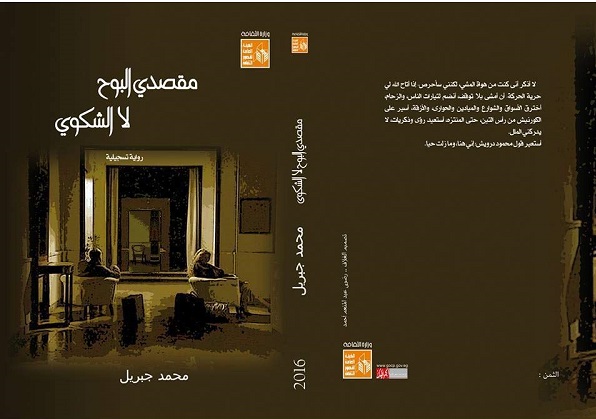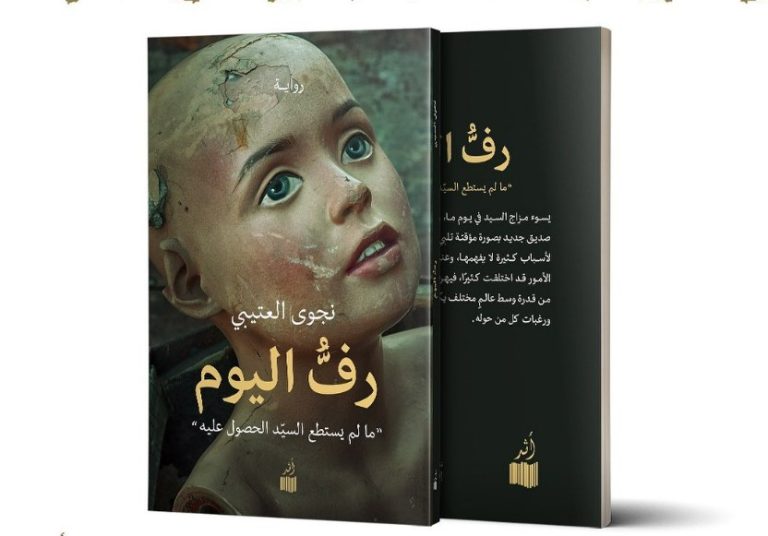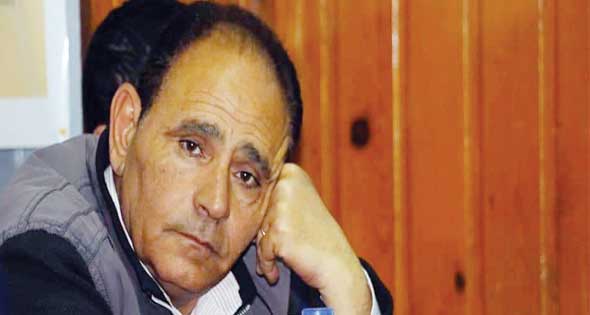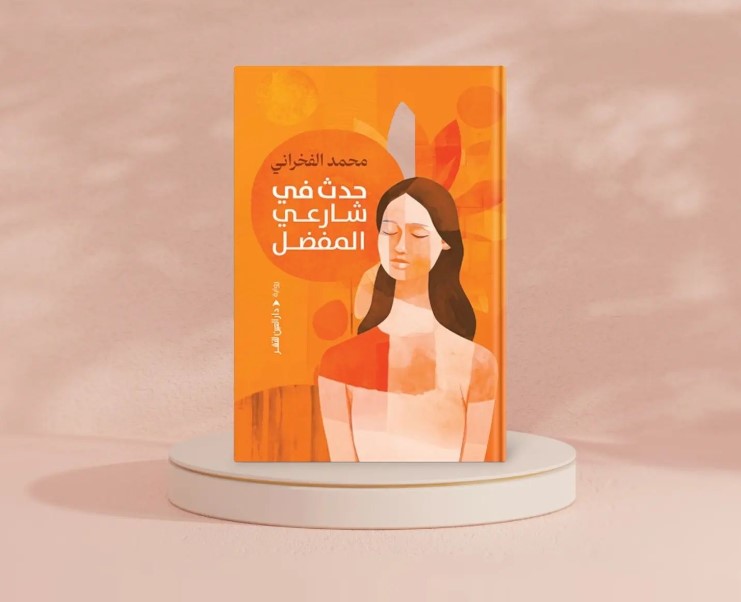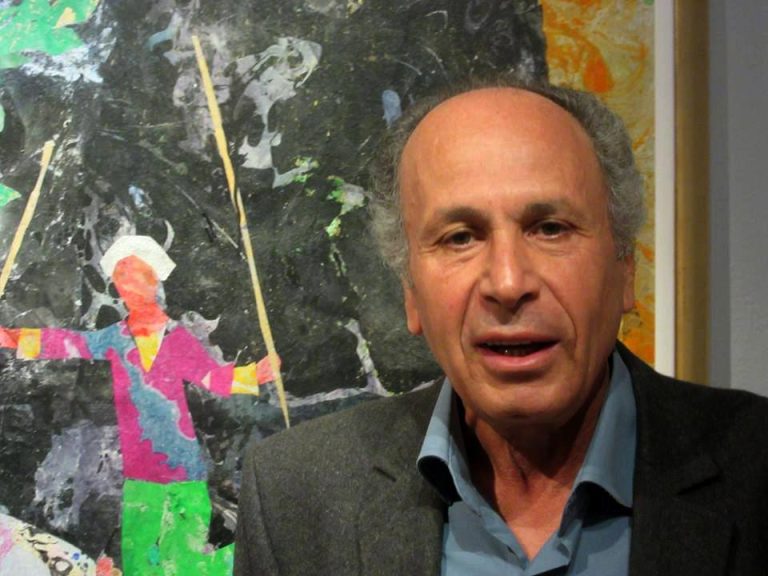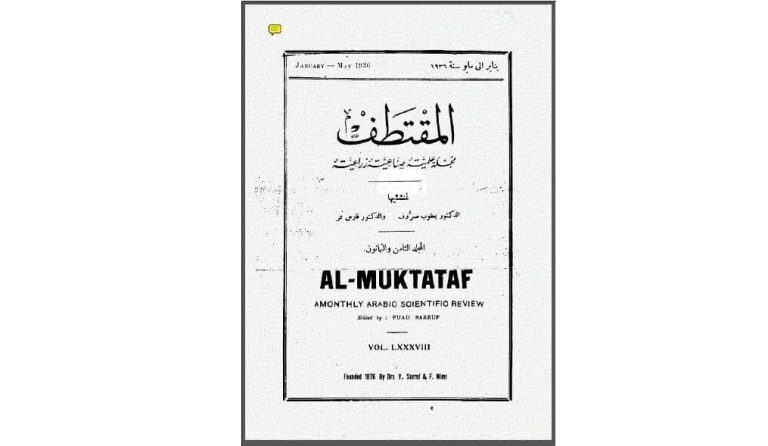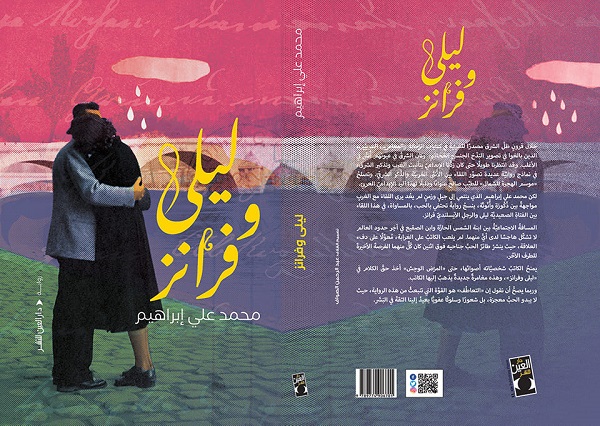أحمد رجب شلتوت
حين يكتب الشاعر والروائي سمير درويش سيرته الذاتية، فهو لا يسرد فقط وقائع حياته، بل يعيد بناء مشهد اجتماعي وثقافي لإنسان مصري نشأ في قلب الريف، متخفيًا خلف ستائر الفقر والحرمان، وخرج من طفولته مثقلًا بتركة الهزيمة، لكنه جذوة الحلم ظلت متقدة بداخله.
في كتابه “العشر العجاف: من الهزيمة إلى النصر”، لا يصطنع ولا يدعي بطولة بأثر رجعي، بل يقدّم حكاية صادقة ومؤثرة عن التكوين، وعن عشر سنوات (من نهاية الستينيات إلى السبعينيات) شكّلت بذور ما أصبح عليه لاحقًا.
يأخذنا الكاتب إلى قريته “كفر طحلة” بمحافظة القليوبية، لنشهد معه حياة من دون كهرباء، ولا ماء نظيف، ولا أبواب مغلقة، لكنها حياة مكتظة بالعلاقات، يبدأ الطفل بالعمل مبكرًا في ورش السجاد، ويُطلب منه أن يكون رجلًا قبل أن يدرك معنى الرجولة، ويتعلم أن الفقر ليس عارًا بل قانون حياة، لا يرسم سمير درويش بريشة النوستالجيا، ولا بعين المسافر، بل يبوح بصوت من عاش داخل هذا العالم وخبر قسوته من الداخل. في القرية، كما يرسمها، لا أحد يشعر بأنه فقير لأنه لا يرى غنيا القرية. والجميع يكدّ، ويكدح، ويكتم معاناته.
من هزيمة الجماعة إلى ولادة الفرد
الطبقي، يعيشسيرة بـ “العشر العجاف”، ويحمل عنوانًا فرعيًا: “من الهزيمة إلى النصر”، في إشارة إلى عقد تكويني يبدأ من نكسة 1967 ولا ينتهي إلا بـ انتصار أكتوبر 1973، مرورًا بوفاة عبد الناصر وصعود السادات، وتغيّر الخريطة النفسية لمصر، لكن الأهم أن الكاتب يربط الهزيمة الوطنية بسيرته الذاتية: فكما سقط الحلم القومي في النكسة، كان هو أيضا يسقط داخل أسرته وأمام قدره الطبقي، يعيش صدمة غياب الأب في المدينة، وقسوة الإخوة الكبار، واختلال ميزان العدالة الأسرية، ويخوض معارك الصمت والمذلة، ويتكوّن وعيه النقدي من قلب الشعور بالعجز لا من وفرة المعرفة.
حين يصنع الهامش كاتبًا
لم تكن الكتب وحدها من كوّن ذائقته، بل الحياة ذاتها. الراديو كان نافذته إلى الأغنية الوطنية، والأوبريت، وصوت فيروز وعبد الحليم. البرامج الحوارية مثل “أغاني وعجباني” كانت دروسًا غير مقصودة في الارتباط بين الفن والحياة، وفي المدرسة، أحب الأبطال الذين قرأ عنهم: قطز، صلاح الدين، كره الظاهر بيبرس لأنه “خان قطز”، ورفض السادات لأنه “خان عبد الناصر”، في مثال فطري على ارتباط التكوين الأخلاقي بالتاريخ الشعبي المتداول، ومع غياب الكتب في البيت، وجد في الخيال بديلًا: صنع عوالمه، وأعاد صياغة قصائد سمعها دون أن يفهمها، بل وكتب قصائد بديلة بنفس الوزن، وكأن الألم الخافت كان يدفعه إلى أن يجد خلاصه في اللغة.
عن الفقر وأشياء أخرى
يربط الكاتب بذكاء بين الفقر والتعليم، بين العمل البدني والتكوين العقلي. لم يكن من السهل أن تدرس بعد 12 ساعة من العمل اليدوي، لكن ذلك علّمه الصبر والانضباط، ولم يتردد درويش في الحديث عن لحظات المراهقة، عن الشهوة المبكرة، عن تأملات الجسد، وكلها أمور نادرًا ما تُكتب في السير الذاتية العربية بهذا القدر من الشفافية والتوازن. في “العشر العجاف”، لا يُقدّم سمير درويش الفقر كموضوع خارجي أو كإطار زماني، بل كـمكوّن داخلي للشخصية، وبنية شعورية وثقافية. إنه يكتب من قلبه، لا عنه، ومن داخله لا كشاهِدٍ عليه، وهكذا لا نجد الفقر في السيرة ليس مجرد نقص في الموارد، بل جده فقدانًا للطفولة، وحرمانًا من الاختيارات، وكتمًا للصوت الشخصي.
كان على الطفل أن يعمل في ورش السجاد اليدوي، أن يستيقظ قبل الضوء، أن يتقن الانحناء على الخيوط، وأن يعود متهالكًا ليحفظ دروسه. هذه الثنائية شبه المستحيلة – العمل والدراسة – كوّنت لديه مبكرًا شعورًا بالتميّز المغلف بالمرارة: لم يكن كسائر أقرانه، لم يلعب، لم يُدلّل، بل تعلّم الانضباط قبل أن يعرف اللهو.
في هذا السياق، يتداخل الجسد مع الفقر. لا يتحدث الكاتب عن الجسد ككائن حسي فحسب، بل كجسد مُرهق، مُستخدم، مُراقَب، يُحرَم من الحميمية ومن الحرية. ومع بداية المراهقة، تزداد حدة الشعور به، ويصير الجسد ساحة صراع بين الكبت والاكتشاف، بين الرغبة والخوف، الفقر أيضًا لا يقتصر على الجانب الاقتصادي، بل يتجلّى في المخيلة الاجتماعية: الخوف من الطبيب لأنه لا يمكن دفع أجره، الحذر من الملابس الجديدة لأنها تفضح الفروق، التوتر عند دخول المدن لأنها تكشف هشاشة الانتماء الريفي، هكذا يصبح الفقر حالة دائمة من القلق الوجودي، وأحد أشكال الحصار الصامت.
ومع ذلك، ومن قلب هذا الحصار، تولّدت الرغبة في الكتابة، كما يتضح في السيرة. لم تكن الكتابة ترفًا ولا تمرينًا جمالياً، بل فعلًا للبقاء، وآلية لتبرير الذات أمام العالم. الكتابة التي خرجت من بين أيدي مرهقة وأعصاب مشدودة كانت بداية تحول الطفل إلى كاتب، والهمس الداخلي إلى صوت مسموع.
بين صدق البوح ووعي السارد
يتميّز أسلوب سمير درويش في “العشر العجاف” بقدر كبير من الصدق العاطفي والجرأة. لا يخجل من كشف نفسه، ولا يتوارى خلف أقنعة، بل يواجه القارئ بذاته كما هي، وهو ما يخلق تعاطفًا سريعا، وما يمنح سرده تدفقا وعفوية، وما يجعله أقرب إلى حديث داخلي متدفق من قلب الذكريات، دون ترتيب زمني صارم، بل بانسيابية شعورية تقترب من الشعر.
أيضا يميل الكاتب إلى مسرحة المشهد وتكثيف الحوار، فيبدع من أبسط اللحظات مشاهد درامية تنبض بالحياة، مع سخرية ناعمة تضيء عتمة الوجع، ذلك بلغة سلسة واضحة، لكنها محملة بإيقاع باطني وثراء تصويري، تجمع بين المفردة الشعبية والبناء الأدبي، وتصنع توازنًا بين الغنائية والواقعية.
خلفية باهتة
على الرغم من إشارة العنوان إلى “من الهزيمة إلى النصر”، إلا أن الكتاب يدع الأحداث السياسية الكبرى مثل النكسة، الاستنزاف، رحيل عبد الناصر، وصول السادات، انتصار أكتوبر، تمر مرورًا خفيفًا، لا بعمق سردي أو تأملي يتناسب مع أثرها التاريخي أو الرمزي، هذه الأحداث تظهر كمجرد خلفية باهتة، وليس كعناصر مركزية مؤثرة على الوعي الجمعي أو الشخصي، رغم أن الكاتب نفسه يشير إلى تأثره بها. كنا ننتظر أن توضح السيرة كيف تسرّبت السياسة إلى تشكيل وعي الكاتب؟
كذلك ينتهي الكتاب دون أن يُكمل مسيرة التكوين إلى لحظة الانخراط في الحياة الأدبية أو الشعرية علنًا. هناك نوع من الانقطاع السردي قبل “التحول العلني” إلى كاتب، مما يترك القارئ متعطشًا لمعرفة ما حدث بعد ذلك؟
وأخيرا فليست هذه السيرة “نصًا للتفاخر” كما يفعل الكثيرون ممن يكتبون، بل وثيقة حياة لإنسان عادي مرشح لأن يُنسى، لولا الكتابة. وثيقة تسرد، وتقاوم، وتتأمل، وفي زمن تعلو فيه أصوات الواجهة، يتقدم صوت سمير درويش ليقول إن الهامش هو مخزن الحكايات ومنبع الدهشة وأصل الحياة.