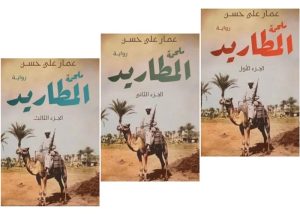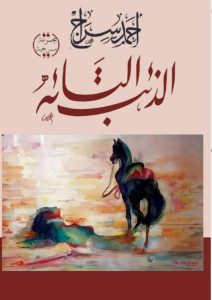ليوناردو
ولدت إلى جانب البئر
والشجرات الثلاث الوحيدات كالراهبات
ولدت بلا زفّة وبلا قابلة
وسميت باسمي مصادفة
وانتميت إلى عائلة مصادفة
وورثت ملامحها والصفات
ميمُ / المُتَيَّمُ والمُيتَّمُ والمتمِّمُ ما مضى
حاءُ / الحديقةُ والحبيبةُ، حيرتانِ وحسرتان
ميمُ / المُغَامِرُ والمُعَدُّ المُسْتَعدُّ لموته الموعود منفيّاً، مريضَ المُشْتَهَى
واو / الوداعُ ، الوردةُ الوسطى، ولاءٌ للولادة أَينما وُجدَتْ ، وَوَعْدُ الوالدين
دال / الدليلُ، الدربُ، دمعةُ دارةٍ دَرَسَتْ، ودوريّ يُدَلِّلُني ويُدْميني / وهذا الاسمُ لي …
سنة 1941 الثالث عشر من شهر مارس، في قرية تسمى البروة إحدى قرى فلسطين والتي تقع على بعد ٩ كم من مدينة عكا، لأب يدعى سليم درويش رجل بسيط يعمل بالفلاحة وأم ابنة عمدة قرية الدامون التي كانت لا تعرف القراءة والكتابة ولد الابن الثاني، شاعر الجرح الفلسطيني، لاعب النرد والعاشق السيئ الحظ، المنفي مريض المشتهى محمود درويش
إلى أين تأخذني يا أبي
إلى جهة الريح يا ولدي
لماذا تركت الحصان وحيداً؟
لكي يؤنس البيت يا ولدي
فالبيوت تموت إذا غاب عنها سكانها
في عام 1948 هاجرت الأسرة إلى لبنان بعدما اجتاح العدو الصهيوني القرية ودمرها ثم عاد في عام 1949 بعد اتفاقيات الهدنة ليجد ملامح الطفولة وذكرياتها في ذاكرة النسيان ليقام فوق ركام الطمأنينة المبثوثة في ظل السلاح، الطمأنينة الغائبة والوطن المسلوب قرية زراعية إسرائيلية تدعى أحيهود
ها هنا حاضر يلامسه الأمس
حين وصلنا إلى آخر الشجرات
انتبهنا أننا لم نعد قادرين على الإنتباه
وحين التفتنا إلى الشاحنات رأينا الغياب
رأينا الغياب يقدس أشياءه
عاش محمود درويش في حيفا على إثر التنقلات والتهجيرات التي كانت تمارس عليهم من العدو بعدما انتقلت أسرته إلى قرية آخرى تسمى الجديدة التي امتلكت فيها بيتاً… يقول محمود درويش ” في حيفا عشت عشر سنين وأنهيت فيها دراستي الثانوية ثم عملت محرراً في جريدة الاتحاد وكنت ممنوعاً من المغادرة مدة عشر سنوات، كانت إقامة جبرية ثم استرجعنا هويتنا. هوية حمراء في البداية ثم زرقاء وكانت أشبه ببطاقة إقامة. كنت ممنوعاً من المغادرة وكان من حق الشرطة أن تأتي ليلاً لتحقق من جودي وكنت اعتقل في كل سنة وأدخل السجن من دون محاكمة. كان منتسباً للحزب الشيوعي وهو في سن الثامنة عشر، عمل في صحافة الحزب مثل الاتحاد والجديد التي سيصبح فيما بعد رئيس تحريرها، اتهم بنشاط معاد لدولة إسرائيل المزعومة فطورد واعتقل خمس مرات 1962، 65, 66, 67, 69 وفرضت عليه الإقامات الجبرية حتى 1970
أحن إلى خبز أمي
وقهوة أمي
ولمسة أمي
وتكبر في الطفولة
يوما على صدر يوم
وأعشق عمري لأني
إذا مت أخجل من دمع أمي
يقول شقيقه أحمد درويش عندما ذهبنا لزيارة محمود في السجن كنت مذهولاً، هذا الفتي النحيل الوسيم يزج به في السجن لكن كما هو معهود عليها من العبقرية كتب قصيدة أحن إلى خبز أمي على قصاصة ورق. والذي لا يعرفه الكثير عن محمود درويش أنه كان رساماً لكنه ترك الرسم ليصبح هتلراً جديداً في عالم الشعر، أمزح يا حضرات، بل ترك الرسم لأن الأدوات كانت باهظة الثمن مقارنة بالحبر والورق. ويروي درويش عن علاقته بأمه التي كانت حتى العشرين من عمره مزيج من العصبية المفرطة والحب المكنون تحت الرماد ” أمي كانت جميلة وقاسية تنشر الرعب في البيت، وكثيرا ما كانت تشاكس الأب الحزين المتحسر على الأرض. بدأت المشاحنات بين الأم والأب مع الخروج من الأرض، كنت منحازاً لأبي، أهرب بعيداً عن البيت تفاديا لشراسة أمي التي اكتسبتها عندما تخلت عن البيت، كانت تضربني كثيراً ولأي سبب، وكثيراً ما شعرت أن السبب هو خلافاتها مع أبي، وأنها تحمّلني مسؤولية هذا الخلاف، تكوَّن لدي شعور بأنها تكرهني، كانت هذه عقدة أو شبه عقدة، وبقيت هذه الفكرة معي، لكن حين دخلت السجن للمرة الأولى، زارتني في السجن وحملت لي خبزها الساخن وقهوة وفواكه. احتضنتي، وقبـــَّـلتني. ومن هنا خرجت (أحنُّ إلى خبز أمي وقهوة أمي) التي تحولت إلى أغنية جماعية”.
أولى قصائده قطعت رزق والده
سبقت الإشارة إلى سليم حسن درويش، الذي لعب دور الأب في ملحمة الشاعر، كان فلاحاً بسيطاً، يرعى أرضه قبل تهجير عام 1948، ويوفر الطعام للأولاد من الخير الذي تجنيه يداه الطيبة من أرضه الطيبة، التي استولى عليها المستوطنون. وبعد التهجير كثيراً ما نزفت روحه وهو يستحلب رزقهم من المحجر، واستهلكت معركة الخبز قواه، وأوكل إلى الجد رعاية وتثقيف الحفيد.
يروى درويش “جلب الشعر إليّ المتاعب منذ البداية”؛ فذات مرة ألقى قصيدة وهو في المرحلة الابتدائية عنوانها “أخي العبري”، كانت صرخة من طفل عربي إلى طفل يهودي، لم يعد يتذكر كلماتها، وإنْ تجسدت معانيها، وفقا لروايته (يا صديقي! بوسعك أن تلعبَ تحت الشمس كما تشاء، بوسعك أن تصنع ألعاباً، ولكني لا أستطيع.. أنا لا أملك ما تملكه؛ لك بيت، وليس لي بيت، فأنا لاجئ.. لك أعياد وأفراح، وأنا بلا عيد ولا فرح).
انتهت القصيدة، لكن لم يُقدّر لها العبور الآمن، إذ بلغت الكلمات أبواب الحاكم العسكري الإسرائيلي، فاستدعاه؛ وبَّخـــه، ضربه، فما بكى. وحين هدده بأبيه بقوله “سأمنع أباك من العمل في المحجر، وأقطع عنه تصريح الموت”، هنا اهتز الطفل، وبكى في طريق عودته من المدرسة، وحينما أخبر الأب، هز الأبُ رأسَه، ونظر لابنه وحثه على المسير، وطمأنه بجملة واحدة: الله يرزقنا. وللأسف أصاب الأب المكروه الذي كان يخشاه الابن، وقُطع مصدر دخل الأسرة، وأصبح الأب بلا عمل.
تهديد ووعيد الحاكم العسكري للطفل محمود، جعله يفكر كيف ستوفر الأسرة تكاليف المأكل والمشرب والملبس والتعليم، وسط ميزانية أصابها الضيق، ويتحصل عليها الأب بشِق الأنفس، ففكر في الإقلاع نهائياً عن تعاطي الشعر، لكن غَضبَ الرجلِ ذي المنصب الكبير لم يعكر صفاء رؤية الطفل التي طرحت سؤالا عفويا على عقله، كان مفاده، بحسب درويش “ما الذي جعل كلمات القصيدة العابرة لطفل يلهو بالكلمات تهز جدران الحاكم العسكري؟ هنا أدرك محمود سلطة الكلمات في وقت مبكر من طفولته، وقرر أن يشدّ الرحال إلى مدينة الشعراء، ليكون أحد سادتها العظماء، بعدما تساءل ذات ليلة “عمّ تبحث يا فتى في زورق الأوديسة المكسور؟ــ عن جيش يهاجمني فأهزمه، وأسأل هل أصير مدينة الشعراء يوماً؟”.
العاشق السيئ الحظ
بين ريتا وعيوني بندقية
والذي يعرف ريتا، ينحني
ويصلي
لإله في العيون العسلية
هذا السر الغامض في شعر درويش وحياته ظل يطارده أينما ارتحل، من ريتا وما الذي دفع درويش إلى إطلاق الرصاص في صدر الحب. ريتا تامار التي كانت تعمل راقصة وتعرف عليها درويش من خلال رقصها في الحزب الشيوعي الذي كان درويش عضواً فيه. جاء هذا القرار صعبا بشكل كبير على محمود درويش الذي عاني لسنوات طويلة من طيف هذه الفتاة وذكرها في العديد من الأبيات الشعرية فقد كتب قصيدة ريتا والبندقية وكذلك قصيدة شتاء ريتا الطويل وقد كانت هذه القصائد مؤثرة بشكل كبير وتنم عن ألم بالغ قد شعر به درويش بعد اختيارها لسلاح الطيران والتجنيد في الجيش الإسرائيلي.
ظلت الصحافة لسنوات طويلة تبحث عن الهوية الحقيقية لاسم ريتا الذي كان يردده كثيرا في قصائده، ولم يستطيعوا التعرف على هذا السر إلا بعد سنوات طويلة ومن خلال إفصاح الشاعر نفسه مع المذيعة الفرنسية التي أصرت وألحت عليه لكي تعرف الهوية الحقيقية لشخصية ريتا.
تم كشف هوية ريتا بفيلم وثائقي للمخرجة ابتسام فراعنة التي عرضت فيلم مميز جدا يحمل اسم سجل أنا عربي، وقد تم عرض هذا الفيلم في مهرجان تل أبيب. أثرت هذه التجربة على درويش في الحب والزواج، فبالنسبة لزواجه سواء المرة الأولى أو الثانية لم يدم طويلاً،
بكوب الشراب المرصع باللازورد
انتظرها
على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا
انتظرها
في واشنطن عام 1973 التقى درويش للمرة الأولى بالسيدة رنا قباني، ففي زيارة لا تتعدى مدتها 24 ساعة، حلّ درويش ضيفًا لأمسية شعرية، وأثناء إلقائه الشعر وقعت عيناه على فتاة جميلة تجلس في الصف الأول، تعلّقت عيناه بها ولم تفلتها، وبعد انتهاء الأمسية تعرّف درويش بها، وعلم أنها ابنة أخ الشاعر اللبناني نزار قباني، وشيئًا ما حدث في تلك الليلة، سرى انجذاب بينها مكان الهواء، وكانت دقات القلب أعلى من صوتهما، والجُنون سمة الأمسية الساحرة، ففي لحظة ما وجد درويش نفسه يقول لرنا “تقبلين الزواج مني؟”، وافقته الشابة على الفور التي لم تبلغ بعد العشرين عامًا، لكنها كانت سكرى بالحُب.
لم تأت قلت: ولن
إذاً سأعيد ترتيب المساء
بما يليق بخيبتي وغيابها
أشعلت نور الكهرباء
شربت كأس نبيذها وكسرته
أبدلت موسيقى الكمانجات
بالأغاني الفارسية السريعة
لم يُفلح درويش في زواجه الأول، انتقلت رنا للعيش في بيروت التي تعاني من الحرب الأهلية في تلك السنوات القاتمة، واختفت حلاوة الحُب، وظهر الواقع بمشكلاته ومآسيه، لكن ما جعل رنا لا تحتمل تلك الحياة هو فشل درويش كزوج ومسئول عن بيت، كانت أولوياته هي شعره فقط، وفي غمرة تلك الحياة التي لم تستمر سوى 9 شهور، غادرت رنا ووقع الطلاق الأول، حاول درويش العودة مرة أخرى، لكنه فشل مُجددًا، واستمر زواجهما لثلاث سنوات، وبعدها انفصلا نهائيًا.
عَبَر طيف رنا في قصائد درويش، ففي قصيدة “المساء الأخير” شبهها بالنهر الوحيد: “البحيرات كثيرة\ وهي النهر الوحيد\ قصتي كانت قصيرة\ وهي النهر الوحيد”، وداخل قصيدة “الرمل” أيضًا تحسّر على ضياعها: “الرمل هو الرمل\ أرى عصرًا من الرمل يغطينا\ ويرمينا من الأيام\ ضاعت فكرتي وامرأتي ضاعت\ وضاع الرمل في الرمل”.
بعد سبع سنوات من علاقته برنا، جاءت حياة عصام الحيني، المترجمة في اليونسكو، كانت الزوجة الثانية في حياته، ومثلما أصاب الحب بسهمه الطائش في المرة السابقة، تكرر السيناريو مع حياة عام 1983، مع اختلاف بعض التفاصيل، لكنه في النهاية تزوج حياة بعد لقائه الأول بها بعام واحد، ويبدو أن الزواج كان مُفاجئًا أيضًا، حيث يحكي الشاعر اللبناني شربل داغر في كتابه “محمود درويش يتذكر” أنه تفاجئ بزوجته حياة حينما زاره في شقته بباريس المطلة على برج إيفل
تمرد قلبي عليّ.
أنا العاشق السيء الحظِّ
نرجسة لي وأخرى عليّ
أمرّ على ساحل الحب. ألقي السلامْ
سريعاً. وأكتب فوق جناحِ الحمام
رسائل منِّي اليّ.
كم امرأةٍ مزقتني
كما مزَّق الطفل غيمةْ
فلم أتألم، ولم أتعلَّم. ولم أحْمِ نجمهْ
من الغيم خلف السياج القصيّ.
محطات في حياة المنفي مريض المشتهى
رسالة من المنفى
تحيةً . وقبلةً وليس عندي ما أقول بعدْ
من أين أبتدي؟ .. وأين أنتهي؟
ودورة الزمان دون حدْ
وكل ما في غربتي
زوادةُ, فيها رغيفٌ يابسٌ, وَوَجْدْ
ودفترٌ يحمل عني بعض ما حملت
بصقت في صفحاته ما ضاق بي من حقدْ
من أين أبتدي؟
- موسكو
توجه إلى الاتحاد السوفييتي للدراسة عام 1970. يقول محمود:
“أول رحلة لي خارج فلسطين كانت إلى موسكو. وكنت طالباً في معهد العلوم الاجتماعية، ولكن لم يكن لي هناك بيت بالمعنى الحقيقي. كان غرفة في مبنى جامعي.
أقمت في موسكو سنة. وكانت موسكو أول لقاء لي بالعالم الخارجي. حاولت السفر قبلاً إلى باريس لكن السلطات الفرنسية رفضت دخولي إلى أرضها في العام 1968. كانت لدي وثيقة إسرائيلية لكنّ الجنسية غير محددة فيها. الأمن الفرنسي لم يكن مطلوباً منه أن يفهم تعقيدات القضية الفلسطينية. كيف أحمل وثيقة إسرائيلية وجنسيتي غير محددة فيها وأقول له بإصرار إنني فلسطيني. أبقوني ساعات في المطار ثم سفّروني إلى الوطن المحتل.
كانت موسكو أول مدينة أوروبية وأول مدينة كبيرة أعيش فيها. طبعاً اكتشفت معالمها الضخمة ونهرها ومتاحفها ومسارحها.. تصور ما يكون رد فعل طالب فتيّ ينتقل من إقامة محاصرة إلى عاصمة ضخمة! تعلمت الروسية قليلاً لأتدبر أموري الشخصية. لكن اصطدامي بمشكلات الروس يومياً جعل فكرة “فردوس” الفقراء التي هي موسكو، تتبخر من ذهني وتتضاءل. لم أجدها أبداً جنة الفقراء، كما كانوا يعلّموننا.
فقدت الفكرة المثالية عن الشيوعية لكنني لم أفقد ثقتي بالماركسية. كان هناك تناقض كبير بين تصوّرنا أو ما يقوله الإعلام السوفييتي عن موسكو والواقع الذي يعيشه الناس، وهو مملوء بالحرمان والفقر والخوف. وأكثر ما هزّني لدى الناس هو الخوف. عندما كنت أتكلم معهم أشعر أنهم يتكلمون بسرية تامة. وإضافة إلى هذا الخوف كنت أشعر أن الدولة موجودة في كل مكان بكثافة. وهذا ما حوّل مدينة موسكو من مثال إلى مدينة عادية.
- القاهرة
يتحدث درويش عن القاهرة، محطته الثانية بعد الخروج من الوطن فيقول:
“الدخول إلى القاهرة كان من أهم الأحداث في حياتي الشخصية. في القاهرة ترسخ قرار خروجي من فلسطين وعدم عودتي إليها. ولم يكن هذا القرار سهلاً. كنت أصحو من النوم وكأنني غير متأكد من مكان وجودي. أفتح الشباك وعندما أرى النيل أتأكد من أنني في القاهرة. خامرتني هواجس ووساوس كثيرة، لكنني فتنت بكوني في مدينة عربية، أسماء شوارعها عربية والناس فيها يتكلمون بالعربية. وأكثر من ذلك، وجدت نفسي أسكن النصوص الأدبية التي كنت أقرأها وأعجب بها. فأنا أحد أبناء الثقافة المصرية تقريباً والأدب المصري. التقيت بهؤلاء الكتّاب الذين كنت من قرائهم وكنت أعدّهم من آبائي الروحيين.
التقيت محمد عبد الوهاب، وعبد الحليم حافظ وسواهما، والتقيت كبار الكتاب مثل نجيب محفوظ ويوسف إدريس وتوفيق الحكيم. ولم ألتق بأم كلثوم وطه حسين، وكنت أحب اللقاء بهما”.
يضيف: “عيّنني محمد حسنين هيكل مشكوراً في نادي كتّاب “الأهرام”، وكان مكتبي في الطابق السادس، وهناك كان مكتب توفيق الحكيم ونجيب محفوظ ويوسف إدريس وبنت الشاطئ. وكان توفيق الحكيم في مكتب فردي ونحن البقية في مكتب واحد. وعقدت صداقة عميقة مع محفوظ وإدريس، الشخصيتين المتناقضتين: محفوظ شخص دقيق في مواعيده، ومنضبط، يأتي في ساعة محددة ويذهب في ساعة محددة. وكنت عندما أسأله: هل تريد فنجان قهوة أستاذ نجيب؟ كان ينظر إلى ساعته قبل أن يجيب، ليعرف إن كان حان وقت القهوة أم لا. أما يوسف إدريس، فكان يعيش حياة فوضوية، وكان رجلاً مشرقاً. وفي القاهرة صادقت أيضاً الشعراء الذين كنت أحبهم: صلاح عبد الصبور وأحمد حجازي وأمل دنقل. كان هؤلاء من الأصدقاء القريبين جداً. وكذلك الأبنودي. كل الشعراء والكتاب الذين أحببتهم توطدت علاقتي بهم. والقاهرة كانت من أهم المحطات في حياتي.
في القاهرة تمّت ملامح تحوّل في تجربتي الشعرية وكأن منعطفاً جديداً يبدأ.
كان يُنظر إليّ عندما كنت في الأرض المحتلة كوني شاعر المقاومة. وبعد هزيمة 1967 كان العالم العربي يصفق لكل الشعر أو الأدب الذي يخرج من فلسطين، سواء كان رديئاً أم جيداً. اكتشف العرب أنّ في فلسطين المحتلة عرباً صامدين ويدافعون عن حقهم وعن هويتهم. اكتسبت إذاً النظرة إلى هؤلاء طابع التقديس، وخلت من أي ذائقة أدبية عامة. هكذا أُسقطت المعايير الأدبية عن نظرة العرب إلى هذه الأصوات المقاومة بالشعر والأدب في الداخل. ومن القصائد المهمة التي كتبتها في القاهرة قصيدة “سرحان يشرب القهوة في الكفاتيريا” ونشرت في صحيفة “الأهرام” وصدرت في كتاب “أحبك أو لا أحبك”.
- بيروت
بعد القاهرة انتقلت إلى بيروت مباشرة.. عشت فيها من العام 1973 إلى العام 1982. حنيني إلى بيروت ما زلت أحمله حتى الآن. وعندي مرض جميل اسمه الحنين الدائم إلى بيروت. ولا أعرف ما هي أسبابه. وأعرف أن اللبنانيين لا يحبون مديح مدينتهم في هذا الشكل. ولكن لبيروت في قلبي مكانة خاصة جداً. ولسوء حظي، أنني بعد سنوات قليلة من سكني في بيروت، وهي كانت ورشة أفكار ومختبراً لتيارات أدبية وفكرية وسياسية، متصارعة ومتعايشة في وقت واحد، لسوء حظي، أن الحرب اندلعت. وأعتقد أن عملي الشعري تعثر حينذاك.
أعتقد أن أجمل ما كتبت ديوان “تلك صورتها وهذا انتحار العاشق”. ولكن بعد اندلاع الحرب صار الدم والقصف والموت والكراهية والقتل.. كل هذه صارت تهيمن على أفق بيروت وتعكره. وبعض أصدقائي هناك ماتوا وكان عليّ أن أرثيهم. وأول من فقدت هناك غسان كنفاني. وأعتقد أن الحرب الأهلية في لبنان عطلت الكثير من المشاريع الثقافية والفكرية التي كانت تجتاح بيروت. وانتقل الناس إلى جبهات مختلفة ومتناقضة ومتحاربة.
منذ بداية الحرب، كنت أعبّر لأصدقائي ومعارفي عن تشاؤمي من نتائج هذه الحرب. وكنت أطرح السؤال الآتي: هل كان في وسعنا ألا نُستدرج كفلسطينيين إلى هذه الحرب؟ كانت هناك أجوبة رسمية تقول إن دور الفلسطينيين في الحرب هو الدفاع عن النفس ومواجهة محاولة إقصائنا. ولكننا أخطأنا في بيروت عندما أنشأنا ما يشبه الدولة داخل الدولة.
كنت أخجل من اللبنانيين إزاء الحواجز التي كان يقيمها الفلسطينيون في الأرض اللبنانية ويسألون اللبناني عن هويته. طبعاً لكل هذه الأمور تفسيرات وتبريرات. ولكن كنت أشعر دوماً بالخجل. وكنت أطرح على نفسي أسئلة عدة حول هذه الأمور، حتى أمام أصدقائي المتحمسين للقضية الفلسطينية والحركة الوطنية. ومن هذه الأسئلة: ماذا يعني أن ننتصر في لبنان؟ هذا سؤال كان يلح عليّ دوماً. ولنفترض أننا أنهينا الحرب وانتصرنا، فماذا يعني الانتصار هنا؟ أن نحتل لبنان ونتسلّم الحكم في لبنان؟ كنت متشائماً جداً. ولم أكتب عن الحرب اللبنانية إلا كتابة شبه نقدية.
بعد أن وضعت الحروب أوزارها، الحروب الفلسطينية- اللبنانية أو الحروب الأهلية… تستطيع من خلال رؤية محايدة أن تنظر إلى الآثار الايجابية للتفاعل الفلسطيني مع الحياة الثقافية اللبنانية أو التفاعل اللبناني مع القضية الفلسطينية. هناك جوانب إيجابية فعلاً. هناك مركز الأبحاث الفلسطينية، مجلة “شؤون فلسطينية” ومجلة “الكرمل”، وسواها.. كنت أشعر أن وجودي في بيروت سيطول، ولم أكن أشعر بالحرج وكأنني مقيم في شكل شرعي. ولكن أن أكون مقيماً في شكل إجباري ومضاد لرغبة اللبنانيين عبر تعايشهم القسري معنا، فهذا كان يزعجني. وعندما خرجت القيادة الفلسطينية والمقاتلون الفلسطينيون من بيروت لم أخرج. بقيت في بيروت أشهراً عدة. لم أتوقع أن الإسرائيليين سيحتلون بيروت. ولم أجد معنى لخروجي في السفن مع المقاتلين. ولكن في صباح ذات يوم وكنت أسكن في منطقة الحمراء، خرجت لأشتري خبزاً وإذا بي أشاهد دبابة إسرائيلية ضخمة. دخلت إسرائيل قبل الإعلان عن الدخول. حينذاك وجدت نفسي وحيداً أتجوّل في الشوارع ولا أرى سوى الدبابات والجنود الإسرائيليين ورجالاً ملثمين. قضيت فعلاً أياماً صعبة جداً، ولم أكن أعرف أين أنام.
كنت أنام خارج البيت في مطعم، وأتصل بجيراني لأسألهم إن كان الإسرائيليون سألوا عني. إذا قالوا: نعم جاؤوا، فكنت أدرك أنهم لن يأتوا مرة أخرى، فأذهب إلى بيتي، أتحمّم وأرتاح ثم أعود إلى المطعم. إلى أن حصلت الكارثة الكبرى وهي مجزرة صبرا وشاتيلا. عندذاك تيقنت أن بقائي هناك ضرب من العبث والطيش.
رتّبت الأمر مع السفير الليبي في بيروت حينذاك، فهو كان في مقدوره أن يأخذني من منطقة الأشرفية التي كانت “الكتائب” تسيطر عليها، إلى سورية. ولكن كان عليه أن يجد طريقاً ليأخذني من بيتي إلى مدخل الأشرفية. اتفقنا مع ضابط لبناني أوجد لنا شارعاً كان سيمر به الرئيس الراحل شفيق الوزان، وكان هناك اتفاق بين الإسرائيليين والحكومة على ألا يتعرضوا لهذا الشارع. وفعلاً سلكنا هذا الطريق وخرجنا من بيروت. وعندما وصلنا إلى طرابلس، ذهبنا إلى مطعم لنأكل السمك بعدما مللنا أكل المعلبات. وبعدما دخلت الحمام لأغسل يديّ، نظرت إلى المرآة فرأيت أنفاً عليه نظارتان. لم أعرف صاحب هذا الوجه لثوانٍ. كأنني كنت أنظر إلى وجه آخر. وعندما وصلت إلى دمشق أقمت هناك أسبوعاً. وكان حصل حادث طريف جداً على الحدود السورية- اللبنانية. فالضابط اللبناني على الحدود الذي طلب أوراقي، وكنت أحمل جواز سفر تونسياً دبلوماسياً، وجد أن إقامتي قد انتهت وهذه مخالفة قانونية. قلت له: صحيح، ولكن ألا تسمع الأخبار؟ ألا تعرف أنه ما من سفارات أو دوائر تعمل؟”.
جاء إلى دمشق أواخر 1982 ليحيي أمسية كانت مقررة على مدرج جامعة دمشق التي لم يتسع مدرجها للجماهير، فاضطرت الجهة المنظمــة إلى نقل الحــضور إلى مـــدرج الأسد في باصات النقل العام والعسكري، فوجئ الشاعر بأن المدرج والملعــــب مليئان فقال أحد الشعراء “الجندي” عبـــارته التي بقي محمود يرددها “والله لو قتلناه ـ نحــن الشــعراء ـ وشرحنا أسبابنا للقاضي سنأخذ براءة!!”.
- تونس / باريس
“غادرت دمشق إلى تونس ورأيت خلالها الرئيس عرفات والاخوان في مشهد تراجيدي. رأيت الثورة الفلسطينية تقيم في فندق على شاطئ بحر. كان المشهد مؤلماً جداً ويستدعي كتابة رواية عن هذا المصير. لكن عرفات سرعان ما أعاد بناء مؤسسته. وقال لي: واصل إصدار “الكرمل”. كان مهتماً حتى بالجانب الثقافي. فقلت له أين أصدرها؟ قال لي: حيث تشاء، في لندن، في باريس، في قبرص.. ذهبت من ثم إلى قبرص كي أرتب شؤون الرخصة. وصدرت “الكرمل” من قبرص فيما كنت أنا أحررها في باريس وأطبعها في نيقوسيا وكان معاوني الكبير هو الشاعر سليم بركات”.
عاش في باريس نحو عشر سنوات ولكن في شكل متقطع، إذ كان يسافر باستمرار. وبقي قريباً من منظمة التحرير في تونس.
يصف درويش إقامته في باريس بالقول:
“كانت باريس عبارة عن محطة أكثر منها إقامة أو سكناً. لا أعرف. لكنني أعرف أنه في باريس تمت ولادتي الشعرية الحقيقية. وإذا أردت أن أميّز شعري، فأنا أتمسك كثيراً بشعري الذي كتبته في باريس في مرحلة الثمانينيات وما بعدها. هناك أتيحت لي فرصة التأمل والنظر إلى الوطن والعالم والأشياء من خلال مسافة، هي مسافة ضوء. فأنت عندما ترى من بُعد، ترى أفضل، وترى المشهد في شموليته. علاوة على أن باريس جمالياً تحرّضك على الشعر والإبداع. كل ما فيها جميل. حتى مناخها جميل. في باريس كتب في وصف يوم خريفي: “أفي مثل هذا اليوم يموت أحد؟”. ومدينة باريس أيضاً هي مدينة الكتّاب المنفيين الآتين من كل أنحاء العالم. تجد العالم كله ملخصاً في هذه المدينة. وكانت لي صداقات مع كتّاب أجانب كثيرين. وأتاحت باريس لي فرصة التفرّغ أكثر للقراءة والكتابة. ولا أعرف فعلاً إن كانت باريس هي التي أصابتني أم أن مرحلة نضج ما تمت في باريس، أم أنه تطابق العنصرين بعضهما مع بعض؟ في باريس كتبت ديوان “ورد أقل” وديوان “هي أغنية” و”أحد عشر كوكباً” و”أرى ما أريد” وكذلك ديوان “لماذا تركت الحصان وحيداً؟” ونصف قصائد “سرير الغريبة”. وكتبت نصوص “ذاكرة للنسيان” وغاية هذا الكتاب النثري التحرر من أثر بيروت، وفيه وصفت يوماً من أيام الحصار. معظم أعمالي الجديدة كتبتها في باريس. كنت هناك متفرّغاً للكتابة على رغم انتخابي عضواً في اللجنة التنفيذية. وفي باريس كتبت نص إعلان الدولة الفلسطينية. مثلما كتبت نصوصاً كثيرة ومقالاً أسبوعيا في مجلة “اليوم السابع”. كأنني أردت أن أعوّض عن الصخب الذي كان يلاحقني في مدن أخرى”.
- عمّان / رام الله
بعدما أصبح في إمكاني أن أعود إلى “جزء” من فلسطين وليس إلى “جزء” شخصي بل إلى “جزء” من وطن عام، وقفت طويلاً أمام خيار العودة. وشعرت بأن من واجبي الوطني والأخلاقي ألا أبقى في المنفى. فأنا أولاً لن أكون مرتاحاً، ثم سأتعرض إلى سهام من التجريح لا نهاية لها، ثم سيقال إنني أفضل باريس على رام الله أو على غزة. وبالتالي اتخذت الخطوة الشجاعة الثانية بعد الخروج وهي خطوة العودة. وهاتان الخطوتان من أصعب الأمور التي واجهتها في حياتي: الخروج والعودة. اخترت عمان لأنها قريبة من فلسطين ثم لأنها مدينة هادئة وشعبها طيب. وفيها أستطيع أن أعيش حياتي. وعندما أريد أن أكتب أخرج من رام الله لأستفيد من عزلتي في عمان.
التوتر عالٍ جداً في رام الله. ومشاغل الحياة الوطنية واليومية تسرق وقت الكتابة. إنني أمضي نصف وقتي في رام الله والنصف الآخر في عمان وفي بعض الأسفار. في رام الله أشرف على إصدار مجلة “الكرمل”.
ويكشف غانم زريقات صديق درويش عن بعض التفاصيل في حياته بالقول: “جاء محمود إلى عمّان نهاية العام 1995، لأنها المدينة الأقرب إلى فلسطين أول الأمر، فعندما دخلت القيادة الفلسطينية إلى فلسطين بدأ محمود يفكر جديا في ترك باريس، وكان الخيار أمامه القاهرة أو عمّان. بعض الأصدقاء، بينهم الدكتور خالد الكركي، الذي كان وزيرا للإعلام شجعوه ورحبوا به للإقامة في عمّان، وقوبلت الفكرة بالترحاب الشديد وعلى أعلى المستويات في الدولة الأردنية، وعندما وصل محمود إلى عمّان، بدأ يفكر في استئجار شقة متواضعة، كما كان الحال في تونس، الرجل الطيب المقاول الأردني مروان العبداللات رفض أن يؤجر محمود درويش، وحلف أيمانا كثيرة أن الشقة هدية ورفض أخذ ثمنها. ولكن محمود رفض بشكل قاطع هذا العرض، وأخيرا اشترى المنزل بسعر التكلفة. اختار عمّان لأنها برأيه أفضل مدينة يمكن أن يختلي فيها بكل هدوء ويكتب، وهذه المدينة وفرت له حقا هذه الميزة، كما أن أصدقاءه قليلون جدا فيها. راق له هدوؤها وسهولة التنقل فيها، وارتبط بمجموعة علاقات منتقاة مع العديد من العمّانيين، الذين أحاطوه بكم هائل من الحب غير القاسي”.
لم تختلف حياته في بيروت وباريس والقاهرة عن حياته في عمان وإن كان أبرز ما يميزها أن معظم وقت درويش في عمّان كان للعمل الجاد، خير دليل على ذلك أعماله الشعرية جميعها التي صدرت عن دار رياض الريس في بيروت مثل: الجدارية 2000، حالة حصار 2002، لا تعتذر عما فعلت 2004، كزهر اللوز أو أبعد 2005، في حضرة الغياب 2006، أثر الفراشة 2008، معظم هذه الدواوين كتبت بين عمّان ورام الله.
في مديح الموت
لقد كان الموت عند درويش ملحميا في أوديسا هوميرية ذا طابع عربي، في تراجيديا الحياة العصيبة التي كان يعيشها، ظل ينكر آلامه أو لأكون أوضح آلام الشاعر قياساً بآلام المهجرين واللاجئين، ففي لقاء تلفزيون عام 1983 قال درويش أن معاناته لا تساوي شيئا قياساً بآلام الجنود الفلسطينيين لكنني أفعل كل ما بوسعي لكل أجعل الحرب ليست حرباً على الصعيد الأرضي بل أيضاً على الصعيد النصي للقصيدة، وهذا يظهر في جداريته الملحمية
فلقد بات الموت الذي يتهدد الذات الشاعرة معاناة وجودية يعيشها درويش بعمق فاجع. وهو ما جعل لحظة انتظار الموت تتحول إلى ضغط نفسي رهيب. ومن هنا شكل الموت في الجدارية حالة ذهنية يتعانق فيها الداخل والخارج نجم عنه جدل شعري لحمته وسداه حركة الخيال الشعري التي تتخذ اشكالا متنوعة بمعاونة جملة من الإمكانات التعبيرية الماتعة التي تجسد معاناة الذات في توهجها الشعري وهي تحاول تخليد كينوتها الرمزية. ولذلك تميز خطاب الموت في جدارية درويش بكونه يتأسس باعتباره احتفاء بالفجيعة والغياب، حيث تتحول المعاناة التي تتخذ صورة الفجيعة إلى حضور جمالي فياض وشفاف.
في هذه القصيدة التي يعتبرها درويش معلقته الأخيرة يعتصم الشاعر بوحدته يصيخ السمع لذاته ويغني لفجيعته لكي يصوغ ملحمته الفريدة والمتفردة التي يواصل من خلالها ديمومة الخلق والإبداع وتجديد الرؤى مستلهما عبقريته الشعرية الفذة التي مكنته من الحفر عميقا في أخاديد ذاته التي امتلأت بكل أسباب الغياب فبدأت تعد العدة للرحيل الأخير:
أما أنا – وقد امتلأت
بكل أسباب الرحيل-
فلست لي
أنا لست لي
أنا لست لي…
9 أغسطس 2008 لاعب النرد يكف عن مداعبة الحظ ويقفل الطاولة ويموت في الولايات المتحدة بعد إجراء عملية قلب مفتوح في هيوستن التي دخل بعدها في غيبوبة أدت إلى وفاته.
…………………..
المصادر:
– الأعمال الشعرية الكاملة طبعة باريس
– أصداء في فلسطين ( فيلم وثائقي )
– مجلة الكرمل
– لقاء مع فنان 1983
– ذاكرة للنسيان
– محمود درويش سيرة ذاتية (مجلة قلقيلية تايمز )