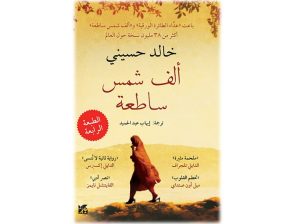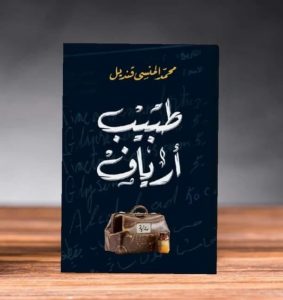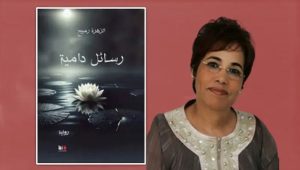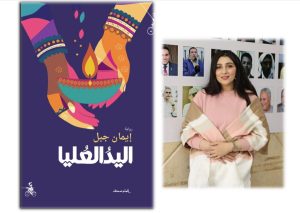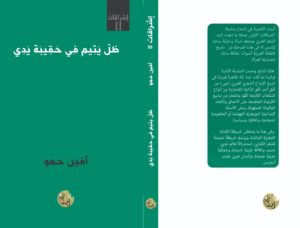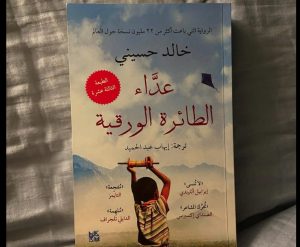محمد عبد النبي
كتب صنع الله إبراهيم روايته الثانية (67) بعد سفره إلى بيروت في العام التالي مباشرة على هزيمة 1967، والأحداث لم تزل ساخنة وحيَّة في الذاكرة والدخان لم يتبدد بعد، غير أنَّه عمدَ إلى كتابتها من أبعد نقطة ممكنة عن السخونة والغليان والخطاب المباشر الزاعق. وقد نقل فيها الأجواء العامَّة المُخيمة على المجتمع المصري وشريحة المثقفين والفنانين تحديدًا في تلك اللحظة المظلمة والمشبَّعة بالخوف وانعدام اليقين.
عبرَ اثنا عشر فصلًا أو شَهرًا، من يناير إلى ديسمبر 1967، يستعرض كل فصل لمحة خاطفة من حياة صحفي شاب (ليس في مقتبل العُمر كثيرًا مع هذا)، له تاريخ سياسي وخاض تجربة الاعتقال على ما يبدو. يعيش مع أخيه الكبير وتربطه بزوجة هذا الأخ علاقة عاطفية وجنسية سرية، ويفكِّر في السفر خارج البلاد، ويتحرك في محيط من شخصيات شبيهة ذات صلة بالفن والثقافة والسياسة، وتكاد تكون جميعها مشوَّشة بدرجة أو أخرى.
السَرْد محايد بارد والعبارات تلغرافية ولا استبطان للشخصيات أو تأمُّل للمشاعر والأفكار. كل شيء يمرُّ على السطح سريعًا خفيفًا، سَطح الوعي أو القشرة الخارجية (المُدرَكة بالحواس فقط) للعالَم. قد يشعر القارئ أحيانًا أنه أمام شريط سينمائي مكتوب بالسرد، لكنه فيلم لا يكاد يحدث فيه شيئ. ثمَّة حوار بين الشخصيات لكن بلا تواصُل حقيقي أو فَهم عميق متبادَل. ولولا شذرات أحلام للرواي لما اطَّلعنا على أي جزء من باطنه المخفي عمدًا، كأنَّه يخشى الإفضاء به حتَّى لنفسه. نعرف عن كرَّاسات يكتب فيها دومًا لكننا لا نلقي نظرة ولو خاطفة عليها. كل شيء مصمَت وصامت كأنَّها حالة ترقُّب أو انتظار لكارثة وشيكة.
في أجزاء كبيرة من الرواية نتابع حركة الراوي وهو يدور من شارع إلى آخَر ومن أتوبيس نقل عام إلى تِرام، حيث يعكس هذه الأجواء المخيمة من القلق والحَنق المكتوم، مع تظاهُر بأنَّ كل شيء على ما يُرام. في زحام المواصلات العامة يبحث عن أنثى ترتضي شيئًا من العبث الجسدي الخفيف، هربًا مِن شيء يثقل على كاهله ولا يجرؤ على تسميته صراحة، شيء يشبه فقدان المعنى أو ربما الإحساس بالعجز والذنب تجاه أخيه الذي يخونه.
بحسب مقدمة صنع الله إبراهيم للرواية المنشورة في دار الثقافة الجديدة سنة 2017، أنَّ سهيل إدريس في دار الآداب اللبنانية في معرض رفضه نشر الرواية بعد كتابتها مباشرةً، قال إنَّ بطلها مصاب بالهَوَس الجنسي. قد يبدو الأمر كذلك للوهلة الأولى، لكنَّ الاندفاع المستميت نحو الآخَر، نحو جسد الآخَر، سواء كان في مع زوجة أخيه أو في زحام الحافلات العامة مع امرأة مجهولة غريبة، ليس بالضرورة هَوَسًا جنسيًا بقدر ما قد يكون تعبيرًا عن ذُعْرْ حبيس، هربًا مِن مطاردة أشباح غير مرئية تثقل الهواء نفسه وإزاحة لهواجس ومخاوف في نشوة الجنس المؤقتة كأنها نوع من المخدرات.
هذا الخوف المُهيمن على الجميع مثل غمامة سوداء لا يظهر صراحة في خطاب فج أو عبر حوارات الشخصيات أو حتَّى أفكار الراوي ومناجاته لنفسه، بقدر ما يتسلل عبر السطور مثل غازٍ سام. وقد يُلمَح خطفًا في وجه بقَّال تبدو ملامحه كأنه يوشك دائمًا على البكاء، أو في حلم مِن أحلام الراوي، أو في الحقيبة التي يعدُّها استعدادًا لأخذه، أو حتَّى في طفح جلدي يداهمه بلا سبب.
أمراضُ الخوف والتظاهُر والتواطؤ أعارت لرواية 67 الأسلوب الصافي المجرَّد بلا زخارف وحلي هي أصلًا مستبعدة من كتابة صنع الله إبراهيم، ربما كرد فِعل واعي على فائض البلاغة في تراث الأدب العربي أو الخطاب الرسمي المهيمين سياسيًا. تقدَّم لحظات الحرب بلا إغراق في توثيقها بالمعلومات والبيانات، بل بالاكتفاء بالشذرات التي تصدر عن الراديو أو على لسان شخصية أو أصوات الانفجارات ونزول الناس للمخابئ ، حيث حتَّى في قلب ظلمة قد تمتد يدٌ خائنة لتعبث بجسد متواطئ، كأنَّ مثل هذه المشاعر لا مكان لها إلَّا في ظل الخوف والظلام.