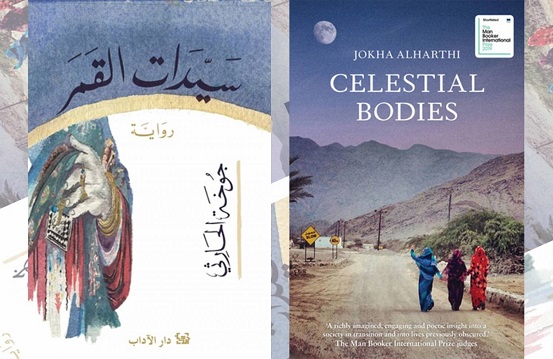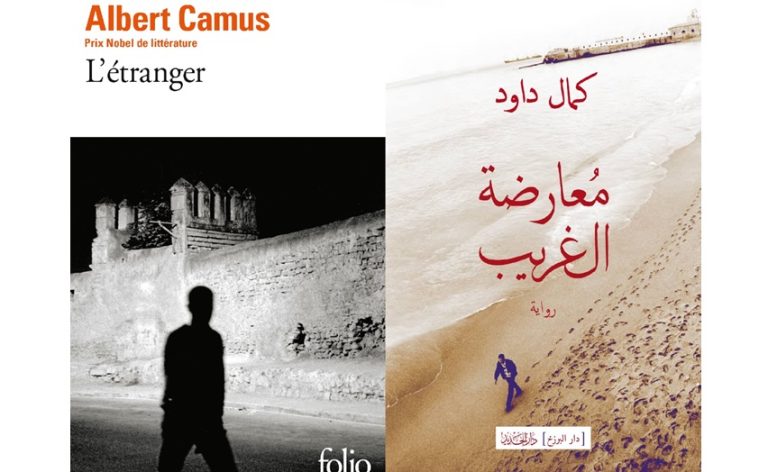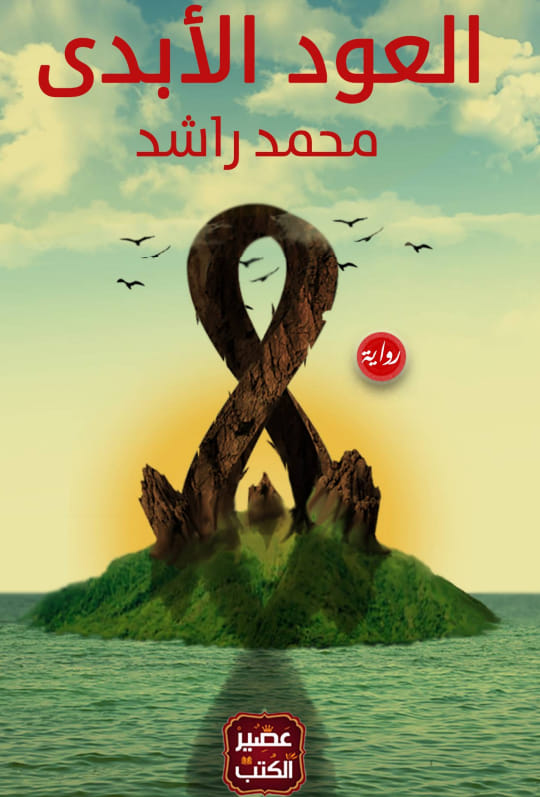حاورها: عبدالدائم السلامي
أصدرت هدى بركات، الروائية اللبنانية المقيمة في فرنسا، مجموعة من الروايات منها “حجر الضحك” و”حارث المياه” و”سيدي وحبيبي” و”بريد الليل”. وهي روايات نالت ببعضها تكريمات وجوائز منها، جائزة نجيب محفوظ والجائزة العالمية للرواية العربية. في هذا الحوار تكشف هدى بركات عن مناخات الكتابة لديها، وعن موقفها من النّقد، وتؤكّد أنّ النصوص التي تُكتب على مقاسات الرَّواج لا تعيش طويلا، وأنّ جهدها الرّوائي مُنصبٌّ في أغلبه على الإنصات إلى أصواتِ الغرباء والهامشيين والضعفاء.
■ الشروع في كتابة رواية، على حدِّ قول رولان بارت، هو دخول في نوعٍ من الزُّهد العظيم، أو هو شبيهٌ بدخول المرء في ديانة جديدة. هل بهذا الشعور تُباشرين كتابة رواياتك؟
□ يسبق الشروع في الكتابة شعور عميق بالقلق. فالدخول إلى عالم رواية جديدة يأتي مصحوبا بالخوف. الخوف من الفشل في التقاط الجملة الأولى، والخوف من مواجهة مغامرة لا تدري إلى أين ستأخذك، ربما في الكشف عن نفسك، هذا إذا كنت بدأت بوضع كلمات على الصفحة البيضاء بالفعل. هذه الفترة تتصف بعدم الاستقرار ذهنيا، كأنّك تبحث بإلحاح عن شيء لا تعرفه، وأيضا وبصعوبة التواصل مع العالم الخارجي. لكن “الزهد” يفترض وضعا مريحا، اجتماعيا وماديّا، أي أن تكون لك القدرة الباذخة على الانقطاع عن العالم أي عن العمل من أجل العيش. هذا حلم. وهذا الحلم يصبح مع الأيّام أشبه بالضرورة… أي أن يكون العالم الخارجي مجرد ظلال بعيدة، وبحيث تصبح مخيلتك هي “الواقع” الوحيد، أو الأكثر تحقّقا. لقد تعمّقت قناعتي هذه بعد الحصول على بضعة شهور من العزلة في استضافات أدبية انصرفت خلالها كليّا للكتابة. وهذا لا يعني فقط الوقت التراكمي المعطى للكتابة، لكن أيضا الوقت النوعي لإعطاء التجربة مداها التجريبي والبحثي والتأملي. كنت أعمل وأربّي أولادي وأكتب. لم يكن ذلك سهلا بالمرّة، لكنه كان ممكنا. الآن أنا بحاجة كبيرة للعزلة قبل وخلال الكتابة، لأن بحثي في تعميق تجربتي يزداد، وحاجتي للوقت البطيء والمرتاح صارت أكبر. ربما استطعت الكتابة في “أوقات الفراغ” لكنّها لن تكون الكتابة التي أطمح إليها. وفي كل الأحوال أنا بعيدة عن هاجس الانتظام في النشر. وبطيئة في الكتابة، بحيث تفوت سنوات طوال ما بين رواية وأخرى.
■ يغلب البُعد السّوداويُّ على شخصيات رواياتِك، فكلّ أبطالِها مُطارَدون (بطل “حجر الضحك” مطارَد بمثليتِه، وبطل “حارث المياه” مُطارد بكلاب الحرب، وأبطال “بريد الليل” مطارَدون بماضيهم، …)، فهل قدر الرواية أن تكون ديوانًا للأحزان؟
□ أنا لا أعرف ما هو “قدر الرواية”. وأنا أستنتج معك أن أبطالي هم فعلا كذلك. لكنّني لا أخطّط لذلك. أنا أكثر قابلية للإنصات إلى الغرباء، أو الهامشيين والضعفاء. وليس عندي أوهام كثيرة جميلة مطمئنة عن العالم المحيط بنا… كما أن إيماني بصحّة العلاقات البشريّة وقدرتها على الإنقاذ، ضعيف، ربما يعود ذلك إلى تجربة العنف في الحرب الأهلية التي عشتها في بلادي. وعموما لست إنسانة ميّالة إلى الإجابات السهلة على أسئلة الوجود المعقدّة، أو أنني لست من النوع المتفائل إن كان ينبغي توصيف الناس وطبائعها اختزالا بـ”متشائم”/ “متفائل”. هل من المجدي أن نضيف أحوال مجتمعاتنا العربيّة، وذلك سوء الفهم الفظيع في علاقتنا أفرادا ومجتمعات بالعالم، بعالم الأقوياء؟ على أيّ حال في الكتابة عموما ما يشبه الشكوى من عدم التطابق مع “منهج” العالم الخارجي، من فقدان لأدوات الطواعية المتوجّبة، من إعاقات ربما تحول دون التكيّف مع أدوات السلوك العام، الناجح اجتماعيا. هناك أيضا ما يسمّى بالوعي الشقي الذي استخدمه هيغل للتعبير عن شعور المرء بالاغتراب، ببقائه رغما عنه خارج “حفلة” السعادة العامّة. بوعيه لمسافة نقدية تنشأ عن مبالغة في التفحّص، ربما. بالنسبة لشخصيات رواياتي، تختلف “الأحزان” باختلاف المصائر، وطبعا باختلاف الحكايات، لكن ربما يجمعهم نوع من التوحش، بالمعنى الفلسفي للكلمة. وأقدار تخضعهم كأفراد إلى حكم الجماعات بدون إرادة منهم، أو قدرة على التأثير في مسارات حيواتهم. أليس لنا عبرة في ما تعلّمناه عن الإغريق ومآل التراجيديا، وعودة ملامحها قوية إلى عالمنا المعاصر. صحيح كما تقول إحساسهم بالـ”مطاردة” بأنهم مطاردون، بأنهم طرائد، ولا حيلة لتفسيرهم ما هم فيه، أو معرفتهم بالصيّاد أو بالفخ. فـ”أبطالي” ليسوا من المثقّفين، أو شديدي الذكاء أو المالكين لأدوات المعرفة…
■ إنّ قراءةَ المنجز الروائي العربي الراهن يوقفنا على ملاحظة أنّ أهمّ ثيمات السرد فيه هي “العبودية” و”الإرهاب” و”المثلية الجنسية” و”الصديق اليهودي” و”نقد التاريخ الوطني”، وهي ثيمات تبدو هي نفسها العناوينَ الرئيسةَ لمطالب السياسة الغربية التي ترغب في تأصيلها في واقعنا العربي. إلى أيّ مدى تصحّ هذه الملاحظة؟
□ أنا لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال لأن اطلاعي على حديث الرواية العربية غير كاف، ولا يؤهلني للحديث عن “المنجز الروائي العربي الراهن”. عيشي الدائم في أوروبا/ أو بين أوروبا وأمريكا/ يجعلني أقنّن في مشترياتي من الكتب، إذ لا تسمح الأوزان المسموح بها في حقائب السفر بحمل الكثير. لعلّ ما تفترضه في سؤالك صحيح. لكن النصوص التي تُكتب على مقاسات الرواج، إن شرقا أو غربا، لا تعيش طويلا. وليست الترجمة إلى لغات أجنبية انتشالا لها من الفشل، بل غالبا ما يحصل العكس، وتفضح الترجمة تسطّح أو غباء النصّ. على أيّ حال ليست “المواضيع”، مهما كانت، هي ما يحمل النصّ. فالكتابة الروائيّة ليست شرحا لموضوع أو دفاعا عن قضيّة ما. أي أن هذا لا يكفي أبدا. الكتابة الروائية هي وعي المعالجة، ورفدها بثقافة عالية، غير استعراضيّة، وبحسّ رهيف بالإنصات إلى العالم… هذا إن كان هناك من “نظرية” فاعلة وأنا لا أعتقد بوجود وصفة ناجحة في هذا المجال. ومع ذلك ينبغي القبول بقواعد اللعبة. يعني أن تتقبّل رواج نصوص كثيرة بتأثير الموضة أو الشعبوية، أو تلك التي تستجيب لأفكار رائجة تحاكي الغرائز أو الأيديولوجيّات. هذا موجود عندنا وعند غيرنا، وفي كل زمان ومكان. أنا شخصيا أجد أن هناك متسعا للجميع، فعلا.
■ بِمَ تفسِّرين قول بعض النقاد بأنّ لدينا كثيرًا من الروائيين مُقابلَ قليل من الرواية؟
□ في الحقيقة أنا لا أعرف ما يقول النقّاد. أنا أتابع كتابات نقاد يقل عددهم عن عدد أصابع اليد الواحدة. ثمّ هناك “نقاد” مفوّهون على اليوتيوب، صاروا أصحاب سطوة، وآراء “نقدية” في صفحات “الغود ريدرز” يقابلهم نقّاد أكاديميّون ونظريّون – كنتَ أنتَ كتبت عنهم- يقرأون بعضهم بعضا، ولا يقدّمون مادّة نقدية تنير القارئ أو تبعث فيه حسّا أدبيا أو حب القراءة. أعتقد أن ذلك أصبح خطيرا على الذائقة الأدبية عندنا.
……………..
*نقلا عن “القدس”