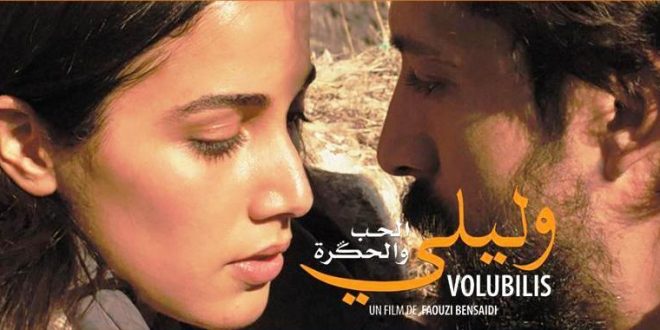أحـمد عبد الرحـيم
فى المسلسل التلفزيونى المصرى أحلام الفتى الطائر، تنكر اللص “إبراهيم” (أداء عادل إمام) كطباخ هروبًا من مطاردة الشرطة، وعند عمله لدى رجل أعمال، طلب منه الأخير طبخ وليمة مبهرة لضيوفه الصعايدة، ولأن “إبراهيم” لا يفقه فى الطبخ شيئًا، ظل يضع الخضراوات، على الفاكهة، مع البهارات، والسكر، والبيض؛ مدعيًا أنه يصنع “يخنى” خاصًّا جدًا، وكانت المفاجأة أن هذا اليخنى المزعوم نال استحسان الضيوف الصعايدة، معتبرين إياه أكلة لذيذة لا مثيل لها. لابد أن أتذكر هذا المشهد الساخر عند التعرض لفيلم المخرج الأمريكى “ستانلى كوبريك” The Shining أو الإشراق (1980)؛ فالطبخة غريبة، والنجاح كبير، فى الحالتين!
الفيلم مأخوذ عن رواية ناجحة صدرت بالعنوان نفسه سنة 1977 لأديب الرعب الأمريكى المعروف ستيڤن كينج؛ والذى اقتبست السينما والتلفزيون حوالى 100 عمل أدبى له خلال الأربعين سنة الماضية، ويدور الفيلم حول أديب اسمه “چاك” (أداء چاك نيكلسون) يعانى من جفاف إبداعى، ويبدو تعافيه من إدمان الخمر، فيسافر وأسرته إلى منطقة مهجورة، ليعمل كمشرف لفندق خلال إغلاقه طيلة الشتاء، رغبة فى العودة لممارسة الكتابة وسط جوّه الهادئ. يمتلك طباخ الفندق “ديك” (أداء سكاتمان كروثرس) قوى تخاطرية يسميها “الإشراق”، ويتواصل بها مع ابن “چاك”، الطفل “دانى” (أداء دانى لويد) الذى يمتلك القوى ذاتها. يخبر الطباخ الابن أن الفندق به “إشراقات” أيضًا بعضها سيئ، كما حذّره من الاقتراب من الغرفة رقم 237. بمرور الوقت، يزداد “چاك” إنعزالًا، وعصبية، وجفافًا إبداعيًا؛ ليكتب رواية كاملة مكوّنة من جملة واحدة / مثل إنجليزى يقول: “All work and no play makes Jack a dull boy” أى “عدم اللعب يجعل چاك بليدًا”. ثم يقابل فى الغرفة 237، وغيرها، أشباح أناس عاشوا قديمًا فى المكان، منهم مُشرِف قديم قتل أسرته ونفسه منذ سنوات طويلة. يرى “دانى” كوابيس مخيفة، ويتواصل مع طفل وهمى يبتكره خياله ويسميه “تونى”، ويظل يردِّد كلمة “Redrum” وهى عكس كلمة “Murder” بمعنى “قتل”، ويحاول شبح سيدة خنقه عند دخوله الغرفة 237. تقلق الزوجة “ويندى” (أداء شيلى دوڤال) بخصوص سلوكيات زوجها، وتشك فى عودته للخمر، مع حدوث عاصفة تعزلهم جميعًا عن العالم الخارجى، وفى إحدى الليالى، تتطوّر حالة “چاك” إلى العنف، ويقتل الطباخ “ديك”، ثم يطارد زوجته ببلطة، مُحاولًا قتلها وولده، واللذين يهربان إلى متاهة تحويها حديقة الفندق. ثم فى الصباح، تهرب الأم وولدها، ويموت “چاك” متجمدًا وسط الثلوج، وتقترب الكاميرا ببطء من صورة فوتوغرافية بالقصر، مأخوذة سنة 1921، أى قبل الأحداث بـ60 سنة تقريبًا، لنرى فيها “چاك” شابًا، يبتسم وسط مجموعة من الأثرياء فى حفلة!
لهذا الفيلم مشكلة واضحة: أنه أراد أن يقول الكثير فى وقت واحد. بعد 3 مرات مشاهدة، لم أستطع أن أقرِّر؛ ما الموضوع بالضبط؟! هناك مؤلف لا يستطيع التأليف، وظاهرة تخاطر تحدث بين ابنه الصغير والطباخ العجوز، ومنزل ملىء بالأشباح، ناهيك عن أن هناك طفلتين توءمين تظهران وتختفيان فجأة، وطفل يردِّد كلمة واحدة بالعكس إلى ما لا نهاية، وإمرأة جميلة تتحوّل إلى جثة نتنة فى لحظة، وإنسان، أو إنسانة، فى زى دب يمارس الجنس الفموى مع رجل، وأخيرًا، صورة فوتوغرافية تشير إلى تناسخ أرواح.. حسنًا، هذا كثير بالفعل!!

تتأجج المشكلة عندما يترك كوبريك الباب مفتوحًا لقراءة مضامين هجائية كثيرة ومتباينة. فهناك فندق تم بناؤه فوق مقابر الهنود الحمر، وحضور للعلم الأمريكى فى الخلفية، وحضور أكثر كثافة لألوانه فى ملابس الشخصيات، وموت البطل وسط الثلوج؛ أهى أمريكا التى شيَّدت حضارتها على الإبادة الجماعية، وستنتهى متجمدة مفلسة مجنونة؟! كما أعتبر البعض أن هوس البطل، واتجاهه إلى العنف، ثم نهايته المأسوية دلائل على أن الفيلم يستعرض ألمانيا النازية، والهولوكوست، وموت أودلف هتلر؛ مع تمييز كثيرين لشارب هتلر على وجه البطل فى لقطة تجمده! أو أن تفاصيل صغيرة فى أرقام الغرف، وملابس الابن، ونقوش السجاجيد توحى باعتراف كوبريك أن هبوط مركبة أبوللو 11 الأمريكية على القمر فى يوليو 1969 كان مزيفًا، وأنه أخرج هذا الأمر بأحد الاستديوهات كجزء من خدعة استهدفت المواطن الأمريكى والعالم؛ إذًا أهو اعتذار متأخر من المخرج، واتهام لـNASA أو وكالة الفضاء الأمريكية بتخطيط ذلك؟! إننا حتى لو سلّمنا بأنه مجرد عمل عن جحيم يعيشه مبدع نَضُب إبداعه، وتشوّهت علاقته بأسرته، وتحوّل تدريجيًا للهلاوس ثم الجنون؛ فما معنى القوى التخاطرية التى يملكها ابنه وطباخ الفندق؟ وما الذى قادت إليه؟ وما مغزى تفاصيل عديدة أولها الصورة الفوتوغرافية الأخيرة؟!
دعنا نفترض أن الفيلم عن التواصل فى المجتمعات العصرية؛ المستريحة ماديًا، والمتطوِّرة علميًا. حيث يتوافر المسكن والمأكل والمشرب.. والفراغ أيضًا، ويستسلم أبناء الطبقات الوسطى أو العليا للآليات الحديثة التى تتيح لهم ما يريدون، بدون بذل تعب أو إنفاق وقت؛ مثل – كما يعرض الفيلم – مخزن هائل للطعام، وجهاز تلفزيون، ولاسلكى.. إلخ. وكيف أنه وفقًا لهذه الظروف تتفسخ العلاقات الإنسانية، حتى وسط الأسرة الواحدة، ليصبح هناك من يتقوقع على روحه، وينعزل عن العالم، ليغرق فى الأفكار السوداوية، ويتواصل مع أشباح (البطل)، وهناك من يحاول الاحتفاظ ببراءته، واللعب، والتحرُّر من هذا السجن بالتواصل مع بشر مثله (الطفل عبر التخاطر). ليصاب – فى النهاية – النوع الأول بالجنون والشراسة، ويتمكن النوع الثانى من الفرار بعقلانيته وحياته. ربما هذا كلام جيد كان يمكن للفيلم أن يعبِّر عنه ويكتفى به. لكن المأساة أن كوبريك لم يكتف به، وتفنَّن فى طمره، أو طمسه، تحت محيط من الألغاز. تستشف هذا وسط حديث للناقد المصرى الأستاذ محمد فتحى فى كتابه “سينما العصر والإنسان”، الصادر عن دار الهلال سنة 1991، عندما يقول فى صـ141 و142 أن كوبريك لم يتطرّق لظاهرة التخاطر فحسب، وإنما تطرق لظواهر أخرى منها “العلاقة بين الإبداع والعدوان، بل والعلاقة بين الحب والعدوان، وتجسيد ظواهر مثل تعدد الذوات داخل الإنسان، من حالات الأنا: الطفل واليافع والوالد، إلى ثنائية دانى وتونى الطفل الذى يعيش فى داخله، وثنائية الطفلتين، إلى تعدد وجوه الأب بين المرآة والشكل الشبحى، مما يصل حتى إلى تناسخ الأرواح والعيش قبل 50 سنة فى نفس الفندق. هذا ناهيك عن أفكار مثل كمون الشر والجنون فى داخلنا وفكرة العالم النقيض؛ Murder نقيض “Redrum. ألا تلاحظوا، رغم النبرة المادحة ضمن حديث الأستاذ محمد فتحى، أن كل ذلك كان كثيرًا جدًا، وصعب الهضم جدًا؟!
أصل الحكاية أن كوبريك بعد الفشل التجارى لفيلم الدراما التاريخية Barry Lyndon أو بارى ليندون الذى أخرجه سنة (1975) رغب أن يقدم فيلمًا ناجحًا تجاريًا، ومشبعًا فنيًا وفكريًا أيضًا، ولما أعجبته رواية “الإشراق”، صمّم على اقتباسها بنفسه مع الروائية دايان چونسون. لكن لا شك أن معادلة “فيلم الرعب ذى البعد الجاد” التى انتواها كوبريك لم تحقِّق ذاتها بتوازن. فعلى الرغم من اللمعان الجمالى، والنجاح التجارى للفيلم، فإنه لم يُقَابل نقديًا بحفاوة. والسبب ظاهر كالشمس؛ فأيًا ما فرضه كوبريك من قضايا هامة، وشفرات معقدة، أبعد فيلمه عن التناغم والوحدة، وقضى فيه على أى دراما، وحرمه من معنى واحد متماسك.
نعم، يصوغ كوبريك بأحجام وزوايا كادراته، وحركة كاميرته، وإضاءته، حالة من الغموض الممتزج بالرهبة، وثمة مشاهد تبث الخوف؛ كمشهد اكتشاف الزوجة لمشروع الكتاب الذى يؤلفه زوجها كجملة واحدة مكتوبة آلاف المرات، ومشهد تهديد البطل لها بالقتل. كما تحمل صورة الفيلم قدرًا من التفرد؛ مع – مثلًا – قصر مبدع الخواء، لقطات خارجية مهيبة الإتساع، كاميرا محمولة (steadicam) ناعمة الحركة. أى أن الفيلم حظى بعناصر، كالإخراج والديكور والتصوير، جعلته يبدو أرقى فنيًا من أى فيلم رعب عادى. لكن.. ماذا أضافت هذه العناصر غير صقل العمل بصريًا وإحكام جوِّه؟! ما المعنى الذى ساهمت فى تأسيسه وقوله؟! حتى لو افترضنا أن الهدف لم يكن سرد قصة لها “معنى” مباشر، وإنما تجسيد حالة شعورية لإنسان يفقد عقله؛ فإن الفيلم يمطرنا بسيل من التفاصيل والإحالات التى تُفقِدنا عقولنا!
أغلب المقطوعات الكلاسيكية المُستخدَمة على شريط الصوت كانت غاية فى الملل. شخصية الزوجة ظهرت بين الضعف والبلاهة، وكأنها موجودة فقط لتبكى وتصرخ. الأداء التمثيلى، خاصة من جهة دانى لويد كالابن، كان كوميديًا لكن معروض بجدية تامة مما أرعبنى شخصيًا! الفيلم طويل وبطىء (حوالى ساعتين ونصف الساعة)؛ فإذا ما كان هذا لتعزيز حالة الغموض والرهبة؛ فقد أدى غرضه، وإن كان على نحو يصل لحدود البرود أحيانًا. لكن إذا ما كان مقصودًا لحثِّك على التأمل؛ فلابد أن تسأل نفسك: ما الذى يملكه الفيلم، ومترابط، كى تستنتجه من هذا التأمل؟ إجمالًا، الإشراق كفيلم رعب بحت لا يمتعنى أو يرضينى رغم تميزه تكنيكيًا، وكفيلم له بعد باطنى؛ فمن المؤكد أنها أبعاد وليست بُعدًا واحدًا، وإنها مستقرة فى بطن الشاعر!
جدير بالذكر أنه عندما شاهد المخرج الأمريكى ستيڤن سبيلبيرج، صديق كوبريك، هذا الفيلم لأول مرة كرهه. لكنه يقول إنه بعد جلسات مطولة مع كوبريك، ومشاهدات تعدت 25 مرّة، أصبح من عشاق الفيلم. لم يدر سبيلبيرج، والذى حكى هذه الذكرى ضمن لقاء تلفزيونى سنة 1999 اُعدَّ لتكريم كوبريك بعد 4 أشهر من وفاته، أنه وجَّه أكبر إهانة للمخرج الراحل. فعندما يكون مطلوبًا منّا أن نجلس مع صانع الفيلم كى نستوعب مقاصد وبلاغيات فيلمه، فهذا لا يعنى إلا شيئًا واحدًا؛ أنه صنع فيلمًا منقوصًا، يستلزم كتيبًا توضيحيًا مُصاحِبًا ليسبر أغواره، ويفسِّر طلاسمه. باختصار، عندما لا يفلح الفيلم فى أن يكون مفهومًا، أو ممتعًا؛ فهذا اخفاق، ومع مخرج له وزنه.. فهذا اخفاق أكبر!
أظن أنه مثل المخرج البريطانى / الأمريكى ألفريد هتشكوك، والمصرى يوسف شاهين؛ تراجع مستوى كوبريك مع تقدمه فى السن. سواء كان السبب هو الغرور، أو فقدان الوحى، أو محاولة مناقشة 100 موضوع فى فيلم واحد؛ فقد انحدرت أعماله للضعف. انظر لأفلامه الأحدث لترى ذلك بوضوح. فإن Barry Lyndon أو بارى ليندون (1975)، و Full Metal Jacket أو بدلة معدنية بالكامل (1987)، و Eyes Wide Shut أو عيون مغلقة باتساع (1999) لا تطاول أفلامه الأقدم مثل Spartacus أو سبارتكوس (1960)، و Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb أو د. سترينچلاف أو كيف تعلمت أن أتوقف عن القلق وأحب القنبلة (1964)، أو حتى A Clockwork Orange أو برتقالة آلية (1971). تزداد المفارقة سوءً مع سلوك كوبريك الشهير لبلوغ الكمال، الذى وصل فى “الإشراق” – وهو العمل الأقل قوة – إلى التطرف الصارخ. طالع هذه المعلومات: لاختيار الطفل الذى سيؤدى دور “دانى”، أجرى كوبريك اختبارات لـ5 آلاف طفل استمرت على امتداد 6 شهور، كى يختار بعد كل ذلك دانى لويد؛ ذلك الطفل البعيد عن الموهبة، والمتمع بقدر مذهل من البلادة (والذى لم يستمر بعدها كممثل). المشهد الذى يشرح فيه الطباخ للابن ما هى ظاهرة الإشراق، أصر كوبريك على إعادة تصويره 148 مرّة؛ ومع أنه رقم سُجِّل فى موسوعة “چينيس” للأرقام القياسية، فإن منتوجه النهائى مشهد لا يحوى أى شىء عظيم. أراد كوبريك إعادة تصوير قتل البطل للطباخ 70 مرة، وعندما توسّل چاك نيكلسون لكوبريك أن يرحم كروثرس، ممثل دور الطباخ، لاسيما أنه كان فى السبعين من عمره، لم يستجب كوبريك، واستمر فى إعاداته المرضيِّة، حتى انهار كروثرس، وصرخ باكيًا: “ما الذى تريده يا سيد كوبريك؟!”.. الحق أنى لا أعرف ما الذى أراده السيد كوبريك، وهذا السؤال المحيِّر يصلح طرحه بخصوص الفيلم كله!
العجيب أنه وسط هذا الخليط الثقيل، تمكّن الفيلم من أن يصير مخيفًا. شخصيته القاتمة، وفنيِّاته المتميزة، والجنون الكاريزمى لنيكلسون؛ كل ذلك أنتج عمل رعب إستثنائيًّا. ثم جاء غموضه الأبدى ووهبه نوعًا من السحر. هناك ملايين يظنون أن “غير مفهوم” × “”كوبريك” = أمورًا عميقة + فن عبقرى + شىء لا يصح انتقاده! فى الواقع، كون الفيلم متخمًا ومشوَّشًا ومبهمًا، بالإضافة إلى حمله اسم “كوبريك”؛ ترك كل الفرص فى العالم لعشاق الفيلم، ودراويشه، ليملئوا المساحات الفارغة بتفسيراتهم الخاصة، صانعين نظريات متفرقة، أو يائسة، لتأويله. لكن أحدًا منهم لم يملك القدرة على ربط كل مكونات ذلك الخليط الثقيل. أترون كيف أن خطأ هذا الفيلم يمثِّل جزءً كبيرًا من سبب مكانته الكلاسيكية!
الإشراق فيلم فاتن من الخارج لكن مضطرب من الداخل. إنه عمل تائه فى متاهة مخرجه وموضوعاته المتعددة. للأسف، كوبريك لم يكن ليرضى أن يُخرِج فيلم رعب عادى، لذلك ظل يكدِّس ويمزج مكونات متنوعة معًا. صحيح حقّق هذا “اليخنى” الذى طبخه نجاحًا جماهيريًا، لكن لا يزال تشتته يُفسِد مذاقه، واكتظاظه يسبِّب التخمة!
…………………………..
نُشرت فى مجلة أبيض وأسود / العدد 41 / مايو 2015.