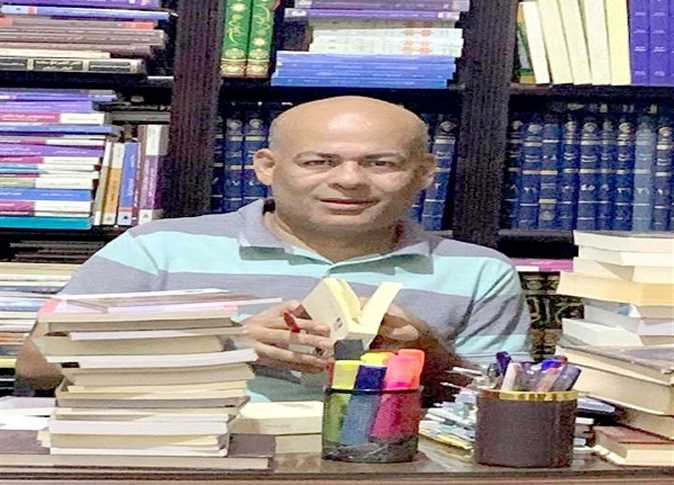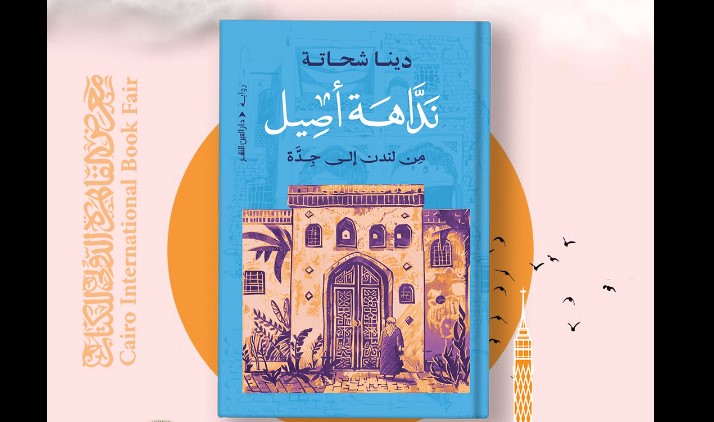محمد فيض خالد
لا يَزالُ لوقعِ رَحيلهِ لوعَة يأسف عليها أهل القرية جميعا، تتجدّد شُجونها غمّا، كلّما تناثرت “كيزان”طلع ذكور النّخيل، يملأ غبارها الغيطان، في مثل هذه الأثناء، وبينما الوجودُ يُراقِبُ في كمدٍ ظِلال المَغيب، ماسِحا بكفهِ رؤوس النَّخيل، اقبلَ ” بركات السِّكي” يُنوحُ نواح الثّكلى، ويندبُ حظّه مَفجوعا فوقَ حمارهِ، ما إن بَلغَ مَشارِف البيوت إلّا وهتَفَ مُتَوجِّعا:” لقد سقطَ قاعود من فوقِ نخلة السيد “، كَان لحديثهِ صداه المُروّع، امتلأت الجسور بأهلها يُجفِّف الحزن القلوب، لبست الدُّنيا قناع الكآبة فوق وجهها المغبر، لم تخلع ” زبيدة ” لباس حدادها مُنذ طارَ لبّها، لحظة رأت ابنها مُجندلا في ثيابِ الموت، لم تلوث شفتاها الابتسامة ولو سرقة، تُطالِعُ في ذهولٍ النخلة التي سقط من فوقها، تغيبُ للحَظَاتٍ عن أفكارها ؛ إيذانا باطلاقِ سلسالِ الصّراخ المُلتَهب، لحظات وتنقضّ عليها تكيل اللّكمات لجذعها وهي لاهثة، تُردِّدُ مأخوذة:” سوف اجتثّ أصلك أيّتها الملعونة، والأيام بيننا “، وبينما تهدد وتنذر تطلق صوتها في تباكي:
يا جريد النخل الغالي
طاطي وارمي السلام
واعمل ايدي مخده
واسبل عيني وأنام
وإن عشت يا بوابة
لأعملك ديدابان
يثير شدوها لواعج النِّساء العائدات من الحقولِ، حتّى بدت بعد هنيةٍ عليهِنْ نذير شؤومٍ، جاهدن طويلا في تحاشيها، تقول ” مستورة ” وابتسامة ترتعش خجلة على شفتيها:” هَمّ يضحك وهمّ يبكي “، أما ” سكينة ” خطيبة القتيل، فقد وجدت نصيبها مع رجلٍ غيره، حتّى وإن بقي لصاحبها أثرة من محبةٍ تُخَامِر قلبها، تَذكرهُ بها في خَبيئةِ نفسها، تنتَفضُ كَقطٍّ شرس ساعة رؤيتها، قائلة في وجدٍ مَشبوب: ” منها للهِ هي من قوّت قلبه صغيرا على طلوعِ النخيل حتّى أردته قتيلا !”،تعلّقَ صبيا بالنخلةِ، يضم شفتيهِ عن ابتسامةٍ صِبيانية يُطالِعُ جريدها المتهدِّل، تمنّى ألفَ مرة أن تجري بهِ الأيام ؛ ليكبر ويصبحَ في زُمرةِ الرِّجال، يُصارح أمه في تلهفٍ ساذج:” أريدُ أن اكبر مثل خالي عنتر، اتخذ بيتا في شواشي النّخيل”، تضمه في حنوٍ للحظات قبل أن تطلقهُ، مُستغرِقا في لَوامع أفكارهِ، ينَتفض من بينِ أيديها كعصفورٍ صغير، يضربُ بجناحيه، يُجاهدُ في استماتةٍ وقد احتضنَ بذراعيهِ “الكرناف”، يرمي ببصرهِ مليا، يجد في نفسه شيئا من اللومِ، تنزلق قدمه تحتَ تأثير الرغبة العارضة مُتَعثِّرا، يَعودُ سريعا يحملُ نفسهُ على سجيتهِ يُكرِّر المحاولة، لا ينتزعهُ من خضمِ أحلامه غيرَ صوت والدته يَأتيه مُهدهدا، يحثه العودة للدارِ، مشت بهِ الأيام، ومشى معه حِلمه يصحبهُ كثوبهِ، يتَخطَّفهُ في تَشوّقٍ؛ أن يُحلِّق كطيرٍ قوي لا يحجبهُ عن قُبةِ السَّماء حِجاب، اسلمَ قياده لهذه الأماني، أصبح بعد هنيةٍ لا يُرى إلّا مُتربّعا فوقَ الجريدِ، قد هيّأ لنفسهِ مُستقرّا يُلازمه، يقول ” حسين الحُصري “:” عجيبٌ أمر هذا الغلام، إنّه كغراب ٍ عجوز لا يحطُّ إلّا قمم النّخيل، تُرى ماذا يُخبَّئ القدر لهذا المُغامِر الجَرئ؟!”، لا تستعص أمامه نخلة، تراه يجري فوقَ جسدها الخشن جَريا، حتّى يلُامس قلبها، ثم يشرع في عملهِ، لا ينشغل بأجرهِ قدر ما تستهويه النخلة نفسها، حَذّره خاله من التَّهاون في استخدامِ ” المطلع ” اللّيف، يضحك ملئ شدقيهِ، وقد أضاءت السُّخرية وجهه:” مطلع إيه عيب، المطلع دا للعيال؟!”، وفي يومهِ الموعود، وبينما الدِّجنة تغزو حواشي الأفق الصَّافي، وطيور الجو تعزف نشيد الوداع، امتلأ الفضاء بصراخٍ كئيب، قادمٌ من جهةِ الشّرق، ليحمل النّاعي هلاكه، بكتهُ القرية كما لم تبك ميتّا من قبلِ، بدت الحقول قاتمة يلفها الحزن، يذكر “رمضان الحلاق “ذاكَ المساء جيدا، يقول في مرارةٍ:” لقد ذبل جريد النخيل، وكفّت نخلة السَّيد عن طرحها حتى ماتت، وفقد البلح حلاه “، شاخت ” زبيدة” ولعب بها الكبر، حطّت رحالها قعيدة دارها، لكن ذكراه لم تشيخ، حرمت نفسها أكل البلح، لا تمسّ يدها شيئا من أثر النخيل، اللهم إلا ” الجمار”، تلوكه بين أسنانها المهترئة في غرابةٍ، يتدفق البِشر من قسماتها، تدندن كلمات لحنها القديم، سألتها ذات مساء:” لماذا كُلّ هذا التَّلذذ من الجمار، وكراهيه سواه؟!” رمتني بعينٍ حَمئة ولم تجِب، غابت في قضم يُشبه التّشفّي، تُطالِعُ الفضاء الهامد أمامها.
***
العَوَض
مرّت الأيّام يقطر في إثرها عمره، يتألق في عينيهِ بريق الأمل، يُطالِع شبحهُ حينَ يتراءى فوقَ ماءِ التّرعة، يغرفُ غرفة بيدهِ يلَطمُ بها وجهه النّاحل عابثا، تمتزج قطراتها بدموعهِ المنسابة، يُساورهُ شعور الكَمد، لا يجد دون نيران صدره مَصرِفا، حين يشخص بصره قبالة ذراري من حولهِ من أبناءِ عمومته، الذين فَاضَ بهم الدّرب، يأمَل وجهَ النّهار وييأس آخره، يبوح بهِ الفِكر تبريحا، لا تزال كلمات أمّه ترنّ في مسامعهِ وهي تُحدِّثه حديث لهفة، تُحذِّره أن يصبِح أُحدوثةً في أفواهِ القوم:” دَعْ عَنكَ أوهامك، واتّخذ لكَ زَوجة جديدة تجلب لكَ من يحمل اسمك واهجر ثُريا، فهي أرض سبخة تجحد بذرتها”، يعودُ بذهنهِ يكرّ دفتر أيامه مُتَحسِّرا عليها، بعدما نُفضت دونما فائدة، يقولُ في لهجة ملؤها رنين الاقتناع:” كَيْفَ السّبيل وقد انقضى العُمر يا أمي وفاتَ الأوان؟!”، يُمرّر يده فوقَ جبهتهِ المحتقنة يعتصرها عصرا، يعالجها بطرفِ جلبابه يدسّها خَجلا، مُستعيذا باللهِ من كيدِ النساء، يَلح صوت الماضي، يأتيه مقتحما بلا إذن، تشخص فيهِ” ثريا ” شابة ملئ السّمع والبَصر، ترفلُ في جلبابها الفلاحي الأحمر، قد عصّبت رأسها بطرحةٍ بيضاء، تتلألأ صَبابةً تَحتَ أضواءِ ” الكلوب “، وأصوات النّساء والصّبايا من حولها، تتطايرُ مبتهجة، هي وإن تصغرهُ، لكنّه وجَدَ فيها فتاته التي يبحث عنها، حتّى ظنّ الناس أنّها عِلة تأخير زواجه، يتيمة الأب والأم، جلبتها خالتها ” عواطف ” بعدما انقطعت بها سُبل الحياة، مُذ قدمت لم يعرف جنبها الرّاحة يوما، تراها اعمل عمل الرِّجال، تحصد وتغرس وتقلع، وفي البيتِ تخبز وتمسح وتغسل، من وراءها خالة زرقاء النّاب ؛ لا تشبع من غلتها، حتّى ذهبت عن قلبها زهرة السّعادة، كَانَ زواجها من ” حسونة ” طوق النّجاة الذي مُدّ إليها فتعلّقت بهِ مُكرهة، آثرها دون بقية بنات العائلة، يكيل لها الحُبّ كيلا، انطوت أيامهما قانعا يدبّ في قلبهِ دبيب الرَّاحة، لم يفكِّر يوما في أمرِ ” العَوَض” مُكتفيا بهذهِ الحبيبة التي وجَدَ من عطفها ما يُرطِّبُ قلبه، اعتَرَف بينه وبين نفسه أنّ كلام أمّه المملول نَبّه قلبه الغافل، لكن فات أوانه !، فقد مرَّ على حديثها سنين طِوال، أيامئذ كان في مَيعة الشّباب، يستقبل الحياة بصدرٍ فتي لا يعرِف الخوف طريقه، أمّا الآن وقد انسلت الأيام منه، أخيرا أدرك أن سبب التعاسة حماقته، التي ساقته لأن يلقي بذكراه في آتون النسيان.
يحمل أبناء العائلة فوق كتفه منشرح الصّدر، ترضيه عبارات المحبة تملأ الحنوك، تغيّبه لحظات دافئة عن أوجاعه:” عامل إيه يا بويا حسونة؟”، هذه تكفيه، يرى في توقيرهم لعجوزٍ مثله ما يبلغ الحدّ، لم ينكر يوما أن تلك المشاعر الجياشة كانت تثير حفيظة ” ثريا “، يضحك ملئ شدقيه، حتى يغرق جفنيه الدّمع على سذاجتها، يقول في انبساطٍ:” هؤلاء من سيحملون رمّتي بعد مماتي “، لكّن المرأة الثرثارة لا تفتأ تذكره عجزه، تفرك الأرض من تحتها تغمغم بلسانٍ موتور، تدورُ بمخيلتها صورة حماتها الرَّاحلة، تلقي إليها التّهم الموجعة:” اتشطري علشان نشيل عيالك “، أصبح همّ الرّجل أن يتعالى على علتهِ بعدما أضحت ظِلّ شقوته الذي يحيا معهُ ليفسد حياته، يختلي ساعات فوق سطحِ داره، يّطوفُ وسط غَمراتِ الحزن مُنكَفئا نادِبا حَظّه العاثر، حاول أكثرَ من مرةٍ التَّخلي عن ” ثريا “، لكنه فَشلَ، تسائل في حيرةٍ:” أهو الحُبّ، أم الاستسلام للمصيرِ المحتوم؟!”، وهل ذنب المسكينة أن وجدت في قلبهِ دوحة حُبٍّ آوت إليها بعد مشقةٍ؟! يَلعن في عَصَبيةٍ تلك العصابة من حنانها ورحمتها التي أنسته كُلّ شيء.
ظَلّ على حالهِ يُطالِع الوجوه الفتية التي تتحلّق بهِ، تأخذ بمجامع قلبه؛ تُغالِبُ صدى صوت أمه القادم من سجف الذِّكرى، يُحَرِضهُ على هؤلاء، يُغريه بهم مُستَخِفا، يذكره فشله في ايجاد ” العَوض” الذي يحمل امتداده، يَهبُّ واقفا، ينقطع عندها سلسال الكلام، تتطلع إليهِ العيونُ في وجَلٍ، ينفض جلبابه ويمضي في تيهه بين الحقول.
تَبدّت خيوط الشّمس النّارية من خلفِ الحُجب، في رونقٍ جليل، لاحت الحقولُ من تحتها مع غبشِ الصِّبحِ الوليد رحبة، زاهية مليئة بآيات الحُسنِ والجمال، عندما تقاطرت حشود العائلة تودِّعُ شيخها الفاني، تخطّفت نعشه أيادي المحبين الذين أفنى عمره في حملهم، بكتهُ القلوب التي اندفعت لاهثة لوداعهِ بالمُهجِ والأرواح، تُردِّد سيرته، وتَلهجُ بذكراه رحمةً وغُفرانا.
***
جلال
ما أقسى تَصاريف الأيّام، ها أنا ذا انصرِف عن طريقي الذي سَلكتهُ خمسة أعوامٍ، تَتردّد في صدري مشاعرَ الكُره، اجدني بمفازةٍ من العذابِ في وجهةٍ اطويها، اُطالِع مطلع كُلّ صباحٍ طريقي ؛ من عينينِ تجولُ بهما أطياف الدَّمع، لا يَعرِفُ ما أُكَابِدُ غيرَ حقيبة كتبي، التي اُتخِمت بحملِ بعيرٍ، كتب وكراسات احملها طوعا وكرها، وصُحبة طريقٍ لا أجدُ في رفقتهم إلّا التَّشَاكس والتَّراشق بالمعَايبِ، ومعاركَ لا نهاية لها، وصياد مجهول انشقّت عنه الأرض، يَستوطنُ الطريق بياض النّهار وطرفا من الليلِ، يقف في شموخِ المارد المهيب، يَذرع الطّريقَ جِيئة وذهابا، لا يسلم منه سالِك، ” جلال ” هكذا ينادونه، ما أقسى مرآه في أسمالهِ البالية، وسحنتهِ المُكفَهرة، وأقدامه الحافية الخَشنة، يُلوِّحُ بعصاه الغليظة في طيشٍ مُريع؛ يملأ تَصايحه المُخيف زِمام الفَضاء، ليرتطم بقلوبِ المارة، فترى وجوههم مصفرة، ترهقهم ذِلة، قد زَاغت الأبصار، وبلغت القلوبُ الحَنَاجِر، يَودّ أحدهم لو يفتدي من هَولِ سَاعتئذٍ ببنيهِ وصَاحِبتهِ وأخيه، وفصيلته التي تُؤويهِ، صغيرا شُغلِتُ بأمرِ قاطع الطَّريق هذا، تواردت القصص عن شَمسِ فتوته وشبابه المنصرم، لازالت كلمات الريس ” مزارع ” الخشنة تستفز أذني:” خرجت عليه جنية وهو راجعٌ من العسكريةِ، بعدما سَلكَ طريق المقابر وسط أكداس الظَّلام، احتالت عليهِ حتّى مسّ يدها، فسلبته عقله وطاش لبّه”، أصبحَ مجرد التَّفكير فيهِ يطردُ عني أيّ مظهرٍ من مَظاهرِ البَهجة، اجدني وقد انفلتَ زِمام عقلي مُتنَقلا بين متاعب لا حدَّ لها، انسلخ عن أماني الصَّبيان من حولي، ممّن تبَاروا في تِعدادِ المَشاهي والمُتَع، فمن قائلٍ:” لا فِكَاك من شراءِ العسلية، ومن متردّدٍ حائر بين لذةِ القصب وأقماع الجَلاّب “، أمّا أنا ففي يأسٍ مُقيم، وزهدٍ مطبق، حتّى إذا ما قطعنا نصف المسافةِ، وتلوثت أجسادنا بترابِ الجِسر الخانق ؛ إلّا وتشكلت أمامي هيئة ” جلال ” بلحيتهِ المغبرة، وابتسامته الميتة التي تقطر شرا، عندها تَتلجلج مفاصلي، وتتوانى خطواتي، يُخامرني شعور القهر والضّياع، في استحياءٍ تنَسابُ مدامعي حارة، أعاجلها بكمي، مُتلهيا عنها قليلا بتفاهاتِ رِفَاقي، الذين استسلموا لوطأةِ ذَاكَ الكابوس، ولسان حالهم يقول في استماتةٍ:” العمر واحد والرَّب واحد “، في تلك الدقائق يَتبادر إلى ذهني كلام شيخ الغفر” محفوظ ” مُتناصِحا في فزلكةِ فطاحلة رجال القانون:” جلال لو ضرب العمدة ذات نفسه وموته مش هياخد فيه ساعة سجن، دا مخبول رسمي ومعاه شهادة بكدا”، اسقط ساعتها مُتحَسِّرا على نفسي، اتذكّر ما تناثرَ حَولَ سورِ المدرسةِ من ملاهي، الترمس، الجيلاتي، الحمصية، وطعمية الحاجة ” موزة” التي تفوق الكباب مذاقا، كم تمنيتُ مِرارا ؛ لو كنتُ نسيا منسيا، أو دابة من دواب الطّريق تجهل حقيقة ” جلال” فلا تخشاهُ، ارميه من طَرفٍ خفي مُقبلا في عُجالةٍ، يُبرطمُ شاتما، يسبُّ ويلعن، اقسِمُ بأغلظِ الأيمان بأن الدِّماء تهرب من عروقي، لا املكَ غير الدّعاءِ، يراودُ خاطري أمل عزيز؛ أن يرزقني الله تعالى منجاة تغشيه عني فلا يبصرني.
لا اُنكِرُ رحمة العناية الإلهية ولطفها بي، تنشق الأرض عمن يُبدِّد مخاوفي أمنا، عابر سبيل يجرُّ بقرته، أو سائق عربة ” كارو” ألوذُ بهِ مُتحننا، متناسيا لدغات ” كرباجه”، لم يكن ” جلال ” شرّ كله، بل كانَ في مراتٍ نجدة من السّماءِ، اهتاج ” ناظر ” المدرسة يوما، مُستنكِرا أفعاله، وكيفَ أصَبحَ ذاكَ المعتوه عقبةً كؤود، في طريقِ التلاميذ، وآن الأوان من تدخل الجهاتِ المعنية للحدّ من أفعالهِ، وتلك لعمرك فاتحة خير، سهلت على أمثالي التعلّل، فالتأخر عن الطَّابورِ مباح ولا حرج.
جلستُ إلى عمي يقصُّ عليّ من سيرِ الغابرين، وإذ بيدٍ ثقيلة تحطُّ فوق كتفي، وصوتٌ قاسي النَّبرة يندلقُ قائلا:” معاك سجاير “، انفرجت أسارير عمي، أشّرَ لهُ بالجلوسِ في ترحابٍ ينبيء عن سَابقةِ معرفةٍ، كانت صدمتي مهولة، ومصيبتي تفوق الوصف، وأنا اجلس إلى جوارِ ” جلال “، نعم !، إنّه هو بشحمهِ ولحمهِ، اسودّت الدُّنيا واحمرت في عيني، اخرجني الذّعر عن طوري، فجعلت أحبو كالصّغارِ، عاجزا عن القيام، كَان عمي من الحكمةِ لأن يفطن لِما يدور ببالي، انفلت في شدةٍ قائلا:” دا ابن اخويا بيروح المدرسة عندكم، خلي بالك منه”، هزَّ صاحبنا رأسهُ مُؤمِّنا على كلامهِ، وهو يسحبُ آخر أنفاس سيجارته، اخبرني عمي أن ” جلال” صديق عمره، أمّا أمر جنونه فكذبةٍ أذاعها،يتَكسَّب من وراءها، و تضفي عليه هيبة ووقارا، عادت الحياة إلى جسدي المهمل، ودبّت الثقة رويدا في قلبي الكسير، لأجدني وقد هانَ أمر ” جلال”، حتّى آنست بهِ، فقادتني الثقة لأن ألقي إليهِ بتحياتي، وإن لم يرد سلامي..