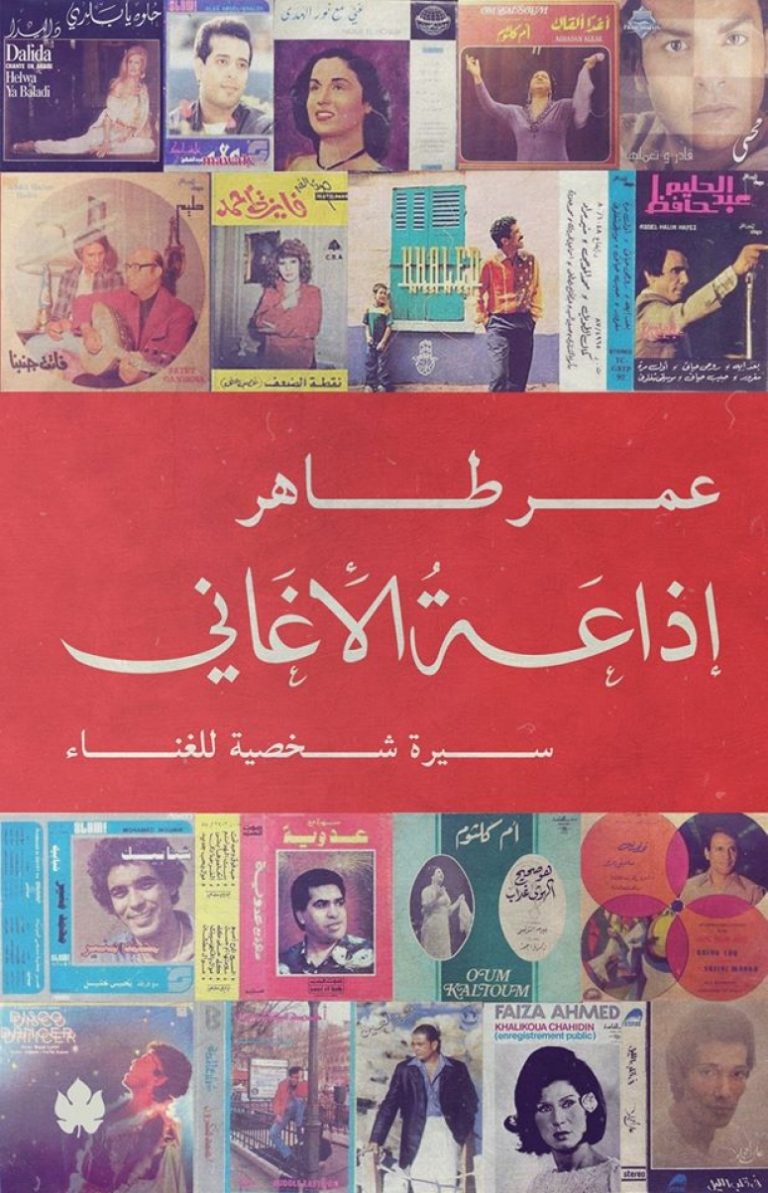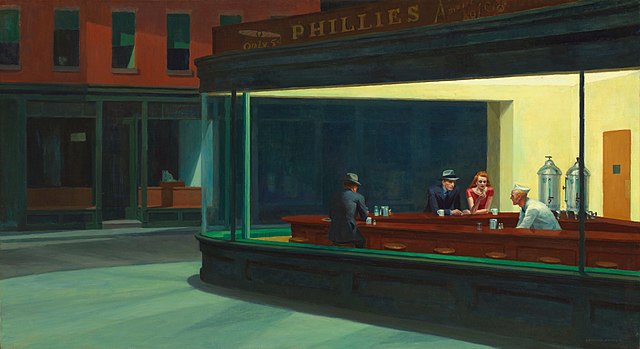أميرة مصطفى محمود
الجميع يرددون، بأريحية، كاعتراف جميل: الكتابة هي الملاذ.. فعل استشفاء وتعاف، يعلنونه بصدق وامتنان يخلو من أي مبالغة، أو شبهة كذب، أو كما يروقني أن أتخيل: دونما شبهة تملق.. لها.. الكتابة.. لئلا تمسك عنهم القلم.
وما من أحد بوسعه أن يجحد أو ينكر عليها فضلها الفعليّ ولكن.. يسعني الشك والجزم أيضا بأنها ليست كذلك على الدوام، وأن لها وجوها أخرى غير تلك الودودة الخدومة.. للأسف غير جامدة أو حيادية.. بل شرسة ضارية ضاربة في القسوة.
تتمحور الراحة الذاتية التي تخلفها الكتابة في نفس الكاتب: في عملية الإفراغ، البوح.. وإن شئت الفضفضة، التعبير امتنانا أو احتجاجا إزاء العالم، المواجهة.. ومن ثم المقاومة، التخفف، التخلص، التعافي.
فالكتابة هي الصوت المشحون المحتقِن والأعمق والأجهر والأثقل من أن تهتز به أحبال حنجرية، بغض النظر عن نهجها الاختياري أو الاضطراري، في المباشرة أو الإسقاط والتورية، والذي يبرأ، بصُداحه، صاحبه، من انفعاله المحموم. ويحدث أن تكون هي الطريقة الوحيدة لقول الكثير الذي ربما لا نستطيع إزائه غير التخفف منه بالتلميح حتى.. لا بالتصريح. ويتحقق ذلك حينما ينطلق ذلك الصوت من أعماق صاحبه الذاتية بما هو كائن فيها فعليا يؤرقها، مستقرا أو مضطربا، بينما قد يضطر ذلك الصوت، في عوالم الأدب، إلى اختراق الأعماق المنغلقة أمامه والتي لا تخصه، ليكتشفها، وحينذاك تصبح فعلا تنقيبيا شاقا ثقيلا منهكا وعرا.
ليست الكتابة، كفعل، بالأمر السهل الهين الذي يتصوره البعض. يعترف بعض من يمتهنون.. وبالأحرى يحترفون الكتابة، بأنها صعبة، مجهدة، تحتاج إلى المثابرة والإصرار والصبر عليها، بروح مجاهد.. وربما انتحاري!
يعترف “جورج أورويل” في مقال يتساءل فيه “لماذا أكتب؟”: “الكتابة رهيبة، نضال مرهق كنوبة طويلة من الأمراض الموجعة.” وليس بوصفه أية مبالغة بل إن الأمر فعليا قد تفاقم عند البعض إلى درجة الأمراض الموجعة فعلا إذ تخطى الإرهاق النفسي والمعنوي إلى الضرر الجسدي. فها هو “هرمان ملفيل” الذي قد تجاهل مناشدات جميع أفراد عائلته، لينهي روايته “موبي ديك”، برغم تشنجات عينيه ونوبات قلقه وآلام ظهره، وحسبنا ما كتبه عنه الطبيب “جون ج روس”: “إن عمل الدماغ المستمر وإثارة الخيال يرهق هرمان الذي كان يشرع في الكتابة من وقت مبكر حتى وقت متأخر لينهي أعماله الأدبية مخاطرا بصحته.”
وقد يصير التفاقم المَرضي أبشع من ذلك بمثل ما حدث مع شاعر القرن التاسع عشر الإيطالي والملقب بشاعر المعاناة السلبية الأسمى “جاكامو ليوباردي” الذي ساءت صحته من تحدب في العمود الفقري إلى حدبة أشبه بقبر متحرك يضعه على ظهره كان ألقى اللوم فيه على تجاوزاته العلمية كالكتابة والقراءة المسرفتين قائلا: “لقد دمرت نفسي بشكل لا يمكن شفاؤه لبقية حياتي، مما يجعل ظهوري مرعبا ومشينا لمعظم الناس.”
والأبشع على الإطلاق، كان التفاقم حد الموت، وكان من نصيب “بلزاك” الذي آثر التضحية والمخاطرة بصحته بسلاح القهوة المفرط التي كان لها مفعول السحر، على وَحْيه، حد موته متسمما بالكافيين، وكل ذلك لأجل عيون الكتابة.
ويجدر القول إن ليس ذلك هو الوجه الموحش المخفي لها إذ يفعله الكاتب على أي حال بمحض إرادته بوجع لا يخلو من اللذة وإنما..
العطش الداخلي للكتابة الذي يحدث كنوبة لا إرادية، يزامنه عند مرحلة ما عطش مواز داخلي، إلى القراءة.. أن تُقرأ، أن تكون، أن توجد وأن تلمس حيز وجودك الفعلي في خارطة القراءة العامة والنقد والترشيح والإعجاب والتقدير والمعارف. عطش مستبد يلهب النفس لفرط الجفاف.. إلى أن يطال بالحرق كل ما هو أخضر بداخلها من: ثقة، أمل، دافع، سكينة، مصالحة مع النفس ومن ثم العالم. حينها يصنع وحشا ينهشك من الداخل نهشا، وحشا جائعا محروما يأكلك، ولأنك لست أنت غذائه، لا يشبع، إلا إنه رغم ذلك يظل، بحرمانه، يأكلك، ولا يُبقي بداخلك غير الفراغ.. الفراغ الذي تتيه فيه وتتعذب فيما قد تضبط نفسك وأنت تستجدي أي أمل.. أي فرصة تنتشلك من شعور الضياع واليأس والفشل والإحباط، وتظل تستجديها على أمل يظل بدوره لا يتحقق.. ولا يجود عليك بالملاذ.
قرأتُ يوما أن الكاتب كما المُقرئ، يحب ويحتاج أن يسمع كلمة: الله، ألّا يبخل عليه المستمعون المنتشون بكلمات الاستحسان والثناء والإطراء، وكنت أظن قبل ذلك أنه لا يليق به وبالكاتب إلا أن يترفع عن هكذا تطلعات، في ظل عبارات نقيضة كانت في استقبالي لدى وطأة قدمي الأولى في الكتابة، وكنت فريسة ساذجة لُقطة لها، رددها على مسمعي إحدى الكاتبات المبتدئات وكانت تحمل ذلك المعنى “المضاد” وأظنني كنت اتخذتها حينذاك على محمل الاعتناق إذ قالت: “أن تكتبي لنفسكِ فقط غير آبهة بأن يقرأكِ أحد”، فيما كانت، وللمفارقة، تداوم على نشر ما تكتب على جدار صفحتها الزرقاء ثم فيما بعد في الكتب.
هل يُجدي الكاتب أن يظل يكوّم أوراق كتاباته في الأدراج؟! هل سيظل إذذاك شغوفا بالكتابة! ونستثني من ذلك من يكتفي ويكتب مجرد خواطره الشخصية ويومياته فليست الكتابة تأخذه على محمل الجد حتى وإن كان هو يفعل، وإنما.. أقصد الكتابة الإبداعية.. الأدبية.
إن كان ذلك صحيحا فما الذي يدفع إذن كُتّابا مشهورين إلى شعور الإحباط والسخط وربما الاحتداد، بعلاقة عكسية مع نسبة التفاعل مع منشوراتهم الثقافية الفيسبوكيه ولا سيما طبعا منجزاتهم الحديثة من الكتب! ولماذا يسعى الكاتب “وإن أنكر” متطلعا إلى الجائزة.. محتفيا بنوالها أيما احتفاء؟! فليست الجائزة تقتصر أبدا على قيمتها المادية، وإن كانت قيمة لازمة للكاتب العربي على وجه التحديد لاعتبارات مادية كثيرة لا يجهلها الوسط الأدبي، وإنما تتجاوز المادة إلى المعنى: الإنجاز، التقدير، التحقق..
المرء، يحتاج إلى تحقيق ذاته، وإلى التقدير، خاصة وإن كان يعتقد في نفسه الاستحقاقية بما منحه إياه الخالق من مواهب أو مقومات شخصية. تلك الحاجتان من الأهمية والإلحاح درجة أن تُفرد لهما خانتان مستقلتان بهرم ماسلو الشهير للاحتياجات.
ثمة حاجة أو رغبة.. وبالأحرى وَحْش آخر يترقب الكاتب، فضلا عن حاجته إلى التحقق والتقدير، وهو حاجته إلى مشاركة كلماته وانفعالاته وخواطره وآرائه وصوته وآهاته مع القراء. ويتفاوت الأمر في إلحاحه لا سيما إن كان الكاتب يكتب فنا.. الأدب، فيحتاج إلى أن يُطالع القراءُ نتاجه، أدبه، خلجاته وأفكاره، وعباراته التي يعتز بها، ولغته التي يباهي نفسه سرا بها، وفلسفاته وتحليلاته التي يتوق فخرا إلى مطالعة القراء والنقاد لها، ومن ثم يتطلع هو إلى تجاوبهم وتفاعلهم وانفعالهم مع ما كتب. يحتاج إلى ذلك بشدة، كحاجته إلى الكتابة، للإبقاء على اتقاد شعلة حماسته وثقته، وروحه.. لإنقاذه.