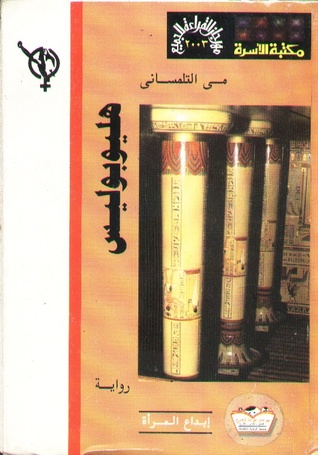عمران عز الدين
في القرية التي كان يقطنها ذات حرمان، كانوا ينعتون يوم الأربعاء بالشؤم، متوهمين بأنّ كلّ ما يقومون به في ذلك اليوم مآله الفشل، وربّما الموت أيضاً! هذا ما كان الأهلون موقنين به أباً عن جدّ، ولهذا راحوا يستشهدون بالكثير من الأدلة المؤكدّة، فأبو بكر السمان مات في دكانه صباح الأربعاء، لأنّه ـ آنئذ ـ أعلن على الملأ بأنّ اعتقادهم هذا ينتمي إلى عالم الخرافات. أمّا أمينة، تلك الفتاة الصغيرة، التي خَالَسَتْ أبويها، واتجهت صوب النبع لتشرب، فلقد لدغتّها حيّة، وماتت من توّها! في حين أنّ الداية أم حسين خرجت من البيت سهواً ربّما! كان هذا ذات أربعاء ممطر، وغبّ أن أحكمت باب الكوخ في وجه الدجاجات، اختفت إلى الأبد! ثمّ ها هو حسين يضيق بالقرية وأحاديثها، فهجرها، وسافر إلى العاصمة بقصد العمل، على إثر اختفاء أمه! ربّما دفعته جمل بعينها إلى اتخاذ قرار كهذا، إذْ كانوا ينعتونه بالثور، جاء الثور… ذهب الثور… غاب الــ … أو نجح الـ … يااااا ثور!
كعادتها، وعلى حين غرةّ، ظهرت أم جابر، لتطالبه بالأجرة المتراكمة، وراحت تهدد وتتوعدّ إن هو تأخر عن السداد، فتظاهر بالسكر، وأنشأ يترنح ذات اليمين وذات الشمال، ما أخافها، ودفعها إلى الهرب نحو غرفتها، وهي تلعن الساعة التي جمعتهما!
عاد إلى الغرفة، مغلقاً الباب وراءه، وتمتم:
” إنها امرأة طاعنة في السنّ ووحيدة! ثمّ أنها لا تطالبني بالأجرة إلاّ لأمر هام، كأن تشتري دواءها مثلاً!”
توجهّ صوب المغسلة، وبلّل كفيه، ثمّ مسّ بهما أرنبة أنفه، ليستعمل المنشفة بعدها. راحت النافذة تناديه، فوضع يده في جيبه، ليخرج علبة التبغ، ويشعل لفافة، ثمّ قذف بنثار التبغ العالق بشفته السفلى، وسحب نفساً طويلاً، فيما غاصت سحنته في صدى همس مديد:
” إلامَ ستطالبني هذه العجوز الشمطاء بالأجرة!؟ أليس هناك حلّ!؟ حَتَاّمَ سأردد ” لو كان..”، وأزدرد ريقي متحسّراً!؟”
كانت الــ ” لو ” في طريقها لأن تضعه على طريق الجريمة! إنها ـ على ما يبدو ـ آخر الحلول التي وقع عليها ذهنه! وستكون أم جابر اختياره الأول! ذلك أنّه كان قد وضع يده بشكل ما، على دليل قاطع بأنّها تنام على ثروة كبيرة! إنه موظف صغير، وراتبه لا ينهض بأعباء معيشته! إنه عاجز على التحصل حتى على لفافات التبغ.
لقد قدم إلى المدينة منذ أمد، إذْ ما الذي يمكنه أن يقوم به في القرية بشهادته التي حملها فوق كتفه وزراً!؟ ألم تمنعه الظروف من إكمال تعليمه العالي، فاكتف بالثانوية، وراح يعمل تحت خانتها، ثمّ ها هي المدينة تسخر من أحلامه الريفية، وتضرب بها عرض الحائط! إنه الآن تحت رحمة ضجيجها، الذي يثقل على المرء بالهموم، ويغتال الأماني النائيات، التي أضحت في حكم الغيب! رباه! أيّ شوق هذا الذي أنشأ يحفر في النفس، إنه يحنّ إلى أيام القرية الوادعات.. إلى طبيعتها الهادئة والخلابة… سهراتها البريئة… سقاية المزروعات، وأيام الحصاد. آنئذ كان الاستيقاظ على زقزقة العصافير ضرباً من الإدمان، فأين هذا كلهّ من هذه المدينة الملعونة، التي لم تورثه إلا الهمّ والوجع!؟ كلّ هذا في جهة، وسلوى في كفة، آه يا بنة المختار، لقد اشتاق المهر الصغير إلى ذلك الوجه الصبوح…. إلى تلك اللحظات التي سرقاها في غفلة عن الأعين، هناك تحت أغصان صفصافة تدلتّ أغصانها نحو بركة، راحت تتوسّط أرضاً، كان الأب يملكها، إنهّ الرجل ذاته الذي ضبطه ذات يوم متلّبساً، إذْ أمسك به في اللحظة التي كان يقطف فيها قبلة من خدّ الصبية، وها هي لحظات التعذيب والإهانة والضرب، تحضر بتفاصيلها المهينة، من غير أن يستطيع شيئاً حيال اللكمات المتتالية وعصا الخيزران. أما كيف تصادف مقتل كلب الحراسة على يديه بوساطة حجرة، حملها ـ آنذاك ـ ليدافع بها عن نفسه، فهو نفسه لا يدري كيف حصل ما حصل. ومن يومها راح أهل القرية يرددّون وسمه بالثور، بعد أن نعته المختار بهذا الاسم. لكنه سيعود… عليه أن يعود حاملاً مهر سلوى، ليزفهّا إليه، وليصحبها معه إلى المدينة.
ارتفع مواء قطّ حزين، فتوقف سيل الذكريات، ورنا إلى الساعة، التي كانت تشير إلى الحادية عشرة، لقد حان الوقت الذي حددّه لتنفيذ ما راح يخططّ له على مهل! ” سامحيني يا أم جابر، إذْ أن سعادتي ـ على ما يبدو ـ مرهونة بموتك، فالحياة لا تحتملنا معاً!” كان يتمتم بهذه العبارات، فيما كانت قدماه تنسحبان متسللتين إلى غرفة أم جابر، هناك فوق السطح، لكنه ما لبث أن ابتعد عن المكان! هو لا يستطيع أن يكمل ما بدأه في ذهنه! فابتعد نحو غرفته بسرعة، وأشعل ضوءها، اقترب من المرآة، فعكست له وجهاً شاحباً، يعلو هيئة رثة، لم يكن لهذا كلهّ معنى أو جدوى، وداهمته رغبة عارمة في النوم، فأطفأ النور، واستلقى على فراشه، ثمّ ما لبث أن غطّ في نوم متقطعّ.
وعند الصباح، سيستيقظ حسين، ليتفاجأ بأنه قد انقلب إلى ثور صغير، فتركبه الدهشة، ويبدأ بشدّ شعره وقرص جسده، على أمل أن يكون ما يحدث له حلماً سمجاً! كان الأمر يفوق طاقته على التصوّر، لكن الإسطبل المعتم برائحته الحريفّة، التي جمعت نفاذ البول إلى بذاءة البراز، وشميم العلف، ما يسيل له الأنف، أكدّ له أنّ ما يتعرض له واقعي إلى درجة العري الصفيق! فاندفع نحو النافذة ليفتحها، لعله يبصر أحداً، لكنه تفاجأ بملعب واسع تتسابق فيه الثيران، كانت الناس تهتف بوحشية، فحاول أن يصرخ مستنجداً، علّ أحداً ما يأتي لنجدته، وكان أن تفاجأ بالصوت الذي صدر عنه على شكل خوار أبحّ أخرسه تدريجياً، ثمّ أختار أن يمشي، ومرة ثانية تفاجأ بأنه لا يملك إلاّ أن يتقدمّ على قوائم أربعة، بعدها سيحشر نفسه في زاوية ضيقة، ربّما لأنه كان يخشى افتضاح أمره، وبمرارة المغلوب على أمره سيجهش بالبكاء.
طويلاً.. طويلاً سيمكث هكذا، وسيحرص على ألاّ تصدر عنه أي نأمة كي لا يلفت إليه الأنظار، لكن الخدر سيركبه، ويتحرّك رغماً ليمنح دورته الدموية فرصة أن تتجدّد.. كانت مثانته قد امتلأت، فامتدت يده بشكل لا إرادي إلى أزرار بنطاله، وندّت عنه آهة حرّى. كان طنين الذباب حول ذقنه بإلحاح مزعجاً له، تماماً كحال الحشرات التي أخذت تحوم حول مؤخرته، ولم يكن ثمة بدّ من استخدام لسانه الطويل إلى جانب ذيله المنتفض في إبعادها. وعلى إثر ذلك، سيفتح باب الإسطبل، وكما لو كان في حلم، سيدلف رجل متدثر بجورب أسود يخفي ملامحه، ويطلب إليه أن يتبعه إلى الخارج، لكنه سينكمش متكوّماً على بعضه…. ومنذ تلك اللحظة سيختفي حسين إلى الأبد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ قاص من سوريا
القصة من مجموعة “موتى يقلقون المدينة” الحائزة على جائزة رابطة الكتاب السوريين