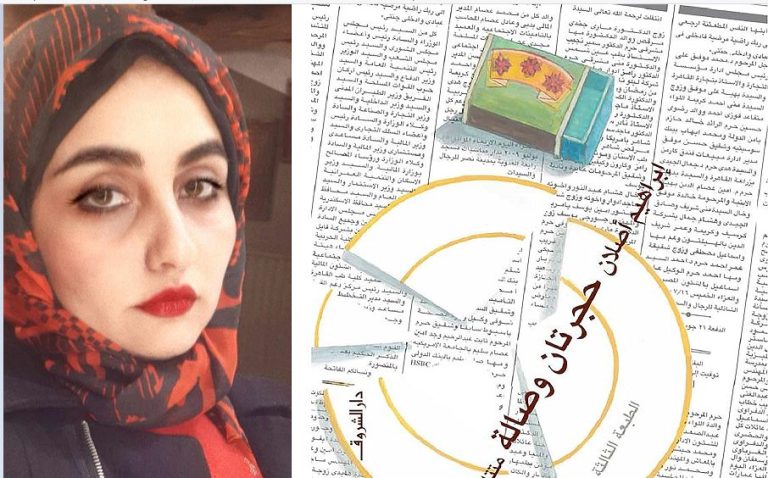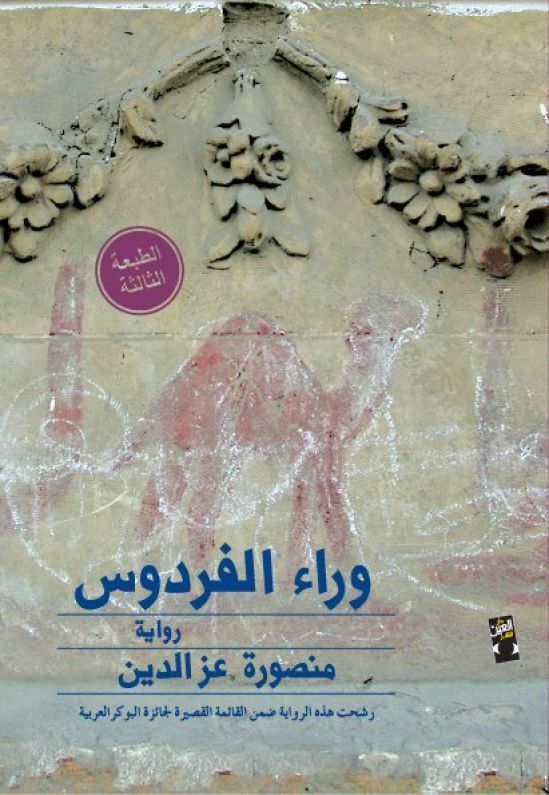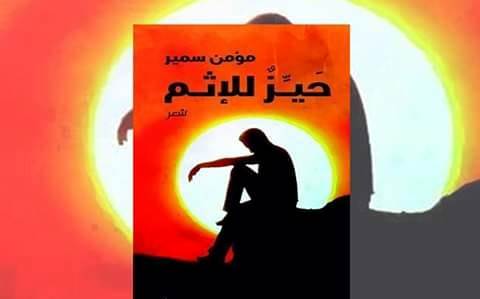هذه الرواية ممارسة متقنة لـ”ألعاب الهوى” على الورق بعد أن بنى قرية مقطوعة واختار لها موقعها الجغرافي وأوجد فيها اناسها الذين هم رغم انقطاعهم عن الخارج ولا مبالاتهم به فان لهم (وكيل تموين) معتمد من الحكومة، ولهم ممثل في (الاتحاد الاشتراكي) ولهم أيضاً طموح في أن يصل أحدهم للبرلمان.
من يقرأ هذه الرواية لا يصدق أن القرية لا وجود لها على الخارطة المصرية، وأن الناس النابضين بالحياة أولئك الذين عجّت بهم وضجّت هم توليفة من الكاتب. تشكلوا من ومضات لبشر عرفهم وعاشوا في ذاكرته، في هذه القرية او تلك المدينة من مصر المحروسة.
لا أستطيع أن اصف هذه الرواية الا بالفاتنة، ولقد جعلتني مفتونها لدرجة انني تأنيت في قراءتها رغم قصرها (270 صفحة) حتى استمرئ الاحداث وأتملاها وهذا ما أفعله مع كل عمل إبداعي يأخذني ويفتتني، و”ألعاب الهوى” جعلتني – انا القارئ- لاعبا فيها.
تلك القرية القصيّة، بعيدة عن العاصمة، وعن مركز أي مدينة أخرى، ورغم أنها في بلد اسمه مصر إلا ان لها قانونها، وكبارها ممثل الاتحاد الاشتراكي ووكيل التموين- وهما يمثلان الحكومة- وخطيب الجامع الذي هو بالنسبة للناس المحور والرأس، هو مقصدهم لحل كل اشكال يمرون به، وهو عرّافهم وحكيمهم، وهو أيضا الخبير باللصوص والمطاريد والمطلوبين.
خطيب الجامع اسمه الشيخ حامد بن عروسة ويشكل ثنائياً متآلفاً مع الشيخ الضرير اسماعيل مؤذن الجامع (عفيف إلا في موضوع الأكل، يأكل بقرة بحوائجها، يمشي وراء الشيخ حامد على طول الخط يصدّقه ويصْدقه الا في حكاية الأكل).
ذلك لأن الشيخ حامد لا همّ له الا الأكل فهو لذته ومبتغاه. يستحوذ على (ذكر البط) وملحقاته ويترك أبناءه يتضورون جوعاً هم وأمهم “نميرة” والتي تراقبه وهو يحيط “الطبلية” بساقيه فكأنه يدافع عن الطعام الذي فوقها من هجوم متوقع قد تقوم به زوجته التي تشقى في إعداده ولا تنال منه شيئاً.
يشكل الجامع مركز القرية، والشيخ حامد خطيبه (كبيرهم ومرجعهم) عندما يعتلي المنبر فانه يقول ما يعنّ له، ولا أحد يستوضحه، والجامع هو إذاعة القرية ومن مكبر الصوت المعد لرفع الآذان لا يستغرب المرء انه سمع نداء من أحدهم بأن عشرين ذكر بط سرقت منه. والشيخ حامد يعرف جيداً أن السارق هو ابنه الدمرداش. ويقول في سره: (كيف يقف على المنبر لينهى الناس عن السرقة وابنه سرق ربع بط البرية وحدها؟) وكانت النسوة يعرفن السارق لذا فهن (على باب دار الشيخ حامد كل صباح يشتكين الدمرداش ويطلبن العوض ونميرة تطيب خاطرهن حتى لا يطلع صوتهن في الشارع ومعه الفضيحة). أما (القانون) الذي صار يسود في القرية وبعد ان (أخذت السرقة تفعل فعلها بين العائلات) هو ان الامر (اقتضى ان يكون لكل عائلة حرامي معتمد يدافع عنها ضد حرامية العائلات الاخرى تجاوزت سلطته وصورته صورة كبير العائلة في كثير من الأحيان).
تتكون عائلة الشيخ حامد من زوجته نميرة وولده الدمرداش أما شقيقه الكبير فاسمه النادي وله شقيقان أخوان هما محي الدين وابراهيم. ورغم ان الشيخ حامد قد درس في الازهر الا ان عائلته هذه كلهم من اللصوص وقد لحق بهم ولده الدمرداش في حين ان عمه الشابوري نال سجناً مؤبداً.
تسيطر على أجواء الرواية نغمة واحدة هي السخرّية وهو ما لم نجده في النصوص الروائية الكثيرة الخالية من هذه (الخفّة التي تحتمل) بل وتُستزاد.
حتى اللصوص يمرون في سياق الاحداث بظرفهم غير المحدود. ومن أشهرهم راغب الذي مرّ على الشيخ حامد (وهو يحمل على كتفه جوالاً مكبوساً على آخره) وسلّم على الشيخ حامد (السلام عليك يا عم الشيخ)، ولكن الشيخ حامد انتبه الى (أنات مخنوقة تتسرب من الفتحات الضيقة للجوال) فكان رده: (عليكم السلام يا حرامي يا ابن الحرامي).
وذهب راغب بسرقته من ذكور البط الى (الغبايشة) القرية المجاورة التي دعي الشيخ حامد ليخطب في جامعها الشاغر من أي خطيب، ولكن مؤذن الجامع أفهمه بأن راغباً هذا (فرد جوالاً به عشرون ذكر بط ليبيعها للمصلين) كان يخرجها واحداً واحداً وكلها جثث هامدة مختنقة بالجوال.
أما خطبة الشيخ حامد في قرية (الغبايشة)، فكانت من أظرف الخطب فرّ بعدها هارباً بجثته الضخمة. ومما جاء في خطبته تلك: (ربنا قال يا جبريل هات لي أنظف صّولة طين في المحيط الاطلنطي.. إنتو عارفين المحيط الاطلنطي ده قد إيه يا ولاد؟ هه؟ أكبر من بحر السخاوي الغول ده ميت مرة).
و(انفتحت الافواه على آخرها ولم تعد) واضاف: (بحر السخاوي اذا كان عرضه عشرة أمتار فالاطلنطي ده بيجي أكثر من خمسة ستة كيلو بالعرض).
واستمر هذا الكلام وسط ذهولهم فتحول الى القول: (انتو عارفين المحيط الهندي قد ايه بقه يا جماعة.. علشان تعرفوا انتو غاليين عند ربنا قد ايه يا بتوع الغبايشة يا امراء، أكبر من بحر النحال عشرين مرة أقلّه).
السخرية النادرة في هذه الرواية لا تخفت نبرتها بل هي ماضية نحو التألق كلما أوغلنا في قراءتنا لها.
وتتواصل السخرية في الوصف الطريف مثلا لأبوشبارة (هل هلال أبوشبارة اول مرة يحضر صلاة الجمعة من سنين، رجل تخين فعلاً، بمؤخرة منتفخة كأنما جمع مؤخرات العائلة في مؤخرته، لا ينفع معها كرسي ولا دكة خشبية ولا يحزنون).
وكأن هذا الوصف يعيدنا بشكل ما الى رواية سارتر “الغثيان” اذ وصف رجلاً كبير الأنف بأنه كاف لضخ الهواء لعائلة كاملة. ولكل وصف سياقه بالتأكيد.
ولعل “هرم” السخرية في الرواية هو ذلك الذي ينطق او يقوم به الشيخ حامد، ومع هذا له من يحذو حذوه مثل “وفا زيت حار” ابن عمه الحاج قرد الذي ألصق باسمه “وفا” لقب “زيت حار” لأنه عاد من التحاقه بالازهر مع حامد خالي الوفاض الا من زجاجة “زيت حار” سرقها فأصبحت له لقباً ملتصقاً به “سرقها من المطعم المجاور للمعهد الأزهري، الزيت الذي كان يأبى أن يذوق الفول بدونه. و”وفا زيت حار” لم يعتل منبراً ولذا استغل احدى الفرص و(طلع على المنبر من غير حد ما يدعيه) ولم ينته الامر عند هذا الحد بل انه عندما فعل ذلك كان معه كتاب قديم عن الخطب المنبرية (وبعد أن حمد الله وأثنى عليه، تكلم عن فضائل الصوم مع ان إحنا مش في شهر رمضان).
والأطرف من الخطبة الدعاء القديم الذي قرأه كما هو رغم انه موجه للسلطان (قطز) وعساكره ونصها:
(اللهم عافنا واعف عنا
اللهم ارزقنا واكرم مثوانا
اللهم انصر السلطان قطز وعساكره وامحق بسيفه رقاب الطبقة الكافرة الباغية، يا مالك الدين والدنيا، يا رب العالمين).
فتحول جمع الحاضرين لأداء الصلاة الى حناجر تقهقه.
بين أجمل شخصيات الرواية “الفنجريّة” تلك المرأة الوافدة على القرية منذ عشرين عاماً واقامت ولم تغادر، كانت تكدّ وتكدح فعلّمت الآخرين ان يحترموها بمن فيهم بعض الحرامية التي حاولت ان تصلحهم بعد أن وفرت لهم العمل الحلال. وصفها الروائي بقوله: (طرحتها الشبيكة على رأسها حتى ظهرها، والكحل يلمع في عينيها، عايفه من يومها. لا يدري- المتكلم- متى جاءت الى القرية ولماذا حطت في غفلة من الزمن كأن الأرض طرحتْها، لا أحد يسأل عن أصلها وفصلها، كأنها سرقت لسان الناس ورمته في بير، تحيط نفسها بأشباه الهاربين من بلادهم من الثأر ومن الموت).
وهذا الوصف يعمق اغتراب هذه المرأة المعلومة في عالم القرية التي أصبحت فيها لا بائعة فقط بل وتقوم بتزيين النساء وأعمال صغيرة اخرى عدا بيع جسدها او ابتذاله.
وكان النادي شقيق الشيخ حامد الكبير ملاذها وحاميها، وموته كان خسارة لها وليس لأسرته فقط حيث كان الشيخ حامد الأكثر حزناً عليه فهو الأمين وسط أجيال من الحرامية.
وكان سؤال عروسة أم حامد العجوز الخرفة يلاحقها: (يا بنت يا فنجرية جوزك الأولاني عايش ولا ميت يا بت؟).
ولم ترد على هذا السؤال. لكن الفنجرية وبعد وفاة النادي ظلت قريبة من اسرته وأسر اخوته خاصة الشيخ حامد.
ولكن وفا زيت حار كان يلاحقها، يخاطب المرأة فيها، يوقظ جسدها الملهوف لفحولة الرجل، ولم يستطع الوصول اليها الا بخديعة ومكيدة عندما أسند لها مهمة إعداد الحلوى في حفل أسري. وقدّم لها الحشيش وزاده عليها حتى فقدت وعيها فاغتصبها وعندما استيقظت واكتشفت ذلك ورأته جوارها ممدداً جنّ جنونها وانتهى الأمر بزواجه منها عرفياً رغم كرهها له.
تزوجت مضطرة وبتستّر حيث ان العارفين بالأمر قلة وعلى رأسهم الشيخ حامد، ولذا كان يتسلل الى بيتها ليلاً كاللص، وهو لص حقاً.
كل هذا الفيض الساخر الذي يشكل موسيقى الرواية وعليه ينتظم ايقاعها لم يكن سخرية من أجل السخرية بل كان مقارعة للموت المتربص، وقد وفق الروائي في ايجاد ما يمكن أن أسميها فانتازيا الموت التي عاناها الشيخ حامد منذ بداية الرواية عندما جاءه عزرائيل ليقبض روحه فطلب منه أن يمهله ولكن وفق الايقاع الساخر فكأن الأمر مجرد دعابة ليس إلا. وقد جاءه عندما كان يتناول الطعام هو ومساعده الضرير اسماعيل الذي لم يكن يسمع ما يدور بين الشيخ حامد وعزرائيل الذي يسأله: (انت مين ودخلت هنا إزاي؟) فيرد: (أنا عزرائيل يا شيخ حامد) ويظن الامر مزاحاً فيقول: (مين مين يا خويا؟) فيأتيه الجواب: (عزرائيل).
ثم يستمر الحوار بينهما هكذا:
( – وعايز ايه يا ابن خالي؟
– عايزك علشان تيجي معايا
– آجي معاك؟ يا داهية دقيّ، ملقيتش غيري ليه؟).
الى آخر هذا الحوار.
كما ان أمه “عروسة”، في آخر أيامها وهي غارقة في تدخين الحشيش ولم تعد تقدر حتى على حبس بولها كانت ترى موتها القريب وتحدثهم عنه فهو الحلم الجميل الذي تحلق في عالمه كل ليلة.
وتأتي نكبة الشيخ حامد بوفاة أخيه النادي. وتذهب الرواية بهذا المنحى الفانتازي في خاتمتها بعد ان عاد الشيخ حامد من المقبرة حيث دفن أمه ”عروسة” وقراره في أن يذهب للحج يداعب أحلامه ليغفر الله له ذنوبه.
وكان عزرائيل قد أمهله ثانية رغم انه لم يرد ذلك حيث واجهه بالقول: (إوعى تكون فاكر اني خايف منك، الكفن واضب، الصلاة واضبة، ونميرة- زوجته- في النازعات والمحجّة- هنا يقصد حجة الأرض التي سرقت منه- تعال وقت ما انت عايز يا خويا).
ولذا جاءه وهو يهمّ بمغادرة المقبرة فناداه:
(- على فين يا شيخ حامد؟)
فيرد عليه:
( – حياتك الباقية يا خويا!)
ويعود ليسأله:
(- على فين يا شيخ حامد؟)
فيرد:
(- رايح أفك حسرتي)
ويكون قول عزرائيل: (- ما تيجي تفك حسرتك عندي؟)
خاتمة الرواية.
ويبدو لي ان وحيد الطويلة كانت منتبهاً لهذه المسألة منذ بداية روايته الممتلئة بالشخصيات الضاجة بالحياة واعتمد عليها ليختم بها روايته هذه التي بدأت بالشيخ حامد وانتهت به. وهي نهاية ذكية جداً.
ان قارئ هذه الرواية وخاصة من أهل الشأن – كتاب رواية ونقادها- لن يتساءلوا: لماذا كان حوارها بأكمله دارجاً؟ ولماذا تسربت هذه الدارجة حتى الى متنها؟
والسبب كما أراه هو أن الروائي أقنعنا بأن روايته لا تكتب الا هكذا. ولو انه فصّحها لأصبحت رواية أخرى، وستفقد توهجها حتماً.
ولعلي وأثناء قراءتي لها وجدت أن ثوابتي اللغوية في ضرورة الكتابة بالفصحى متناً وحواراً قد غادرتني حيث شكّلت الدارجة سنداً هاماً في معمار هذا النص الروائي الساحر والشخصيات التي نبضت فيه والمشيَّد كله من خيال الكاتب فصارت حقيقة مثل قرية “ماكوندو” التي شيدها ماركيز العظيم في روايته “مائة عام من العزلة”.
وهناك ملاحظة مهمة انتبهت لها هي ان المناصب الحكومية او الرسمية في هذه القرية هي مناصب من حديث المسميات السياسية مثل “ممثل الاتحاد الاشتراكي” او “وكيل مصلحة التموين” والحلم الذي راود “الحاج قرد” عم حامد بأن يكون نائباً وزيّن له البعض الأمر.
لم نجد التركيبة التقليدية للقرية المصرية حيث العمدة وشيخ المغفر ومأمور المركز… الخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ صدرت الرواية ضمن منشورات دار ميريت- القاهرة 2004