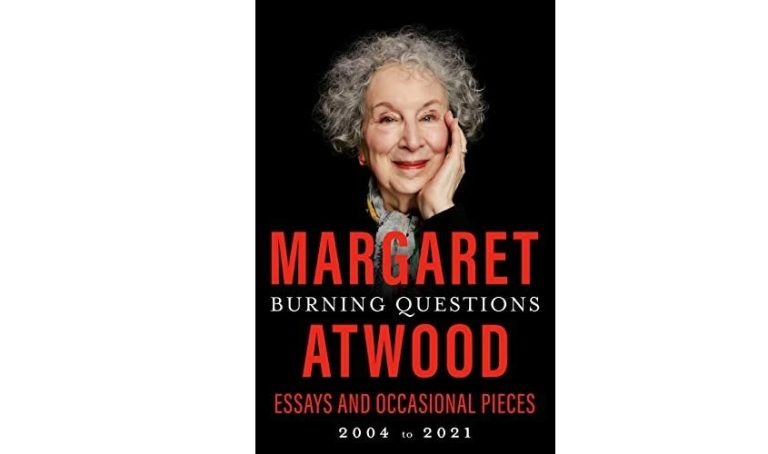روبير فالزير
ترجمة: عثمان بن شقرون
تقديم
يعتبر النص المترجم: ” هُنا، يُمارَسُ النّقد”، جزءا من النثر القصير الذي لم يُجمع في كتاب خلال حياة روبير فالزير. وقد نُشر ضمن المجلد الثاني من مجموعة (Nouvelles du jour. Proses brèves II). ويُشكّل نموذجًا نوعيًا لفن المقال اليومي (Feuilleton)، وهو النوع الأدبي الذي هيمن على إنتاج الكاتب السويسري خلال فترة حياته في برن السويسرية. تعود كتابة هذه النصوص إلى فترة زمنية حساسة في مسيرة فالزير المهنية، تحديدًا بين عامي 1921 و 1933. فبعد أن غادر فالزير مدينة برلين وعاد إلى سويسرا، دخل مرحلة جديدة عُرفت بـ “فترة برن”. رغم أنها كانت فترة إنتاجية غزيرة، إلا أنها تزامنت مع انحسار فرص نشر رواياته الطويلة. وبسبب اعتماده على إرث صغير وحاجته إلى الاستمرار في الحضور الأدبي، اضطر فالزير إلى التكيف مع متطلبات الصحف والمجلات اليومية. في هذه الفترة، أصبح فالزير يمثل حالة “الكاتب المهمش” الذي يعيش في عزلة نسبية في برن، فاقدًا الاتصال بالبيئة الأدبية الصاخبة في برلين. هذا الوضع اضطره إلى ابتكار نمط كتابي خاص للغاية، حيث كان يدوّن مسوداته في البداية بخط دقيق وصغير جدًا (الميكروغرام ـ Microgrammes) باستخدام قلم الرصاص، ثم يعيد نسخها بالحبر لإرسالها إلى صحف في برلين وفرانكفورت وبراغ، وزيوريخ. لم يكن هذا الشكل من الكتابة مجرد مقالة ثقافية بل كان وسيلة مفتوحة وذاتية سمحت لفالزير بتحويل كل ما حوله – من مسائل الروح إلى مسائل المعدة – إلى محاولة لتعميق اليوميّ. كان هذا الشكل بمثابة قناع (ضمير “الأنا” المتجول) حافظ به فالزير على اتصاله بجمهور قرائه المتناثر، حتى بعد دخوله المصحة العقلية عام 1929، حيث استمر في الكتابة وإرسال نصوصه.
يبدو روبير فالزير في هذا النص كمن يتسلّل إلى قاعة النقد، ليس ليحتل مقعدًا، بل ليعيث فيها بهدوءٍ ماكر. فالنص الذي بين أيدينا ليس «مقالًا نقديًا» بالمعنى التقليدي، بل مشهدٌ ساخر يرسم فيه الكاتب صورة الناقد حين يعتلي منصّته المتخيّلة، فيتحول من قارئٍ متواضع إلى سيّدٍ متسلّط. هنا، يتظاهر فالزير بالاتزان والتواضع، بينما هو في العمق يوجّه ضربة قاسية إلى فكرة السلطة الأدبية نفسها، تلك التي تجعل من النقد أحيانًا ضربًا من الغرور المتقِن للتنكّر. إنه يعرّي لذّة السيطرة التي يثمل بها الناقد حين يشعر بأنه قادر على سحق المؤلف بكلمة، كما لو أنه يمارس فنّ الإعدام بلغة مهذّبة. النص، رغم بساطته الظاهرية، يكشف جانبًا من فلسفة فالزير حول العلاقة بين الإبداع والحكم عليه. فالقيمة، في نظره، لا تصنعها الصرامة الأكاديمية ولا العبارات المتعالية، بل ذلك الشعور الخفي بالإنسانية الذي يتسرّب إلى الكتابة. إنه يضع الذوق مكان السلطة، والخيال مكان التحليل، واللطف مكان الكِبر.
*
هُنا، يُمارَسُ النّقد
أنا إنسان متواضع، لست متعجرفًا على الإطلاق، ولا متكبّرًا ولا مُتعالٍ. لا أجرؤ على انتقاد كتاب تكرم به عليَّ ناشرٌ إلا على استحياء، ولكن ما إن أشرع في ذلك حتى أتخيل نفسي جالسًا في مقعد وثير كما لو كنت أحد أولئك النقاد المترَفين. إن المهمة التي أؤديها بتفانٍ وإخلاص تام، تزج بي فجأة في مزاج استعلائي آمر. على أي حال، هل يُفترض بحامل شهادة الدكتوراه في الأدب أن يبدو كديكتاتور ثقافي؟ هل أكون، يا تُرى، قد غدوتُ أحد صنّاع النفوذ؟ وأنا أتحسّر على غياب ترقيم الصفحات في مواضع عدة، أبدأ بالتهجّم على الطَّابِع، حيث لا يخطئ أحد في ذلك. ثم، حين أبذل كل ما في وسعي لاستحضار محتوى الكتاب أجد أن كل محاولة في هذا الاتجاه تبوء بالفشل، أبتسم ساخرًا من المؤلف، وأسحقه بنظري كأنني أحدق إليه من قمة جبل. لقد سبقني نقادٌ آخرون في هذا السبيل؛ وأنا أسير في أثر أسلافي. من المحتمل أن المؤلف قد بدأ يتساءل، في قرارة نفسه، إن كنتُ أرى نفسي أرفع منه شأنًا. هل أشبه حديقة تتفتح فيها أزهار صغيرة من الغرور والازدراء؟ يبدو أن الأمر كذلك حقًا. في هذه اللحظة، يبلغ شيء ما في داخلي حدّ النعيم من كثرة الضحك، ولماذا هذه الروح المرحة؟ هل ينبغي أن أكشف السبب؟ قد يكون أبلغ لو احتفظت بهذا لنفسي؛ لكن بما أن الصراحة، كما يقولون، جزءٌ مهم من قواعد اللياقة الأدبية، فإني أعترف دون تردد أن الحماسة التي يظهرها مؤلف هذا الكتاب ترفّه عني. أنا أسمو فوق حماسته، إذ أكتب هذه السطور في خلوة هانئة، معطرة بعطر رقيق، ما يمنحني قدرة على إدراك أدق التفاصيل بحساسية فائقة. لقد قرأت الكتاب بسرعة تفوق دون شك السرعة التي كُتب بها. كانت وتيرة قراءتي تشبه سكونًا صفيريًا، كسهم توقف في منتصف طيرانه. أما القراءة البطيئة فهي تتطلب جهدًا أعظم بكثير من ذلك التحليق الخفيف فوق الصفحات، الذي لا يعدو أن يكون نوعًا من الراحة المريحة. بالمناسبة، راقت لي جملتان أو ثلاث، إلى حدٍّ بعيد أثناء عبوري لحقول الكتاب وغاباته وأراضيه المزروعة. هذا اعتراف صادق أهنّئ نفسي عليه. ولكن الآن، حذارِ، فها قد جاء وقت الجدّ النقدي: ناسخ هذا الكتاب يُقحم امرأة تتسم بقلة الاهتمام لا يمكن إنكارها. أستطيب نكهة سيجار هافانا، بينما أتشجع لأشير إلى أن الكاتب يتوهّم عن رضا أنه يعرف ماهية الحب. بلهاث نمطي، وبطاقة مضحكة لجهول تام، يركض ويتعثر، أو يتهاوى في تصويره للعواطف، تصوير أُعلن عنه، من جانبي وبحركة حاسمة، أنه فاشل. عساه يترك القلم للأبد، ويتعلّم بأسرع ما يمكن حرفة صيانة الطرق، ليقضي أيامه في عدمية مطلقة، حتى لو كان يرتدي معطفاً ممزقا بالكامل. يسرني أن أتصور أنه قادر على رفع مطرقة، وحمل كيس، ودفع عربة صغيرة، وتحريك مجرفة، أو دقّ وتد في الأرض، ذلك المختار، الذي ستتسع عيناه دهشةً حين يطّلع على هذا النقد القاسي. ولا شك أن هذا الأبله فائق الذكاء قد أراق قطرات من العرق في صنع تحفته المشكوك فيها، التي لا بد أنه كتبها بمذراة لا بقلم، إن سمح لي القارئ بهذا التعبير. وحين بلغت نهاية قراءتي، اعتراني دوار كاد أن يصرعني، وبصعوبة تمكنت من استعادة توازني. قد يكون المؤلف شخصاً لطيفاً ومحبوباً للغاية؛ إلا أن كتابه، في المقابل، قاسٍ مثل الصفعة التي يوجّهها للذوق السليم. أرى أن الأهم بالنسبة لصانع الكتاب، هو أن يكون ذا روح جميلة، بدلاً من ادّعاء الصواب في أغلب الأحيان؛ وأن الشاعر الحقيقي يعرف النساء والحب أفضل من أي إنسان آخر، وأن منتهى اللباقة، حين يكتب المرء قصة حب، هو أن يبتكرها قدر الإمكان.