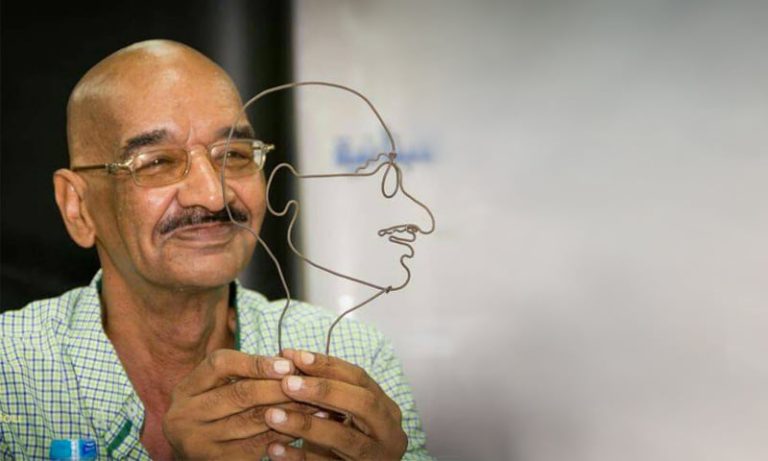حسين عبد الرحيم
خمسة وثلاثون عاما. أنا العاشق لهذه المدينة ؟!!، تي إليها في الخريف، مرتحلا على الدوام. كم تمنيت وحلمت ولم ازل أن اكتب عنها، أمشي بنفس الشوارع، أنظر تحت قدمي في النبي دانيال أتحسس رقدة الإسكندر، وأتوه وأعاود الزيارة في اليوم التالي فيشدني الحنين لصوت البحر الهادر، طوفان الماء وصخب الامواج العاتية قبل محطة الرمل ومرورا بالشاطبي وستانلي والعصافرة والمنتزه لأعاود الكرة من أعلى بنظرة طائر الشؤم، مات صديقاي هاهنا، “حسين الصومالي” بطل روايتي الجديدة، الحبشي ابن بلدتي الساحلية وخالد السروجي ومحمد طلخان ابن قنواتي، حارس الغروب.
في نفس الميقات، كانت الرحلة عبر القطار وصوت الديزل يفتح آفاقاً سحرية في بلاد تشق الزرع وتفتح الضرع على خلق الله التي استكانت للرقود بجانب ظلال الشجر، القطار، كم حلمت بالكتابة عن القطار، هذا الصوت الذي يردني بحسية جهنمية لتاريخ تليد، اصطكاك القضبان ومفارق الطرق وتلك الصلصلة والوشيش والبخر في غمام الفجر بجانب عربة السائق الذي يتثاءب على صوت زعيق السرائن العابرة في طريق عكسي يهشم ذاكرتي لأنهض من جديد بعد غفوة تتابعت فيها مدن الدلتا والبحر، دقة السيمافور ونحن نودع الخضرة وركاب حمير وجلبة طفلتين في صدع السرعة وتعالى الرجرجة وطحن حبات الحصى الذي يتطاير في المشوار الذي تمنيت كثيرا أن يطول ليرميني في آخر بلاد الله.
كم تمنيت أن اسرد هذه التفاصيل عن الصوت. جحيمية الكركرة والهدر وتناوب المساعدين على عجل بعد منتصف الليل ونحن نودع عاصمة الغبار، خرجت لتوي من المكتبة وتناولت قهوتي السادة في سوتر، في ترابيزة تخصني جالست فتيات الجامعة بدء الخريف، رايتهن يرقبونني ويتحدثن بهمس لتقول أجملهن، والتي بانت قصتها الكاريه تخايل نزواتي المحجوبة تحت ظلال هيبة الاربعين وتحفظي النسبي الذي انفرط مع أول لفحة للهواء عبر الكراسي الخالية آتية من قبل كورنيش الشاطبي، واضح من نظراته أنه غريب، عاشق ولهان أتى من بلاد الهوى.. نظرت للوجه في جلال، الغمازتين والشامة أسفل الذقن المخضب بحمار ارستقراطي النزعة وقت أن نادت على موسى وطلبت شيشة تفاح، وأشارت بغنج وقت أن انتصب قوامها الشهي اللدن ليكشف هيئة الجسد من أمام و خلف، وفي لقطات قريبة جانبية تتجلى بفرادة خارطة الجسد الشهي، الساحر، المغناج، الملاوع، المقتحم والذي سلبني كل إرادة كانت. فقلت في نفسي: إلى اين ستذهبين بي أيتها السكندرية الغواية الصامتة إلا من همس ولمس وطلل بنصف الحاجب الاسود الكثيف على صوت ترام الرمل الذي ناداني من زمن آخر.
كنت أودع الغروب بحسرة وشغف لا مبرر واضح لهما..، فألمح العم إدوار وهو يشير لقلعة قايتباى وحكايا الغرقى هناك والعم شجرة حكاء الغروب الذي يسير بنفس الطريق منذ العام 1946 ولم يهنأ بما حقق ولا بإنصاف الحياة التي ضحكت له أخيرا يحدثني عن سينما مترو وسبارتاكوس وأحدب نوتردام وسيرة مونتجمري كلفت وتشارلز برونسون وآلان ديلون الذي عمل طفلا وصبي كحمال للحقائب بمطار” اورلي”، يحكي لي.. في شرائط كاسيت تركها في متحف كفافيس، في عهدة العم محمد السيد، عن عشقه لاودري هيبورن وآفاجارنر وإيريني باباس الذي راقصها عنوة وهو سكران في العرض الاول لزوربا اليوناني بسينما مترو في العام 68. تهزني نبرات صوته على وقع همس الوشيش وعراك الموج واصطدامه بالصخور الصماء.يفيض في الحكي عبر سماعات ال ناشونال الموضوع بجانب مدخل غرفة النوم الوحيدة لكافافيس،يقول وقد وهن الصوت وكاد يتلاشي وقتما طللت أتفحص غرفة قسطنطين وسرير وحيد بملاءة بيضاء ووقت أن سكر انتوني كوين. وفي لمح البصر صار يتحدث العربية بلهجة سكندرية ويبصق في صورة قديمة بالابيض والاسود لكيرك دوجلاس وهو يرتدي القفاز في لقطة شهيرة من فيلم الملاكم.
أعود للميدان لأتطلع لتمثال سعد زغلول الذي لم يزل منتصبا بشموخ مفرط ومستفز منذ مايزيد على ستة عقود..أتذكر الاستاذ في صحبة الفقيخ الاعمى والمشي ليلاً من بترو حتى سيسل بعد انتصاف الليل بنصف الساعة وتوقف الزعيق وجلبة السوارس في الميدان جهة المتروبول..هنا وبعيدا نسبيا عن ناظري، أنظر لسماء الله، النجوم المحجوبة خلف غمام. كانت مليكة تتعلق بكف ريري الناعم الاشقر وهي تنظر شذرا لعيسي الدباغ، تخرسه بنظرات كالطلقات. كسهام من نار وهو خرس، كاظم الغيظ، عصابي، سكران، يهذي و يتوه ويطيل في التحديق. يعود الطلل لسعد، بحسرة هذه المرة. يجول بعينيه في البعيد جهة بحري محاولا الإنصات لصوت البحر في البعيد ينصت وينصت لعله يسمع جديدا أو يستشف أمراً آخر في رحلة “حسين الصومالي” ابن بلاد الساحل.