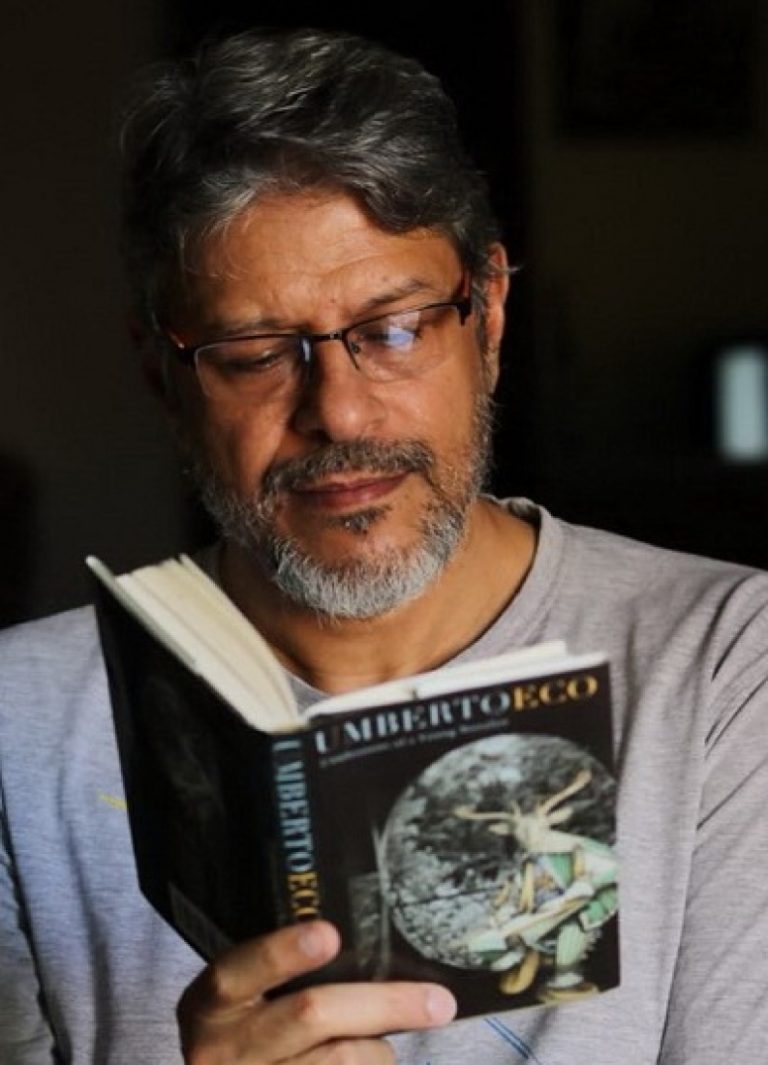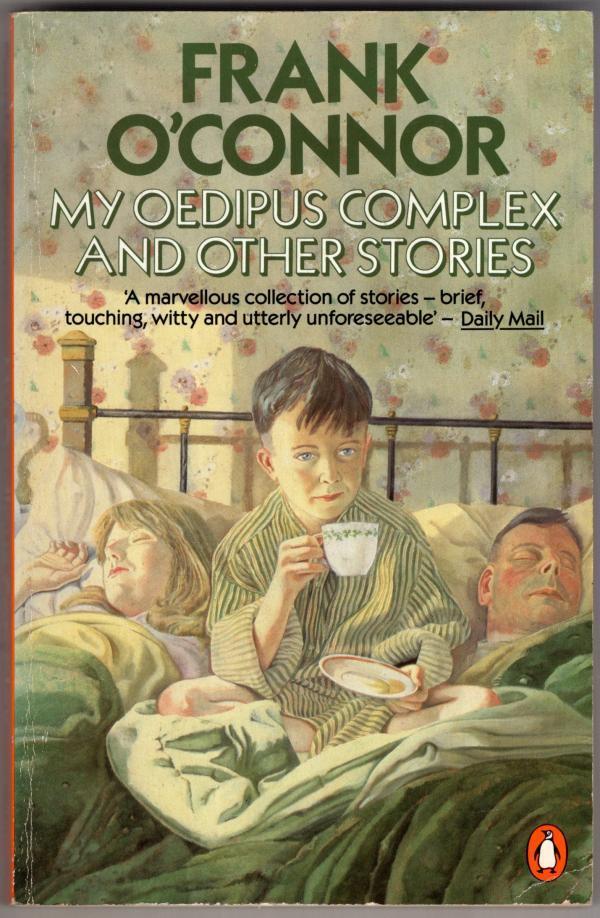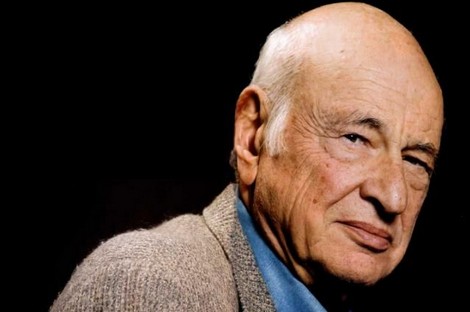***
حكي لي شيخ في الحانة: كنت أتناول العشاء كل ليلة في “إل موروكو” أو “نادي ستورك” بصحبة بعض نجوم السينما، وفي وجود نادل يشعل لي سيجار هافانا بمجرد أن أضعه بين شفتي، بينما يتطلع إليّ كل من في المكان في حسد. ومرة غسلت يدي بصابونة استعملتها قبلي مباشرة آيفا غاردنر.
وواصل في غضب “لا أعتقد أنك تفهم ما أقوله يا غلام. لقد كنت في الأيام الخوالي أمتلك ناطحات سحاب وخيول سباق”.
***
عند التقاء الطريق الخامس والشارع الثالث عشر، وعلى بعد كتلة سكنية من حيثما كنت أعيش في الستينيات، كانت هناك سينما تعرض الكثير من الأفلام الأجنبية. كنت آوي إلى فراشي، فأتقلب عاجزا عن النوم، ثم أدرك أنه لا يزال لدي وقت للحاق بالعرض الأخير. فأقفز من الفراش، وألبس على عجل، وأجري. ففي دقيقة كنت أتقلب وسط أغطيتي مشغول البال بكيفية دفع إيجار الشهر القادم، وفي الدقيقة التالية أشاهد فيلماً فرنسياً أو يابانياً أو هندياً. فإذا كانت الليلة عشية عطلة نهاية الأسبوع، فإن السينما تكاد تخلو تماماً، ومع إحساسي بشيء من النعاس، كان الفيلم يبدو أقرب إلى حلم أراه. وما يكاد الفيلم ينتهي، وتخلو القاعة تماماً، حتى أخرج عابراً ـ في ما أتذكر ـ بهواً خاوياً في الواحدة صباحاً وأنا أرتدي البجامة تحت معطف المطر لأكتشف أن مزيداً من الجليد قد هطل حتى ارتفع بوصة أو اثنتين عما كان عليه.
***
خطرت لي ذات يوم فكرة أنني ينبغي أن أقرأ قاموس أكسفورد الضخم للغة اللاتينية الذي تركه الساكن السابق في شقتي. كان سمكه يبلغ قرابة قدمين ووزنه نحو خمسة عشر رطلاً. حاولت أن أقرأ القليل منه كل يوم وفعلت ذلك لبضعة أشهر. وفي صباح يوم سبت جلست إلى مكتبي، نابتَ اللحية معانياً من شرب الأمس، وأوشكت أفتح الكتاب حينما خطرت لي فكرة بديعة. ماذا لو بعته؟ كنت مفلساً وتصورت أن القاموس قد يساوي خمسة عشر دولاراً أو أكثر، وذلك كان مبلغاً كبيراً من المال في ذلك الوقت. وكنت قد بعت من قبل كتباً في مكتبة ستراند، ولكن لم يكن بينها شيء في قيمة ذلك الكتاب، فلبست على عجل وخرجت، ساحباً الكتاب الثقيل متوقفا لأستريح كل حين. لم يكن في المكتبة زبائن. وضعت القاموس على المنضدة وانتظرت المحاسب الشاب أن يرجع من آخر الدكان بالعجوز الذي يقيِّم الكتب ويشتريها. تذكر كلٌّ منا الآخر، أطرق لي إطراقة عابرة، وفتح القاموس، تصفحه بسرعة وقال “ثلاثة دولارات”. صدمت. وغمغمت بشيء عن قيمة الكتاب وأنه يساوي أكثر. قال بحزم “هذا أفضل ما يمكن أن أقدمه”. غضبت بالطبع، لكن فكرة حمل الكتاب طوال الطريق إلى البيت كانت مقبضة أيضاً، فأخذت النقود، وتناولت إفطاراً هائلاً، وأنا أشعر بالذنب.
***
برغم أن ملايين من البشر يعيشون في نيويورك ويعملون فيها، والصدف نادرة بصورة مذهلة، إلا أنك بين الحين والآخر تصادف من تعرفه في الشارع. فمثلاً، قابلت مرة رجلاً أعرفه معرفة سطحية ثلاث مرات في ثلاثة أيام متتالية وفي ثلاثة أحياء مختلفة من منهاتن. في المرة الأولى تبادلنا تحية وجيزة. في الثانية توقفنا وتكلمنا وعلقنا على غرابة التقائنا مرة أخرى بهذه السرعة بعدما مضت سنوات كثيرة لم ير أحدنا فيها الآخر. في الثالثة ضحكنا بغير ارتياح، وتساءلنا أي منا يراقب الآخر، وكنا نتعجل الافتراق.
***
لم يكن العمل في مكتب بشركة كبيرة في وسط منهاتن بالعمل الصعب إذا تصادف أن كنت واحداً من مئات الموظفين ذوي الوظائف المكتبية. ففي غضون سويعات من اليوم كان يمكن للمرء أن ينجز العمل الذي كان عليه إنجازه مهما كان حجمه، ثم تنقضي بقية الوقت في الدردشة مع الزملاء الذين كان أغلبهم من النساء في منتصف العمر. ولما كن قد عملن في المكتب نفسه لسنين، فقد كانت كل منهن تعرف قصة حياة الجالسة على المكتب المجاور لها. فتسأل واحدة جارتها “كيف حال فريد؟”. كلهن يعرفن أن فريد صديق مارثا التي تنغص عليه حياته. تقول الجارة “لن تصدقوا” ويتوقف الجميع عما يفعلونه وينتظرون. وإذا لم يتكلم أحد، تجد من يقول “تصوروا من تجاسر وطرق عليّ بابي ليلة أمس؟”.
أصدقاء، أزواج خونة، أمهات كريهات، آباء مدمنون، أطفال ومشاكل، أقارب فضوليون ـ سمعنا كل شيء عن أولئك ضمن حوارات هي عملياً مسلسلات تليفزيونية عديدة حية ومتداخلة. من المؤكد أن بعض الأمور كانت تسير على نحو طيب، ولكن القصص ما كانت تنتهي في العادة إلا والجميع يهزون رءوسهم غير مصدقين. فيقول أحدنا “أتصدقون أن هذا حدث؟”. أعترف أن قصصهم كانت تجعلني متلهفاً على الرجوع إلى المكتب في اليوم التالي، ولا بد أن ذلك كان حال زملائي أيضاً. لم يحدث قط أن رأينا بعضنا البعض في غير أوقات العمل، ولكننا ما كنا نجلس إلى مكاتبنا حتى نتحول إلى أصدقاء. مؤكد أن مرتبي كان ضئيلاً، ولكن التسلية كانت لا تضاهى. كنت أحب أولئك النساء كثيراً. كان فيهن ذكاء وسذاجة في شؤون الدنيا، وكن طيبات، أطيب من قابلت من بشر في حياتي.
***
كان صدور أنطولوجيا “الشعراء الأمريكيون الشباب” لباول كارول سنة 1968 حدثاً ضخماً في حياتي وحياة غيري من الشعراء الذين شملتهم الأنطولوجيا. أقيمت خمس قراءات شعرية في شرفات وشقق فنانين وكتَّاب مشاهير في نيويورك للإعلان بكثافة عن الكتاب. فشاركت مثلاً مع مارك ستراند في ستوديو فرانك ستيلا في قراءة قدمها جيمس رايت وتكلم فيها بعبقرية عن أعمالنا، وإن تبين لاحقاً أنه كان يخلط بين اسمينا. وإذا كان الجمهور لم يدرك ذلك ـ وكيف له أن يدرك وقد كنا مجهولين تماماً؟ ـ فسرعان ما تبين له الأمر حينما قرأت القصائد التي أثنى عليها رايت بوصفها لستراند، وحينما قرأ ستراند القصائد التي كان يفترض أنها قصائدي أنا. كان رايت شاعرا كبيرا، ومرموقا، وكنا معجبين به أيضاً، فلم يجرؤ أحدنا أن يصحح خطأه وقتها أو بعدها.
***
“أول خطاب في حياتي كان موجها إلى الله”، هكذا قال لي عجوز على أريكة في حديقة سنترال بارك بواشنطن. وكان الجنرال واشنطن على طابع البريد الذي استعملته. لم يدر هل كان الطابع كافياً أم غير كاف. سمع أن هناك مخزناً في بروكلن، فيه ملايين من أجولة الرسائل التي لم يتم تسليمها على مدار قرن. قال “يمكن أن نذهب إلى هناك الليلة بالكشافات ونبحث عن الخطاب”. أراد أن يعرف رأيي في ذلك. قلت إن الفكرة تروق لي ولكنني ميت من التعب وأريد أن أنام، ولكنني الآن، وبعد كل تلك السنين، أشعر بالأسف لأني لم أقض معه وقتاً أطول على الأريكة، فقد كان طيب الروح، ووحيداً في الدنيا.