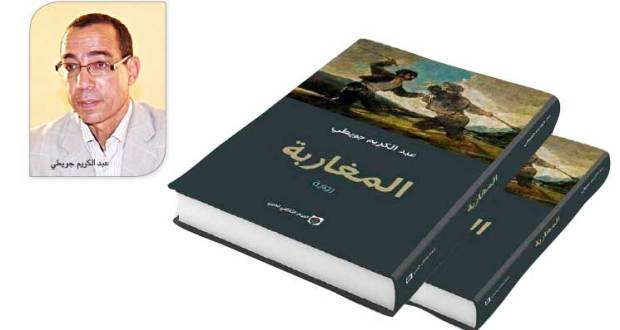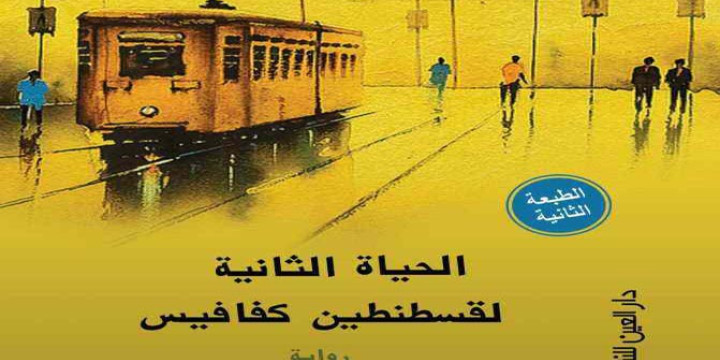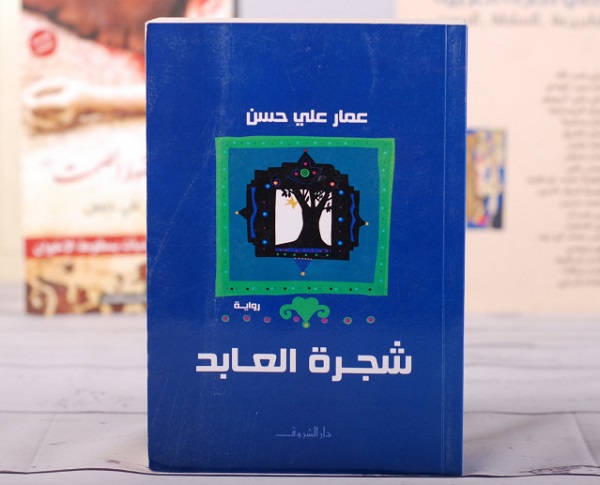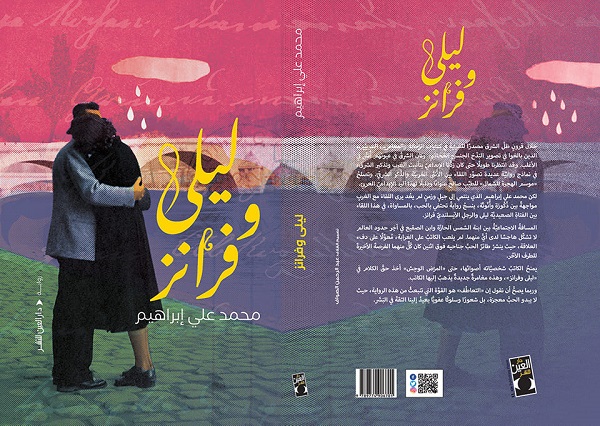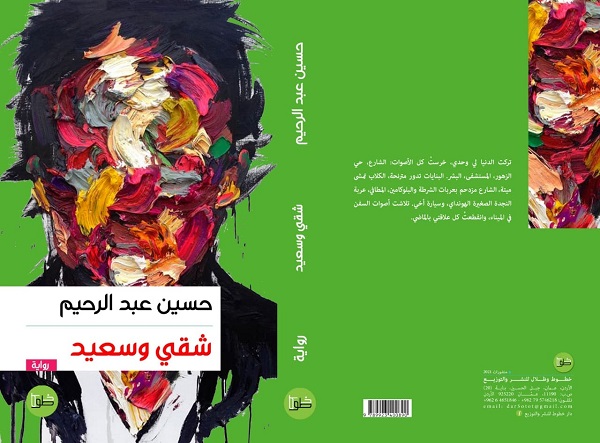عبد السلام فاروق
ماذا لو كانت الرواية نبوءة متأخرة؟ وماذا لو كان الخيال هو أقصر الطرق إلى الواقع؟ أليس من الغريب أن تكتب “نسف الأدمغة” قبل أن تنسف الجرافات عقولنا؟ قبل أن تتحول القرافة إلى أطلال، والمقابر إلى أرقام في حسابات المقاولين؟
كيف لرواية أن ترى ما لا نراه؟ أن تسمع أنين الأحجار قبل أن تتحول إلى تراب؟ أن تشم رائحة النسيان قبل أن تعم المدينة؟
هل كان خيري شلبي يقرأ المستقبل من خلال شقوق الماضي؟ أم أننا نحن من نعيش في ماض متكرر، لا نتعلم من دروسه، ولا نقرأ تحذيراته؟ لماذا نفاجأ حين نكتشف أن الأدب كان يصرخ منذ عقود، بينما كنا نغط في سبات التقدم الوهمي؟
هذه ليست مقالة عن رواية، بل هي استجواب للواقع. استجواب نوجهه لأنفسنا قبل أن نوجهه للنص. فما حدث في قرافة المماليك ، ليس سوى فصل من فصول رواية كتبها خيري شلبي قبل أن نعيشها. فهل نستطيع قراءة الفصل التالي قبل فوات الأوان؟
(1)
كنت أعتقد، في سذاجة متكررة، أن الرواية هي ابنة لحظتها. أو أنها تنبت من رحم الواقع كالنبات الشوكي، قاسية لاذعة تثقب غفلة الزمن. لكن “نسف الأدمغة” للمبدع الراحل خيري شلبي، جاءت لتخبرني أن الرواية يمكن أن تكون نبوءة أيضًا. نبوءة مرعبة، كأن كاتبها اطلع على سفر الأقدار فنسخ منه فصلًا، ثم ألقى به في الماضي، ليصطدم بنا نحن أبناء هذا الحاضر المفزع.
(2)
هناك، في قرافة المماليك، حيث ينام الموتى في بيوت من الرخام، تحول خيري شلبي إلى مؤرخ للكارثة قبل وقوعها. كتب عن شق أوتوستراد الأموات. عن هدم المقابر. عن صراخ الأحجار وهي تتساقط. عن ذاكرة مدينة تنزع من جذورها. كتب ذلك كله وكأنه يسجل وقائع جريمة لم ترتكب بعد.
والآن، نحن نشهد التحقيق في ذات الجريمة. نفس المشهد يتكرر ببرود مشين. نفس الجرافات، نفس غبار الأحجار المتطاير، نفس الصمت الرسمي المخيف. الفارق الوحيد أن خيري شلبي كان ينسف الأدمغة في الخيال، بينما نحن نفضل نسفها في الواقع.
(3)
الطريق هنا ليس مجرد شريط إسفلتي. إنه استعارة عن عقلية واحدة، أحادية المسار، لا ترى في المدينة سوى معادلة هندسية بائسة. هي معادلة تقول: لكي يتحرك الأحياء بسرعة، يجب أن تداس رقاب الأموات. لكي يندفع المستقبل، يجب أن يحرق الماضي.
هذه هي الفلسفة الحقيقية وراء “نسف الأدمغة”. هي عملية جراحية في جماجم شخصيات الرواية، وعملية جراحية أخرى تجرى كل يوم للوجدان الجمعي. إنها اقتلاع للذاكرة من مكانها، واستبدالها بفراغ معقم. خيري شلبي يرى أن تدمير المقابر ليس مجرد انتهاك للموتى، بل هو إعلان عن موت آخر: موت الإحساس بالانتماء. عندما تهدم شواهد قبر “عبد الرحمن كتخدا”، فإنك لا تهدم حجرًا، بل تهدم سردية كاملة عن مَن كنا، وبالتالي.. عن مَن يمكن أن نكون.
(4)
في الرواية، يتحول المكان إلى شخصية رئيسية تئن تحت وطأة العبث. القرافة مدفن للملوك، وهي أيضًا أرشيف مفتوح، مكتبة من الرخام تحكي عن فنون العمارة، عن تفاصيل الحياة اليومية، عن عقيدة وفلسفة في الموت والحياة. شق الطريق عبرها هو بمثابة إبادة لهذا الأرشيف. هو قرار يقول: تاريخنا من الآن فصاعدًا هو التاريخ المسموح به فقط. تاريخ لا يعطل سير السيارات.
وهنا تكمن المأساة الفلسفية التي أمسك شلبي بتلابيبها: تحويل التراث إلى عائق. تحويل الجمال إلى مشكلة. تحويل العمق إلى حفرة يجب ردمها. إنها الحرب الدائمة بين “الكفاءة” الجوفاء و”الهوية” المتجذرة. بين من يرى في المدينة آلة، ومن يراها كائنًا حيًا يتنفس بذاكرته.
(5)
ما يفعله خيري شلبي في “نسف الأدمغة” هو تفجير الزمن. لأنه يجعل الماضي حاضرا، والحاضر ماضيا، في بوتقة الخيال الروائي. يخلط تراب المقابر بأسفلت الطرق، ويمزج صلوات الأموات بزمجرة المحركات. هذا الخلط المتعمد هو محاولة لإنقاذنا من فصامنا التاريخي. نحن نعيش في شقوق الزمن، نرفض الماضي لأنه “انتهى”، ونخاف من المستقبل لأنه مجهول، فننكمش في حاضر عديم الجذور والاتجاه.
الطريق الذي يشق اليوم في قرافة المماليك هو نفسه الذي شُق في رواية خيري شلبي. هو ليس طريقًا في المكان، بل هو جرح في جسد الزمن نفسه. جرح يثبت أننا لم نتعلم شيئًا. أننا ما زلنا نعتقد أن التقدم يقاس بعرض الأسفلت، لا بعمق الذاكرة.
(6)
“نسف الأدمغة” رواية عن أحياء يموتون ببطء. عن شعب يقدم على “أوتوستراد النسيان” بسرعات خيالية. خيري شلبي لم يكتف بأن يكون شاهدًا على العصر، كان نادياً في صحراء اللامبالاة. نذيرًا لمن يهدمون مقابر أجدادهم، ليقيموا فوق أنقاضها.. مقابر لأحفادهم.
السؤال الذي تطرحه الرواية، ويطرحه واقعنا المرير: أي نسف للأدمغة أخطر؟ ذلك الذي تصوره خيري شلبي في عمل روائي، أم هذا الذي نعيشه كل يوم ونسميه.. تقدّمًا؟
(7)
لا يكفي أن نقول إن خيري شلبي كان “نبياً”؛ النبوءة هنا ليست سحرًا، إنها فعل قراءة للطبقات العميقة للواقع. إنها القدرة على رؤية الجمر تحت الرماد. الطريق الذي يتحدث عنه شلبي هو مجرد تعبير مادي عن عقلية تزحف مثل النمل الأبيض: عقلية تقوم على “إخلاء المكان من معناه” لملئه بوظائف مبتذلة. القرافة لم تكن مجرد مقابر، كانت متحفًا مفتوحًا، جامعة شعبية، سجلاً للحرف والزخارف والألقاب والصراعات. تحويلها إلى مسار للسيارات هو تحويل “النص” إلى “رقم”. هو انتصار للكم على الكيف، للسرعة على التأمل، للسطوح على الأعماق.
(8)
في الرواية، يصبح تدمير المقابر استعارة مزدوجة: تدمير للماضي، وتشويه للمستقبل. عندما تزال شواهد القبور، لا يمحى الماضي فحسب، لكن يسرق المستقبل أيضًا. الأجيال القادمة التي ستسير على هذا الأسفلت، لن تعرف أن أحذيتها تدوس على تاريخ. ستكون قد حرِمت من ذلك الحوار الصامت مع الأموات الذي يمنح الأحياء عمقًا وأسئلة. شلبي يكتب عن “الموتى” لأنهم، بغرابة، أكثر حيوية من كثيرين منا. هم من يملكون الأسئلة، ونحن من نجر وراءنا إجابات جاهزة، مبتذلة، كتلك الإسفلتية.
(9)
ثمة عنف مزدوج في ما يحدث: عنف ضد الموتى، وعنف ضد اللغة نفسها. الكلمات التي تستخدمها السلطة لترويج هذه المشاريع – “التطوير”، “التحديث”، “تحسين المرور” – هي كلمات مجوفة، بلا ظل، بلا رائحة، بلا ذاكرة. خيري شلبي، في المقابل، يستعيد لغة المكان. يجعل للحجارة لسانًا. يجعل للقبور حكايات. مواجهته ليست مع الجرافات فقط، بل مع ذلك الصمت الرسمي، مع ذلك الفراغ اللغوي الذي يلبس ثوب التقدم. إنه يذكرنا بأن المقاومة الحقيقية تبدأ باستعادة اللغة من براثن الابتذال.
(10)
المفارقة الأكثر إيلامًا التي تكشفها الرواية ويعيدها الواقع: نحن لا نهدم المقابر لنسهل حركة الأحياء فحسب، بل لنهرب من موتنا نحن. نحن ندفن ماضينا كي لا نرى وجهنا في مرآة الموت. نحن نسوي القبور بالأرض كي نظن أننا نحارب الفناء. لكننا، في هذا الهرب الجنوني، لا نقتل الماضي، بل نقتل مستقبلاً قد يكون مختلفًا. مستقبلاً يمكن أن يحمل شيئًا من الجمال، من الغموض، من الاحترام للزمن والروح.
(11)
خيري شلبي، بجبروته السردي، لا يقدم لنا بطلًا واحدًا في “نسف الأدمغة”. البطل الحقيقي هو المكان نفسه. هو ذلك الفضاء الذي يقاوم بالصمت، بالحجارة، بذاكرته المتراكمة. الشخصيات البشرية في الرواية – مثل سكان المنطقة، والعمال، والموظفون – هم مجرد كائنات عابرة في مشهد أكبر منهم. بعضهم مشارك في الجريمة عن جهل، وبعضهم ضحية، وبعضهم يتفرج. هذه هي تراجيدتنا الحقيقية: أننا إما جلادون، أو ضحايا، أو متفرجون. نادرًا ما نكون أولئك الذين يقفون في وجه الجرافة ويقولون: هذا يكفي.
(12)
في الختام، “نسف الأدمغة” هي مرآة نكسرها لنرى ما بداخلنا. هي صرخة ضد “الوطن البديل” الذي يبنى فوق أنقاض الوطن الحقيقي. وطن الأسلاك الشائكة والطرق السريعة والواجهات الزجاجية، لكنه يفتقر إلى الروح.
الطريق الذي شقه الروائي الراحل خيري شلبي في خياله، والذي نشهده اليوم في واقعنا، هو أكثر من مجرد طريق. إنه خندق يفصلنا عن أنفسنا. وعبر هذا الخندق، لا تمر السيارات فقط، بل تمر أشباحنا نحن. أشباح لم نعد نعرف لها موطناً إلا في كتب مثل كتاب عمنا خيري شلبي.