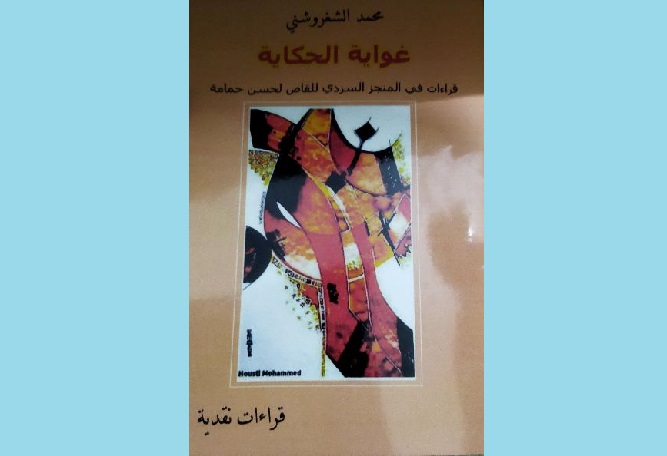أحمد جاد الكريم
في مجموعتها القصصية الأولى “عن الحب والعزلة” منشورات المتوسط 2022م تعرض الكاتبة مريم القحطاني صورًا لمعاناة المرأة اليمنيَّة على وجه الخصوص وشبيهاتها في بيئات عربية أخرى من خلال نماذج نسائية متعددة؛ ولذلك آثرتْ الكاتبة أن تُعنون قصصها الإحدى عشرة بأسماء نسائية، باستثناء أربع قصص، كانت المرأة في جُلِّها محور التعبير عن القضايا الخاصة بتلك المجتمعات.
فبدءًا من القصة الأولى “هدية” الشخصية التي ماتت بسبب تعطل الكهرباء في المستشفى حيث توقفت آلات غسيل الكُلى، عرض راو الحكاية الإهمال والقهر في المجتمع من خلال تلك الشخصية التي يموت أيضًا ابنُها في الغربة، ويُكلف الرَّاوي بإبلاغها بخبر موت الابن، فيكتشف أن الأم قد مات أيضًا، هنا يسيطر الموت بوصفه نتيجة حتمية لغياب العدل عن مجتمع لا يحصل فيه المريض على حقه في العلاج بل ويموت بسبب انقطاع الكهرباء.
وموت سرور بن هدية وأمه يذكر بموتِ أمِّ طفلٍ كان يلعب أمام منزل “صفية” في آخر قصص المجموعة “راحة بالٍ”، فقد طلبت منه أن يذهب بعيدًا عنها ويلعب مع الأطفال، تخبره بأن أمه تريده، وهي لا تعلم أنه يتيم، يركض الطفل فرحًا ظانًا أن أمه لم تمت كما أخبره أبوه، هنا تحضر مفردات الموت والمرض واليتم لترسم سياقات هذه البيئة.
ومن المرض إلى الجنون المصابة به الشخصية الرئيسية في قصة “حوريَّة” الكاشفة عن طبيعة البشر من حولها؛ فزوجها أهملها وتزوج غيرها، لينجب البنين، وأخوها تعلل بأن لديه أولادًا يُريد إطعامهم، ولا يقدر أن يعول أخته، أهل قريتها أنفسهم لم يقفوا بجانبها، بل خصفها الصبية بالحجارة، ونادوها بالمجنونة في ذهابها وإيابها، حتى راوية القصة لم تستطع سوى نقل ما حدث لها دون أن تقدر على إنقاذها مما هي فيه، شاهدة على نظرات الرجال المصوبة إليها وقت عريها، كل ذلك يدلُّ أن شخصية “حوريَّة” قدمتها الكاتبة كتجلٍ للمجتمع القاسي برجاله ونسائه وأطفاله، وفي المشهد الذي يعذب فيه الأطفال قطة بشنقها وتطويحها في الهواء إشارة ليس إلى حكاية “حوريَّة” فقط بل دليل على غياب التراحم والغلظة التي يلقاها كل كائن ضعيف، سواء أكان بشرًا أم حيوانًا، وهذه إدانة لهذا المجتمع، الذي من آفاته تزويج الفتيات الصغيرات مبكرًا، مثل ما حدث في قصة “خديجة” التي تعمل ناقشة وشم للعرائس، فتفاجئ أن العروس صبية صغيرة، سوف تزف إلى رجل أربعيني، متعجبة من كون أسرتها ثرية، في غير حاجة إلى المال كالأسر الفقيرة التي تضطرها الظروف لتزويج بناتها في هذا العمر، ولكن عادات المجتمع هي التي تتحكم في مصائر النساء بغض النظر عن المستوى الاجتماعي لهن، وسواء كنَّ يعشن في قرية أم مدينة.
ولا يقتصر قهر النساء على تزوجهن صغارًا، بل صبرهن على سفر الزوج لسنين طويلة، متحملات عبء تربية الأبناء بمفردهن، مثلما حدث لفتون التي ظلت وفيَّة لعهدها مع زوجها “أبو صالح” حتى ذبَلت زهرة شبابها، “إنها السيدة التي قضت عمرها خمسة وعشرين عامًا في الحقول والشعاب والجِرب تزرع وتحصد، وتربي العيال لزوجها”، وعندما عاد إلى القرية، تزوج بأخرى، أصغر عمرًا من زوجته الأولى، يحدث كل ذلك مع تواطؤ مجتمعي مع أولئك الرجال دون إبداء أية مظاهر لمقاومة تلك العادات الاجتماعية، التي يعرضها الراوي في استنكار يبدو على لسانه أحيانًا، وعلى لسان الشخصيات النسائية في أحيانِ أخرى، وهناك شخصية مضادة لشخصية “فتون” وهي “جميلة” في القصة التي تحمل اسمها، الأم المطلقة الشابة الجميلة التي تدعو على زوجها، وتطلب من الأبناء أن يؤمنوا على دعائها؛ لأنه نرجسي، هنا نموذج مناقض لفتون، حيث المرأة القوية القادرة على صد جبروت الرجل، بالدعاء عليه ومعاداته، وعدم الاستسلام لواقعها.
كما تسيطر حالة العزلة على المستوى الفرد والمجتمع ففي قصة “عزلة”، يتعجب الراوي من وصول الميكروفون إلى قريته النائية، وكذلك وجود البُسط على ضريح الولي “مِغفران”، “الضريح شامخ في الزاوية.. مدثر بالسِّجَّاد الأندلسي المطرز الذي تحتار في كيفية وصوله إلى هذه الأرض المهجورة المقطوعة”؛ هنا إشارة إلى التناقض الصارخ بين الحضارة التي مسَّت قشرتُها البيئة من الخارج في حين ظلتْ بعيدة عن التمدن الحقيقي الذي يُخلص الفرد والمجموع من سطوة الخرافة والجهل، وما يزيد من قتامة الواقع أجواء الحرب فرحلة الأب الذي يحمل ابنه المريض إلى مدينة صنعاء في قصة “الطريق إلى صنعاء”، فيموت الابن، ويشتد حزن الأب رغم أنه يعلم أن ابنه سوف يموت، في هذه القصة اجتمع قهر المرض مع ويلات الحرب التي وصفها الأب بأنها “لن تنتهي”.
على أنَّ الأمل في وضع نقطة نهاية للحرب لم يخفت قط؛ ففي نهاية قصة مارلين تتحد والدة الرَّاوية ووالدة مارلين ويتبادلان الأغصان الخضراء، متفقتين على نذالة الحكومة والرئيس، كأنه استشراف يؤمل في اتحاد فصائل الشعب اليمني– على الرغم من الخلاف- لتواجه القوى التي أطاحت بسلامه وأججت نيران الحرب الأهلية.
الراوي في القصص حاضر بنفسه، شاهد على كلِّ ما يرويه، يقول: “وكنت أنا لسوء حظي السيء، أشهد الحدث”، وفي مواضع أُخرى يستخدم ضمير المخاطب فيحدث الشخصية الرئيسية، وكأنها تسمعه بينما يقص الحكاية؛ كل ذلك جعل من الراوي مشاركًا في الحدث، القائم على الرؤية والمشاهدة، موثوقًا فيما يحكيه؛ ولذلك صارت رؤاه أكثر عمقًا في طرحها من خلال لغةٍ قريبةٍ إلى واقع البيئة مع عدم التحرج في استخدام ألفاظٍ تخصُّ سياق الحدث المروي مما جعلها أدقَّ مما لو ذُكر مقابلها الفصيح .
على أنه يُمكن أن يتطرق الظن إلى أن القضايا التي عالجتها الكاتبة في قصص المجموعة أُعيد معالجتها عند كتابٍ آخرين، لكن هنا الأمر مختلف؛ فاللغةُ التي رويت بها القصص لم تكن أداة توصيل وتواصل مع القارئ بل تحولت إلى جزء من تشكيل النص القصصي، ومدخل للتأثير عليه، ونقل صورة للمجتمع عن طريق تناول عديد من التيمات التي عبرت عنها الكاتبة مما يُعيد الالتفات مرة أخرى إلى الإهداء الذي وجهته للنساء: “إلى اللواتي عرفَتهن الشموسُ وعرفن الظلمة”؛ فقد كشفت كل حكايات هؤلاء النسوة اللاتي عشن في ظلمة “الموت – القهر – الفقر – الطلاق- المرض- الحرب –غياب الزوج)، وغيرها من أشكال المعاناة التي أظهرتْ حقيقة المجتمع من خلال تجلية حقيقتهن، وإخراجها للنور.