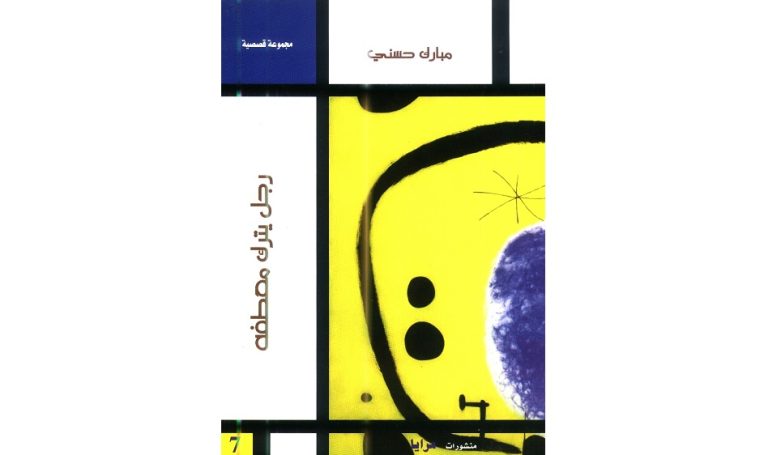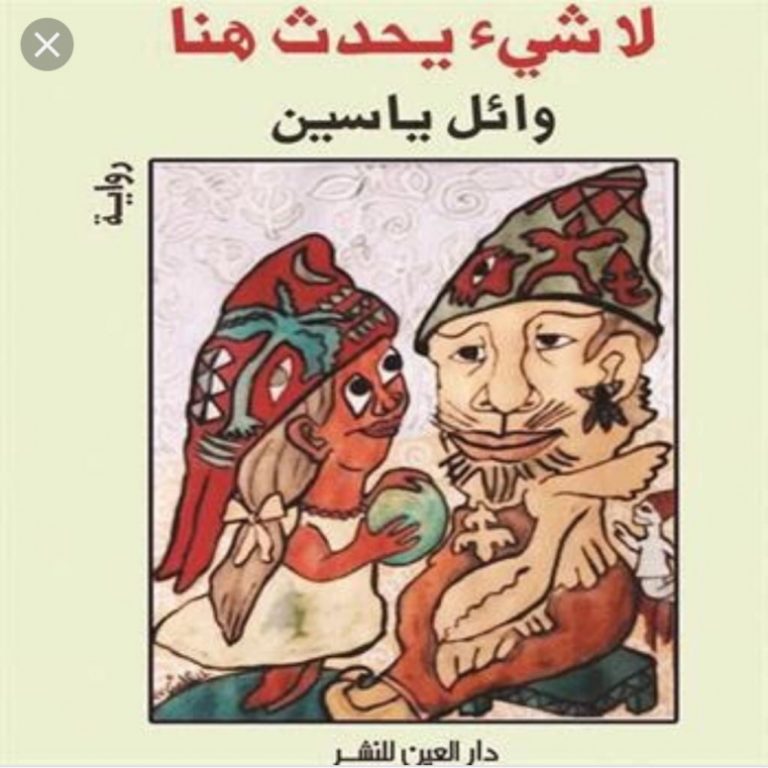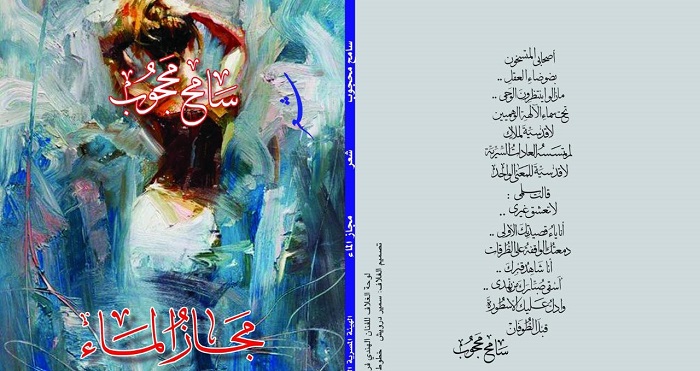شوقى عبد الحميد يحيى
تأتى رواية “نساء المحمودية”[i] لتؤكد ما كررناه كثيرا، من أن الرواية هى المؤرخ الحقيق لتاريخ الشعوب، مع حكامهم. ولا شك أن الفترة التاريخية التى بدأت منذ العام 1952، والممتدة حتى الآن، كانت تغييرا جذريا فى مسيرة الإنسان المصرى على الأرض المصرية. فقد تناولت “نساء المحمودية” تلك الفترة، وكيف تغيرت الحياة المصرية خلالها ، بتنوع من تولى الحكم فيها، وكأننا عدنا من جديد إلى الحكم الملكى، حيث أصبح الحكم يتوارث فيها. غير ان منير عتيبة، لا يكتب تاريخا فى تلك الرواية، ولكنه يكتب مسيرة الشعب مع تلك المراحل، ويعبر على تلك المحطات، التى توقف الشعب المصرى عندها – بعد فوات الآوان- بكثير من التأمل والمراجعة. ولا شك أن عبد الناصر، رغم أنه ليس أول رئيس للبلاد، غير أنه كان الأكثر تأثيرا فى المسيرة، فيذكر عتيبة له، حرب اليمن، وما دار فيها، من خسائر، والتى كان لها كبير الأثر على أكبر هزيمة فى التاريخ 1967. كما يذكر للسادات الذى تولى الحكم بعده، ما ذهب به إلى أعماق الشخصية حيث فى عهد الاستعمار، وقبل أن يقوم الضباط بما قامو به فى 1952، أنه كان أحد المجاهدين ضد الاستعمار الأنجليزى {أما المخابرات البريطانية فتلقى القبض على حسين جعفر ومونكاستر وحكمت فهمى والضابط المصرى أنور السادات التى رأت عائدة صورته بعد أيام فى مجلة لدى “أبراهام” الذى كان منتشيا بانتصاره. تذكرت أنها رأت ذلك الرجل فى خورشيد، يرتدى ملابس الفلاحين ويحمل جوالا فوق كتفه، دخل القصر دون أن يوقفه أحد، رأت من شباك المطبخ البك يستقبله بنفسه، ويحمل عنه الجوال، ثم دخلا القصر واختفيا فى حجرة المكتب. ..
– لابد أن الجوال كان به جهاز إرسال}ص211.
كما ذكر له الكاتب، انتصار 1973، دون أن يذكره فيها، ليرجع الفضل للجندى، الإنسان المصرى، ولكنه تذكره قبيل النهاية عندما {ظهر البك بعد ثورة يوليو، كان قد هرب إلى تركيا عن طريق ليبيا، ثم استدعاه صديقه القديم أنور السادات وقدمه إلى زملائه الضباط}. والبك هو أحد الباشوات –قبل يوليو- وردوا له أملاكه، وكأنى بالكاتب يرمى إلى محاولة السادات لإرجاع أموال الباشاوات إليهم، أو إرجاع الرأسمالية، بعد فترة قضاها الشعب مخدوعا بالاشتراكية التى اهتمت بالفقر، وكأنها تسعى لإفقار الجميع. وكأن الكاتب أراد الربط بين الحالتين.. الدفاع عن الوطن-حتى لو بالعمل السرى- والإيمان بالرأسمالية. وكلتاهما سعى نحو الحرية.
وكما يقال بضدها تتميز الأشياء، نرى “عائدة” التى عادت بعد خمسة وثلاثين عاما، لأرض خورسيد، فوجدت فيها ما أفاض فيه الكاتب، حيث عادت “عائدة”. إلى خورشيد فوجدت الأمور أصبحت فى منتهى السوء، وتعددت مناظر التخلف فيها.. تذكرت “حسين” وكم كان فحلا {ليتنى أخذته كله} فى إشارة إلى الرجال فى تلك الفترة، ولنذكر أنها منحت “حسين” نفسها، دون أن تسمح له بالإيلاج الكامل{هالها فعل الزمن فى المكان.. أصبح مكان المخيمات محطة أتوبيس نقل عام … أكوام القمامة، المحمودية أصبحت مجرد قناة ضيقة يسير فيها الماء مختنقا، يُثقله من أعلى ورد النيل الذى لا يجد من يتخلص منه لينقذ الترعة من جشعه، وعلى الجانبين تلال من القمامة وروث البهائم المعجون على شكل أقراص تجفف لتستخدم بعد ذلك كوقود لأفران خبيز الفلاحين}ص289.
ومن الأمور التى تحسب للكاتب، ان يشير إلى الأفعال والتأثير، دون أن ينزلق للخطابية، او التأييد أو الرفض المباشر، فإذا كان قد اشار مجرد إشارات للسادات، ففى تصورى أنه فعل ذلك، لأن تأثير السادات، رغم ما فعله، لم يكن شعبيا بالدرجة التى كان عليها سابقه، خاصة على الفئات البسيطة من الشعب. فإذا نظرنا إلى تصرف “صباح” إحدى شخصيات “نساء المحمودية” بعد النكسة، وتصورها أنها قريبة من عبد الناصر للدرجة التى تصورت أنها ستقابله فى الأسكندرية، لتسأله عن ابنها حسين. فحين يموت عبد الناصر، أثناء الإسبوع اليتيم الذى حصل عليه ابنها “حسين” من الجيش فى سيناء، ترى الدنيا{ظلام رحيل الرئيس سيعقبه رحيل حسين إلى الجبهة، القنديل الذى أضاء حياتى لأيام سينطفئ، حتى الإسبوع الذى ارتضيت به معه لن يكمله، متى سيعود لى حبيبى؟ متى أرى زوجى مرة أخرى؟}ص104. ورغم تلك المأساة، والحزن الذى يعتصر الزوجة، ترى أم حسين أن حزنها على عبد الناصر كان أقوى من فرحتها بِحَملْ عروس ابنها لتقول فى وجهها {ملعونة يا وجه النحس}ص105. وكأنها هى التى كانت وجه الشؤم لوفاة “الزعيم”. وتعود أم حسين لتكفين الراديو، وتجلس صباح على السطوح {تشعر خلايا يدها بآخر مرة سلم عليها حسين، ينتفض صدرها شوقا لحضنه، فتنزل دمعة على خدها، بطيئة ، ساخنة، لعروس لم تمض مع عريسها سوى إسبوع واحد، لم يدخل بها سوى ليلة واحدة، ثم غرقا مع كل البلد فى الأحزان}ص129. وتحولت الحياة فى عينيها إلى خرائب وأطلال.
ويترجم الكاتب التناقض بين الحالتين، حالة الهزيمة وحب الشخص، وحالة النصر وكراهية الشخص. فرغم فقد ابنها فى الحرب، وبرغم ما كان ابنها يمثل لها، وبرغم مرض الحفيدة “إنتصار”، كان حبها لعبد الناصر، اقوى وأشد. حيث تمرض إنتصار الصغيرة، اثناء إعلان السادات عن نيته واستعداده لزيارة إسرائيل. بينما أم كلثوم تغنى للسلام، وبائع الروبابكيا ينادى بالخارج و{سمعت أم حسين صوت بائع الهلاهيل كما يسمونه فى خورشيد، أو الروببكيا كما يسميه أهل الإسكندرية، نادته، ناولته الراديو دون أن تُغلقه؟ بكم يا حاجة؟” “بلا ثمن” . اخذه ووضعه على عربته الصغيرة، دفع العربة بيديه، وصوته يختلط بصوت أم كلثوم “السلام . ملابس قديمة للبيع. يا سلام. أجهزة قديمة للبيع. يا سلالالام .أى حاجة قديمة للبيع”}ص300. وكأنها لم تعد فى إحتياج للراديو بعد أن غابت خطب الزعيم، فلا حاجة لها بالسلام، او بأم كثلوم ذاتها.وهو ما يترجم تلك القطيعة التى مارسها أبناء جيله، ومن يسمون بجيل الستينيات، مع كل عمل يقوم به السادات، حتى لو كان السلام وتجنيب الشعب للحرب- التى ضاع فيها ابنها- والدعوة للسلام. وهو ما يعكس قدرة الكاتب على الوصول والتعبير عن مكنون شعب ذلك الجيل، وما لم تذكره كتب التاريخ الرسمى.
وامتدادا للخط وصولا للحالى منه، نرى أن الحاضر يتم فيه هدم القصر وتقطيع الشجر والنخيل، فكان شعور مصر-ممثلة فى صباح {كانت “صباح” تشعر بالقهر وهى ترى الشجرة المفضلة لديها ولدى زوجها الشهيد تسقط بلا كرامة وشجيرات الياسمين تطأها الأقدام}ص293.
وقد تولى التعبير عن المراحل الزمنية أربعة من “نساء المحمودية، ثلاثة من أبنائها، وواحدة واردة، أو دخيلة على خورشيد، وهى “عائدة” التى عنى الكاتب تسميتها بذالك الاسم، وليس “عايدة” كما أهل البلد، لتتحول من مجرد اسم، إلى فعل. حيث كان لها دور كبير فى فعل الرواية، كما أنها تمتد من الماضى للحاضر. ويكون علينا أن نجمع أشلاء كل شخصية، عبر الفصول المتتالية، لنكون الصورة التى عليها الشخصية، والتى نجح الكاتب فى رسمها، إنسانيا، ورمزا فى ذات الوقت، أو تجسيدا لصفة معينة.
فبالنظر مثلا إلى “رضوى” تلك التى، منيت بأن تكون عرجاء. تعايرها زميلاتها بالمدرسة، فتهجر الدرس، لكن فى محاولة علاجها بمستشفى الطلبة، وفى إحدى العنابر المكتظة، ترى ما يرسخ فى أعماقها طوال السنوات. ترى ممرضة تقتل أحد المرضى، فتصرخ، لكنها لاتبوح بالواقع إلا عند النهاية، وهو أحد الكرات التى يرسلها الكاتب، دون أن يحدد معالمها،، ليخلق لدى القارئ، ذلك التشويق الذى يربطه، ويعلقه، للقفز على الحوائط التى يضعها فى طريقه. غير أن حادثة تقع لزعيمة التهكم منها “شيماء” فتعتقد، ويعتقد زميلاتها أنها وراء تلك الحادثة، فيبدأن فى النظر إليها نظرة مختلفة. وبعد أن ذاقت “رضوى” الأمرين من زوجتى أخويها، وتشاؤمهم منها، وفى سيطرة غضبها، تذكرت ممرضة المستشفى {اللعنة عليه وعلى قاتلته وعلى اعتماد وسعدية وزميلات المدرسة والعرج}ص87. وتنظر إلى إحدى زوجتى أخويها .. فيسقط الحمل لكلاهما معا. فيظنن للمرة الثانية أنها هى السبب فى عملية السقوط. و بعد أن يأست “فاطمة” من الخلفة. نادتها “رضوى” وسألتها عما تريد:{ أتريدين ولدا أم بنتا؟ } فتجيبها فاطمة بالمهم أن تلد فتواصل رضوى {وتكون عروسا لخالد ابن سعيد؟…………. ما الذى تستطيعه رضوى لتحقيقه.. هى نفسها لا تعرف لماذا قالت ما قالته}ص137. ويتوقف الكاتب عما حدث بعد ذلك، ليؤكد أن “رضوى” ليست تعلم الغيب، أو أنها تستطيع فعل شئ باستخدام الجان، لكنها إنسانة تعيش بالفطرة. تحب كما تحب الأخريات، فاحبت “ماهر” الذى منحه والدها حجرة فى سطوح البيت، بجوار أخويها، غير أن حملة شعواء قامت من زوجاتهما. فيرحل “ماهر”. لكن الحرب لم تتوقف، فيقرر أخوها زواجها من “البدرى” رغم ما فيه من ضياع، لكنها لا تعترض، حتى أنها لم تتدخل فى شراء الجهاز الخاص بفرحها، تولى الأمر “سعدية” زوجة أخيها، وتم شراء {ثلاجة إيديال 11 قدم لرضوى، ثلاجة إيديال 16 قدم لسعدية، بوتجاز ثلاث عيون بفرن لرضوى، بوتجاز خمس عيون بفرن وشواية لسعدية، أنبوبة بوتجاز لرضوى، أنبوبتان لسعدية. فتقول “رضوى لابن أخيها “خالد سعيد”:- أمك تجهزت كعروس على حسى يا خالد. ابتسمت بمرارة، لم تكن تلومه، بدا كأنها تسجل الواقعة للتاريخ، وشعر بالعجز عن حماية عمته التى يحبها، وبالمرارة للخذلان الذى تشعر به}ص220. وسلمت نفسها لزوجها “البدرى، فلم تكن لتمانعه، حتى أن ابنه (الصايع) عندما كان يعود مخمورا، يمارس معها. دون أن تعترض. الأمر الذى يوضح شخصيتها، المسالمة، المستسلمة، فقد كانت تعيش بروحها مع ماهر، وسلمت جسدها الذى يملكه “البدرى”. وبعد سنوات تُصر على الطلاق، وتتزوج من “ماهر” وأصر على ذهابها معه لحفل تكريمه كعامل مثالى وترقيته مديرا ماليا للشركة، وفى الحفل تشير إلى السيدة “عائدة” بانها هى. فتهرب “عائدة” إلى مكتبها، وتموت هناك… وتشير “رضوى” إلى الطفل الذى يلعب بطائرته الورقية، ويحاول أن ينقذه.. بينما ينظر”ماهر” ليجد أن الكرسى الذى تجلس عليه “رضوى” فارغ.. فيشفق عليه البعض، وبينما يراه آخرون .. مجنون؟.
وكانت “سنية” هى المرأة الأخرى التى عاصرت حفر ترعة المحمودية، حيث كانت زوجة “حسين”، الذى ارتبطت به كثيرا، حتى أنها شعرت بالخوف عليه، عندما أتى الخواجة “كوست” المكلف بحفر الترعة، وتوسعت معه أملاك “حسين” حيث انتقل إلى بيت أوسع، وبدأت هى بالخوف من أنه كلما اتسعت أملاكه، زاد تفكيره، فيمن سيرث كل تلك الأملاك. خاصة عندما أتى ب”عليات” التى توفى زوجها قريبا، ولم يشأ ان يتركها وحيدة. فعاشت معهم بالبيت –كخادمة- إلى ان يصارحها “حسين” برغبته فى الزواج، فتوافق على أى إمرأة إلا “عليات”. الأمر الذى يُغضبه كثيرا، إذا لأول مرة تراجعه “سنية” فى أمر يراه. فتشعر “سنية” أنها {لم تحب ترعة المحمودية ولم تكرهها، لكنها بعد ذلك بوقت ليس طويلا، كرهت هذه الترعة المشؤومة، وتمنت لو لم يترك مسيو كوست بلاده ويأتى إلى هنا}ص150.
وأثناء حفر الترعة، يجد العمال بعضا من القطع المعدنية، يسلموها ل”حسين” الذى يسلمها بدوره للخواجة، الذى يسلمها أيضا للبك الكبير، غير أن حسين يحتفظ بقطعة منها فى قاع صنوقه الخاص. ويتفق مع كل من “سنية” و”عليات” بتقسيم الليالى بينهن، وان يظل له ليلة خاصة يقضيها فى حجرته، التى بها صندوقه. فتتبدل أحوال سنية وتذهب إلى الأحراش، وتخالط الذئاب، ليحدث حريق كبير يبتلع معظم أملاك “حسين” ورغم علمه بأن “سنية” وراء ذلك، غير أنه يأبى مكاشفتها، خوفا من تعاملها مع الذئاب {لم يفكر حسين فى إيذاء سنية، أيقن أنها السبب فى ما حدث لوجهه، وفى الحرائق، لا يدرى كيف تفعل ذلك، ربما تآخت مع بعض الجن الذين يسكنون الأحراشن لكنه لم يكرهها،علم أن حبها له يدفعها لفعل ذلك}ص260. ثم تبدأ العلاقة مع “عليات” فى الأفول، حيث لم يعد ينجح فيها. فتبدأ المقارنة{ سنية تصل إلى عنفوان متعتها بمجرد أن يلجها، روحها تمتن لمجرد أنه معها، ظل يشعر بذلك، لكنه لم يعلم أن الصدق التام فى مشاعر سنية لم يعد بذات كماله القديم. وهو فوقها، ترى عليات فى عينيه، والأسوأ أنها كانت ترى إمرأة أخرى لا تستيطع تمييز ملامحها، لم يكن حسين يلجها هى إذن، لم يكن يلمس جسدها، بل يمارس رغبة قوية فى جسد “عليات”، وعشقا مجنونا لجسد المرأة الغامضة، ولم يكن أمام سنية سوى الاستسلام حتى لا يبتعد عن فراشها، ولو جسدا بروح فى مكان آخر}ص231.
وتحمل “عليات” ب “حسين الصغير” غير أنها تموت، لتلحق بزوجها “حسين” الذى ذهب إلى الأحراش .. ولم يعد فتسعى “سنية” للتكفير ورعاية “حسين الصغير” {تعلم أن كفارتها هى رعاية هذا اليتيم، لا، حسين ليس يتيما، هى أمه وأبوه، وهو ابنها، لم يكن فى بطن عليات، فقط نزل من فرجها، لكنه نبت فى هذه الأرض البور، وتغذى منها …. لكن عليها أولا أن تحكى للباشا الكبير كل ما فعلته ترعته بها وبزوجها، ليعرف غلطته الكبرى، ويامر بردمها، لتتخلص سنية من سم الكراهية السارى فى بدنها، وتتفرغ للحب ترضعه لحسين. نز ثديها بقطرات من لبن، فألقمته الطفل، فأخذ يمصه منتشيا}ص288.
تأتى بعد ذلك “صباح” تلك التى أحبت “حسين” الذى خطبها من والدها منذ أن ولدت، وبعدها سافر إلى اليمن {اليمن، الإمام ، السلال، شرح لها أن اليمن يحكمه رجل يقال له الإمام، وأنها تعيش فى ظلمات القرون الوسطى، لم تفهم ما القرون الوسطى وبين أى قرون هى الوسطى، لكنها واصلت الاستماع إليه، قائد عسكرى قريب من الإمام، يتفق مع آخرين أن يثوروا عليه ويخلعوه عن الحكم، ويريدون من مصر أن تساعدهم، والرئيس جمال عبد الناصر “جدع” وابن بلد ويقف مع من يطلب نجدته… الأمر لن يستغرق شهرين، ستة أشهر على الأكثر، هى مجرد نزهة نساعد فيها الثوار الأحرار ليتقدموا إلى المستقبل مثلما تقدمنا نحن بعد ثورة يوليو 1952 منذ عشر سنوات}ص54، 55. وبعد خمس سنوات قضاها فى اليمن، يتجه إلى سيناء، لتحدث النكسة{ذهبت لأحرر اليمن، ففقدت أرضى يا صباح}ص76. ليعانى مرارة التدريبات. ينزل أجازة عشرة أيام، وترفع صباح حجاب منع الحمل.. وبعد شهر أرسلت له تخبره أن بذرته انغرست بداخلها، وأنها تحارب لتبقى على قيد الحياة. بينما ابنها قد بدأ يتحرك فى بطنها، كان الجنود يتمرنون على عملية العبور، بعيدا عن الأعين، وهى تبحث فيما بينهم عن “حسين”.
وبينما الشمس تصارع وتتحدى الليل، تردد صباح {فلماذا طال ليلنا نحن، أنا وحماتى وزوجى؟ وأين شمسنا المتمردة الخائفة التى تخشى اتخاذ قرار يعيد الحياة إلى طبيعتها ويجمع شتات الأحباب؟}ص213. وكأنها تتحدث عن الوطن، لا عن نفسها، الوطن الذى طال انتظار ظهور النهار، بعد نكسة أظلمت الحياة من حولها. وتأتى “إنتصار” فى ذات اللحظة التى يعلن فيها السادات نجاح العبور. غير أنها تمرض، وكأننا أمام عملية الثغرة، لكن “إنتصار” الصغيرة تفارق الحياة، لتلحق بها أمها بعد وقت قصير ويلحق بهما “حسين”، لتفقد صباح كل أمل فى الحياة {وأصبحت حياة صباح مملة ومؤلمة، لاشئ تنتظره ليجئ من أى مكان، حتى حماتها لم تتحمل الحياة أشهرا قليلة بعد موت انتصار، وأسرعت لتلقى ابنها وحفيدتها تاركة إياها فى هذا الخواء الموحش}ص307. فتموت “صباح”.. ويخمن البعض أنها ماتت بالكوليرا، ويريدون هدم البيت وحرقه،، غير أن الشباب بزعامة “خالد سعيد” ينجحون فى إخراجها من البيت ودفنها.
ثم نأتى للشخصة الممتدة، بصور مختلفة خلال الفترة الزمنية الممتدة منذ العام 1933 إلى وقتنا هذا، وهى “عائدة بانايوتس” اليونانية، والتى تعمد الكاتب –منير عتيبة- أن يجعلها منطقة مسكوت عنها، لأنه لايكتب التاريخ، وإنما يكتب رواية عن التاريخ، واكتفى بأن يُظهر بداية الخيط الرفيع الواصل بين “عائدة” و”رضوى” والذى لم يُظهر نهايته إلا مع نهايات الرواية، وترك قارئه يبحث عن مسار ذلك الخيط، فجاءت الجملة الشاملة، والحاوية أيضا لعلاقتها ب”أبراهام”.
{لم تر “أبراهام” فى يومها الأول بالمستشفى، إذ لم يكن بالأسكندرية أصلا، لم تعرف يومها الأول 30 يناير1933، يحتوى حدث آخر فى مكان بعيد، رجل يحتفل بانتصاره كما تحتفل هى بتسلمها العمل فى المستشفى، ربما فى اللحظة نفسها، كان أدولف هتلر يشرب نخب بلوغه منصب مستشار ألمانيا، وكان “أبراهام” فى اللحظة نفسها يجلس فى حديقة عامة ببرلين، شابا تخرج فى الجامعة منذ أشهر، يحلم بأن يكون طبيبا كبيرا، يتخيل نجاحه المبهر، عمله بأكبر مستشفيات ألمانيا، نجاحه فى امتلاك عيادة خاصة به، وشهرة كبيرة بالقدرة والمهارة، ولم يكن يعلم أنه بعد أقل من ثلاثة أشهر سيصبح ملعونا من معظم الألمان}50. حيث أقيم ما عرف فى التاريخ بالمحرقة الألمانية التى اقامها “هتلر” لليهود، فنشأت العداوة بين اليهود والألمان، وترسخت فى أعماق الشاب اليهودى “أبراهام”. فاستخدم مَنْ وقعت فى حبه “عائدة” للانتقام من الألمان، بمساعدة الإنجليز. على عكس ما كانت العداوة قد ترسبت فى أعماق الضابط المصرى “أنور السادات” وكثير من المصريين، ومن بينهم أحمد بك الجزيرى، فكانت هناك قوتان متصارعتان، فكان الصراع بين المصريين واليهود، على الأرض المصرية، وكان الصراع بين “حسين” وأنور السادات المصريين، وبين “عائدة” و”أبراهام” من جانب آخر.
تسعى “عائدة” اليهودية، وبتشجيع من “أبراهام” لدخول القصىر، حيث يقول لها {هذا الرجل الجزيرى قد يكون ضالتنا المنشودة، حاولى التقرب إليه أكثر، كونى فى بيته أكبر فترة ممكنىة، لو سلمناه للمخابرات البريطانية بأدلة تدينه فسوف ترتفع أسهمنا لديهم، وسنحصل منهم على مكاسب كبيرة فى أرض الميعاد}ص155، فتتقرب إلى “حسين” المقرب من القصر والبك، فتتخيل أنها نجحت فى مسعاها، فيدعوها “حسين” على غداء فى القصر، وهناك يخبرها أنه سيطلعها على سر من أسرار القصر لا يعرفه غيره والبك “أحمد الجزيرى”. لتدخل وراءه، وتفاجأ بان البك يجلس هناك، وفى انتظارها. ويخبرها البك بأنه يعلم كل شئ، كما يخبرها بما لا تعرفه، أنها تساعد فى دمار مصر {أنت لا تعلمين ما كان يريد الإنجليز وأبراهام ومن خلفه فى الوكالة فعله بمصر فقط ليعيقوا الألمان عن التقدم إلى القاهرة، كانوا يريدون إغراق الدلتا كلها، ينسفون جميع القناطر والكبارى، لايهمهم أن تغرق مصر كلها، 16 مليون مصرى يموتون غرقا من أجل أن ينتصر الإنجليز فى الحرب، هذه هى خطة الاستعمارى القمئ ونستون تشرشل، جاء إلى القاهرة، وضع الخطة، ذهب إلى بلاده مطمئنا كشيطان أدى مهمته على أفضل ما يكون}ص239. ويحبسانها فى الحجرة المظلمة، ويَدْهمُ القصر ضابط مصرى وضابط إنجليزى و”أبراهام”، للبحث عن البك، ورغم أن حسين أبو حسين أظهر شجاعة وتماسك، إلا أن أبراهام إكتشف وجود “عائدة فى المكان، فتمكنوا من الوصول إليها. وبينما سيق حسين أبو حسين مقبوضا عليه، فحاول الهروب.. غير أن رصاصات الإنجليز كانت أسرع فقضت عليه.
وتخرج “عائدة” خارج البلاد.. لكنها تعود بعد خمس وثلاثين سنة، كسيدة أعمال بلجيكية، لتجد الأمور قد تحولت للأسوأ كثيرا. تعود كصاحبة شركة دولية، يحمل أعضاء مجلس إدراتها جنسيات متعددة. وبينما أرادت تعيين ابنها “أبراهام ديفيد أهارونى” عضوا منتدبا لإدارة الشركة، لتكون هذه آخر زيارة للشركة، لمحت ظل “رضوى” لتجدها تجلس بين أعضاء مجلس الإدارة لتجد نفسها{تجرى فى ممرات المستشفى الإسرائيلى بعد أن حقنته بالسم.. ألقت بجسدها المرهق من مطاردة استمرت لما يقرب من سبعين عاما، زاغت عيناها، دق قلبها بعنف وهى ترى القتيل الألمانى يخترق أحد جدران المكتب متقدما إليها ببطء، وفى يده حقنة كبيرة جدا، حسين يخترق جدارا آخر وفى يده الخيط الحريرى الأسود الذى كان حول رقبته، خنقها حسين، وحقنها الألمانى …. وجدوا جثتها ممدة على أريكة، وفى عينيها فزع ورعب غير مفهومين}ص306. ولتتضح الرسالة التى أرادها الكاتب، ان الوجود الأجنبى، واليهودى تحديدا، لا يألو جهدا فى العودة إلى مصر.. سواء مباشرا-كالاحتلال المباشر- وعندما كانت هى السيد “عائدة بانايوتس” اليونانية، أو فى صورة الشركات الدولية، مثلما أصبح هى سيدة الأعمال لبلجيكية. أو تقديم المعونات والمكافآت، التى تقدم كالطُعم لأبناء البلد.
التقنية الروائية
تعيد رواية “نساء المحمودية” إلى الذاكرة، الكثير من إبداعات الراحل “خيرى عبد الجواد”، حيث التشابه والتقارب، الذى جعل كلا من منير عتيبة، وخيرى عبد الجواد، يحاولان إحياء منطقة عاشا فيها، فحاولا إخراجها من الظلام والنسيان، إلى عالم النور، والأضواء. بل جعلها هى الوطن. وإن كانت منطقة المحمودية، هى الفضاء المكانى الذى استغله عتيبة، ليُشَيّدَ بناءه فيه، فهو فى ذات الوقت، يقول لقارئه، بأن هذا المكان ليس خياليا، وإنما هو مكان فعلى على الأرض المصرية، وهو موطنى الذى أعتز به، وهو قائم منذ كثير من السنين {تحولت عزبة أبو حسين إلى خورشيد، إذ اقتطعها الخديو إسماعيل لمحمد خورشيد باشا الذى كان محافظا للأسكندرية مرتين من عام 1857 إلى 1863 ومن عام 1868 إلى 1870 عندما إلتقى خورشيد باشا بعائلة أبو حسين، عرف أن هؤلاء الرجال ليسوا عبيدا، وليسوا أتباعا بلا قيمة، وعليه جعلهم رجاله المخلصين الأوفياء …. فكل منهم يؤمن بأنه سلطان نفسه، ولا يعلو عليه سوى سلطان العائلة وكبيرها حسين أبو حسين أيا كان عمره}ص97. ومن هنا، كان اختيار الكاتب لاسم “حسين” ومنحه صفة البطولة للعمل، كان على أرض صلبة تتحمل تلك البطولة، التى جعلت من أحد آل”حسين” لا يستسلم للإغراءات الجسدية لليهودية “عائدة” ، رغم ما تتمتع به من جمال، وأن يسير معها إلى أن يستدرجها لِمعَقِله داخل القصر. وليغيب أل”حسين” بعد ذلك، لكن “عائدة” تعود إلى ذات المكان، وإن بصورة أخرى، ومع وجود –رجال- آخرين. ومن هنا جاء الجزء الثانى من العنوان “التاريخ السرى لخورشيد فى 200عام”. أى أنه يتحدث عن بداية الإنشاء، ومن هنا كانت “نساء المحمودية “وليس رجال المحمودية”، فالنساء هم بداية الحياة، بالنسبة للإنسان، الذى يتعرف على الحياة من خلالها، وليس من خلال الرجل.
تأخذ رواية “نساء المحمودية” الشكل الدائرى، فتبدأ ب”رضوى” و”ماهر” وتنتهى بهما فى ذات الموضع، وكأنها تحصر كل ما بينهما فى تلك الدائرة التى تحيط بها، والحدث الذى يعيشانه معا. فإذا كانت البداية عندما طلبت “رضوى” أن تخرج مع “ماهر” لحضور زيارة الرئيس لافتتاح مشروع الطريق الجديد، الذى يفتتحه الرئيس بنفسه، فتجرى الاستعدادات التى تصاحب زيارة الرئيس، والأولاد يلعبون بالطيارات الورقية التى يلعب بعا الأطفال فوق الكوبرى الجديد، وتنتهى –الرواية- والطفل يصارع الطيارات الورقية الأخرى، حتى كاد يسقط، ولما أنقذه، ماهر- بإشارة من “رضوى”- بحث عنها،، فلم يجدها.
وتصف الرواية حالة “رضوى” -أيضا- {شعرت رضوى بالاحباط الشديد عندما لم يتوقف موكب الرئيس بخورشيد، إحساس يشبه ما شعرت به أم حسين حين لم تستطع مقابلة عبد الناصر، وما شعرت به سنية لأنها لم تقابل محمد على، برغم أنها ليس لديها ما تريد قوله للرئيس}ص310. فالمسألة تتكرر عبر الزمن، وعدم وجود شئ محدد تريد “رضوى” توصيله للرئيس، يؤكد شيآن، أن الرؤية الأساسية للرواية تكمن فى الانفصال بين الحاكم والمحكوم. وثانيا، ان ل”رضوى” دور يختلف عن دور باقى “نساء المحمودية”، لأنها إختفت –كإحدى استخدامات الفانتازيا- التى جاءت فى موضعها، كتيمة رمزية. الأمر الذى يجعلنا ننظر للرواية على أنها ليست رواية أصوات-على عكس ما قد يراه البعض غير ذلك. لأن كل شخصية لا تتحدث عن ذات الموضوع، مثل ذلك المثل الشهير الذى يتحدث عن أربعة من العميان، وقفوا أمام جمل، ولمس كل منهم جزءا من الجمل، فراح يصفه، فكان وصف كل منهم مختلفا عن الآخر. فالموضوع هنا واحد، وهو الجمل، ولكن تعددت وجهات النظر حول رؤيته، أو تحديد كنهه. أما نحن هنا أمام شخصيات، تختلف فى توقيتات الزمن، من جانب، وفى دور محدد تقوم به، أو تترجم به وضعا معينا، يختلف باختلاف الزمن. فبينما نرى “صباح” مثلا تتحدث عن الزمن الحاضر، فإن “عائدة” تتحدث عن فترة الحرب العالمية الثانية. وإن كان كل من “رضوى” و”سنية”، قد اتحدن فى الممارسات الجنسية، إلا ان هناك اختلاف بين كل منهن، حيث تَعِتبِر “رضوى” الجسد شئ لا يخصها، فإن سنية على العكس من ذلك. أى أن الشخصيات لا تتناول شيئا واحدا، ولذا فلا نراها رواية أصوات.
فقد أسلمت “رضوى” جسدها دون أى تأثير لديها بما يُفعل فيه، حتى أنها تستسلم لأبن زوجها، دون أى أهمية لذلك، بينما فى كل الأحوال، كان ماهر هو من تراه، وتتمناه، كما إيمانها بأن الجسد ملك لزوجها، ولا يخصها، يقربها من الروحانية، ويبعدها عن الشهوانية. فإذا أضفنا عملية الاختفاء، فما يختفى هو الجسد، أما الروح، فلا تموت، ولا تُرى. كما أن مقولة رضوى التى تؤكد رؤيتها الاتصالية بالسماء، ففقط تذكرت والدَها عندما كان يتحدث عن الصالحين الذين يَكشفُ اللهُ عنهم الحجب، فيرون ما لا يراه غيرهم، لكنها لم تعرف ما علاقتها بالصالحين.
كما يجب أن نلاحظ أن العرج فى حياة رضوى، هو إشارة للعجز الذى يعانى منه كل من يتعامل بشفافية، او بنقاء. لذلك تمسك بها “ماهر” رغم أنها لا تعلم ما الذى يجعله يتمسك بها. كما نجد كثيرا، أن من يطلق عليهم أن (فيهم شئ لله) أولئك الذين فقدوا شيئا من وجودهم المادى، لذا كان العرج هو هذا الشئ المفقود.
لذلك نرى أن رضوى هى من تمثل الروح، فى جسد الرواية، وكأنها القوة العلوية التى تشير إلى مكامن الخطأ، فظلت محتفظة بما فعلته “عائدة” ، لتكشف السر بأنها هى الممرضة التى قتلت الألمانى فى مستشفى الطلبة، بينما كانت تُعالج هناك. كما أن الطائرات الورقية (وليست الحقيقية)، المستخدمة فى تلك المهرجانات التى تُجَهز لزيارة الرئيس، تُدمر المستقبل، حيث تضع فيه تلك الاحتفالات الشكلية، الازدواجية بين الأقوال والأفعال، غير أن الاجتهاد والإصرار، الذى يمثله “ماهر” هو الذى يصلح لأن يكون نموذا لتنشئة الطفل، ف”ماهر” هو من أنقذ الطفل، أو هو من يمكن أن يُنقذ المستقبل. فالروح بما لها من أسرار.. هى ما تكشف عن المستتر، لمن يعيشون على الأرض, وتلك كانت “رضوى”.
بينما كانت علاقة “سنية” ب”حسين” قائمة على أساس من الحب، والذى أخذ صورة الجسد للتعبير عن ذلك الحب وما فعلته من اتصال بالقوى العلوية- الذئاب والتراب- ليس إلا إنتقاما من انصرافه عنها جسديا، حيث نازعها فيه، كل من “عليات” الزوجة الثانية، والمرأة الخفية التى لا تعلم عنها شيئا – فى إشارة إلى القطعة المعدنية التى حصل عليها “حسين” من باطن الترعة- ولذلك فإنها وإن كانت تمثل فترة زمنية مضت، حين حفر ترعة المحمودية، إلا انها فى ذات الوقت يمكن أن تمثل .. الجسد فى بنية الرواية.
ثم تأتى “صباح” لتمثل تلك الفترة الممتدة من بداية الستينات إلى السبعينات، والتى تنتهى بالموت لكل الأسرة، حتى الأمل الذى تمثل فى الإبنة “إنتصار”. وكأن الشعب المصرى ، لم تستمر فرحته طويلا بإنتصار أكتوبر، فكانت الثغرة، وكان إعلان السادات للسلام. فكانت تمثيلا للتمسك بالموروث المصرى القديم، والذى معه يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان إذا ضحك، ويقدس الموت، الذى هو الحزن. وهو ما يمكن معه القول بفقدان معنى الحياة، والذى معه يمكن ألا يشعر الإنسان بالفرح. ومن هنا يمكن أن نصف “صباح” بانها فقدت الإحساس بالحياة. أو تحكم الماضى (الموروث) فيها.
فإذا كانت الرواية تتحدث عن تاريخ مصر(الحديثة)، أى أنها تتحدث عن البشر، فإننا نستطيع تصور تلك الشخصيات بما عليه الإنسان المصرى. فسنجد أن الجسد تمثله “سنية”. بينما “رضوى” تمثل الروح فيه. أما “صباح” فتمثل فقدان بهجة الحياة. فإذا كان هذا هو الجسد المصرى- أو العربى- فإنه ينقصه (العقل). الذى لعبت عليه “عائدة” ومن وراءها، بالتخيطيط، وحساب كل شئ. فغيرت الشكل التقليدى للاستعمار من الشكل المباشر، إلى الشركات متعددة الجنسيات، ذلك التخطيط الذى استمر نحو 200 عام فى حورشيد. وليس أدل على ذلك من إشارة “عائدة” فى حديث مع “ماهر” بأن الشحنة التى سَتُصَدر إلى إسرائيل، ستصل إلى هدفها، رغم تغيير جهة الوصول-شكليا- إلى “فلسطين”، وكأن الكاتب يريد الإشارة إلى السفن الإسرائيلية التى كانت تعبر من مياء العقبة، وإن كانت تحمل علما غير إسرائيلى، والمصريون لم يعلموا بذلك إلا عندما أُعلن عن غلق الممر قبيل حرب 1967، وهو ما درج عليه عتيبة كثيرا فى روايته، التمويه، والرؤية الخلفية. ومن هنا يمكن أن تشير “عائدة” إلى فكر وتخطيط اليهودى للعودة إلى أرض مصر، وما يمكن الإشارة به إلى.. العقل، الذى يختفى فى الجسد المصرى، ونقطة الضعف فيها، وهو ما لعبت عليه القوى الاستعمارية. والذى لعبه النموذج، “ماهر”.
أما عن النهج الذى استخدمه الكاتب، بتقطيع مسيرة كل شخصية، فى أكثر من فصل من الرواية، فقد أدى ذلك من جانب، إلى خلق التشويق الذى يربط القارئ بالعمل، سعيا وراء استكمال ما قد بدأه، وكأننا أمام مسلسل يقف فى نهاية كل حلقة بشئ، يربط المشاهد، لينتظر ما سيتم. مثلما نجد أن البك- أحمد الجزيرى- وحسين، المصريين، استدعوا “عائدة” اليهودية، والتى ظنت أنها تسير بخطى واثقة، نحو خدعة كل منهما، بِحيلها التى اتفقت عليها مع حبيبها “أبراهام”.. ويفاجآنها، بانهما يعلمان ما تفعل، وأكثر منه، ثم ينتهى الفصل، بترك مصيرها مجهولا، وتركها وحيدة تصرخ تتساءل، عما يمكن أن ينتظرها. وكذلك، سنية تخبر “حسين” أن “عليات” لا تحبه إلا لنجاحه فى العملية الجنسية معها، فيطلب “عليات” للفراش ، ويفشل فى الممارسة معها، يُحضر القطعة التى خبأها فى صندوقه، للاعتقاد السائد أنها تحوى تعويذة الفحولة، ثم يعتلي “عليات” من جديد .. ثم جلس يبكى. دون أن نعلم حقيقة ما حدث، انتظارا لفصل آخر- وقد وصل عتيبة إلى عمق التفكر، أو الموروث المصرى، بالاعتقاد بأن القطع الأثرية، تلعب دورا مهما فى العملية الجنسية، فضلا عن إعتقاده بأن هذه العملية، هى ما يُثبت فحواة الرجل-.
ومن جانب آخر، جعلت هذه الوسيلة- عملية التقطيع- التأرجح فى الزمن، وتقلباته المتعددة، بين الماضى والحاضر، ليصبح الحاضر متجسدا بحضوره الخلفى، متوهما –القارئ- أنه يقرأ من التاريخ عن ما مضى من أحداث. فضلا عن الهروب من سرد التاريخ، بما يمثله من ثقل على القارئ. كما يؤكد أن الكاتب يكتب رواية إبداعية، لا يسرد تاريخا مضى، وتصبح معها الدعوة لتأمل الحاضر، الذى هو ابن للماضى، ونتيجة من نتائجه.
كما نلاحظ أن “حسين” هو الاسم المتكرر فى الماضى، وتقريبا لم يشذ أحد عنه طبقا للتقاليد فيقول والد “رضوى” ل”ماهر” {أن اسمه محمد محمد محمد إلى الجد الأكبر علوانى ، فقد اعتادت العائلة منذ جاءت إلى المنطقة التى أصبحت “خورشيد” تسمية الإبن الأكبر باسم أبيه، يضحك الحاج: ورثت الاسم أبا عن جد، وكأنى الملك فاروق}ص140…
استخدم الكاتب الكثير من الحيل الإبداعية، وصلا لرؤيته الخلفية، مثا استخدام الفانتازيا، واستخدام تداعى المعانى، واستخدام الرمز، فاستطاع أن يبنى الشخصيات ، لتنجح كونها أنسانا من لحم ودم، إلى جانب كونها ترمز إلى شئ بعيد. كما نلحظ ذلك فى شخصية “ماهر” الذى أنقذ الطفل، انقذ المستقبل .. فهو المجتهد ومن لديه إصرار على النجاح، فوصل فى العلم، من لاشئ إلى أن حصل على الماجستير، وتوالت نجاحاته فى الشركة الدولية التى تملكها “عائدة” ويَرفُض أن تخرج الشحنة باسم إسرائيل، ويلتف حوله العمال، فتقرر تغيير الإسم إلى فلسطين، ثم تخبره بأن الرسالة ستصل إلى من قصدته –إسرائيل-. وكأن الكاتب يعنى أن تغيير المستقبل للأفضل .. لن يتم إلا بتغيير الوجوه، بتغير الهوية التى يعبر عنها الإسم، من “حسين أبو حسين” إلى “ماهر”، أى إلى جيل جديد يعتمد على مجهوده، وفعله، وتخطيطه وعلمه. وقد يؤكد تلك الرؤية، موقف الشباب، عند موت “صباح”، التى باتت وحيدة بعد موت ابنها وزوجته وحفيدتها {يخمن البعض أنها ماتت بالكوليرا، ويريدون هدم البيت وحرقه، غير أن الشباب بزعامة “خالد سعيد” ينجحون فى إخراجها من البيت ودفنها}. ويعود الكاتب بالإشارة إلى “خالد سعيد” بذكاء، وتلميح دون تصريح، إلى 25 يناير، بإعتبارها هى الساعية لتكفين (صباح) أو تكفين مصر القديمة، والسعى نحو إنشاء مصر جديدة. وهو الأمر الذى يدفعنا للقول بأن منير عتيبة، كاتب يحترم قارئه. فلا يقدم له الرؤية على طبق، وإنما هو يجعله يشم رائحة الشواء، فيقوم بنفسه لإعداد وجبته. فما لا يجده مباشرة على صفحات الرواية-خاصة للأجيال التى لم تعاصر الحدث- أن يرجع إلى البحث الذى بالضرورة يخرج منه لا بالمعلومة فقط، وإنما بالفائدة الكبيرة فى حياته الفكرية والثقافية.
ومن أهم ما يُحسب للرواية، وما يجعل مقولة أن الرواية أصدق إنباء من التاريخ المصنوع، أن يشير، من خلال شخصية طصباح” إلى ذلك الذى لم تذكره كتب التاريخ، من أنالكثير نت أبناء الشعب المصرى، خاصة أبنا جيل الستينيات، لم يكن استقبالهم لنصر أكتوبر، وبدء عملية السلام، وإنهاء حالة الحروب التى استنذفت الإنسان المصرى، لم يكن استقبالهم إيجابيا، بل كان إتهاما، والعديد من الروايات التى تنتمى لتلك الحقبة، شاهد على ذلك، فاستطاع الكاتب هنا أن يُجسد تلك الرؤية فى شخصية من شخصيات الرواية، دون خطابية.
وفى النهاية، نستطيع القول بأن الاحتكام إلى العقل، الذى يقود للنجاح الذى يمثله “ماهر”. وبالحب ، الروحى، القائم بينه وبين “رضوى” والتى بثت فيه الروح، يمكن طرد الدخيل، وإقامة مصر الحديثة. ف”ماهر” هو من أصر على إصطحاب “رضوى” معه إلى الحفل، و”رضوى” هى من كشفت عن حقيقة “عائدة” بصفتها، فتحولت “عائدة” إلى{محجرين فارغين كجثة، فتشعر رضوى برعدة عند التقاء عينيها بعينى عائدة، فتغمضهما بسرعة، ثم تفتحهما، وصدرها يعلو ويهبط هلعا، ولا تبدأ فى الشعور بالهدوء إلا عندما يجذب أذنيها صفير شاب صغير على الكوبرى يهنئ نفسه بقدرة طائرته الورقية على إسقاط طائرة أخرى فى مياه المحمودية}ص51. وكأن المستقبل قد نجح فى إسقاط العدو فى مياه المحمودية.
كما نستطيع القول، بإطمئنان، بأن منير عتيبة، إستطاع أن يقدم ملحمة عصرية، لتاريخ مصر الحديث، اعتمد فيها على العديد من الأساليب الإبداعية، وأشار فيها إلى روح الشعب، وأحاسيسه، ورؤاه، دون أن يُصرح، فكان إحترامه لذكاء قارئه، وكان قادرا على فتح العديد من الرؤى، حول الرواية، لتضعها فى مصاف الروايات -التاريخية- بمعناها الواقعى، والحقيقى، وليستغى بها القارئ عن ذلك التاريخ المصنوع.
………………………………………………..
* منير عتيبة – نساء المحمودية (التاريخ السرى لخورشيد فى 200 عام)- مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية – 2023.- [i]