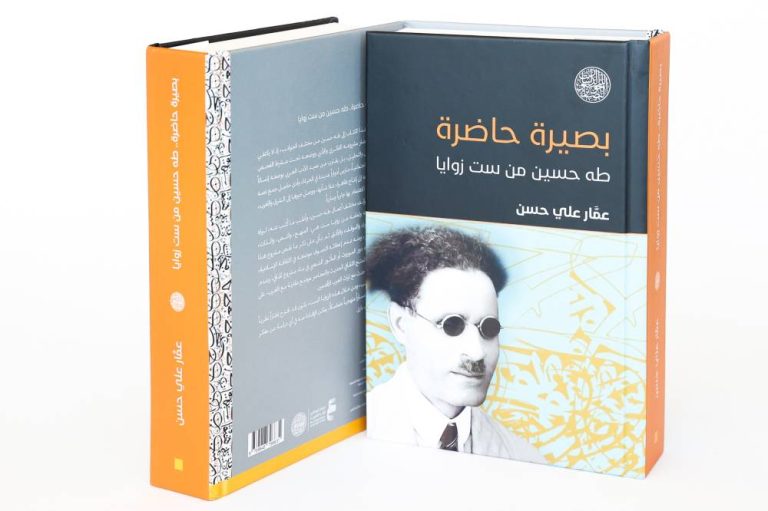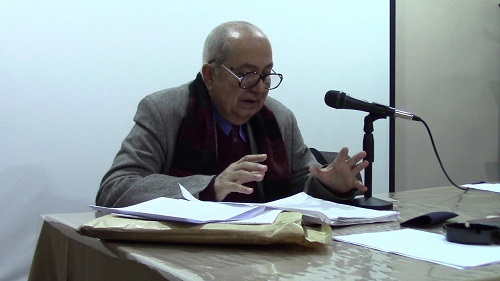هاديا سعيد
لم أرد أن أبحث عمن تكون هذه التي كتبت (صوتي وصورتي هناك) في العدد السادس من “الكاتبة”. اسمها مرَ ولم يستوقفني كي يدعوني لقراءة أو إهمال. وكما يبدو فأنا أكتسب عادة حسنة إذ تسبق القراءة لدي أية نية تحوم حول الكاتب أو الكاتبة، أعني أسمه أو أسمها، بلده أو بلدها، فصيلته دائرته، جماعته، موقفه،.. دينه ودين أهله أو سلالتها. وربما لأني فقدت مثل تلك الشهية أجدني محظوظة أحياناً ببعض اكتشافات اصل إليها واحبها، ربما قبل ان تتحول الى أسماء عامة يتلقفها البريق أو ربما قبل أن تهمل في تجاهل أو كسل بعض نقد يرغب في اللمعان وتبادل انعكاساته.
قادتني قراءتي الأولى للقصص الخمس التي كتبتها مي التلمساني الى دهشة ومتعة، الى تلك المنطقة الخاصة، وتعليقي الأول كان احتفاء يقول ها هي مجلة “الكاتبة” شرعت رحلة ومرحلة جديدتين للقص. ذلك القص المفتوح يقود صوتي في الآخر وصوته فيّ على إيقاع جزئيات الإبداع ويخربط اللحن السائد ويدخل عليه مزحاً من قصة ونفس روائي وقصيدة ومشهد مسرحي ولقطة. فهنا في هذه القصص تلقيت الحالة والزخم والشعر والداخل والآخر وتلقيت شخصية السارد/ الساردة وهي الشخصية التي أرى إنها ستؤسس مملكتنا السعيدة هناك، في توحد الأنوثة والذكورة واكتشاف الجسور التي طالما نسفت بينهما، وخاصة أنوثة النص، أو ذكورته لدى سارد/ راو ذكر أو رواية أنثى.
هنا أيضاً أتوقف لأتذكر هدى بركات بقوة.فهذه المبدعة التي اعتبرها اليوم سيدة القص العربي في التسعينات كانت ومن روايتها حجر الضحك تخترق هذا الفضاء بقوة واندفاع. كانت وكأنها تعلن عن ذلك ” الخراب الجميل” الذي جاء أخيراً.
واقرأ مي التلمساني، يرافقني إحساس مبهم، يذكرني بسومرست موم عندما حاول أن يعبر عن إحساس يرافقه كلما قرأ تشيكوف. ولا اعني هنا بالطبع أن موقعي ومي التلمساني يشبه موقع سومرست موم وتشيكوف. لا قطعاً، لكني أتذكره لأنه كان قد تحدث عن شعور يبقى طويلاً في النفس ولهفة تشده، (شدتني) للمواصلة بنهم وبغياب، بشيء يشوبه الإمساك بخزين في البال في لحظة تجل وبوح نادرتين، ولعل هذا ما ابحث عنه في القص، وما يستهويني كقارئة، على انه لا يلغي اتجاهات اخرى، مثلما لا تغلي الحياة أي عنصر من عناصرنا، على إنها تعلمنا كيف نقبل العطاوات على حساب بعض الخسارات التي لا بد منها.
القصة هنا لا تنسى شرطها الأول وتعريفها الذي يمكن أن يضاف إليه أو يحذف منه دون أن يفقد أسسه وخواصه، وهذه القصص كما قرأتها كانت أمينة لتعريف قدمه سومرست موم وترجمة إحسان عباس ويقول: ” القصة القصيرة قطعة من عمل الخيال لها وحدة في التأثير وتقرأ في جلسة واحدة وأنا أميل إلى القول أن المحك الوحيد لجودتها هو قدرتها على الإمتاع”.
هذا قيل من زمان.ر زمان بعيد، لكني رغم كل القص الذي قرأته واقرأه ومن أي مكان جاء، عبر القصة الفرنسية وتجديدها أو اللاتينية وأساطيرها أو الصينية واليابانية.. فان المتعة، الإمتاع يبقى بالنسبة لي الباب الرئيسي للدخول والاستمرار.
واذهب الى القصص والى عناوينها في البداية، واجد أنها تنويعات، لإيقاع واحد موحد. كأنه يوم بإشارته التي تؤرخ زمنه، وقته، لحظاته على طريقتها: العنوان الأول ” الترصد” وهو يحكي عن حالة ليلية، فيها من الكوابيس والكشف ما يجعل للمناخ لحظة من صوفية اكتشاف. ثم العنوان الثاني ” قطرة من قطرات الغواية”. ويجيء بالنهار. نهار الجسد او الراوي لا فرق. نهار الدنيا أيضاً لا القص يقول ” وتقترب الساعات من نهايتها” ثم نصل الى العنوان الثالث ” أرصفة” ويتجلى هنا لعب يشبه الاحجيات، ويقودنا النص لنبحث عنه وقد توحد بالراوي في المدينة الصاخبة حيث لا مكان لأية حقيقة، لأي داخل يئن وينز بهذا الخارج الصاخب. لذلك يأتي الشعور القوي ” باني رحم في جسد رجل” وعلى ” أطراف المدينة” في العنوان الرابع يأخذني القص إلى أواخر اليوم المنهك المتعب، عندما تقف الجموع بانتظار قطار أو حافلة ليصلني الى مساءات البيوت في العنوان الخامس ” صورتي المتحركة” لأحاول أن أتعرف على ذلك الوطن الصغير المعصور والمتلف داخل الجدران.
تلك كانت هي العناوين، تفرقة على إيقاعات تحت قيادة واحدة هي وحدة الموسيقى، أنها إذن السوناتات في هذا المجال. اما في مجال القص، وقد قلت انه مفتوح على جزئيات الإبداع التي ذكرت فإني أكاد اكتشف الكثير، لكن كل اكتشافي سيظل داخل تلك الظلال من الأحاسيس، تلك التي تبقى في النفس طويلاً، تجعلنا أحياناً ان نهز رؤوسنا. نأسى لأنفسنا، نقول: نعم. نعم. ننتمي نحن أيضا إلى تلك القبيلة حيث العالم يجتز رؤوسنا وحيث الغواية كحيلة، ومكر كان ابيضَ في تراثنا فصار سيئاً وممجاً عندما تم تحويله عن مساره. أقول أيضاً، ودائما بعد تلك القراءة التي تشبه فنجان قهوة لذيذ وشرفة تطل على فضاء يتيح لخيالك ان يمضي الى حيث يشاء، نعم، هو العالم كذلك حولنا. فوق الأرصفة التي تتعارك فيها الخطوات بالأفكار وفي مدينة مدن قد تكون القاهرة أو بيروت أو عمان أو دمشق، بل ربما قد تكون لندن أو تل أبيب أو غزة، وفي البيوت التي يدخلها الوطن من الأغنيات وتعيش هي وطنها، كل يوم، بمآسي صغيرة تتكوم لتصبح قنبلة تتفجر كل ليلة.
هل استطعت أن اقدم مستوى آخر لقراءة؟ أحاول وأيضاً وأنا ابحث في هذا النص، أو القصص الخمس، أو لقصة القصيرة الجميلة بعناوينها الخمسة أن اكتشف السارد الراوي. وتلاعبني الكاتبة هنا لعبة استغماء راقية، هي ماهرة بحجب أي ضمير غائب ومتكلم يتيح لي ان اعرفها أو اعرفه فالصوت هنا يراقب آخر، وأيضاً يراقب داخلاً. هي ثنائية تنفصم في حالات أو عبارات ثم تسرع فتصبح نفسها، والصوت يبحث ويترصد وجوداً ما كائناً او مفهوماً أو نصاً ربما، كان الراوي هو النص الذي يريد أن يتجسد، وابحث فيه عبثاً عن هوية هذا الصوت. جنسه. جنسه بالذات ولا يهمني عمره أو حتى انتماءه الطبقي، فما الذي اكتشفه؟ لا اكتشف بل أتحسس: إنها معالم ذكورة تفسر لي بعد ستة اسطر عندما يقول النص “ملامح رجولته الثلاثة” وإذا ينتهي الترصد باكتشاف مفاجأة (إحساس جديد أسميته قتل الرغبة في المهد) يضعني السارد في المملكة السعيدة، مملكة ذكورة النص وأنوثة الكاتبة، غير ان هذا الترصد الذي انتهى أو توقف هذا بتحسسي لجنس السارد سرعان ما يفلت مني في القصتين التاليتين: قطرة من قطرات الرواية وأرصفة. فهنا تركيز وتكثيف شديدين لحالة ما. حالة تتوازى فيها الأنوثة والذكورة مثلما تتوازى ذراعا السارد أو الساردة مع الجسد في حمى السأم والغواية، قبل وصولها الى الأرصفة تقدم لها لغتها ملغومة بذلك الذكوري والأنثوي. فمن هو هي في صوت النص؟ اهو الذكر الذي يقول (يمر نصفي من الفتحة الضيقة ويصمد نصفي الآخر أمام الغواية) أم هي الأنثى عندما تقول (تمر أصابعي متمهلة بين خصلات شعري، أو (أحرك أصابع قدمي أحرك لساني داخل حلقي الجاف) ولا أريد هنا أن اعتمد أسس فرويد في التحليل النفسي للإبداع ولا الإنشقاقات التي توزعت منه واطلعنا عليها وتعلمنا منها مع بارت وجونيت وسواهما، فهذا ليس مجالي ولا غرضي، لكن النص بكثافته وقدرته يحتمل الكثير من تأويل وكشف انطلاقاً من مفاهيم حديثة عدة، في الإبداع وفي النقد.
ولعل “أطراف المدينة” وحدها تقدم لي “الأنثى” هنا بوضوح فالصوت الذي نكتشف انه لفتاة تتكئ على ذراع شاب وتبادله القبلات أثناء انتظار القطار ظل في معظم الناس يتحدث بشبه هموم أو بشيء من الحياد ما بين منطقتي الذكورة والأنوثة ورغم أن الساردة أعلنت وجودها من السطر الأول (وانتظرت نقطة ضوء وحيدة) غير أن هذا الوجود كان يمكن ان يشتبه أيضاً بالضوء ثم يتلبس تلك اللعبة التي تراوح الضوء والظل عندما يتحدث الصوت عن الناس الذين ينتظرون في المحطة وتهيؤاتها حول أصحاب العوائم وحالات الاختصاب والخوف من ومما يحيط بها ومن الأفكار التي طافت برأسها. وهذه الأنثى أيضاً تصل بشيء من الوضوح-ولكنه الوضوح الذي يحتمل تأويلات شتى-مع آخر القصص “صورتي المتحركة” والتي تنفلش على قمة النصوص موصلة نفسها وقارئها للذروة وهي هنا النهايات ونهايات اليوم والحالة الشعورية ونهايات الأوطان في أزمنة البؤس والإحباط والرحيل والأناشيد.
لعلنا في المرحلة والمرحلة، والتي تنتمي هذه القصص لها بامتياز نستطيع ان نلغي اللغة من مرجعيتها بالنسبة لجنس حاملها. فهذا الشعار:صوتي في الآخر وصوته فيّ وتجلى هنا وبدءاً بعد زيادة-هدى بركات- بلغة متدفقة، لا تدخل العاطفة والنعومة وكل ما اصطلح على تجييره لخانات الانوثة، في الرحم المختلي بنفسه والفائر بأعماقه، كما إنها لا تطلق الشراسة والخشونة وانغمارها بالخارج (الدنيا والمعركة والرصيف) وكل ما فهم تاريخياً على انه ذكورة، مثل إيلاج عضو أو انبثاق نظف، فلا حدود هنا للغة التأنيث والتذكير. ليس هو صوت المرأة الرقيق الضعيف ولا صوت الرجل الخشن، وبالطبع ليس الأمر بهذا التحديد السطحي، غير إننا-وللأسف- فطمنا على كثير مما يشبه هذا التحديد أو يقترب منه عندما قرأنا كثيراً وطويلاً عن لغة الكاتب /الكاتبات الشفافة والعذبة والتي لا تخلو من رقة ودماثة ونعومة. وحتى لغة غادة السمان بحفرها وشراستها ظلت -كما قيل- أنثوية رغم مخاطبتها الآفاق الشاسعة.
هذه لغة هنا، مغايرة، شعرية كقصيدة عندما تبدأ هكذا (أو كالحب الذي تضيع ملامحه في طيات لحظات تمر هكذا كالآخرين” وهي لقطة سينمائية عندما تقول “أو كالحب الذي يتسلل الى أحد الجدران المحيطة يحفر عليه أسماء وقلوباً ساذجة” وهي “علمية” واضحة وموضحة عندما تعبر “لكني لم احفل بالرقبة. التي هي سر الحياة” لكنها لغة التشريح ما بين أسطورة الذكورة والأنوثة وتجليهما المعاصر. ولعل هذا ما تساءلت عنه في قصة أرصفة فهل هذه لغة الرجل الذي يقول: “فتحت أزرار قميصي وتلقيت فوق صدري ساقيها” أم هي لغة المرأة التي تقول “واحدث نفسي في انعكاس صورتي على الزجاج النظيف أمام الثوب الصامت”.
هي اللغتان كما يبدو. الأنثى والذكر، فوق جسر النص أو النص المفتوح هذا النص الذي يدخل آمناً في التسعينات. في مملكتنا نحن الذين نحب أن نجد وطننا المذيع هناك.
كنت أود التوقف لولا هذا الذي قفز على التو الى رأسي. لماذا قرأت في قصة أرصفة مثل هذه العبارة الأخيرة وكانت على لسان سارد رجل: “يجتاحني شعور قوي باني رحم في جسد رجل، يولد من ذاته كل مساء ضيق”. وحدها هذه العبارة التي كنت تلقيتها باحتفاء عادت الى رأسي الآن متململة. لماذا؟ هل لان الكاتبة امرأة، مثلي وهل لأني لست على ثقة بعد أن الرجل يشعر حقاً هكذا؟ لا ادري.