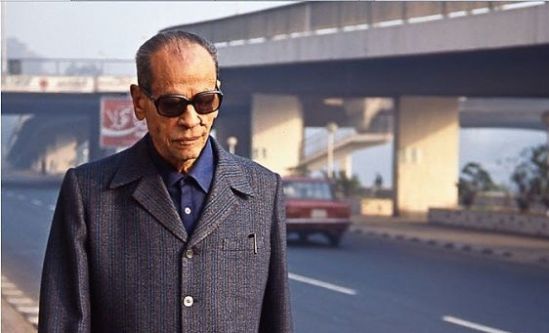حاورتها: صحيفة العرب
كتاب “الحارة في السينما المصرية” لمي التلمساني هو ترجمة منقحة لرسالة الدكتوراه التي حصلت عليها الباحثة المصرية من جامعة مونتريال في كندا، وقد كتبت الرسالة بين عامي 2001 و2004، وتمت مناقشتها عام 2005، ثم صدرت في كتاب باللغة الفرنسية عام 2011 عن دار نشر ألمانية تحت عنوان “الحارة في السينما المصرية: الحي الشعبي والهوية القومية”.
“العرب” التقت مي التلمساني على هامش الندوة التي أقامتها لها مكتبة الكتب خان في القاهرة لمناقشة الكتاب والاحتفاء بصدوره، هنا تتحدث التلمساني عن ظروف العمل في الدراسة، وعن نتائجها والصعاب التي واجهتها أثناء البحث.
تبرر مي أن هذه الأطروحة تمت مناقشتها والعمل عليها في كندا، وليس في مصر، رغم أنها حول السينما المصرية فتقول “إن العمل على رسالة دكتوراه من هذا النوع في جامعة القاهرة بدا مستحيلا، كان ينبغي أن أكون محددة في تخصصي فقط، أي الأدب المقارن، لم يكن مسموحا لي الاشتغال على نصوص سينمائية داخل بحثي. فحين تم رفض الفكرة في جامعة القاهرة، تمكنت من الحصول على منحة للعمل عليها في كندا، وهناك بدأت في إنجازها بالطريقة التي أردتها”.
أتيح للتلمساني في بحثها الأكاديمي أن تربط الفكرة بالفلسفة، وهذا الأمر منحها مقدرة أوسع على الاقتراب من فهم المكان، كما استخدمت مناهج علم الاجتماع التي ساعدتها في البحث داخل فكرة الهوية وطريقة تشكلها.
أما عن سبب اختيار الحارة تحديدا لدراستها أكاديميا في السينما، فتقول “الحارة ترتبط بقيم اجتماعية معينة مثل فكرة الترابط، وأهمية الحارة كمكان أساسي يشكل أهم ملامح الهوية القومية ليست فكرة مصرية فقط، أثناء تدريسي بالجامعة ألجأ إلى مشاهدة أفلام عن الحارة من كافة الجنسيات كوسيلة للاقتراب من سمات هوية هذه الدول. فكرة الحارة وعلاقتها بالهوية، لها أيضا جذور في كتابات الجبرتي التاريخية، وإلى وقت قريب كانت قيد التناول في مسلسلات أنور عكاشة التلفزيونية على سبيل المثال”.
الفترة التي يتناولها الكتاب بحثيا هي من العام 1939 وحتى العام 2001، هذا الإطار التاريخي تشرحه مي: 1939 هو تاريخ إنتاج فيلم “العزيمة” لكمال سليم وهو أول فيلم واقعي، كما اتفقت معظم كتب السينما المصرية، هو ليس أول عمل سينمائي يتناول الحي الشعبي فهناك قبله فيلم “المعلم بحبح” 1937، و”لاشين” 1939.
وفي المقابل يمثل “العزيمة” أول وعي سينمائي بالحي الشعبي بوصفه المكان الأصل الذي تتجلى فيه الشخصية المصرية، وذلك في مقابل الأحياء السكنية الجديدة التي يطغى عليها الطابع الأوروبي. أما سبب توقف الدراسة عند العام 2001، فهو العام الذي رحلت فيه مي عن مصر إلى كندا ولم يعد بإمكانها متابعة الجديد في السينما.
الاستعراض السريع لأفلام الحارة في السينما المصرية ربما يشير إلى تكريس أفكار نمطية في ما يتعلق بالهوية تحديدا، هنا لدينا نمط لما يعرف بـ”ابن البلد” الذي يتمسك بقيم الحارة، ونقيضه الذي يتخلى عنها ومن ثمة يتعرض للنبذ والعقاب.
تقول مي: في أفلام سينمائية عديدة، يصبح من يخرج من الحارة هو شخص ملعون سقط في الغواية، بينما الخير في الالتزام بمبادئ الحارة، ويمكن النظر إلى شخصية حميدة في “زقاق المدق” كأفضل مثال على ذلك، حميدة سقطت في الغواية منذ أن طمحت إلى الخروج من الحارة، وسوف يكون الموت هو عقابها النهائي. وتسترسل مي: هناك أيضا نموذج نقيض تم التكريس له، ابن الباشا الذي يعيش وفقا للأفكار الأوروبية، وهو على نحو ما خائن وليس ابن بلد، طبعا هناك أفلام خرجت عن هذا الإطار، أفلام سعت إلى هدم النمط تماما مثل فيلم “الجوع” لعلي بدرخان، حيث الصراعات تدور بالكامل داخل الحارة التي هي ليست أرضا مقدسة.
الأدب ربما يكون له دور في تكريس هذه النظرة، إذ لا يمكن تجاهل أن عددا كبيرا من أفلام السينما المصرية القديمة مأخوذ عن أصول أدبية، ومن أشهرها في تناول الحارة أعمال لنجيب محفوظ تحديدا.
تعلّق مي: الأدب كان له دور بالطبع، كاتب مثل نجيب محفوظ له بصمة واضحة، وهنا يمكن الإشارة إلى وجهين لنجيب محفوظ، أحدهما محفوظ الكاتب المستنير جدا، ويكفي التذكير بشخصية المعلم المثلي في رواية “زقاق المدق” عام 1946، ولدينا أيضا محفوظ كاتب السيناريو، هنا بدا محفوظ متحفظا جدا، ويكفي فيلم “شباب امرأة” كمثال على هذا التحفظ.
مع ذلك هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها، وهي أن دور الأدب في تكريس أيّ من الأفكار النمطية من عدمه في ما يتعلق بالحارة يعود أساسا إلى طريقة المعالجة التي يرتئيها صناع الفيلم للأصل الأدبي، إن رواية مثل “الحرافيش” تمّ استلهامها مرتين، مرة في فيلم داخل النمط وهو “التوت والنبوت”، ومرة في فيلم خارج النمط وهو “الجوع”.
التنميط الذي لحق بدور المرأة في السينما المصرية لا يمكن تجاهل فداحته، هنا تلعب أفلام الحارة دورا في تنميط المرأة داخل الحارة خصوصا، تشرح مي: هناك تصوّر ما عن المرأة كان يتم فرضه في الأفلام التي ظلت داخل النمط الفكري المحدود هذا، مثلا في فيلم “المظاهر” لكمال سليم، تتخذ البطلة قرارا بالخروج من الحارة والتمرد على قيودها، فتذهب للعيش داخل قصر الباشا حيث الحياة منحلة تقريبا، هذه الفكرة نفسها لا يزال يمكن العثور عليها حتى الآن في أعمال سينمائية.
وتوضح التلمساني: المرأة إذن في سينما الحارة هي إما بنت حلال تقنع بالحياة في الحارة ووفقا لقيمها، وإما ساقطة في غواية الخروج منها، بالطبع هناك تجارب سينمائية تتمرد على هذين النمطين، لدينا على سبيل المثال في سينما الثمانينات فيلم “الكيت كات” لداود عبدالسيد، حيث تتقدم امرأة مطلقة متحررة بشكل غير منفر إنما حنون ومختلف. سمة التعميم بشكل عام ليست لصيقة بالسينما المصرية فقط، إنها حاضرة وبقوة في سينما مثل هوليوود.
السؤال الآن هل حدثت تغيّرات عميقة في هذه الصورة السينمائية التي يتمّ تقديمها عن الحارة بعد عام 2001؟ تجيب مي: بدءا من العام 2001 لم أعد أتابع السينما المصرية بانتظام بسبب سفري، لكن الملاحظة العامة تشي بأن السينما المصرية لم تعد قادرة على تقديم شيء طليعي كما استطاعت أن تقدم من قبل في فيلم “العزيمة” مثلا، الآن هناك إعادة إنتاج لأفلام داخل نمط فكري وتجاري أحادي، هذا العصر أيضا لم يعد عصر أفلام الحارة، وإذا نظرنا إلى فيلم مثل “سارق الفرح” لن نجد حارة حقيقية إنما شيء يشبه الحارة.
بالطبع واجهت مي عدة صعوبات أثناء العمل على هذه الرسالة أهمها قلة المراجع، تحكي مي “معظم الدراسات السينمائية المصرية هي دراسات صحفية لم تستطع أن تساعدني بشكل كامل، الدراسات الأكاديمية قليلة جدا، لكن النقاد الكبار قدموا لي إضاءات بحجم المعلومات الهائلة التي يعرفونها، عموما أتمنى أن يساعد صدور هذا الكتاب بالعربية في فتح الباب لاستكمال هذا البحث، والعمل على أبحاث أخرى تخص السينما”.