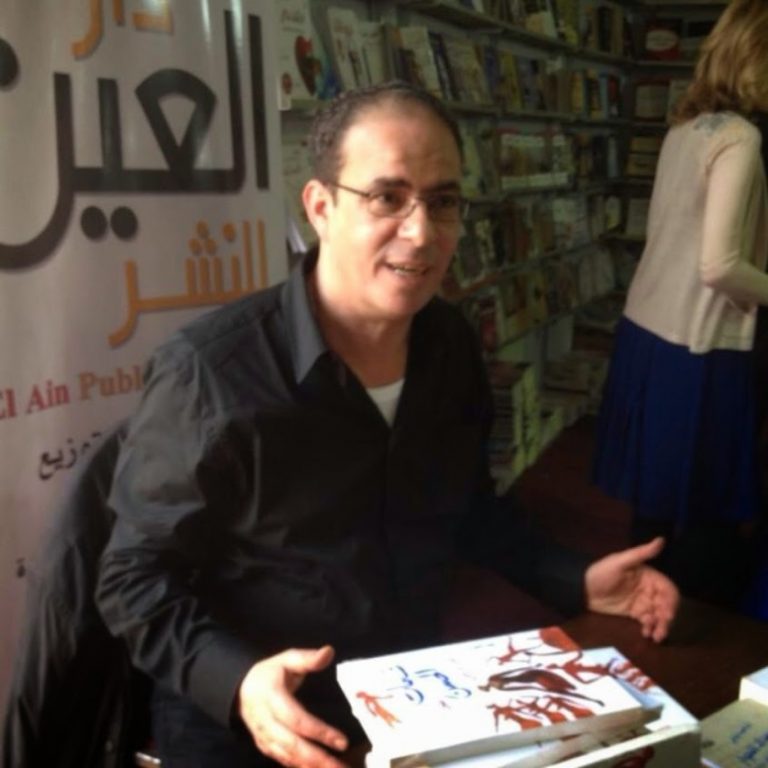حاورتها: سعيدة شريف
تعد الكاتبة الروائية مي التلمساني احدى أبرز الكاتبات الشابات بمصر أو ما يصطلح عليه “أدب التسعينات” الى جانب نورا أمين وميرال الطحاوي ومنتصر القفاش ومصطفى ذكري. وترجمت روايتها “دنيازاد” الصادرة عام 1997 إلى ست لغات وحصلت على جوائز، أبرزها جائزة “آرت مار” لأفضل عمل أول في البحر الأبيض المتوسط من مهرجان باستيا بجنوب فرنسا عن الترجمة الفرنسية لروايتها عام 2001، وجائزة الدولة التشجيعية لأدب السيرة الذاتية من وزارة الثقافة المصرية عن نفس الرواية عام 2002.
والى جانب الرواية فإنها تكتب القصة أيضا ومن مجموعاتها القصصية: “نحت متكرر” 1995، “خيانات ذهنية” 1999، وآخر أعمالها الروائية هي رواية “هليوبوليس”. كما أن لها دراسات وترجمات منها: “السينما العربية من الخليج الى المحيط” 1994، “فؤاد التهامي وزهرة المستحيل” 1995، “لماذا نقرأ الأدب الكلاسيكي” 1999 و”المدارس الجمالية الكبرى”2001.
هنا حوار معها أجري في الرباط على هامش ندوة “الرواية العربية في نهاية القرن”:
* تنتمين الى الجيل الجديد من الكتابة الروائية العربية في مصر أي جيل التسعينات مع منتصر القفاش، نورا أمين، ميرال الطحاوي ومصطفى ذكري. كيف دخلت عالم الكتابة؟
ـ أنا بدأت الكتابة مع بداية التسعينات، فأنا من مواليد 1965. حينما بدأت الكتابة كنت أقيم في باريس، وكانت الكتابة مرحلة غريبة في حياتي في البداية، لأنني لم أكن أدرك أنها ستشكل مسارا مهما في حياتي. فقد كنت في باريس من أجل اعداد أبحاث لرسالة ماجستير عن مارسيل بروست، وهو الكاتب الفرنسي الشهير أبو الرواية الفرنسية في القرن العشرين. فقد وجدت نفسي فجأة أكتب بمنطق التواصل مع اللغة العربية بصفة عامة، وكأنني أقاوم بشكل أو بآخر وجودي في المجتمع الفرنسي، وكان ذلك إبان حرب الخليج. أصبحت الكتابة لدي فيما بعد هي المساحة الوحيدة الممكنة بالنسبة لي للتعبير ولممارسة حرياتي وبعض الجنون والنزق دون أن أكون مضطرة للتواصل مع الآخرين. التواصل يأتي فيما بعد عندما ينشر فعليا الكتاب ويصبح له قراء. لكن لحظة الكتابة في حد ذاتها هي لحظة حميمة وهي لحظة عزلة وانسحاب. وأعتقد أن من حق الانسان في هذا العالم المجنون القبيح الذي نعيش فيه أن ينسحب الى غرفته ويترك لنفسه فرصة تأمل ما يحدث، وربما الخروج من أسر الواقع الى خيال أوسع من اختناق الواقع المعيش سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الانساني والعالمي. فالكتابة إذن أتاحت لي هذه الفرصة في بعض الأحيان، وفي بداياتي كنت أقول، وأنا أضحك، الكتابة بديل للطبيب النفسي، وقد كانت هذه نكتة وما زلت أعتبرها كذلك، ولكن الهاجس الذي يختفي وراء هذه الفكرة هو فكرة التحرر، فإذا آمنت بأن الكتابة هي فعل تحرر فلا أحتاج لأحد.
* هل نستطيع، إذن، أن نتحدث عن “مضمون أنثوي” في كتاباتك؟
ـ عندما أكتب لا أتصور أنني امرأة عربية على الاطلاق، ولا أتصور نفسي في هذا الاطار. فأنا كما سبق وقلت امرأة بألف وجه، فتربيتي في مدارس الراهبات الفرنسية وأنا مسلمة، والتلاقح بين الثقافتين العربية والفرنسية على مدار سنوات التكوين سواء في الدراسة أو حضور المؤتمرات واللقاءات. احساسي بأن المرأة العربية في حاجة الى بوح يرتبط مرة أخرى بفكرة الطبيب النفسي التي ذكرتها سالفا. بمعنى أنها قشرة خارجية ولكن ما وراء هذه القشرة أعمق بكثير. نحن بحاجة الى التثوير(من الثورة) والتطوير والتمرد على أطر فنية وضعت فيها الرواية العربية منذ بدايتها، والهاجس الفني هو الملح بغض النظر عن كون الكاتب رجلا أو امرأة. أعتقد أننا كجيل نتصور أن لنا مكانا على خريطة الرواية العالمية، وأن هذا المكان يجب أن نصل اليه بأعمال أدبية تناطح فنيا وليس جوهريا أو مضمونيا الأعمال الكبرى. ففكرة انطلاق الرواية من المحلية الى العالمية فكرة أسخر منها فعليا، لأنها تسجن الأدب مرة أخرى في المضمون، ومهما كان هذا المضمون سواء كان انثويا بمعنى الدفاع عن حرية المرأة. فأنا حصلت على حريتي فعلا، فعما أدافع؟!. إذا كنت أتحدث عن تجربة خاصة فلست بحاجة للدفاع عن حريتي لأنني فعلا امرأة حرة، فلماذا أجد نفسي مضطرة في بعض الأحيان للدفاع عن حرية الفلاحة المصرية وهو عالم لا أعرفه على الاطلاق. فكيف أدعي الصدق في الكتابة على سبيل المثال وأنا لا أعرف شيئا عن العالم الذي أكتب عنه.
* غالبا ما تدرج كتابة المرأة في صنف السيرة الذاتية أو الكتابة المتمحورة حول الذات. كيف تجدين هذا التصنيف؟
ـ في عام 1995 كتبت دراسة بعنوان “الكتابة على هامش التاريخ: مصر الغياب” عملت فيها على تحليل بعض الأعمال الأدبية الروائية والشعرية في كتابة التسعينات بمصر أو ما سمي بالجيل الجديد أو الحساسية الجديدة. فوجدت أن الملمح الرئيسي في هذه الكتابة سواء كانت لرجل أو امرأة هو ملمح الاستعانة بالخبرة الذاتية في الكتابة سواء كانت سيرة ذاتية واضحة أو رواية سيرة ذاتية، بمعنى أنه يختلط فيها التخييل بوقائع حقيقية من حياة الكاتب. وفي النهاية فالخبرة الذاتية تعتبر منطلقا رئيسيا للعمل كمضمون. كما أن هناك كتابا حتى وإن انطلقوا مضمونيا من الخبرة الذاتية فهم صنعوا أدبا روائيا يطرح نماذج في البناء مختلفة تماما عما تعودنا عليه سواء في التعامل مع الزمان والمكان الروائي، أو في التعامل مع الشخصيات التي تعبر عن تجرية ذاتية كمضمون ولكنها تعبر عن ذلك بشكل متشظ وفيه تفكك كبير.
هذا التفكك في حد ذاته مطلب وهاجس يلح على الكاتب وهو يكتب. لا يستطيع الكاتب اليوم أن يكتب كما كان يكتب منذ خمسين عاما روايات طويلة. فالروايات اليوم أقصر بكثير، حيث لا نجد روايات بـ500 صفحة أو خماسيات وثلاثيات كما نجد عند الكتاب العرب الكبار الذين أكن لهم كل الاحترام. ولكن هناك اختلافاً كبيراً بين هذه الأجيال حتى على مستوى تشكيل العمل الأدبي نفسه، والذي يظهر بشكل كبير لدى كتاب التسعينات الذين تميزوا بالنهل من سيرهم الذاتية.
* كيف تنظرين إلى استجابات النقاد والقراء لكتاباتك وكتابات أبناء جيلك؟
ـ هناك حادثة أذكرها دائما تتعلق برواية “دنيازاد” التي نشرت لي عام 1997. ففي أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة كنت مدعوة للقاء حول هذه الرواية، ففوجئت بأن العديد من المدعوين لم يحصلوا عليها نظرا لثمنها المرتفع، وفضلوا استعارتها من مكتبة الحي، وقرأتها مجموعة كبيرة بالتناوب. أحد القراء طرح مسألة الغموض بمعنى أن الزمن لم يكن بتسلسله المعتاد بشكل خطي في الرواية، وقال إنه اضطر لقراءة الفصل الأول لعدة مرات ليعيد تركيب الأحداث في هذا الفصل. وفعلا لقد كنت أسعد شخص في هذا اللقاء لأن معنى ذلك أن نصي هذا أتاح للقارئ فرصة أن يبدع بنفسه شيئا جديدا، فقد اقترحت عليه ترتيبا زمنيا في النص، وهو ترتيب غير خطي. فالمجهود الذي قام به هذا القارئ لاعادة تركيب النص واعادة قراءته لفهمه يجعل من هذا القارئ مبدعا. الغموض في حد ذاته ليس صفة سيئة بل هو وسيلة لتعميق العلاقة بين الكاتب والقارىء وفتحه على آفاق مختلفة.
* ما هي العناصر الأساسية التي ترتكز عليها هذه الكتابات الجديدة؟
ـ هناك ثلاثة ملامح أساسية أجدها في هذه الكتابات الروائية والشعرية الى حد كبير. الملمح الأول هو النهل من السيرة الذاتية أو مضمون الخبرة الذاتية لدى الكاتب، والملمح الثاني هو أن الكاتب لا يبحث عن القيام بدور تنويري في المجتمع أو المعلم كما كان يبحث عنه بعض الكتاب السابقين، وإنما تحاول الكتابة الجديدة، من خلال إشراك مع القارئ، التعرف على تجاربه الذاتية وعلى إحساسه بالزمن وبالمكان الذي يعيش فيه، وتحاول أن تتواصل مع هذا القارىء بغض النظر عما يمكن أن ينتجه هذا التواصل من تغيير.
التغيير الرئيسي المطروح هو تغيير مفهوم القراءة وتغيير فهم القارئ للنص الأدبي ولمدلولاته. أما الملمح الثالث فهو تداخل العديد من العناصر الفنية في العمل الأدبي والاشارة الى السينما بشكل عام كأحد المرجعيات الرئيسية، لأن الكاتب اليوم يقضي جزءا من يومه في القراءة ومشاهدة الأفلام والاطلاع على التلفزيون، على عكس الكاتب منذ خمسين سنة الذي كان يقضي كل وقته في القراءة. فالمرجعية البصرية أصبحت سمة من السمات المميزة لهذا الجيل وتطرح نفسها بقوة حتى من خلال المضمون كالاشارة للممثلين وللأفلام والاستعانة بالمونتاج والتوليف السينمائي. وتلك ملامح نجدها في كتابات كل من: مصطفى ذكري ومنتصرالقفاش وهما ربما من أفضل الكتاب في هذا الجيل.
* ما هي الاضافات التي حققتها مثل هذه الكتابة للسرد الروائي العربي؟
ـ أولا لقد أضافت هذه الكتابة الجديدة شكلا جديدا للبناء الروائي الذي لا يعتمد على الخطية لا في الزمان ولا في المكان. فمن السهل جدا أن نجد في النص الجديد مثل “مرآة 202” لمصطفى ذكري فقرات منفصلة تماما وتحدث في أماكن وأزمنة مختلفة ومتجاورة. بمعنى أن تشكيل الرواية في حد ذاته لا يعتمد على الاطلاق على خطوط الوصل المعتادة التي كانت تسمح بالشفافية في النصوص الكلاسيكية بصفة عامة. ما يريد أن يصل اليه الكاتب الجديد هو مساحة أكبر من الدهشة أمام كل نص أو كل نص لا يخضع بالضرورة لوصفة جاهزة. فمثلا في أعمال مصطفى ذكري أو منتصر القفاش نجد هذا التجاور بين مشاهد مختلفة تدور في أزمنة مختلفة وتستدعي ذاكرة مختلفة، كما لو أننا داخل متاهة، لأن كل ممر من هذه المتاهة ينفتح على عالم جديد ويسمح بفقرة جديدة. مصطفى ذكري يستعيد نفس الفقرات التي كتبها خلال النص في مواقع أخرى من نفس النص وكأنه يعود الى نفس الحائط الذي يصطدم به منذ الصفحات الأولى في المتاهة التي يبتكرها. النص الجديد نفسه ينبني وكأنه متاهة ونوع من الدهاليز والمرايا المنعكسة، مما يسمح للفقرة بأن تعود مرة أخرى، ويعود بالتالي البطل الى نفس الممر مرة أخرى ليكتشف فيه أشياء جديدة، وكلما قرأنا الفقرة على ضوء السياق المختلف الذي تظهر فيه اكتشفنا أبعادا جديدة لنفس الفقرة. إذن التفاصيل هنا مهمة جدا لأن نفس التفاصيل عندما ترد في مواقع مختلفة من النص تفتح القارىء على عالم التشكيل التكعيبي. وهذا يتطلب من القارئ مجهودا للاحاطة بالنص، لأن الكاتب الجديد يقلب زمن النص الروائي ويعيد استخدامه بأشكال مختلفة داخل العمل الواحد. وهذا يدل على أن هناك لعبة ما يحاول الكاتب أن ينسجها مع القارئ، وهي لعبة تسمح بمساحة من الدهشة والتشويق، حيث يحاول القارئ دائما فض بكارة هذه اللعبة ومعرفة مخرج هذا الدهليز أو المتاهة. وهنا أقول أنه يجب أن نعيد للأدب مساحة اللعب التي كان يتحدث عنها كتاب كثيرون من أميركا اللاتينية.
* عرفت مي التلمساني في العالم العربي من خلال روايتها “دنيازاد” التي استقبلت بشكل جيد، ونالت جوائز عديدة، وهي رواية نابعة من تجربة شخصية. هل فاجأك هذا الاقبال على الرواية؟ هل تعزينه لشيء محدد؟ ألم يخفك هذا التقبل، إذ من الممكن أن يظل إسم الكاتب أو الكاتبة مقروناً بعمل واحد يتحول إلى سجن له كما حصل مع بعض الكتاب العرب والأجانب؟
ـ على مستوى النقد، قد حظيت رواية “دنيازاد” بالانتشار الواسع وبالمدح الكثير من قبل النقاد في مصر والعالم العربي، وكانت هذه في حد ذاتها مفاجأة سارة لي، خاصة أني كتبت الرواية بعد الحادث مباشرة، فوضعتها في الدرج لمدة عامين قبل أن أجرأ على نشرها. وكنت أعتقد أن تجربة ذاتية كتجربة أم تفقد ابنتها لحظة الولادة تجربة لا تخص أحدا ولا تهم أي قارئ. وإذا بي أندهش لأن هذه التجربة الحميمة أو الخاصة عندما صيغت صياغة روائية لقيت اهتماما من طرف نقاد كثيرين بسبب فرادتها. وقد قال عنها الدكتور علي الراعي الناقد المصري المعروف في مقال له بصحيفة الأهرام أن هذه الرواية تمثل تجربة فريدة لا يمكن أن تكتب عنها إلا امرأة، لأن المرأة هي التي تلد وتشعر بألم الفقد بهذا المعنى. وقد كنت سعيدة بهذا الاستقبال للرواية وكنت أسعد بمشاركة هذه التجربة على المستوى العالمي من خلال ترجمة هذا العمل الى ست لغات أجنبية، حيث سافرت الى هذه البلدان التي ترجمت العمل (فرنسا، هولندا، ألمانيا، أميركا…)، وكانت فرصة الترجمة هي فرصة اللقاء بجمهور مختلف عن الجمهور العربي. وقد تبين لي أن التجربة الانسانية هي التي فرضت نفسها على الثقافات المختلفة وهي التي أتاحت لهذه الرواية فرصة الانتشار الواسع، وهو الأمر الذي يرتبط بفكرتي السابقة التي أرفض فيها الانطلاق من المحلية الى العالمية، فتجربتي في هذا العمل هي تجربة انسانية لا علاقة لها بالواقع المحلي المصري، ومع ذلك حظيت بالاقبال الكبير.
وبكل تأكيد فقد أخافني هذا الأمر بشكل كبير، وهو ما جعلني أتريث في الكتابة وفي نشر الرواية التالية لـ”دنيازاد” وهي رواية “هليوبوليس” التي لم أنشرها إلا بعد مرور ثلاث سنوات. لقد كنت أتخوف بشكل خاص من الوصفة. فإذا كانت وصفة “دنيازاد” قد نجحت فإنه علي أن أتجاوز هذه الوصفة، لأنني لا أريد أن أكرر نفسي، ولا أسمح لنفسي ككاتبة بتكرار التجربة التي تخص كتابتي، لأنني أعتقد أن في التكرار نضوباً وفقراً شديداً. لذلك فرواية “هليوبوليس” مختلفة تماما عن رواية “دنيازاد” سواء في منطلقاتها الانسانية والفكرية والفلسفية والانسانية أوحتى في استلهام الحدوثة. ربما ترتبط الروايتان بانطلاقهما من فكرة القصة القصيرة، وكأن المشهد هو العنصر الرئيسي في بناء الرواية بشكل عام، ولكن ما عدا ذلك فالروايتان تختلفان جذريا. وهنا أعتقد أنني نجحت الى حد ما في تجاوز نجاح “دنيازاد” الى نجاح آخر بشكل مغاير ـ ربما ـ في رواية “هليوبوليس”.
* شاركت في ندوة “الرواية العربية في نهاية القرن” بالرباط على الرغم من الضجة التي أثيرت حول اعتذار بعض المثقفين والكتاب المصريين بسبب مسألة التطبيع مع اسرائيل، فما موقفك من هذا الأمر؟
ـ موقفي ينسجم تماما مع ما أقول دائما عن علاقة الفن بالسياسة، فقد دأب كثير من الكتاب على الربط القسري بينهما، واعتبروا أن للفن دورا أساسيا في تغيير العالم. وأنا لا أعتقد ذلك، فالرواية تطبع منها 1000 نسخة في مجتمع عربي يضم 200 مليون فرد. فماذا يمكن أن تغيره 1000 نسخة في 200 مليون فرد مثلا؟. أعتقد أن هذا من باب الجنون، ففكرة أن ينسب الكاتب لنفسه دورا نضاليا بالضرورة وتنويريا، فكرة مضحكة، لأن الكاتب له دور محصور في فئة من المثقفين. المثقفون يقرأون للمثقفين، والصحف التي تنشر بها كتابات نقدية أو غيرها نقرأها نحن ولا تغير في المجتمع شيئا، وبالتالي فإن التعبير عن مواقف نضالية من خلال الأدب فيه خلط شديد. ولذلك ما زلت أعتقد أن بامكان الكاتب أن يكتب في عزلته ويبحث عن الفن وعن الجمال من خلال النص الروائي وهذا نشاط منفصل تماما عن خروجه الى المظاهرات أو المشاركة في النضال السياسي أو اشتراكه في أحزاب تنادي بتغيير المجتمع. أعتقد أن النشاطين منفصلان تماما عن بعضهما البعض.
……………….
*نشر في الشرق الأوسط