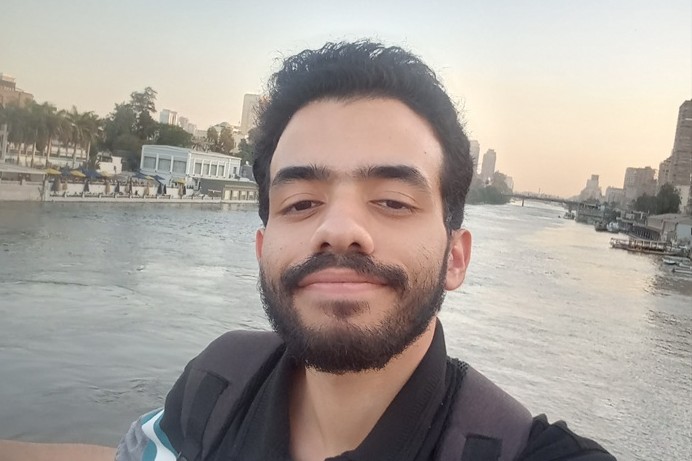تذكرتُ في وقفتي تلك مديري في أول عملٍ تسلَّمته، كان رجلاً حازمًا جدًّا ومهيبًا رغم أنه لم يكن طويل القامة، وكان هذا غريبًا بالنسبة لي لأنه كان عميدًا متقاعدًا. لم يكن يتحدث كثيرًا عن زوجته السابقة، لكن حقيقة كونها ممثلةً رقيقة اشتهرت في الثمانينيات لم تكن تخفى على أحد، فكان العاملون معه أحيانًا ما يجرُّونه للحديث عنها. حكى مرة أنه كان يشتري بنفسه كل لوازم بيته فلم يكن ينقصه شيء، وتذمرتْ زوجته لأنها كانت ترغب في التسوق مثل كل النساء، فاصطحبها إلى متجرٍ ضخم، وكلما توقفتْ أمام غرضٍ ما تذكرت أنه موجودٌ في المنزل بوفرة. وحتى لا تخرج بعربة التسوق فارغة، وضعتْ فيها شَبَكَة ليمون.
لماذا يصعب على الرجال إلى هذا الحد فهم الدوافع الشرائية للمرأة؟ ألهذا تركته؟ أو تركها؟!
لدي في درج الخضروات في ثلاجتي كيلو من الليمون.
وضعتُ في السلة عبوَّتين من الموكا، إكرامًا للونها البنفسجي الذي غنَّى صالح عبد الحي لزهرِهِ، وتحاشيتُ النظر إلى العامل حين مررتُ بجواره، بل رفعت أنفي في كبرياء.
ولأن المتجر ضخم، ولأن زبائنه من المعتادين على شراء لوازمهم الشهرية أو الأسبوعية على الأقل، فلم تكن هناك أكياسٌ بلاستيكية صغيرة. تخيل أن تسير في الشارع وأنت تطوِّح كيسًا كبيرًا طوله نصف متر تستقر في قاعه عبوتان لا يتجاوز وزنهما مئة جرام، وهو وزنٌ لا يتناسب إطلاقًا مع وزن حامله -الذي هو أنت- ولا مع الثقل الذي يرزح قلبك تحته، ويتآمر عليك الهواء الساخن في أغسطس ويؤرجح ذلك الكيس شبه الفارغ في خفةٍ مثيرة للأعصاب. أتخلص من الكيس كي أضع العبوتين في حقيبتي الكبيرة. كانت لحظةٌ واحدة من عدم الانتباه، مع ميلٍ خفيف بجسدي كي أتمكن من فتح الحقيبة دون إنزالها عن كتفي كافية ليصدمه ميكروباص مسرع، لأسقط أنا والحقيبة والعبوتان أرضًا، ويمر الإطار الخلفي للميكروباص على مسافة سنتيمترات قليلة من كفي ويدهس عبوتي الموكا. الغريب أن ألم كتفي المخلوع لم يشغلني عن ملاحظة انفجار العبوتين وتناثر المسحوق البني على الأسفلت. وفي قلب الإطار اللامع، ترائى لي وجه مديري الضاحك.
حينما كنت أجري فحص الأشعة، غضب مني الفنِّي بشدة لأنني تحركتُ لألعق البودرة الناعمة التي تطايرت واستقرت على كفي من العبوتين المدهوستين، وكان لها طعم الليمون.