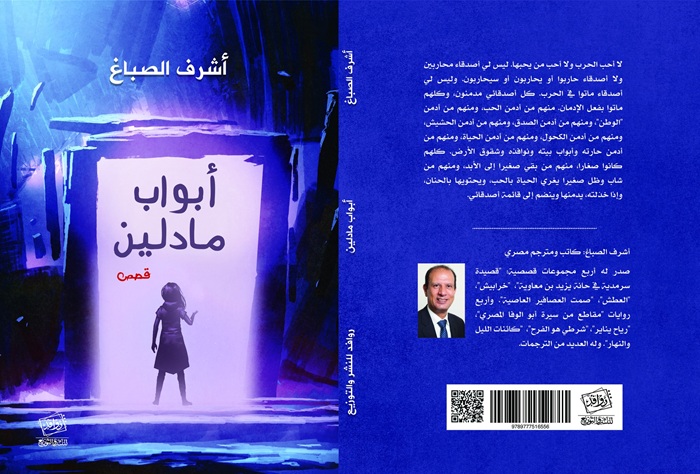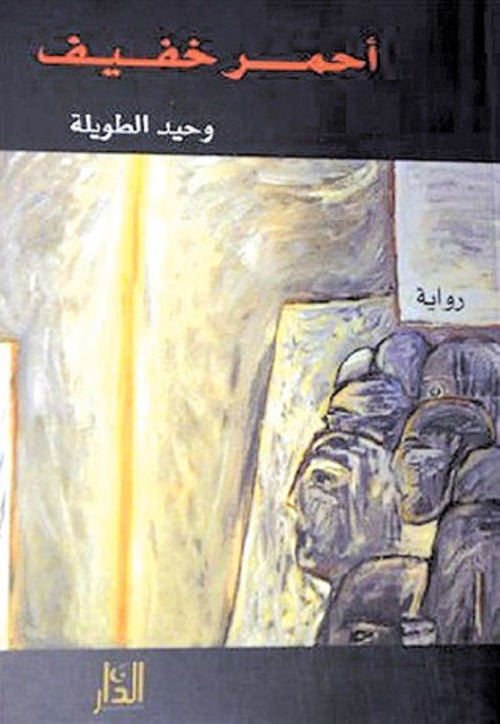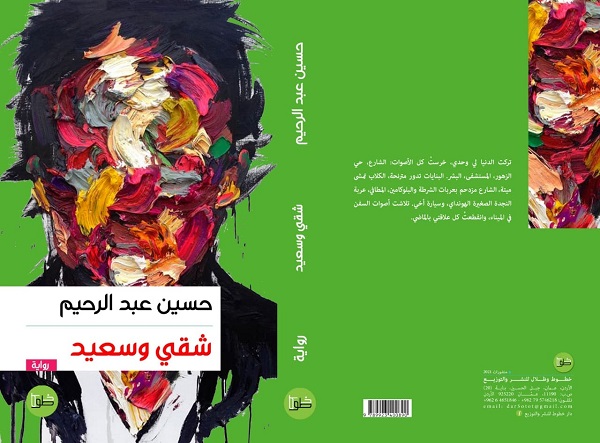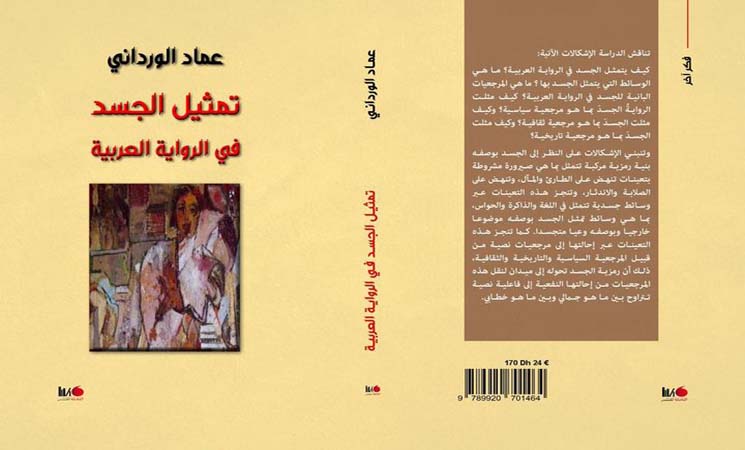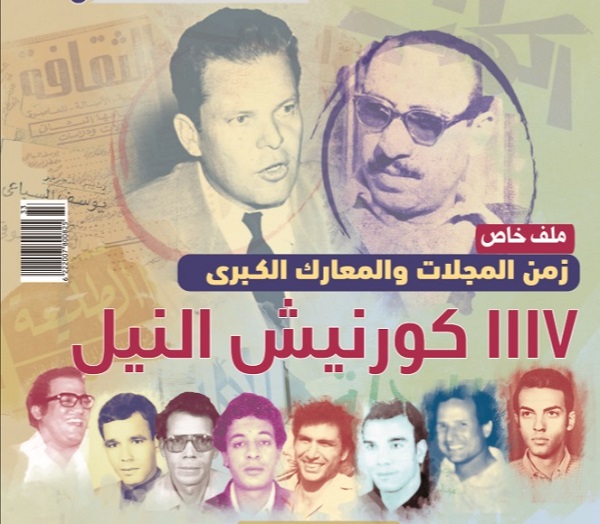دينا الحمامي
في روايته الأحدث “مهدي باريس المنتظر” والصادرة حديثاً عن دار العين، يعتمد الروائي محمد إسماعيل على بنية روائية دائرية تتناول قضية سياسية معاصرة وشائكة في آن واحد، إذ وظف الكاتب الخيال لمزج ما هو عام بما عاصره من وقائع كعربي يعيش في فرنسا ويرصد التحولات الاجتماعية والسياسية الساخنة، ومن ثم يعيد توظيفها من خلال الأدب كمحكية شاهدة على فترة مرتبكة وحرجة من عمر العالم بشكل عام وأوروبا وتحديداً فرنسا بوجه خاص، تنهض السردية الكبرى للنص على تقاطع السياسة بكل ما تحمله من ألاعيب وعوار مع الأدبيات التاريخية لنبوءات مشكوك في صحتها مع آمال شخص مضطرب الهوية الوطنية ويعاني من اكتئاب ثنائي القطب، تبرز من السردية الأساسية سرديات فرعية لثلاث نساء يختلفن في الاتجاهات والأصول والطبائع، ويتفقن في سعيهن نحو حياة أفضل وأهدأ.
لا تكتفي السرديات الست الفرعية بتفنيد وجهة نظر كل شخصية في واقعها وما يعتمل بداخلها من أفكار وما يؤرقها من ذكريات، بل تعمل وبوعي نحو فهم الآخر ودوافعه وأحلامه وآماله، مثلما تعاطفت المهاجرة “آميدا” مع “محمد” الشخصية الرئيسية بالرواية بعدما كانت تتعامل معه كعميل يجب أن تنتفع من خلاله بأقصى شكل ممكن، ومثلما تفاعل “جيوفرانش” رئيس حزب “أخوية الحرية والمساواة” بشكل عكسي مع البطل ذاته، على الرغم مما بذله من مال ووقت وجهد لإنجاح بطل الرواية الهش، والذي تبدلت أحواله من النقيض إلى النقيض لأكثر من مرة خلال الأحداث، ولكنه ظل رمزاً مخلصاً للهشاشة الإنسانية بكافة تجلياتها واضطراباتها.
يتأرجح السرد بين التكثيف الموجز والتقطير المحسوب على امتداد الرواية، كلٌ حسب رؤية الكاتب وما يحتاجه النص من إسهاب أو إيجاز، ولكن وعلى اختلاف الوزن السردي بين تكثيف وإسهاب، حافظت اللغة على إيقاع واحد رشيق وسلس ساعد بسلاسته على استقبال المرارة الساكنة في ثنايا النص بلطفٍ ونعومة، حافظ الراوي العليم أيضاً على متانة النص كونه تكنيكاً يمكنه استيعاب وجهات نظر متباينة ومتداخلة دون أن ينقطع عن رؤية الكاتب نفسه، فيما جاء السرد في بعض الفصول المروية على لسان البطل “محمد” كمعامل مهم لتمرير أزماته وهزائمه وطموحاته التي تتجاوز حد عقله المثقل باضطراب ثنائي القطب، وغرفته الضيقة، ومناديله البيضاء التي تحمل منياً مهدراً كدليل بيولوجي هزيل على حياة إنسان مهمش.
من أهم وظائف الفن أنه يحيلنا طوال الوقت إلى سرديات سبقته، سواء إن كانت تنتمي إلى نفس النوع أو القالب الفني، أو إن كانت تلتقي تلك السرديات بشكل خاص في الروح التي تشكل الواقع التاريخي المتكرر، فبينما حرص وحيد حامد في فيلم معالي الوزير على إظهار الوزير كمسؤول تولى منصبه بمحض الصدفة الخاطئة، حاول المحيطون به تصحيح هذا الخطأ عن طريق تلميعه واختلاق دعاية هزلية لا تعبر عن شخصيته بأي حال من الأحوال، التقى بطل مهدى باريس المنتظر مع وزير الصدفة في نقطة واحدة؛ وهي محاولة بناء مستقبل على واقع مزور، يمتلك محمد بطل الرواية حلماً بسيطاً في حياة أفضل فأصبح مهدياً منتظراً، وكل هذا خلال شهور بسيطة وبمساعدة رجل سياسة برجماتي ولا يعلم شيئاً عن الشعارات التي يرددها، فيما عاونت ظهورات الدجال “نواه” المُدّعي لانتسابه لعراف عاش قبل خمسة قرون على ترسيخ صورة البطل الورقي كمخلص ومنقذ لفئة عربية مسلمة تقابل تحديات شتى، فتح كل من نواه وجيوفرانش الباب أمام شاب تعس يرزح تحت وطأة نير واقع محبط وأليم. في الوقت الذي عرف فيه بطل وحيد حامد حجم أخصامه ومدى خطورة انكشافه أمام الأمة التي يدعي أنه يحقق مطالبها، لم يجد سوى مساعده وصديقة الأقرب وأمين سره “عطية” ليتخلص منه كمكافأة نهاية خدمة، فيما استغل صانعو المهدي المنتظر المزعوم محمد الصنهاجي سذاجته وحماسته وجموحه وأطاحوا به من نافذه الأمل التي أشرعوها له من قبل على مصراعيها.
تمثل المرأة نقطة محورية أيضاً، فرقية أم محمد هي المبتدأ وأصل حكاياته ومصدر الحنان الأوحد له، فيما شكلت “آميدا” أو “حميدة” صورة رمزية للنهايات التي تحمل بعضاً من الرحمة والمواساة في واقع شخصي ينهض على الأحلام المبتورة، والآمال الموؤودة المجهضة، فاللمحة الكاشفة لمحاولات استمناء البطل طوال الوقت حتى مع معرفة أمه ووجود حميدة معه تشاركه المنزل لفترة من الزمن، يعكس العجز الإنساني التام لشخص لا يستطيع تحقيق أدنى حاجاته البيولوجية سوى في خياله، وهنا تأتي المفارقة بين بطلة وحيد حامد “زهرة فؤاد” والتي طلبت الطلاق من معالي الوزير قبل أن يصبح وزيراً لأنه قد تجاوز حدود الدناءة البشرية المقبولة بأنه كان يكتب التقارير عن زوجته ليحظى ببعض المكاسب المهنية، على النقيض تأتي حميدة على الرغم من عمليتها ولهاثها نحو الجنسية وطموحات التدرج الوظيفي والأكاديمي كشخصية ليست مثالية في حياتها الخاصة، ولكنها بُعثت كملاك متعقل رحيم لم تنل منه تروس الغربة والزينوفوبيا والإسلاموفوبيا.