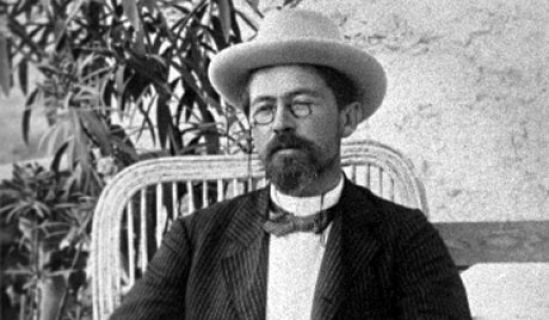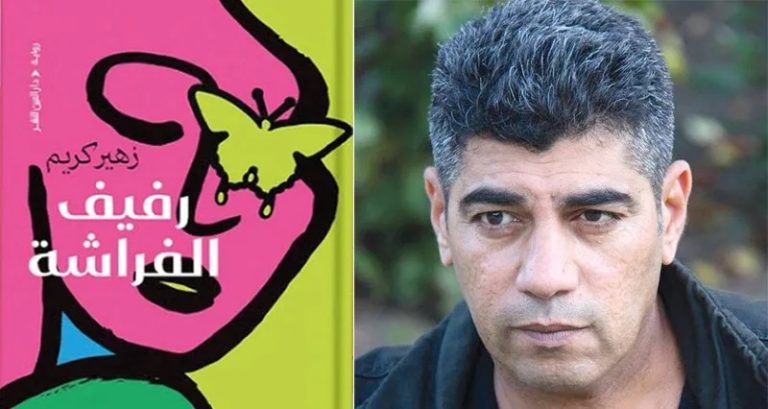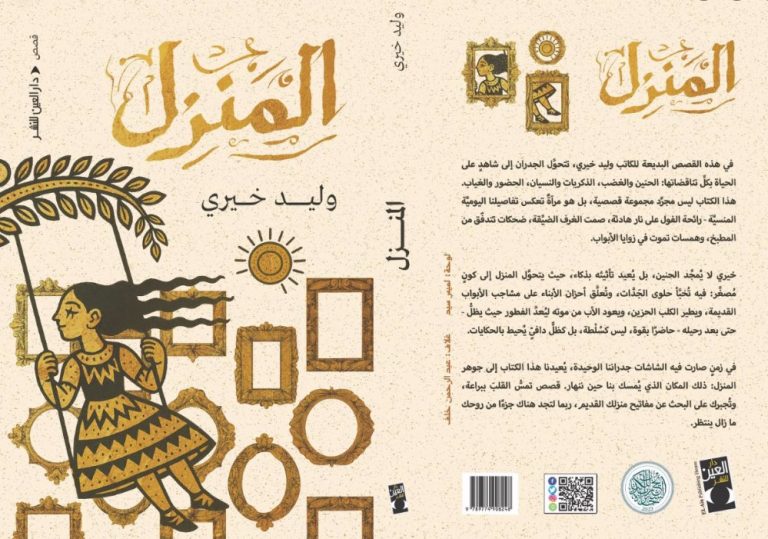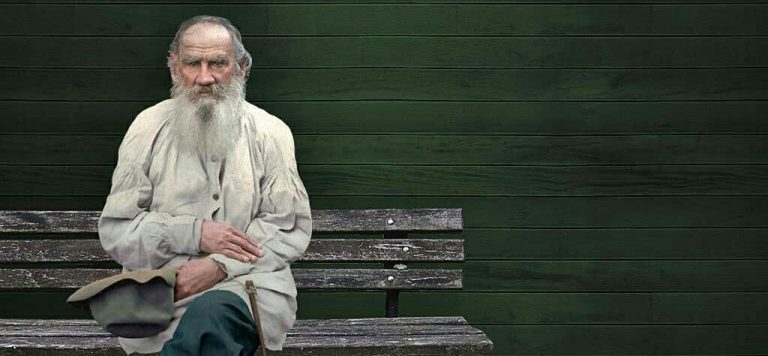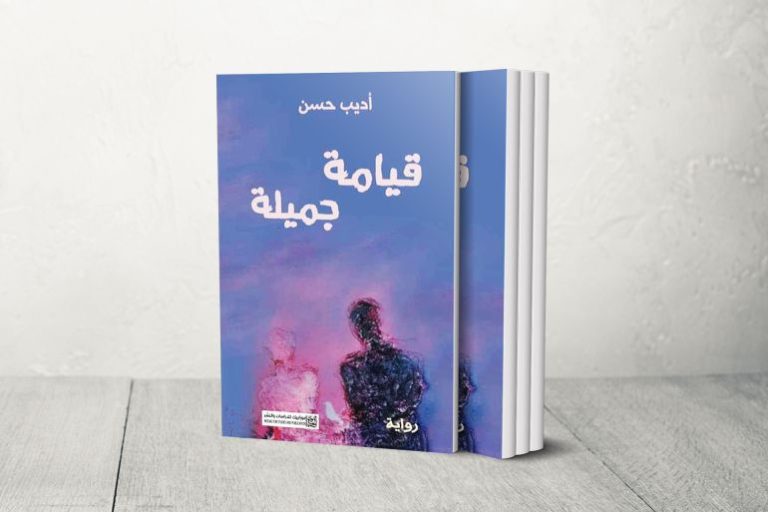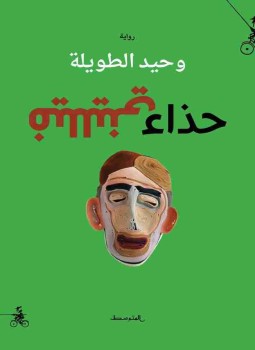بولص آدم
منذ بدايات الأدب المسرحي والقصصي، ظلّ التمثال كائناً مشبعاً بالرمزية، يتجاوز كونه حجراً منحوتاً ليصبح وسيطاً بين الإنسان ومصيره، أو بين الجماعة وأحلامها المكبوتة. فالتماثيل في النصوص الكبرى لا تُصنع لتزيين الساحات وحسب، بل لتفجّر معنى يتجاوز حدود الفن. وإذا عدنا إلى موليير في مسرحيته الشهيرة دون جوان، نجد أن تمثال القائد الحجري الذي ينهض في النهاية لم يكن قطعة صامتة، بل ممثلاً للعدالة الإلهية التي لا تفلت من قبضتها الأرواح العابثة. في النص، يقف التمثال شامخاً، متجهماً، ليستدعي المذنب إلى “العشاء الأخير”. لا حياة فيه إلا تلك التي يمنحها له الخيال المسرحي، ولا دور له إلا أن يُنهي التمرد الفردي لدون جوان، ويرسله إلى مصيره المأساوي. الحجر عند موليير رمز للسلطة العليا الثابتة، والعقاب المحتوم، والعدالة الأخروية التي لا مفر منها. التمثال يغلق باب المغامرة، ويثبت العالم في جمود أبدي، ويترك الجمهور مشدوداً أمام حتمية الحساب.
بعد قرون، نجد إنعام كجه جي تستعيد التمثال في قصة “بلاد الطاخ طاخ”، ولكن على نحو مغاير تماماً. في متحف يضم تماثيل شمعية للحكام، يتحرك أحد التماثيل بعد عقد صفقة مع الحارس ليخرج من وقفته الأبدية. بدأ التمثال جولته داخل المتحف، يمر بالملوك والثوار على حد سواء. رأى ملوكاً يرث كل منهم كنيته من السابقين، حتى انقطعت سلالتهم بصوت “الطاخ طاخ”، لتنبثق بعدهم جمهوريات جديدة، لكن “لا يتوقف الطاخ طاخ”، كأن عالمنا لم يعرف غير الرصاص وسيلة للتغيير.
أما في قصة “عارية في الوزيرية”، فالقصة تسير في اتجاه مغاير. الفنان العراقي سالم الشذري يموت في باريس، تاركاً وصية أن يُنثر رماده في ممرات المقبرة الإنجليزية في الوزيرية ببغداد. ومن تربة الغياب ينبثق تمثال امرأة عارية، يصنعه تلاميذه من الرماد والطين. هنا، التمثال ليس خاتمة، بل بداية. الجسد الأنثوي الذي يطلّ فجراً من سطح أكاديمية الفنون يتحوّل إلى فضيحة تمشي على قدمين، يهزّ حيّاً بكامله ويقلب شرايين مدينة مخنوقة. النساء يخلعن عباءاتهن ويصفقن، الملتحون يستشيطون غضباً، الطلاب يستعيدون نشوة الحرية، والأمهات يلوحن بالسواد في وجه القمع. فجأة، يصبح التمثال كائناً يتنفس نيابة عن الجميع، لا ليعاقب، بل ليهب الحياة.
هكذا، يكشف المساران عن وجهين مختلفين للتماثيل في الأدب والفن. عند موليير، التمثال سلطة عليا فوقية، تردع الفرد وتعيده إلى قدره. عند إنعام، التمثال سلطة مضادة، تنبثق من رماد الموت لتفتح أبواب الحياة، ومن الصمت لتطلق ضجيج الحرية. الأول يختزل المغامرة الإنسانية في عقوبة، والثاني يوسّعها إلى ثورة جماعية. الحجر عند موليير يُثبّت العالم في جمود أبدي، بينما الطين عند كجه جي يتشكل ليعلن بدء دورة جديدة.
وفي نهاية مقالة “زمن فائق حسن”، تشير الكاتبة إلى ما يمكن أن يأتي بعد ازدهار الفن، إلى أفق التحديات والقيود، حيث نقرأ:
«أغمض فائق حسن عينيه قبل أن يرى زمناً يعترضون فيه على تدريس الرسم في معاهد الفنون».
هذه الإشارة، تلمح إلى صدام الفن مع الواقع الاجتماعي والسياسي، وتكتسب دلالة مضاعفة حين نقارنها بقصة “عارية في الوزيرية”، قصة قصيرة من وحي فائق حسن للكاتبة إنعام كجه جي، حيث يصبح الفن جسدًا حيًا يتحدى القيود. التمثال العاري على سطح أكاديمية الفنون في القصة يتحوّل إلى رمز للحرية والتمرد، تمامًا كما يظل رماد فائق حسن شاهدًا صامتًا على تجاوز الزمن وقيود المكان. بين زمن فائق حسن المزدهر وزمن عارية في الوزيرية الذي يحمل نذر التحدي، يظهر الفن كقوة تتجاوز الذات والزمان، قادرة على مواجهة كل اعتراض أو رقابة، بصمتها أو بصخبها.
هكذا تظلّ التماثيل، في المسرح والقص، ليست حجارة ولا طيناً فحسب، بل نصوصاً ثانية تُكتب خارج الكتب، على جدران المدن وفي ذاكرة الجماعات. بين موليير وكجه جي وفائق حسن، نرى كيف يُعاد تشكيل معنى الفن: مرة كختم على مأساة فردية، ومرة كنافذة لثورة جماعية. وفي الحالتين، لا يقف التمثال صامتاً أبداً، بل يتكلم بلغة أخرى، لغة لا تُفهم إلا حين نصغي إلى ما يتجاوز الحجر.