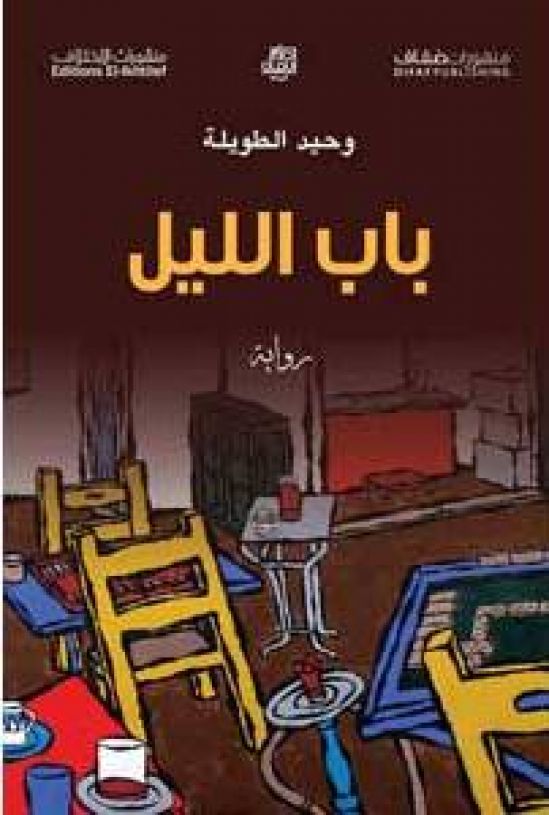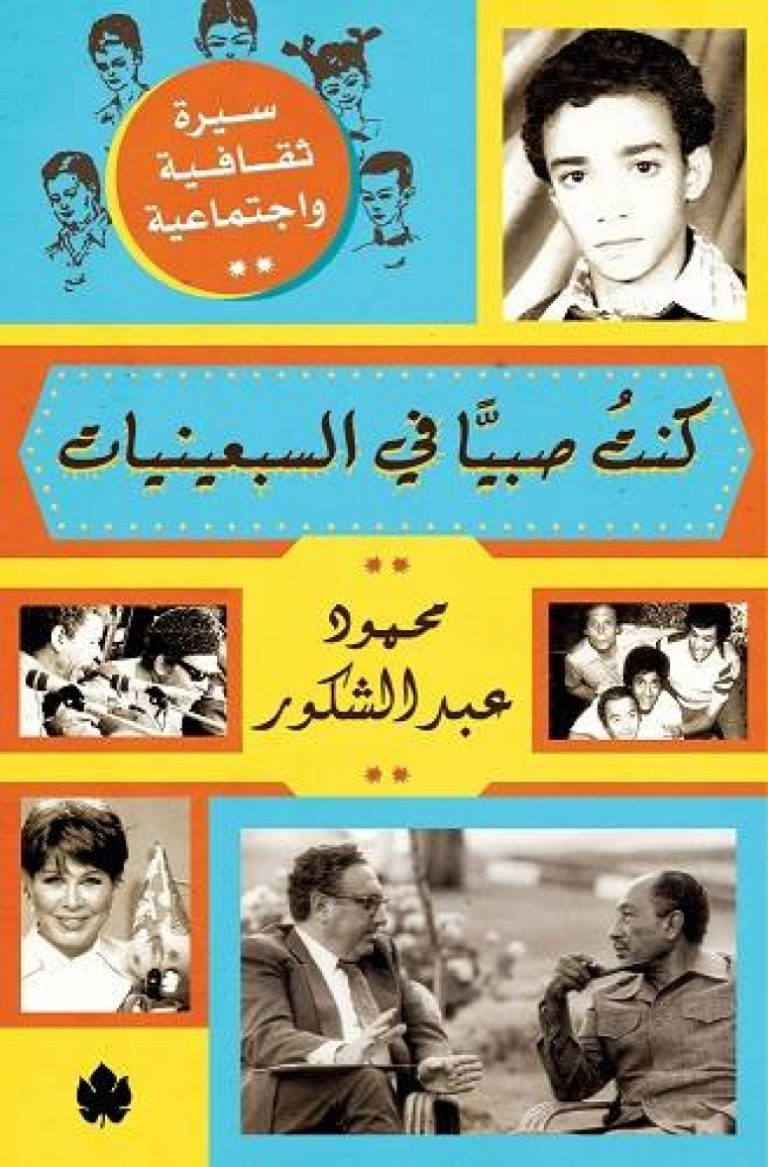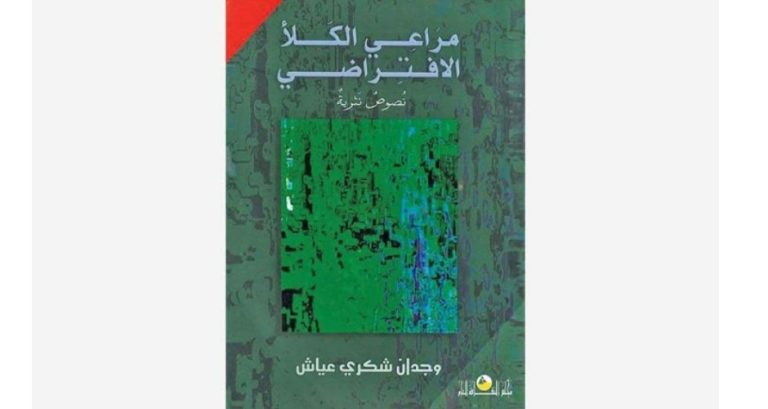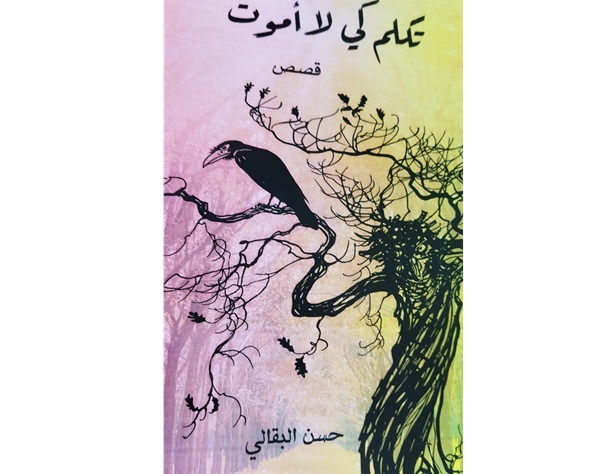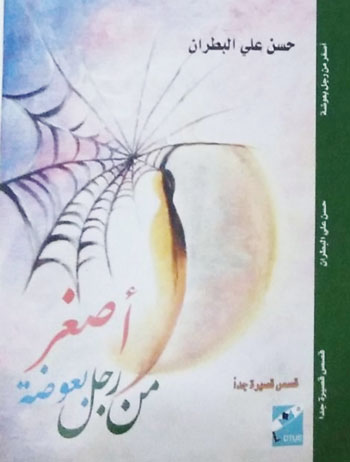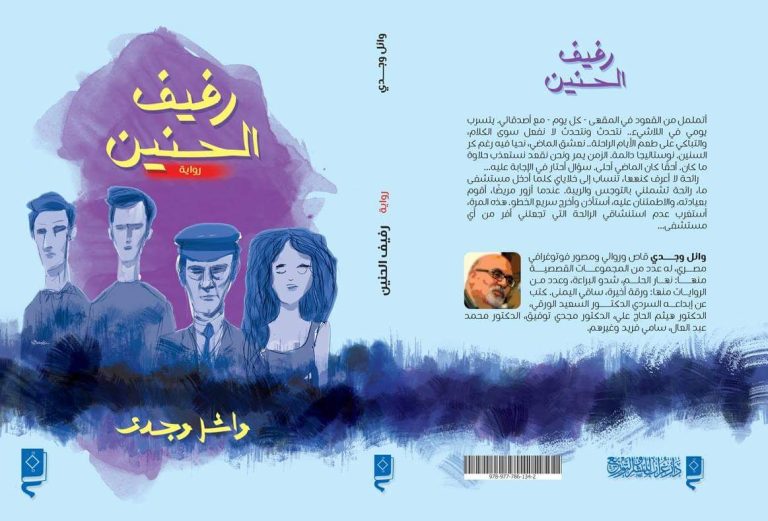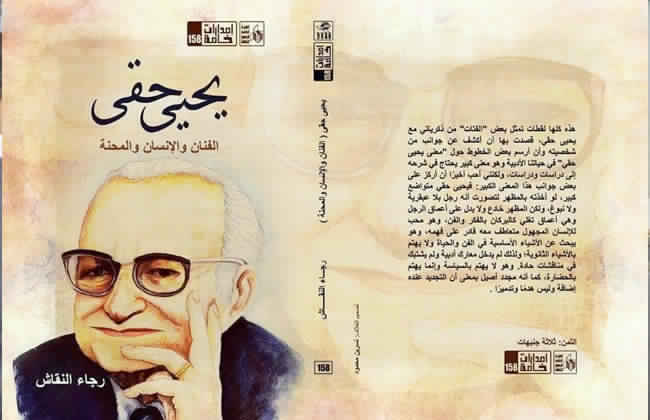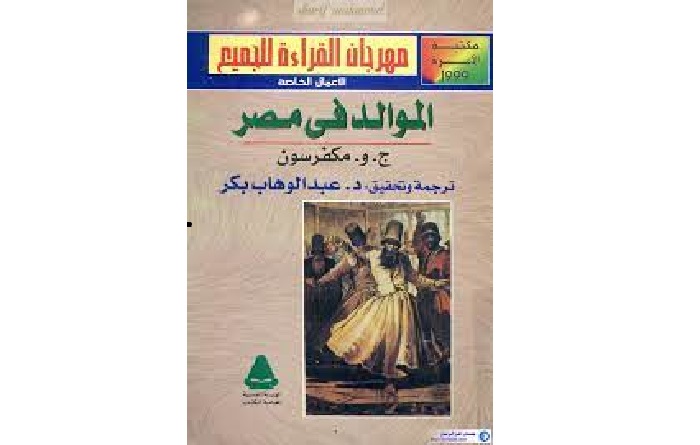كل شيء موجع في “باب الليل” ومختلف، فالليل رغم ما يثيره من التوتر والخوف يمنح القدرة على “البوح” و”الاسترسال” والكلام بما لا يقدر الواحد أن يواجه به نفسه في “وهج النهار”، كما أن الرؤية الليلية بالتأكيد ستكون غير متضحة ينقصها بصيص ضوء ضروري، مما يجعلنا نضيف عليها تهويمات “من صنع أيدينا” ونرى ما نظنه حقيقة وفى الوقت نفسه قد نقهر “خوفنا” تحت مسمى “السراب” فيحكمنا “الوهم” ويقود خطانا لـ”الونسة” أو “للفرار بعيدًا”.
تحدث نقاد كبار وكثر عن رواية “باب الليل” ورأوا فيها كثيرا من “الثيمات الجميلة” وهي بحق كذلك، واعتبروا أن “وحيد الطويلة” يرمز بـ”مقهى لمة الأحباب التونسي” للوطن العربي، لكنهم لم يتوقفوا كثيرا عند المناطق الشائكة التي تحتوى عليها الرواية، وهذا ما سنفعله من خلال نقطتين هما، القضية الفلسطينية، ومقارنات التاريخ.
القضية الفلسطينية/الخسارة الدائمة
في “باب الليل” يتوقف وحيد الطويلة كثيرا أمام القضية الفلسطينية، ويفرد لها صفحات مهمة من الرواية ليعرض لإحدى صفحاتها التى ربما نكون قد نسيناها أو غفلنا عنها بسبب كثرة صفحات القضية الفلسطينية، إنها صفحة “تونس” حيث الفلسطينيون ما بعد معاهدة “أسلو”، رحل من رحل وظل البعض ممن رفضت إسرائيل استقبالهم أو السماح لهم بالعودة للأرض المحتلة، ونرى من خلال السياق كيف اتفقت كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية عليهم، وربما كانت عودة “توفيق فياض” بعد 41عاما من خروجه من أرضه الفلسطينية وحياته فى مصر ثم تونس هو ما جعلنا نعيد قراءة رواية “باب الليل”، والمعروف أن “وحيد الطويلة” قضى شطرا من حياته فى تونس، قرابة الـ10 سنوات، وبالتأكيد بحث “الطويلة” في تونس داخل المقاهي عن المثقفين واستمع لحكاياتهم، وأعاد صياغتها وجعلها حلقة من “القضية الفلسطينية”.
بداية يجب علينا أن نحدد أن “باب الليل” رواية عن القضية الفلسطينية وأكثر، لكن بعد الانتهاء من الرواية، تجد أن هناك بعض الملاحظات على النص فيما يتعلق بـ”الثورة الفلسطينية”، بالتأكيد الرواية تدافع عن القضية الفلسطينية، لكن السؤال: هل يرى وحيد الطويلة العيب في رجالها أم في قادتها أم في الشعوب العربية التي أخذت موقف المتفرج في هذه الإشكالية الكبرى التي هي إشكالية حياة أو موت؟.
الملاحظة الأولى، أنه من المعروف والثابت لدى الذين قرأوا الرواية أن “وحيد الطويلة” يحتفي باللغة ويجعلها الباب الذي يلج منه لقراءة الأرواح والناس وما يحيط بهم من قلق وجودي دائم، لكن من مأمنه يأتي الحذر، إنها اللغة بكل جبروتها وسلطانها تضعنا في حيرة ما، ففي الرواية وفي أول ظهور للقضية الفلسطينية يكتب “الطويلة”، “البعض يسمونه مقهى (الأجانب) يعج ببقايا فلسطينيين بقوا هنا مرغمين بعد أن غادر الجميع تقريبا إلى رام الله مع ياسر عرفات بعد اتفاقية أوسلو. الذين رفضوا تفرقوا في شتات البلاد وراء رزق أو عائلة أو دولة ترحب بهم أو أي مكان أوسع من رام الله وغزة، بقايا لم يجدوا أسماءهم في كشوف السلطة الفلسطينية. في القوائم الإسرائيلية كانوا وما زالوا ممنوعين من العودة، أياديهم ملطخة بدماء الإسرائيليين، وأرواحهم ملعونة أيضا، وعليهم إن تنفسوا أن يفعلوا ذلك في مكان آخر يستحسن أن يكون قبرا سحيقا في جوف الأرض” جاء ذلك في الصفحة 12 من الرواية.. ولما كان الراوي في الرواية ليس “راويا مشاركا” وليست له أي صفة يمكن من خلالها معرفة توجهه، فهو “راو عليم” يعرف كل شاردة وواردة عن الشخصيات لذا فإن صوته لا ينفصل عن صوت “وحيد الطويلة” الشغوف باللغة والمعبر عن جمالها، لذا جملة “أياديهم ملطخة بدماء الإسرائيليين” في أول كلام عن “الفلسطينيين” في الرواية، تجعلك حائرا ومتربصا لأن “الرجل يعرف قيمة “اللغة”.
الملاحظة الثانية، رغم تعاطف الرواية مع كثير من الشخصيات الفلسطينية المشردة فى “تونس” مثل “أبو جعفر” لكنه جاء فى الكتابة الأخيرة عن الفلسطينيين في الصفحة (242) من الرواية يقول “والفلسطينيون على حالهم، مصرون على التجمع يوميا صباح مساء، يضمون طاولتين في طاولة واحدة حتى لا ينسوا بعضهم، كأنهم خائفين أن ينفرطوا ثانية، يمنحون المكان دفئا رغم بؤسهم الواضح، وحكاياتهم التي لم تفهم منها شيئا تقريبا”، هذه الجملة الأخيرة (حكاياتهم التي لم تفهم منها شيئا تقريبا) تطرح سؤالا مهما: ما الذي يقصد الكاتب قوله من وراء استخدامها، خاصة أنه استخدم الماضي “لم تفهم”، هل يعني أن الفلسطينيين لا يجيدون شرح قضيتهم أم أنهم يقولون قولا متداخلا لن يفهمه أحد، وهل جاءت هذه الجملة من باب التداعي اللغوي أم قصدها ليختم بها رأيه في القضية الفلسطينية، خاصة أنه طوال الرواية لم يحدد لنا “الراوي ولا المروي عليه” لذا فإنه يضعنا أمام اختيار وحيد هو أن “المروي عليه” هو “نحن” القراء، الذين نفهم كل ما حكاه الفلسطينيون منذ أول الرواية، فكيف يصادر هو علينا هذا الحق لو كان يقصدنا نحن؟!
الملاحظة الثالثة التى تتعلق بالقضية الفلسطينية، هي النظرة التشاؤمية جدا المسيطرة على مصائر الشخصيات الفلسطينية، فالجميع خاسرون، هو يكتب عن مقهى “لمة الأحباب” التونسي، لكنه من خلال اللغة المعبرة يتجاوز ذلك إلى خارجه إلى الشوارع الخلفية إلى تنفيذ الصفقات التي تتم داخل المقهى وتنفذ خارجه، كل ذلك وأبو شندي وأبو جعفر وشادي رموز القضية الفلسطينية يشاهدون ما يحدث، رجال بهم سماتهم الحسنة وعيوبهم القاتلة لكن الوطن المغلوب على أمره يسيء إليهم ويضعهم في خانة “اليأس” حتى يظل “أبو شندي” دائم المقارنة بين فلسطين والدول الأخرى، والثورة الفلسطينية وقادتها من جانب والمومسات من جانب آخر وعادة ما ينتصر للمومسات، هو نموذج البطل المهزوم المحتار بين الواقع والمثال، يقول “أصبحنا بقايا، بقايا نضال وبقايا حياة، هنا لا أعيش ولا أموت” ويذهب كل يوم تقريبا إلى الشاطئ الذي أبحرت منه سفن الفلسطينيين العائدة إلى رام الله ليتأكد أن الشاطئ ما زال في مكانه في انتظار العودة الحقيقية فهو لا يسمي عودتهم بعد “أوسلو” عودة لكنه يسميها رحيل، لكن “وحيد الطويلة” غير متفائل بمستقبل “الثورة الفلسطينية” ففي كتابة تستدعي التوقف يضيّع “الطويلة” من “أبو شندي” آخر أمل له في العودة، عندما يذهب للشاطئ فيجد الكتل الخرسانية قد زرعت فى “الحافة” وصور السيد الرئيس تحوطها فينقبض قلبه، فنتساءل لماذا لم يرحم “الطويلة” هذه “الأرواح المتعبة” ونكأ الجرح للنهاية حتى أضاع الأمل.
مقارنات التاريخ/الظالم والمظلوم
ما زال وحيد الطويلة يدين الجميع، ويجعل من نساء المقهى النموذج والمعيار الذي يقاس به العالم من حولهن، بل يتجاوز ذلك لمحاكمة التاريخ، ووضعه على سفود المقارنات، فيجعل شخصياته الرئيسية في مواجهة بطلات المقهى، فلدينا اللا درة “صاحبة المقهى وفاتنته الأولى” في مقارنة صعبة مع الملكة المصرية القديمة “حتشبثوت” في موقفين، الأول: ما فعلت كل منهما بالمهندس المعماري الذي بنى لـ”درة” مقهاها وبنى لحتشبثوت “معبدها”، والثاني في مفهومهما عن “الحكم وطريقته وكيفية الوصول إليه” فتقول الرواية “في النهاية هي أجمل من حتشبثوت، وأكثر إنسانية منها… بل هي أفضل منها، ملكة الفراعنة جلست على عرش شيده ذكور قبلها، وعلى شعب لا تعرفه، وملكة حي النصر شيدت مملكة من الذكور صنعتها على يدها وأفخاذها وهي ملكة على شعب تعرفه بالواحد”.
وتعود الرواية في مكان متقدم لتعقد مقارنة بين شخصية شائكة هى “ألفة” (أكثر شخصية سعت الرواية لتجعلك قلقا من ناحيتها) وبين القائد “طارق بن زياد” وهنا تأتي المقارنة للبحث عن سبل التلاقي بينهما في طرق التفكير فبعد رحلة “ألفة” إلى “ألمانيا” كتب “الطويلة” يقول: “طارق بن زياد كان في حكايتها، أحرق المراكب حتى يقطع فرصة الهروب على أي كان وليواجه كل واحد مصيره، بروح المقاتل اليائس لينتصر على الموت قبل العدو. وهي أحرقت كل مراكبها، حرقت الركاب والشاطئ أيضا لتخلق فرصة غير موجودة، وستعود على طريقتها”، الغريب في الأمر أن هذه المقارنات لم تكن تداعيا نفسيا فعلته “النساء” فى الرواية لكنه كان كتابات مباشرة من “الراوي” لذا هي ربما تحمل وجهة نظر الكاتب في التاريخ.
وتظل رواية “باب الليل” تستحق الكثير من القراءات المختلفة، فالنص الجيد يمنح دلالات متعددة بتعدد القراءة.