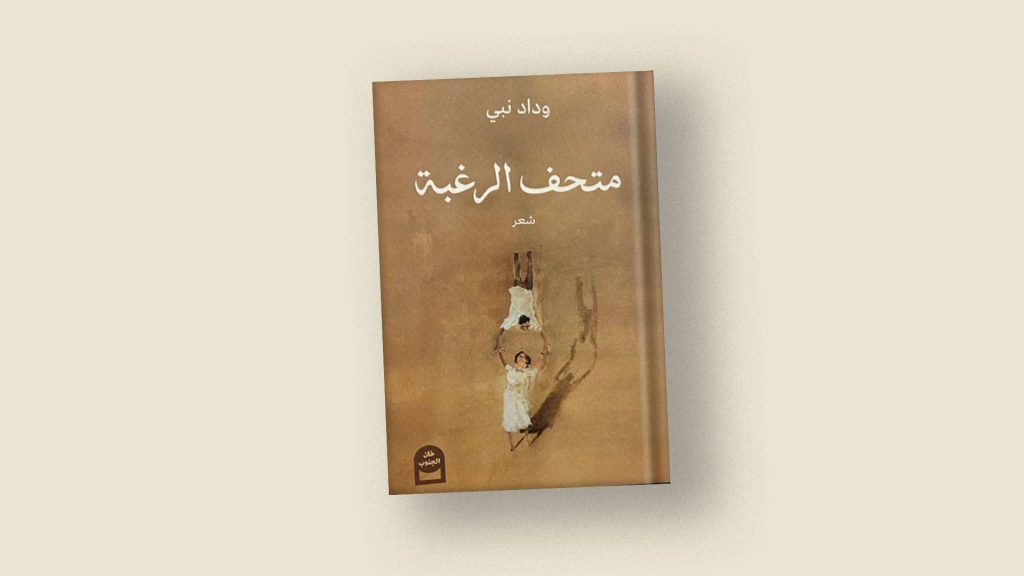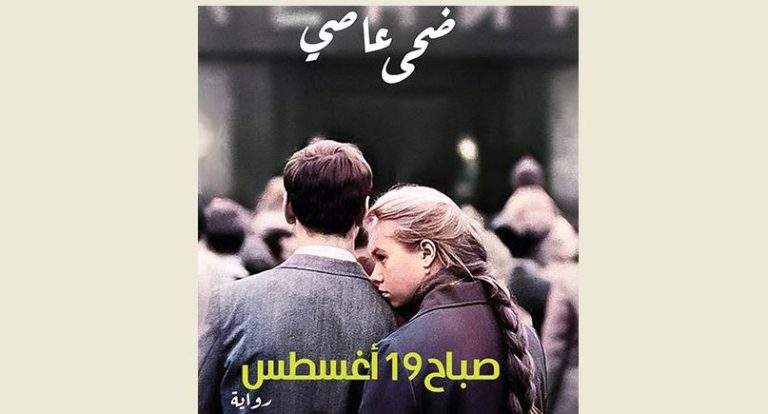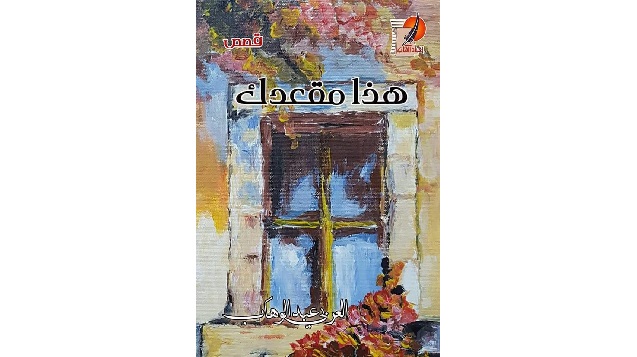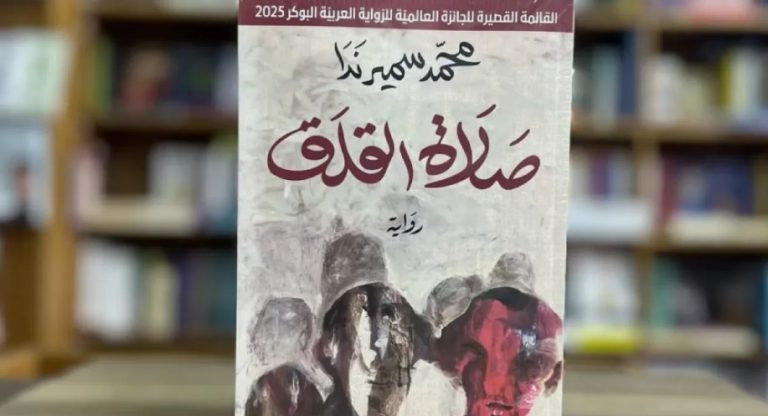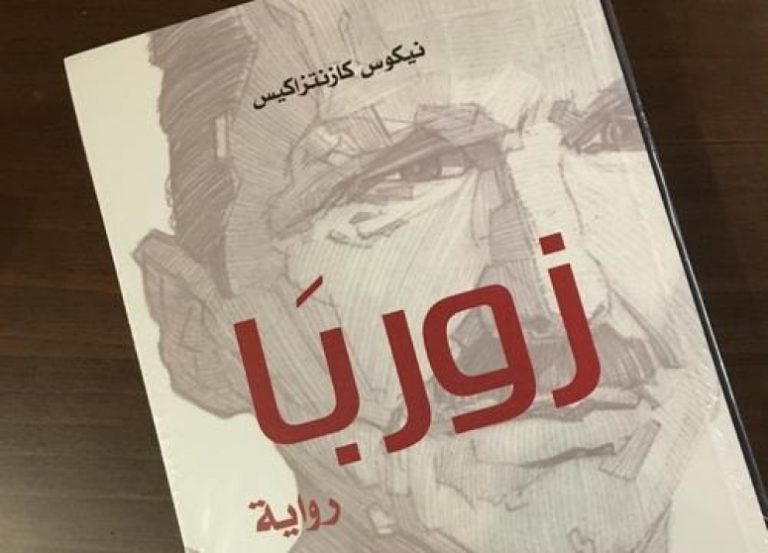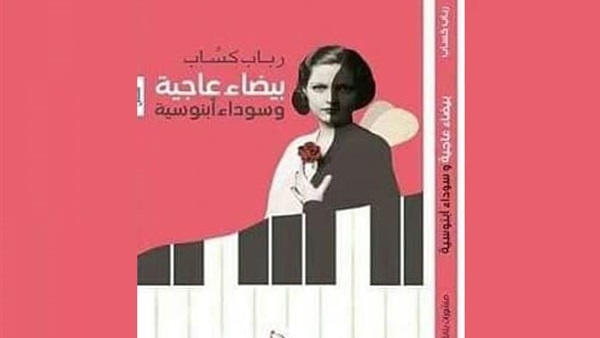سامح قاسم
هناك لحظات في الحياة تتوهّج فجأة دون إنذار، لحظات تشبه فتح ثقب على قلبٍ مشتعل، أو الدخول إلى غرفة يفيض هواؤها برائحة جسدٍ يكتشف ذاته من جديد. هكذا يطل ديوان “متحف الرغبة” لوَدَاد نَبِي؛ ديوان يمدّ ذراعًا من الضوء ويجذبه نحو عالم مكتمل، عالم يختلط فيه اللحم بالمعنى، واللغة باللمسة، والذكريات بالشهقة الأولى.
من الصفحات الأولى يتّضح أن هذا الديوان ليس مساحة للاحتفاء بالحب فقط، لكنه يمتد ليصير فضاءً تتخلّق فيه امرأة تتقدّم نحو حقيقتها من دون خوف. امرأة تنحت جسدها بالكلمات، وتترك للقصيدة أن تعمل كيٍد ثالثة تفتّح الجلد، وتكشف ما تراكم فوقه من ألم وعتمة وأسئلة. فالشاعرة لا تقدّم خطابًا لطيفًا عن العاطفة، بقدر ما تمنح القارئ عالَمًا يختلط فيه التوهّج بطفولة بعيدة، والرعشة بظلّ حرب قديمة، واللغة بدم القلب.
إنه ديوان يكتب الأنثى بطريقة لا تعرف الستر. يقترح على القارئ أن يرى الرغبة كقوة حياة، وأن يتعامل مع الجسد ككيان يملك لغته، وأن يقرأ الشعر في شكله الأكثر حرارة، حيث يتواشج الحب مع الخوف، ويقترب الجسد من حدوده القصوى، وتعود الأنثى إلى مركز الأسطورة التي صادرتها العادات طويلًا.
حين تفتتح الشاعرة ديوانها بمشهد يشبه انفجار الضوء داخل جسد امرأة، فإنها لا تقدّم افتتاحية عاطفية فحسب، وإنما تضع القارئ أمام ولادة جديدة لأنثى تستعيد حقها في التوهّج. كلمة “توهّجتُ” في الصفحات الأولى ليست مجازًا عابرًا؛ إنها إعلان عن لحظة يتحوّل فيها الجسد من كائن عادي إلى كون يمتدّ فوق حدود اللغة.
تقول الشاعرة: “مدينة أُضيئت كلها بالألعاب النارية.. بلاد قُصفت بالقنابل الفسفورية”. هنا يأخذ التوهّج شكلين متناقضين في الظاهر، متكاملين في العمق: ضوء الاحتفال، وضوء الانفجار. وكأن الرغبة نفسها تحمل طبيعة مزدوجة: نعومة وتوتّر، بريق وخطر، قرب واندفاع.
التوهّج في هذا الديوان يأتي كقوة تُعيد ترتيب العلاقة بين الذات والعاشق، بين المرأة وما حولها، بين الجلد وما تحته. فهو ليس فقط شرارة رغبته هو، إنه شرارتها هي أيضًا؛ الشرارة التي يخمدها الزمن وتوقظها اللمسة، الشرارة التي تنام سنوات ثم تنهض عند النظرة الأولى من رجل أحبّته.
هنا يخرج الجسد من دور المتلقّي إلى دور الخالق. المرأة لا تقف في موقع الانتظار، لكنها تفتح جسدها كنافذة كبيرة يدخل منها الضوء. وتتحوّل الرعشة إلى حدث كوني، كأن الشاعرة تشير إلى أن الجسد لا يحتاج الكثير ليكون عالمًا كاملًا.. فقط لمسة صادقة تكفي لتشعل القارات في داخله.
التوهّج هنا ليس عاطفة؛ هو طريقة للوجود. حين تكتب: “كما لو أنني كون اكتشفَ للتو…” فإنها تعلن أن الأنثى يمكن أن تتخطّى حدود الجسد إلى اتساع أكبر، وتكشف أن الرغبة مساحة تُعيد المرأة فيها بناء ذاتها من جديد، وتقدّم نفسها للعالم بعطر آخر، وصوت آخر، وعمق لا يشبه أي عمق سابق.
هذا الضوء الذي تصفه الشاعرة لا يخصّ العاشق وحده، فهو يشعّ على القارئ أيضًا، فيشعر أنه يفتح باب غرفة يقف فيها قلبان يذوبان في ضوء واحد، ضوء يخرج من الكلمات كأنه بخار ساخن، يعلو إلى السقف ثم يعود فيسقط على الصفحة كقطرة ماء جديدة.
التوهّج في هذا الديوان هو لحظة انهيار الحدود بين الألم واللذة، وبين الماضي والآن، وبين الجسد وما هو خارج الجسد.
ومَن يقرأ هذه القصائد يدرك أن الشاعرة تمنح الضوء وظيفة أخرى: وظيفة الكشف. فالتوهّج هنا يكشف المرأة الحقيقية خلف القناع، ويكشف الرجل كما تراه، ويكشف الرغبة وهي تمدّ يديها نحو الحياة دون خوف.
هكذا تضعنا القصائد الأولى من الديوان أمام سؤال أساسي: ماذا يمكن أن تفعله شرارة صغيرة في قلب امرأة؟
الجواب: يمكنها أن تهدم مدينة من العدم، وتبني مكانها قصرًا من الضوء، قصرًا تفتح أبوابه للرغبة، وتعلن أن الأنثى حين تتوهّج.. تتحوّل كلّها إلى غابة من النار والندى.
الجسد في “متحف الرغبة” يظهر كصفحة تتحرك عليها اللغة مثل يد عاشق تعرف طريقها دون تردد. فالشاعرة لا تكتفي بوصف الجسد، لكنها تفتح له مساحة يتكلم فيها، ويمتلك شعوره، ويمدّ أنفاسه على الورق حتى يغدو النص امتدادًا طبيعيًا لدفء الجلد.
في قصيدة “كما لو كنت متحفًا للرغبة” تقول: “أعلّق فمك قمرًا فوق سرّتي… أتوهّج بضوئك”. هنا ينتقل الجسد من كونه مادة إلى كونه ضوءًا. فالمساحة بين السُّرّة والفم تتحوّل إلى سماء، والضوء الذي ينهمر من الشفاه يشبه نجمة تُضاء فوق بابٍ خفيّ، باب تفتحه المرأة حين تريد للعالم أن يراها كما هي، لا كما يريد الآخرون لها أن تكون.
وفي موضع آخر: “في فمي آلاف القبلات، وفي جسدي بستان من أشجار البرتقال”. هذه الجملة تكشف الكثير: الجسد ليس أرضًا محايدة، إنه وطن تنبت فيه ثمارٌ من الأشواق والرغبة، ويعيش داخله فصل دائم من الربيع، حيث تتحرك كل لمسة مثل نسيمٍ ناعم فوق بساتين مشتعلة بالعطر.
الجسد في هذا الديوان يمارس وظيفته الكبرى: أن يكون لغة. فالمرأة تتحدث عن جسدها بوصفه شيئًا ينطق بالنيابة عنها، ينقل رغبتها، يهمس في أذن العاشق، ويعيد تشكيل العالم وفق حركته الخاصة.
وحين تقول الشاعرة: “إذا عانقتني.. أكون الربيع”، فهي تشير إلى أن الجسد قادر على خلق مناخ كامل، فهو لا يمنح لذة فقط، لكنه يمنح موسمًا، زمانًا، طقسًا يتغير وفق حرارة اللمسة.
إنها كتابة تنقذ الجسد من أدوار ضيقة. فهو ليس أداة للّذة وحدها، ولا وعاءً للحزن وحده، هو مساحة يتجلّى فيها كل ما يمكن أن يحدث في القصيدة.
فالجسد هنا يفتح الأبواب للضوء حين يريد، ويغلقها حين يخاف، ويتحوّل إلى غابة، إلى موجة، إلى حقل قمح، إلى قمر معلّق فوق سرّة امرأة تُعيد كتابة نفسها. ويظهر هذا التوجّه أيضًا حين تقول: “ممتلئة بك كما لو كنت متحفًا للرغبة.. فإذا لمستني تهاويتُ كنجمة في مائك البكر”. إنها لحظة انهيار جميل، انهيار يشبه سقوط الكواكب حين تقترب من مدار جديد.
الجسد هنا لا يقاوم، ولا يختبئ، ولا يضمّ اليدين على خوفه، فهو يفتح نفسه للسقوط المضيء، السقوط الذي يُعيده إلى حالة البدايات، حالة الماء الأول.
الجسد في الديوان يصبح تاريخًا آخر، تاريخًا لا يُكتب بالتواريخ الرسمية، ولكن باللمسة، بالقبلة، بالشعور الذي يمرّ مثل شرارة على العنق أو الركبة أو السُّرّة.
هذا الجسد يتكلم بلغات كثيرة، لغة الشهوة، لغة الذاكرة، لغة الجرح، لغة الفقد، ولغة العودة إلى النفس بعد سنوات من الإنهاك.
والمتحف الذي تتحدث عنه الشاعرة ليس معرضًا للصور، بل معرضًا للعشق ذاته، معرضًا تُعلّق فيه رغباتها، وتقف هي في وسطه كأنها التمثال الذي ينتظر اللمسة الأخيرة ليكتمل.
وهكذا يصبح الجسد محور الديوان كله، المساحة التي تلتقي عندها اللغة بالرغبة، والقصيدة باللحم، والشاعرة بنفسها. إنه الجسد الذي تتحول قصائده إلى رئة ثالثة، تتنفّس بها المرأة حين يضيق العالم، وتستعيد بها نورها حين يخنقها الرماد.
الرغبة في “متحف الرغبة” تتجسّد ككائن كامل، لها لسانها، وعيونها، وخطواتها، وطريقتها الخاصة في الظهور. فهي لا تأتي من الخارج، ولا تفرض نفسها بالقوة، وإنما تنهض من أعماق الشاعرة كما تنهض موجة من بحرٍ ساكن، تتقدّم ثم تتراجع، قبل أن تضرب الشاطئ بقلبٍ مشتعل.
منذ قصيدة “فخذ العالم” يتضح أن الرغبة نوع من السلطة الداخلية التي تُعيد توزيع وزن العالم فوق جسد امرأة. تقول الشاعرة: “أطلقتُ نمور الشهوة جميعها على فخذي العالم”.
هذه الصورة تكشف أن الرغبة ليست رقيقة دائمًا؛ أحيانًا تكون حيوانًا يفلت من قفصه، تركض، تخدش الهواء بمخالبها، وتعيد للمرأة شعورها بالهيمنة على ما فُقد منها في زخم الحياة.
إنها رغبة تعرف مكانها، ولا تخجل من قوتها، وتعرف أن اللذة لا تحتاج شروحًا طويلة، هي فقط، تحتاج اندفاعًا داخليًا يحرّك الجسد كما لو أن داخله طبولًا تُقرع في غرفة سرية.
وفي قصيدة “الشوق” تقول: “كما لو كان الشوق رحمًا في شهره التاسع”. هنا يتحوّل الشوق إلى حمل يُثقل الجسد. وليس المقصود انتظار الحبيب، ولكن انتظار الانفجار الداخلي الذي يسبق الاعتراف؛ اعتراف بالكثافة، بالاحتياج، بالرغبة التي تنمو في الداخل دون إذن، دون قرار، وتصل إلى لحظةٍ لا تستطيع فيها المرأة إلا أن تفتح باب القلب وتدع الانفجار يخرج. وقد تصل الرغبة إلى أقصى صورها حين تقول الشاعرة: “خذني بقوة.. بعنف.. برغبة جسد يريد احتلال جسد آخر”.
هذه العبارة لا تحتفي بالقسوة، ولا تمجّد العنف، إنها تكشف مستوى آخر من الصدق؛ المستوى الذي لا تقف فيه المرأة على أطراف قدميها خجلًا، ولا تراقب جملة معقّدة تُنقص من حدّة الإحساس، لكنها تترك للغة حقّها الطبيعي في التعبير عن أشدّ اللحظات حرارة. إنها رغبة لا تتجمّل. تظهر كما هي: اندفاع، اشتعال، قوة تجعل الجسد يتجرّأ على صورته المعتادة ويعيد بناء نفسه وفق الإيقاع السريع لعاشقين يلتقيان للمرة الأولى.
وفي مقطع آخر تقول الشاعرة: “رغبتي بك تنمو مثل زهرة برية في أعالي جبال الألب.. تنمو لأجل ذاتها”. هذه الصورة بالغة الأهمية، فالرغبة هنا لا تتوجّه نحو الآخر فقط، بل تنمو لأنها ترغب في النمو، لأنها تجد في ذاتها طاقة للاتساع، كأن الجسد يكتشف في نفسه زهرة لا تحتاج حرارة العالم، وإنما تنبت على صخرة باردة، في علوّ لا يصل إليه أحد، وتفتح بتلاتها بسرّية تامة.
وفي قصيدة “لموعد قادم” تتكشّف الرغبة كحدث يتجاوز العاشق إلى ذاكرة العاشقين جميعًا. تقول الشاعرة: “سآتيك مع قبلات عشّاق سابقين.. وأريدك أن تأتيني مع كل نسائك”. هذه الجملة تُسقط فكرة الامتلاك المطلق. فالحب هنا ليس ملكية، ولا رغبة بتمزيق الماضي، هو مساحة تتقاطع فيها أرواح كثيرة، وتأتي الرغبة كجسر يصل ما كان بما هو كائن، وكأن الشاعرة تقول: كل مَن أحببناهم من قبل، يسكنون في هذه اللحظة، يتحوّلون إلى طاقة جديدة داخل الجسد، لا تهدم، لكنها تضيف.
الرغبة في هذا الديوان لا تخشى الماضي، ولا تنكر تجاربه، بل تجعله جزءًا من النشوة الحاضرة، كأن الجسد يكتب نفسه من جديد فوق طبقات من الذكريات المتداخلة.
تبدو قصائد هذا العمل كغرف مضاءة داخل متحف لا يشبه أي متحف آخر؛ متحف تُعلّق فيه الرغبات بدل اللوحات، وتُعرض فيه القبلات بدل التماثيل، وتقف المرأة في وسطه كصوت يخرج من عمق سنوات طويلة، صوت يعرف ماذا يريد، ويعرف الطريق إلى ما يريد، ويقدّم تجربته دون تردّد.
لقد كتبت وداد نبي ديوانًا لا يريد أن يبرّر شيئًا، ولا يقدّم اعتذارًا لأي قراءة حذرة، فهو ديوان ينهض من صميم الجسد، ويعترف بالرغبة بوصفها قوة حياة، ويعامل الحب كحقيقة لا تنفصل عن اللمسة، واللغة كمساحة يمكن للجسد أن يحيا فيها جنبًا إلى جنب مع القلب.