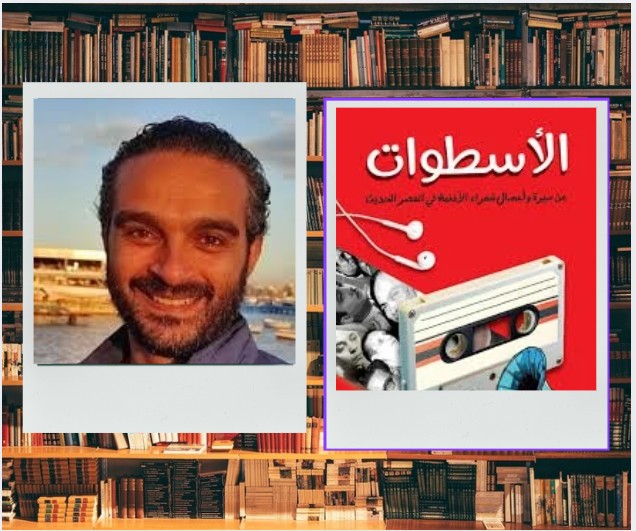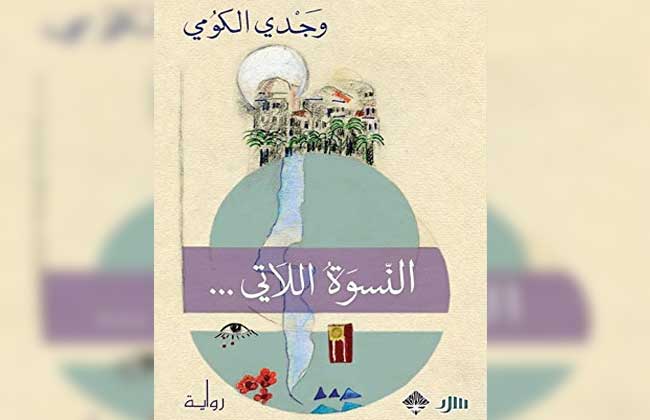عاطف محمد عبد المجيد
حين تقابلها للمرة الأولى، لا تشعر بوحشة اللقاء الأول في حضرتها، بل يتلبّسكَ إحساسٌ أنكَ تعرفها، حق المعرفة، منذ سنوات وسنوات.تبدو، بملامحها التي تشبه الجميع، بسيطة، بل في غاية البساطة، وهي تتحدث إليك بتلقائية، تَنُمّ عن طيبة لا حدود لها، تذيب كل الحواجز بين شخصين لم يلتقيا من قبل أبدًا، كما تُظهر نقاء قلب قُدَّ من البهاء، رغم الآلام والعذابات التي اخترقته.
قالت ذات مرة إن الكاتب عادة يستعين بمشاهد قريبة، ويصف شخصيات محيطة، لكن من الصعوبة نقل واقعه كله بصدق داخل عمل أدبى، إلا إذا قصد كتابة سيرة ذاتية، ويُنظر عادة بعين الشك إلى السير الذاتية التى تمجد كاتبها، لأن النفس البشرية لا تفعل غالبًا الخير والحق والجمال، حتى وإن تظاهرت بغير ذلك، أنا أكتب لصياغة رؤية محددة قد تكون مخالفة للمعتاد، وقد تكون رؤية غير أخلاقية، لكنها موجودة، ولا أنادى بالصلاح إلا فى أضيق الحدود، هذه وظيفة رجال الدين والدعاة، الإبداع يقاس من خلال تعداد التأثير الذى يخلفه على المعاصرين واللاحقين، وليس من خلال مدى أخلاقية هذا التأثير وصدقه، هذه مقولة السابقين عن الإبداع، وليست مقولتى، أنا أجسد أوضاعًا قد تكون حقيقية وقد تكون متخيلة، ولا أعوّل على رسالة، لأنى لست نبية أو قديسة.
هي ترى المرأة التي تسكنها هاجسًا، كما تراها نصفها المتمرد الذي يجعلها تختار عكس المألوف الذي تم فرضه على النساء، في زمن موغل في القِدم، وجعلهن مجرد تابعات، أو منساقات لا صوت لهن.
إنها القاصة والروائية منى الشيمي، صاحبة “من خرم إبرة “، وإذا انهمر الضوء، رشح الحنين، بحجم حبة عنب، و ” وطن الجيب الخلفي “، التي ترى نفسها امرأة عادية، من جنوب مصر، مثلها مثل آلاف النسوة، تعمل مُعلِّمة لمادة التاريخ في المرحلة الثانوية، نصف النهار، وتنسى كونها معلمة حال خروجها من المدرسة، وتجزم أنها ليست معلمة عادية، وفي نصف النهار الثاني تعمل كرَبّة بيت. إنها تحتال لإيجاد الوقت للكتابة، لذا لا يندهش أحد، إذا وجدها تكتب وفي يدها مغرفة طعام، أو كراس تصححه.أحيانًا تضع اللاب توب في المطبخ كي تكتب جملة بين انشغاليْن.
لقد مرت منى الشيمي بمحاولات كثيرة في رحلتها لاكتشاف موهبة الكتابة داخلها: بعد المرور بمحاولات كثيرة لشغل وقتي والاستمتاع به، كتعلم صناعة الحلوى، وتطريز المفارش، وتعلّم صناعة أنتيكات من عجينة الخزف، وصلتُ بالمصادفة إلى الكتابة، ووجدتُ أن روحي ترتاح معها، وتُكمل أكثر خفّةً، فاغتويت بها حتى صرت محققة إلى حد ما.
الشيمي تكتب لتستريح في بعض الحالات، وتكتب لتتداوى في أحيان أخرى، وتكتب احتفاءً بالحياة، وتقاوم الواقع في بعض الأوقات، وربما تكتب لسبب مجهول لا تعرفه هي نفسها، كما تقول.إنها حكاءة بطبعها، تستلهم مقولة ماركيز ”عشت لأروي“، ومن منطلقها يظهر دافعها للكتابة، التي لجأت إليها بعد أن لم تجد هواية أخرى، وقد جربتْ كثيرًا وحاولت مرارًا أن تكون شيئًا آخر لكنها فشلت ولم تجد عنها بديلاً.
لقد حاولت تعلم التطريز، الحياكة، إعداد أطباق مميزة من الطعام، توغلت في كل هواية على حدة، ولكنها فشلت فيها كلها.وفي الوقت نفسه تلبستها غواية الكتابة، فوجدت نفسها مدفوعة إليها من دون تدخل منها.
الشيمي التي حصدت كتاباتها العديد من الجوائز الأدبية رفيعة المستوى تقول إن الجوائز مهمة لأنها تدعم المبدع، خاصة بعدما يكون قد انتهى من عمله، وتساعده في أن يصبح حكاءً مشهورًا، مثلما تُلفت نظر الجمهور والقراء إلى تجربته الإبداعية. غير أن الجوائز، وعلى الرغم من أهميتها، إلا أنها لا تشغل الشيمي حين تكتب، فقط يشغلها مشروعها الذي تتمنى أن يظهر في كتاباتها.الشيمي التي تأثرت كثيرًا في بعض كتاباتها بماركيز، وباولو كويلو، نجيب محفوظ، ومحمد المنسي قنديل، وبهاء طاهر، بالتحديد في روايته ” الحب في زمن المنفى “ ، نجيب محفوظ، ومحمد المنسي قنديل، لا تخجل من قولها إن ”منافي الرب“ لأشرف الخمايسي أثرّت فيها كثيرًا.
لقد ولدت منى الشيمي في الجنوب، وهي تُرجع امتلاكها لموهبة الحكي إلى عماتها وخالاتها اللاتي نشأتْ بينهن، وكانت تستمع إليهن وإلى حكاياتهن، وقد كانت عمّتها هي مَسلّة الحكي بالنسبة لها.
كما كانت تستمع إلى والدها الذي كان ن شخصية مثقفة في زمن قلَّ به المثقفون. الشيمي خريجة كلية الآثار ترى أن هناك تصور فرعوني يقول إن من يمر عليه ظل فرعون فهو محكوم عليه بالموت، ليس من قِبل الحكومة، بل من قِبل الآلهة، فليس من المفترض أن يقف في المكان الذي يمر عليه ظل فرعون، فتقديس الحاكم أمر فرعوني، والشعب المصري يستريح إلى فكرة أن الحاكم إله، وهي فكرة مستمرة إلى الآن، وهو أمر محزن.الشيمي التي تكتب عن المرأة لأنها تراها مهمشة ويتم توجيه نوعين من الخطاب لها، إحداهما إعلامي، من أجل عمل عرض ” شو “، والآخر خطاب حقيقي واقعي مختلف عن الأول، ولديها تحفظات على قانون محكمة الأسرة والقوانين المتعلقة عمومًا بالمرأة، تقول عن مجموعتها القصصية ” خرم إبرة “ إنها كانت تمثل لها مرحلة كانت تهتم فيها بقضايا المرأة، أكثر من الآن، ربما لأنها كانت تشعر وقتها أنها مقهورة، والآن لم تعد تشعر بذلك.
كذلك ترى الشيمي في أحد حواراتها أن علاقة الرجل بالمرأة هى محور الحياة، ولا تنكر أنها كتبت كثيرًا عن هذا الموضوع، لكنه لم يكن محور كتاباتها، وهي لا تخجل عندما تقول إنها لم تكتب بعْدُ كل ما تتمناه فى هذه النقطة، المرأة السوية هى تلك التى تعيش علاقة مستقرة مع الرجل، والعكس صحيح، كما ترى، والرجل لا يشعر بجمال العالم إلا بعلاقة رائعة مع امرأة، حتى وإن كانت علاقة غير شرعية، يرفضها المجتمع وتستقيم بها حياته، معادلة صعبة، ومن المعادلات الصعبة غير المقبولة أحيانًا يشع الأدب، قد تكون الحقيقة هى ما يتم التصريح به ويحدث على السطح، والأدب هو ما يفعل فى الخفاء.
وإذا كان المجتمع يبيح مناقشة كل مشكلاته علانية إلا هذه المشكلة، يتجاوزها ويردم عليها كأنها غير موجودة، فلمَ يغفل الكُتَّاب هذا مثل العامة، أليسوا مثقفين يلقون الضوء على المشكلات، كى يبدأ الآخرون فى حلها، أو مناقشتها، أو التنبه لها. الشيمي لم تتعمد الكتابة فى الرغبة غير المعلنة لكنها حكاءة، تجد فى قصص الآخرين مادة خصبة، وما كتبته لم يخرج عما يحدث، بل ما يحدث على أرض الواقع يفوق ما كتبته إدهاشًا.
ذات حوار سُئلت عن جرأتها في الكتابة رغم كونها امرأة جنوبية، فأجابت: كان يجب أن يُوجّه هذا السؤال إلى إميلى برونتى، تلك المرأة التى اقتحمت عالم الكتابة، فى القرن التاسع عشر غير آبهة بما سيقولون، لكنى كاتبة من القرن الواحد والعشرين، هل ما زال هذا السؤال مطروحًا ؟!
لا أرى أن كتاباتى جريئة أبدًا، هل هى أكثر جرأة مما جاء فى رواية ” إحدى عشرة دقيقة “ لباولو كويلهو؟، أو رواية ” برهان العسل “ لـ سلوى النعيمى، أو ” اكتشاف الشهوة “ لـ ” فضيلة الفاروق “، هل تصفقون لـ ” الحب فى زمن الكوليرا “، وهى رواية تحتوى على وصف دقيق لممارسات البطل الجنسية مع 20 امرأة على الأقل، ولا تقبلون التلميحات التى توجد فى قصصى عن الجنس، وهى تلميحات موظفة لخدمة الفكرة فقط، أم أن مفهوم الكتابة هناك يختلف عن مفهومها هنا، والكاتب الأجنبى يحق له ما لا يحق للعربى، إذن لم يقرأ العرب الكُتاب الغربيين؟ وكيف يأتى هذا السؤال فى هذا التوقيت، والأدب العربى التراثى مليء بكتب الجنس وهناك أفلام البورنو والمواقع الإباحية ! أنا لا أرسخ لأدب البورنو، ولا أرى أن كتاباتى إباحية وساخنة أبدًا، وأدفع بكتبى إلى أبنائى ليطّلعوا عليها، لكنه جيل يفضّل المرئى والمسموع. أما غريب عسقلاني فيكتب ذات مرة عن كتابات الشيمي القصصية فيقول إن اللافت في كتاباتها هو انشغالها باكتشاف الأنثى الساكنة فيها، من خلال البحث الواعي عن الآخر، الذي تريده، في مواجهة الرجل الذي ساقتها أقدارها، وضرورات الحياة لمجاورته في رحلة الحياة.
لذلك نراها تدخل مغامرة الكتابة متحررةً بقدر المستطاع من رقابة الآخرين، وصولًا إلى اكتشاف ذاتها أولًا، والوقوف على تضاريسها الداخلية المخبوءة، متسلحة بالمعرفة، هاضمة لروح الجماعة من حولها، باستيعاب العادات والتقاليد والمواريث الاجتماعية والتراثية، وإدراك سطوة البيئة التي تشكّل الفاعل الأقوى في تشكيل الوعي الجمعي في البيئات المحافظة، وما ينتج فيها من أفعال وردودها، يساعدها على ذلك امتلاكها لغة تمكّنها من القبض على روح الكلام، فهي حكاءة تستدعي التفاصيل وتلضمها في عناقيد سردية مشوقة، تأخذ المتلقي إلى لهاث يوازي لهاثها للوصول إلى محطات الحكاية الأخيرة.
الشيمي التي تكتب ذات مرة فتقول ” ما زلتُ أرقد هنا، أعي زمن اللحظة جيدا، أرقب ما حدث، وما سوف يحدث، أنتظر شروق الشمس، لتغرب من جديد مسجونة في قالب من القار الأسود، محنطة يداي إلى قدمي، ومدفونة بعبثية في مكان رملي ما “، لديها تحفّظ على مسألة الأكثر مبيعًا، وكذلك على الوعي في مصر، ونوعية الثقافة نفسها، والمدهش بالنسبة لها أن البعض يُصنّف الأكثر مبيعًا على أنها روايات رائعة، وفي الحقيقة هي ليست كذلك.
أما عن اللغة التي تكتب بها الشيمي فتقول: ” لا سيطرة لى على اللغة، القصة تكتبنى، ولا أكتبها، أقرؤها مثل أى قارئ لا يعرفنى بعد الانتهاء، وقد أندهش مثله، كيف حضرتنى الفكرة؟ ومن أين جاءت اللغة؟ ليس وحيًا، كما يقول البعض، بل نوع من تسلط جِنّى الكتابة، أكتب فى حالة التدفق والزخم، ولا يتربع القارئ فى مخيلتى عند الكتابة، بشكل أعم؛ إنتاج الكاتب بالنسبة للقارئ مثل السلعة التى تحقق له المتعة، إما أن يأخذها كلها كما هى أو يتركها، ولكل كاتب قارئ يفضله، ووجوده وتحققه لا ينفيان وجود كاتب آخر، له أسلوب مغاير، وفكر مغاير، انتشار كتابات هرمان هسه بعمقها الفلسفى غير المحدود، لم تمنع انتشار أزهار الشر لبودلير ولو بعد حين “.
الشيمي سألْتها عن رأيها سياسيًّا فأجابتني قائلة: ” على المستوى السياسي لا أعرف ما يحث تحديدًا.مشهد عبثي، ولأني ككل الناس غير مؤثرة في ما يحدث أحاول أن أتحصن مما يحدث.أبتعد عن مواكبة كل شيء بالاستماع لقناة الأغاني.لم أعد قادرة على مواكبة العبث، لا أجد مساسًا بالملفات الأهم بالنسبة للشعب الذي أنتمي إليه، الصحة والتعليم والمحليات، لا أشعر بأي تغيير، بل أرصد مزيدًا من التدهور! اسألني عن موعد فقرة فايزة أحمد، أو فيروز، خذ رأيي في فيلم أرض الخوف أو في شقة مصر الجديدة.اسألني عن رواية الراويات لمها الحسن، وعن مدرسة التأثيريين في الفن التشكيلي، من الممكن أن تعرج إلى السؤال عن حال الحديقة التي تقع أسفل شقتي بعد أن قطعت عنها البلدية المياه، وباتت مهددة بالجفاف، هذا هو عالمي الصغير الذي أحاول أن أخلقه وأنشغل به! “
وسألتها عن الدين فقالت: ” الدين هو ما يجعلك متسقًا مع نفسك، أن يكون لديك طاقة خير وجمال، أنا مؤمنة بما قاله عمر الخيام تمامًا: إما إلى العدم، أو إلى رب رحيم ” لم يخلقنا الله لنتعذب، وإذا كانت الحياة التي جعلتها الأنظمة العربية عذابًا، فلا أظن أن ثمة عذابًا آخر ينتظرنا! أما فكرة تجديد الخطاب الديني فتكاد تكون مستحيلة على المدى القريب، ثمة خطابات متعددة داخلية ووافدة ومصنوعة، ثمة اتجاهات متشددة متمثلة في السلفيين، وأخرى أقل تشددًا، وهناك داعش، هل ما يعتنقه الداعشيون يمت بصلة للإسلام؟ ثم ما الجهة التي ستقوم بتصحيح الخطابات؟ الأزهر؟ أظن أن دولة مدنية ستجعل الجميع يتعايش تحت لواء القانون، ستجعل الطمع في السلطة يتلاشى تدريجيًّا.ثم، ستقوم كل فرقة بتقويم سبيلها لتجد لها مكانًا تحت سقف هذه الدولة!
وسألتها عن المرأة فقالت لي: ” المرأة عادةً تحكم الكون، ليس مهمًّا أن تكون في الصدارة، بعد ما مررتُ به من تجربة، أرى أن الرجل نفسه لا يقدر إلا أن يستشيرها في كل كبيرة وصغيرة، ثمة من لا يَرين الصورة واضحة، فيطالبن بالحرية، وثمة مَن يصدق مِن الرجال بأنه قاهر المرأة.انظر: الكون عاشق ومعشوق، لا تفضيل لأحدهما على الآخر، كلاهما يكمل الآخر.هل تذكر ذلك الفيلم القديم، الذي انعزل فيه ثلاثة رجال، ثم، وجدنا النساء وقد ذهبن إليهم، وعادت الحياة لتستقيم، على كلٍّ، الانشغال بهذا الموضوع أجمل، ولا يهدد وحدة الأوطان، ألم تلحظ ؟ هو مجرد مناوشات مهما علت نبرتها، دليل على حب كل طرف للآخر “.
ومن روايتها ” بجحم حبة عنب “ التي كتبتها الشيمي نتيجة لمرض ابنها ورحيله، أختار هذا المقطع كنهاية لهذا البورتريه: ” أشعر أني أفقدك تدريجيًّا.أشعر أنهم لا يعالجونك، بل يساعدونني على تقبل فكرة فقدك بالتدريج، حتى أصل بنفسي إلى نتيجة أنَّ في موتك راحةً لك، فأتمنى لك الموت مع الجميع وقلبي ينفطر.الموت ليس شفاء من واقع بائس، الأمل في حياة أخرى ليس عزاءً حقيقيًّا للحياة مهما كانت الجنة جميلة.الحياة الأخرى في رحم الغيوم يا زياد، أوهام إيمان.تشبَّث بحافة المركب، وأخرج لسانك للجميع.أصبحت صدمة مرضك حدثًا ماضيًا ككل الأحداث، لكنه لا يأخذ لون الحنين.لا أستحضره بألفة، يفقدني إيماني وتريثي.ولا أركن إليه لاحتمال الحاضر والثقة في المستقبل.لنوغل معًا في الماضي الذي صار أبيض الآن، إذا ما قارنته بماضيَّ القريب! سأظل أحدثك بصمت، ما دمتَ قد أصبحت تضجر من الحوار، وتسمع الكلمات بأصداء معدنية “.لهذه الطريقة مفعولها السحري فلا تقلق، ستهبك كلماتي الصامتة المحبة، وجرعة من الصبر والتفاؤل.