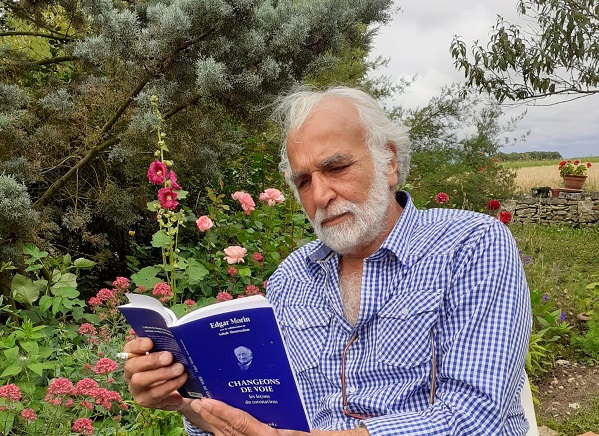تسير الروائية المصرية منصورة عز الدين في طريق مختلف عن الذي يسير فيه أبناء جيلها، فبروايتين ومجموعة قصصية فقط استطاعت أن تحفر اسمها في عالم الكتابة بطريقة مختلفة في السرد وبلغة وعالم يخصانها، فحازت عددا من الجوائز، وترجمت أعمالها إلى لغات مختلفة.
كانت مجموعتها القصصية الأولى “ضوء مهتز”، إرهاصة بداية كاتبة مختلفة، ثم ثلتها برواية “متاهة مريم”، التي أثارت جدلا نقديا، ثم روايتها “وراء الفردوس” التي وصلت بها للقائمة القصيرة في البوكر وترجمت للغات مختلفة. هنا حوار معها.
*وصلت روايتك “وراء الفردوس” إلى القائمة القصيرة للبوكر، قبل عامين. وحظيت باحتفاء نقدي غير مسبوق، هل ذلك يشجع على كتابة نص جديد أم يخيف؟
– بالتأكيد الاحتفاء النقدي الكبير، خاصة حين يأتي من أسماء لها وزنها ومشهود لها بالنزاهة، يمثل تشجيعاً ودعماً للكاتب، لكنه أيضاً يجعله حذراً في خطواته التالية. في ما يخصني أحاول أثناء الكتابة عزل نفسي عن الظروف المحيطة قدر الإمكان، خاصة على صعيد كيفية تلقي أعمالي السابقة. أبدأ كتابة كل عمل جديد كأنه عملي الأول، مع الاستفادة طبعاً مما أكتسبه من خبرة من عمل لآخر. باختصار، سعدت بما قوبلت به “وراء الفردوس” من حفاوة نقدية، كما أسعدني وصولها للقائمة القصيرة للبوكر العربية، لكني أودعت كل هذا في زاوية قصية من ذاكرتي بمجرد انشغالي بكتابة روايتي الجديدة “جبل الزمرد“.
* لماذا يحضر في كتابتك عالم الحلم والذكريات بقوة، هل تستعينين بذلك كاستراتيجية مقاومة للواقع؟
– يهيأ لي أن ما يهمني بالدرجة الأولى محاولة فهم هذا الواقع وإشهار حيرتي المعرفية في وجه عالم إشكالي بالغ التعقيد. في كتابتي لا أقدم إجابات بقدر ما أطرح أسئلة، أنحاز للشك القلِق وأرفض اليقين المطمئن. الحلم عندي وسيلة لفهم العالم، لتفكيكه وإعادة تركيبه المرة تلو الأخرى. هو أيضاً مرآة تنعكس عليها النفس البشرية بما تحمله من تناقضات وجوانب مظلمة. هو لغة اللاوعي ومترجمه. إضافة إلى أن مزج الحلم بالواقع والوقوف في المسافة المخاتلة بينهما يمنح فهماً أفضل لكليهما. منذ البداية أتململ من الكتابة الواقعية الصرفة، ومن التعبير فقط عمّا تراه العين وتلمسه اليد، يغويني أكثر القبض عبر الكلمات على ما لا يُرَى وما لا يُمسَك، على ما نحدس به في أحلام تكسر رتابة الواقع وتعيد اختراعه من جديد ممزوجاً بالفانتازيا. بالنسبة للذكريات، فالذاكرة وآلية عملها، انشغال أساسي عندي. نحن ما نتذكره من حياتنا، ولا يمكن فهم الحاضر دون الرجوع للماضي. في “وراء الفردوس” لم تحضر الذاكرة فقط عبر الذكريات التي تستعيدها البطلة سلمى رشيد، بل استعارت الرواية بنيتها وعمارتها من طريقة عمل الذاكرة، في قفزها من زمن لآخر ومن لحظة لأخرى.
* هل الكتابة من هذا المنطلق، لديك، تبدأ من منطقة “النوستالجيا”؟
– لا هي أبعد ما تكون عن ذلك. النوستالجيا توقع الكاتب في فخاخ كثيرة، قد توهمه مثلاً أن الماضي الذي يتناوله عصراً ذهبياً، فتعطل نظرته النقدية إليه. أحب تناول عوالمي بشكل مركب يتجاور فيه الجيد مع السيئ، المثالي مع الكارثي، وأن تتباين الشخصيات في منطلقاتها ويحمل كل منها خطابه الخاص. الرواية من وجهة نظري هي الفن الأكثر تركيباً، وهذا يجعلها تتجاوز كاتبها ذاته بأفكاره وقناعاته، لتقدم لقارئها عالماً موازياً للعالم الذي نعيش فيه، أو تخترع حتى عالماً غرائبياً لا يربطه بعالمنا إلاّ القليل، مبتعدةً عن فكرة أن الرواية هي مجرد محاكاة للواقع، مخلصةً فقط للخيال الجامح وحرية الاختراع والابتكار.
* لماذا تفضلين العودة في كتابتك إلى التاريخ القريب، سواء في “متاهة مريم”، أو “وراء الفردوس”، وهل الكتابة التاريخية تناسب مزاج القارئ الآن؟
– أولاً لا أظن أن كتابتي، حتى الآن، ينطبق عليها توصيف الكتابة التاريخية، هي فقط كما أشرت أنت تتماس مع التاريخ القريب وتشتبك معه بشكل يختلف من رواية لأخرى وفقاً للطموح الفني أو السؤال الذي كان منطلقي لكتابة كل عمل. في “متاهة مريم” كنت أطمح لمقاربة التاريخ الإجتماعي المصري، خلال النصف الثاني من القرن العشرين، في عمل كابوسي غرائبي. وفي “وراء الفردوس” كان التركيز على عقد الثمانينيات وما شهده من تغيرات أثرّت في المجتمع المصري ككل وليس الريف فقط، وتحضر هذه المرحلة كذكريات وارتجاعات زمنية تستحضرها سلمى رشيد بطلة الرواية وتضفرها مع الواقع الذي تعيشه. أعتقد أن الخيط الخفي الذي يربط العملين، إضافة إلى مزج الواقعي بالفانتازي، هو هذا السؤال الكامن عن تأثير الماضي على الحاضر وإفساده له؟ كأن المؤلف الضمني يسعى للقبض على جرثومة ما من ماضي الشخصيات أفسدت حاضرها وشوهته. بشكل عام لا أؤمن بفصل الماضي عن الحاضر، إذ أرى أن لحظتنا الحاضرة هي جماع من الماضي والحاضر والمستقبل في آن. نعيش حياتنا بصحبة ذاكرتنا الموشومة بآثار الماضي وبقاياه تائقين في الوقت نفسه لمستقبل غامض يتراءى لنا. الحاضر الخالص هو محض وهم وسراب. في “متاهة مريم”، و”وراء الفردوس” الحاضر هو نقطة الإنطلاق، لكن بطبيعة الحال لا يمكن فهمه بمعزل عن الماضي، عمّا حدث به، والأخطاء التي شابته.
* هل ترين نفسك معنية بالموت ومآلات المصائر في نصوصك أكثر من الحياة؟
– سؤال الموت كان مدخلي الأول لعوالم الخيال، إذ تعرفت عليه في سن صغيرة جداً، ولم أفهم وقتها كيف يختفي الموتى فجأة من حياتنا، ولا أين يغيبون. فقدي لوالدي في طفولتي دفعني لتأليف سيناريوهات متخيلة تبرر غيابه، بل وتعيده إلى الحياة. قضيت فترة لا بأس بها أتخيل ما يشبه رواية تقهر موته وتحييه من جديد، وأجهدت مخيلتي الصغيرة في سد ثغرات تلك الرواية ورأب صدوعها وهنّاتها. هكذا ارتبطت الكتابة عندي بفعل الحياة ومقاومة الموت، أو على الأقل محاولة فهمه وتبريره. كانت هذه السيناريوهات تدريبي الأول على الكتابة.
* قلت من قبل إن “القصة كانت بالنسبة لك أشبه بتمرينات على توسيع العالم والإمساك بتقنيات الكتابة وإجادتها”، هل القصة بالنسبة لك مرحلة أولى للكتابة، قبل الرواية، أم أنها يمكن أن تستمر؟
– قلت هذا بالفعل، لكنّي لم أقصد أبداً أن القصة مرحلة أولى سرعان ما أغادرها، كما لم أقصد أنها في مكانة أدنى من الرواية. كنت فقط أشير إلى ما حدث معي، إذ بدأت علاقتي بالكتابة مع القصة القصيرة التي ساعدتني على توسيع عوالمي الفنية والإمساك بتقنيات الكتابة، قبل أن أتجه للكتابة الروائية. القصة القصيرة بطبيعتها تتيح مساحة أكبر للّعب والتجريب، لكنّ الرواية أكثر تعقيداً وتركيباً على صعيد البناء وتضفير التفاصيل والشخصيات والأحداث مع بعضها بعضاً. كل فن من الفنين قائم بذاته، وله جمالياته الخاصة، أحب الرواية وأنحاز لها، لكني لم أنقطع عن كتابة القصة القصيرة، ولديّ مجموعة قصصية قيد النشر بعنوان “نحو الجنون“.
* من مقعدك كروائية، كيف تنظرين إلى المشهد السياسي الراهن في مصر، وكيف ومتى يمكن للروائي أن يشتبك معه إبداعيا؟
– المشهد السياسي الآن بالغ الفوضى. كيفية الاشتباك معه إبداعياً تختلف من مبدع لآخر فهناك من قد يقاربه بشكل مباشر، أو من يتعامل مع آثاره غير المباشرة، أو من يتجاوزه مركزاً على تجلياته الكابوسية والغرائبية، أو من يتجاهله تماماً. أما بخصوص التوقيت فأعتقد أن شرطه وجود مسافة ما تفصل الكاتب عن الحدث الراهن، وتمنحه فرصة التمعن فيه بعيداً عن الانفعال اللحظي، هذه المسافة قد تكون مسافة زمنية أو مسافة وجدانية. التورط عاطفياً أو فعلياً في ما يدور قد يعمي الكاتب ويمنعه من التقاط الكامن والمسكوت عنه، فتتحول كتابته إلى بروباغندا أو إلى مجرد سرد سطحي لما يراه الجميع على شاشات الفضائيات وما يشاركون فيه على الأرض.
* كيف ترين الفارق بين دور المثقفين قبل وبعد الثورة المصرية، هل ثمة جديد دخل على هذا الدور، أم أنه لا زال لا يبرح مقعده التنظيري؟
– المثقفون أصبحوا أكثر اشتباكاً مع الواقع السياسي، عدد كبير منهم شارك في الثورة منذ بدايتها ولم يكتف بالكتابة والتنظير، ورغم هذا أرى أن الثورة أفرزت جيلها الخاص المختلف من حيث اللغة والخيال والرؤية عن سابقيه، وهذا الجيل هو القادر على النهوض بها من عثرتها. يخيل لي أننا نحتاج في الفترة الحالية أيضاً إلى ساسة مسلحين الخيال، يمكنهم قراءة المشهد السياسي بلا أوهام أو أحكام مسبقة، ما نطلبه ونتوقعه من المثقف يختلف عمّا نطلبه من السياسي. وربما يكون الدور الأجدر بالمثقفين الآن، إضافة للمشاركة في التظاهرات، العمل على تفكيك الكثير من الأوهام السائدة، وعلى تحرير اللغة وتسمية الأشياء بمسمياتها.
* عملت طويلا في الصحافة الأدبية، في ظل تقييد الإصدارات الأدبية برؤساء تحرير تابعين للسلطة، على ماذا يراهن الكتاب الآن?
ـ وضع الصحافة المصرية القومية في ظل حكم الإخوان خانق وكارثي، وفي رأييّ أن الرهان دائماً هو على مقاومة الكتّاب والمثقفين ورفضهم لتقييد حرياتهم. معركة الدفاع عن حرية النشر والتعبير معركة مفصلية ودورنا جميعاً أن نتكاتف ضد أي محاولات للتضييق على الحريات بشكل عام وعلى حرية التعبير بشكل خاص. قامت الثورة من أجل مزيد من الحريات لا من أجل وأد الحريات. وأعتقد أن الرقابة في ظل لانفتاح الذي يشهده العالم الآن وفي ظل وجود إعلام بديل هي فعل عبثي يدل على قصر نظر بل عماء، وبالتالي مآلها الفشل، طال الوقت أم قصر.
* ماذا تريد منصورة عز الدين من الكتابة، إلى أين تريدين أن تصلي بها، وتصل بك؟
– ما أريده هو أن أظل أكتب بالشغف نفسه، أن تفاجئني الكتابة وتحملني إلى مساحات وعوالم لم أتخيل وجودها من قبل. أتمنى أن أتفرغ تماماً لها، ليس فقط بمعنى ألاّ أعمل عملاً آخر، ولكن بالأساس أن أفكر بها وأعيشها طوال الوقت.