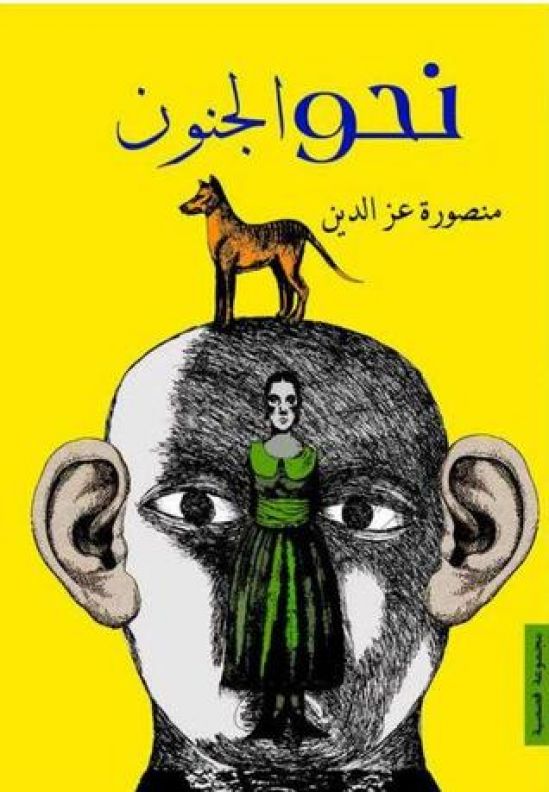أسامة كمال أبو زيد
هناك، بين الماء والحلم، في مساء رمضاني غابر، اكتشفت المقهى. أدركت حينها أن اللقاء لم يكن صدفة، بل ميعادًا تأخر. كنت أفتّش عن ظل يشبه مقاهي المنفيين من ضجيج المدن، تلك التي تحمل أسرارًا تلصق بالروح أكثر من الأرصفة. كنت أبحث عن ركنٍ فيه بعضٌ من نفَس الأولياء، شيء من طقوسهم الصامتة، شيء من عزلةٍ دافئة. وحين وصلت إليه، لم أصل أنا، بل هو الذي احتواني. كأن روحًا قديمة رتّبت الموعد، أعدّت لي المقعد، ثم ابتعدت لتراقب من بعيد. لم يكن المقهى في شارع عريض، بل في زقاقٍ يشبه النسيان، ضيقٍ مُطرّز ببقايا الزمن، تتسرب الحياة من جدرانه المتآكلة، ومن نوافذه نصف المفتوحة، ومن روائح البنّ التي لا تخون موعدها.
ومنذ أن ركنت إليه، لم أغادره. صار هو المرفأ والظلّ والونس. بين طاولاته التقيت غرباء صاروا أصدقاء، وشعراء لا يكتبون، وفنانين لا يعلّقون لوحاتهم في أي معرض. كان المقهى بيتًا لنا، نحن الذين نحمل في صدورنا أصواتًا لا تسمعها المدينة. وكان السرّ كله، والسحر العميق، في ذلك الرجل الجالس في صدر المكان؛ شيخٌ بلا عمامة، لكن عينيه تُمسكان بكل ما يدور. لا شيء يفلت منه… لا فنجان قهوة، لا حجر نرجيلة، لا همسة بين صديقين، ولا ارتجافة يد وضعت النقود ثم سحبتها بخجل. يعرف الجميع، لا بأسمائهم، بل بخطواتهم، بطريقة جلوسهم، وبالحزن الذي يرافقهم كظل إضافي. لم يكن أحد يحاسبه، لأنه يعرف كل شيء. إلى جواره علبة فضية صغيرة، غريبة الملمح، كأنها وصلت من زمن آخر، يصبّ فيها النقود. لا أحد يجادله. وحده كان العارف.
المقهى لم يكن يُغلق إلا في اليوم العاشر من كل شهر، أيًّا كان اليوم: عيدًا أو جمعة. يغلق بابه بهدوء، لا ليستريح، بل ليستعيد توازنه. هناك نظام خفيّ يحكم كل شيء. لكل عامل ركنه، لا يخطئه ولا يبدله، كأن المكان مسرحٌ كبيرٌ يحفظ الجميع أدوارهم عن ظهر قلب. إن غاب واحد، اختل التوازن. وإن اختل التوازن، ارتبك الزمن في المقهى. الرجل الجالس في الصدر لم يكن مديرًا، بل حافظ سرّ. يحفظ الإيقاع والنغمة، حتى تمدّد المكان وابتلع نصف الشارع، وكاد يلتهم النصف الآخر. بدا أن الزمن قد هدأ أخيرًا، وأن الركن تحوّل إلى حصنٍ لا تُفلته الأيام. ثم حدث ما لم يتوقعه أحد. في صباحٍ عادي، رحل الرجل. بلا وداع، بلا تمهيد، بلا علّة. كأن قلبه اكتفى بما رأى. ترك المقهى واقفًا، لكنه لم يبقَ حيًّا. تركه ممتلئًا، لكن الروح انسحبت. جاء الورثة، فوجدوا كنزًا لا يعرفون كيف يقبضون عليه. حاولوا، تراجعوا، انشغلوا، غابوا. وبدأ المقهى ينكمش كما ينكمش الضوء… جزءًا بعد جزء، حتى لم يبقَ سوى ركن صغير، مغلق أغلب الوقت. وإن فُتح، بدا كأنك تفتح صندوقًا قديمًا تتطاير منه الذكرى أكثر من الهواء. لم يبقَ سوى صورة كبيرة للرجل، معلقة وحيدة فوق جدار باهت؛ صورة تشبه تنهيدةً متجمدة في آخر المقهى، تنظر إليك ولا تطلب شيئًا… سوى أن تذكّرك بأن كل ما كان، قد انقضى.
كلما مررت بالمكان، شعرت أن المقهى لم يمت، بل توارى. كأنه يرفض أن يُختصر في ذكرى باهتة على صفحة قديمة. كأنه يحنّ إلى جلسته الأولى، إلى صمته، إلى زبائنه الذين لا يسألون، وإلى روائح القهوة التي كانت تمتزج مثل موسيقى. يريد أن يعود كما كان: ظلًّا حيًّا، مكانًا يُشرب فيه المعنى لا القهوة. المقهى ما زال هناك، رغم الصمت، رغم الغياب، رغم الغبار… ورغم تلك الصورة الوحيدة المعلقة في آخره؛ صورة لرجلٍ كان يعرفنا جميعًا من مشيتنا، وللمقهى الذي كان يعرفنا من صمتنا.
لم يعد… لكنه، في مكانٍ ما، لا يزال ينتظر.
…………………….
*البازار… أقدم وأشهر أسواق بورسعيد، وُلد مع ميلاد المدينة نفسها.