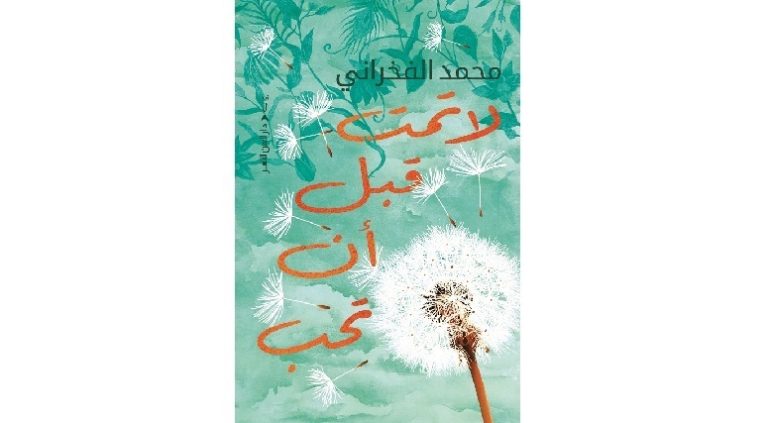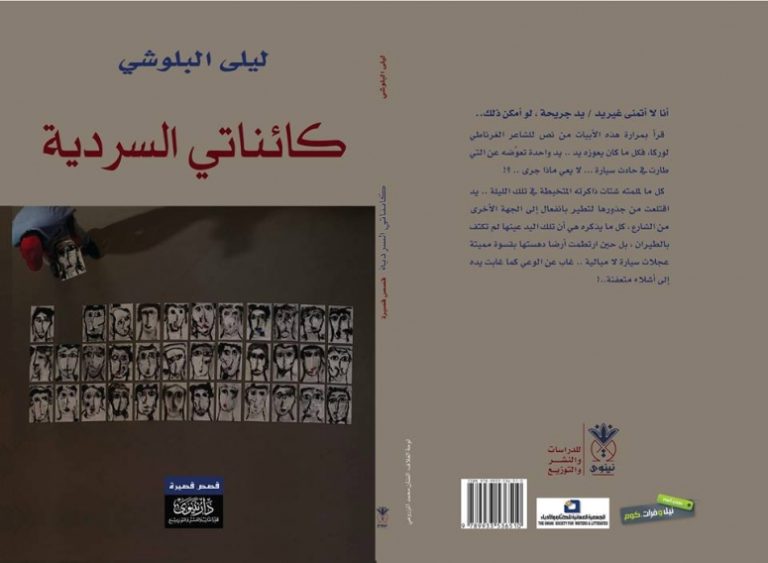مينا ناجي
باريس 1
ونحن ننعطف في ممرِّ سان سباستيان عند نهاية حيِّ سان أمبروس، أحكي لدورا بحماسٍ عن العرض الذي نعدُّه.. سنستعين بلوحات دالي وإرنست وماجريت ودوروثيا تانينج المستوحاة من الرواية كديكورٍ وخلفيَّاتٍ للمشاهد.. ستكون أليس نيمفو حقيقيَّةً تحبُّ الجنس بشبقٍ أصيلٍ.. ستخبر جوقة حفل الشاي الأبديِّ: لنخلع ملابسنا ونتظاهر بأننا أرانب مكهربة! “التفاصيل أنانية، الذوبان معْطاء.. هذا هو الشعار”.. أقول لدورا. الحرِّيَّة في تقبُّل الغير وإهدار النفس على مذبح الجموع.. إيروس وفيلوس وأجابي يرتِّلون في كورس الآلهة معًا نغمة التواصل والتشابك الملحميَّة..
نسير قُدمًا في الممرِّ وأنا أشرح لها أن الأورجي احتفالٌ عربيديٌّ صاخبٌ للقلب الوحيد، الطقس الأكثر تواضعًا: “فيه لا تكوني مركز الحدث، ولا فاعله الرئيسيَّ، بل هي الرغبة العمياء المشاع، أنتِ مجرَّد جزءٍ من الكلِّ، ترسٍ في الآلة الكبيرة، ذراعٍ خشبيٍّ للطاحونة، أرنبٍ في حفرةٍ مليئةٍ بالأرانب”… أستمرُّ في استطرادي عن الإمكانيَّات المسرحيَّة للرقص تعبيرًا عن آلةٍ غنائيَّةٍ جسدانيَّةٍ مركَّبةٍ كالأورجي، تشيع البهجة البوليفونيَّة عبر أوتار الأعضاء الجنسيَّة المشدودة والمتعرِّقة.
حتى سمعنا الصوت يخرج من اللامكان..
تسمَّرنا مكاننا.. ومع ذلك، اصطدم بنا جسد من الخلف.. التصقت دورا بي بشكلٍ تلقائيٍّ وانكمشت بجانبي الأيسر.. عاد الصوت أكثر قسوةٍ.. حاولت أن أتكلَّم بشكلٍ هادئٍ وواثقٍ.. – ماذا تريد؟ كان يغطِّي رأسه كاملًا بغطاءٍ صوفيٍّ أسود لا يُظهر سوى عينيه وفمه، في يده سكينٌ يلمع في أعين الكاميرات بالزوايا.. – لا داعٍ للعنف! نظرتُ في عينيه لأرى وقع كلامي عليه، فصُعِقتُ بقسوةٍ غير عاديَّةٍ فيهما.. لكن شيئًا ما جعلني أتعاطف معه، أن أدرك كنه تلك النظرة بعد لحظة.. تمنيتُ رؤية وجهه مشوَّهًا ومخرَّبًا دون المساس بعينيه.. تلك النظرة الثاقبة أسرتني.. لم أعد أرى عينيه وفمه المغلق في قسوةٍ كتهديدٍ لي، بل أرى خلاصته.. ماهيته.. كلُّ أعضائي ارتجفت.. ليس الأمر غضبًا أو كراهيةً أو حتى خوفٍ، بل أكاد أقول إنني أحبُّه، وأعرف كيف أمدُّ الجسور معه.. كلُّ ضربةٍ هي هتاف مبادرةٍ مني كي ألتحمُ بجوهر ذاته، وبالأشياء كلِّها داخله.. أنزعُ نفسي إليه.. أتَّحدُ معه.. أتناغمُ.. كلَّما واصلتُ طاقتي بطاقته ازددنا وهجًا. كالفيضان أنا وهو نرتفع معًا، وصيحاتٌ تحوِّطُنا بسياجٍ يحمينا.. لم أعد أسمع الآن.. وأكاد لا أرى.. لكني أحضنه إلى ذاته، الذي كان لي منذ البدء، الذي أراه خاصَّتي، بهيامٍ إلى خلاصته، هذا الذي هفا إليَّ وحرارة جسده تدفئني.. أدمِّرُ غلافه كي أجلوه لي.. أستطعمهُ.. أتمادى معه.. أتفاهم وأستفْهمه.. على فمه بكل عزيمتي تكتَّلتُ.
صوت ارتطامٍ مفجِعٍ أفاقني، في نفس اللحظة التي صرخت فيها دورا، وعادت حواسِّي فجأةً كلها بإيقاع الزمن السريع، بعد أن كان سائلًا لزجًا يكتم كلَّ شيءٍ.
ارتدَّ الرجل إلى الوراء كطائرٍ تلقَّى رصاصةً في صدره.. لم أشعر بالآخر يتحرَّك خلفي حتى وصل إلى مجال بصري.. كلُّ ما رأيته أنه سدَّد سكينه الكبيرة المشرشرة في غلٍّ داخل جانبي الأيمن.. متزامنًا بعدها بلحظةٍ مع ضربة شيءٍ صلدٍ على مؤخِّرة رأسي.. واسودَّت الدنيا.
1
الصحراء الغربية 1982.. 7 مارس الساعة 11 مساءً ودقيقتين.
لن تستطيعي أن تكوني في هذا المكان والزمان أبدًا..
المغزى؟ الإنسان له حدود.. أين تنتهي هذه الحدود التي تبدأ بتلك الفجوة الزمكانيَّة؟ لو سردتها عليكِ، لن يطاوعكِ قلبك أن تقومي حتى من مكانك الذي تجلسين فيه تقرأين هذا الكلام!
أكتب لكِ لأن الرسائل علامات انفصالٍ كما يقول بيسوا، علاماتٌ نكتبها بالضرورة لأننا بعيدون الواحد عن الآخر.. أكتب لأنني لم أقدر أن أفهم في مرَّةٍ من المرَّات التي حاولتُ فيها جاهدًا، حقيقة ذلك الذي لا يُستطاع استعادته أبدًا.. حاولت بالفعل جاهدًا أن أفهم.. اليوم كنتُ في خروجةٍ ودِّيَّةٍ، وكان الكلام عن الحبِّ.. جاوبت تلك الفتاة ببساطةٍ ووضوحٍ كأنها تشرب الماء.. فهمت لحظتها أن الأمر ليس أني غير قادر على الفهم، بل غير راضٍ عن القبول؛ هذه الفتاة اللطيفة حلَّت المعضلة بنفيها.. الحبُّ ينتهي ويموت ويحدث مرةً أخرى مع آخرين.
قبل هذا الزمن تقابلنا. في سنتكِ النهائيَّة بالجامعة.. تصغرينني بعامٍ. عندما صارحتِني بمشاكلك، لم أنتبه بما فيه الكفاية، قلت لكِ إننا لسنا أكثر غرابة أطوارٍ عن الآخرين، بل قلتُ أيضًا نحن بطريقةٍ ما أكثر سويَّةً (كم أضحك على هذا الآن!) كان على أن أفهم من البداية، أليس كذلك؟ أن أفهم أن هذه بداية النهاية.. الشكوى المستمرَّة هي علامة بداية النهاية دائمًا.
يقول بورخيس أن المتاهة الأكثر رعبًا من المتاهة الدائريَّة هي متاهةٌ في خطٍّ مستقيمٍ.. لي أن أظن أنه يتحدَّث عن الزمن ومروره الخادع.. ما عرفته خلال تلك المتاهة على وجه اليقين هو أن الحبَّ يظهر بكامل وجوده حين يعمل الواحد ضدَّ نفسه، حين يبدو كشيءٍ خارج الحسابات المنطقيَّة للانتفاع والحفاظ على الذات، مجسَّدًا في شعور الرضى بالخروج من اللعبة خاسرًا.
لكن كيف ارتبط دخولك – وخروجك من – حياتي بشعوري بأني كبرت، وأن الموتَ أفقٌ مرسومٌ، والدين وشاحٌ خلعته، والمجتمع خصمٌ قذرٌ أحتاجه دائمًا، والحب ينتهي ويموت ويحدث مرّةً أخرى في متاهة خطٍّ مستقيمٍ؟
2
جيِّدٌ.. جيِّدٌ لأنك تجعلينني أُخرِج ما أزدرده باستمرارٍ، حتى جعلته خميرةً سحريَّةً تصلح لأن يجلس ويحكيها الأمير الصغير للأطفال الذين لن يفهموا شيئًا، والكبار الذين سوف يتجنَّبونها في خجلٍ وحرجٍ كأنهم لا يسمعونها.. دعيني أقول لكِ في بادئ الأمر: صحوتُ الآن وسط الليل مفزوعًا أتصبَّبُ عرقًا لأكتب لكِ.. لعلَّكِ تعلمين بحدسٍ ما.. تترائين لي في أحلامي كعادتك، دائمًا تنادينني في مكانٍ غريبٍ تسمينه “هنا!”
كلُّ الأمور تمضي.. هذا صحيح.. لكن بعض الأشياء تأخذ وقتًا أكثر من غيرها.. النقطةالأوَّليَّة والأهم في خطوة العلاج النفسيِّ، أقول لكِ، هي أنها تُحدُّ من لا نهائيَّة المشكلة والألمداخل الذات، وتضعها في إطارٍ ذي أبعادٍ مُحدَّدةٍيمكن التعامل معها.. في انتظار دوري في صالة المُحلِّلة النفسيَّة، أنظر إلى أغلفة مجلَّات وكتب تقضية الوقت المتراصَّة على الطاولة، وأفكِّر فيما سيكون شكل الجلسة الأولى بعد قليلٍ.. وهل سأصاب بنوبة فزعٍ أو لا.. تصادقتُ يا ليلى مع طفلةٍ تُعالج أيضًا مع نفس المُحللة لا يتخطَّى عمرها التاسعة.. مؤلمٌ، أليس كذلك؟ طفلةٌ في هذا العمر بدلًا من أن تلعب وتمرح مع أقرانها؟ ننتظر معًا خارج الغرفة في صالة العيادة ونتحادث عن الأفلام والأغاني واللغات التي تتعلمها في الصيف.
تمدَّدتُ على الشازلونج.. المحلِّلة الشابَّة صامتةٌ تنتظرني كي أتكلَّم.. بدأت الكلام بصوتٍ خفيضٍ من ثمَّ ارتفعت نبرته.. لقد حلمتُ هذا الحلم.. لا أتذكَّر الكلمة الأولى، وإن تذكَّرتها سأُبقيها مدفونةً داخلي.. سألتني لمَ أخاف الكبر والعجز والموت؟ لم تعجبها إجابتي وغضبتْ، لكني آثرتُ الصمت كعادتي حين يغضب مني أحد..قلت في خجلٍ إني سأحاول أن أركِّز تفكيري على الزواج والحبِّ والأطفال كما ينبغي لأحدٍ في مثل سِنِّي، لا الموت والرعب والعجز والتحلُّل والوحدة.. بعد انتهاء الجلسة فكرتُ في الله كأمل.. الله كانتظار لشيءٍ سعيدٍ يشرح الروح سيقع ليمسح كلَّ الأوجاع والآلام.. منتشيًا بالفكرة وبإحساسٍ خالصٍ بوجود الله، قررتُ قرارًا مفاجئًا.. أن أذهب خلال شارعٍ مجهولٍ بدلًا من أن أرجع للسيارة، سرتُ خلال مناخٍ مختلفٍ تمامًا؛ أطفالٌ صغارٌ يلعبون في القذارة، ناسٌ يأكلون الفول على عربةٍ على الرصيف، أبتسم وأضحك بطريقةٍ مريضةٍ بهذه النغزة الصغيرة بقلبي.. نغزةٌ قبضت صدري وصعدت إلى حلقي وجعلتني أُجهش في البكاء في وسط الشارع.
أحدِّق في الظلام يا ليلى بعد أن استيقظت مفزوعًا من كابوسٍ كنتِ فيه، لأكتب لكِ على ضوء شاشة اللابتوب: الحبُ هو الخدعة التي تنجينا من جنون هذه الفكرة.. فكرة أننا داخل أسطواناتٍ معزولةٍ بمفردنا، أنه لا سبيل للتوصُّل إلى آخر ما أينما كان، أننا وحدنا، وحدنا تمامًا داخل أجسامنا. هذه الفكرة المرعبة بأنه على الرغم من تلك المليارات من البشر لا نعرف أحدًا حقًّا، ولا نعيش مع أحدٍ سوى أنفسنا.. تتحوَّل هذه الخدعة إلى أفكارٍ نعيش بها، أفكارٍ كونيَّةٍ تسمح لنا بالتسامح مع كوننا ضعفاء وهشُّون.. وبالرغم من كوننا وحدنا، إلا أنه يوجد شخصٌ ما بالخارج موجودٌ لأجلنا.. لأجلنا فقط.. نستطيع التواصل معه على عمقٍ قد يدفع هذه الوحشة اللانهائيَّة، تلك التي نُميت أنفسنا كلَّ لحظةٍ للهروب منها.. كان لا بدَّ أن أطوي الصفحة، أعلم، لكني فشلت.. أنا شخص يا ليلى لا أودُّ العيش معه.
مع ذلك لم أبلغ الجنون، أقول لكِ، دائمًا كنتُ أتجنَّبه ما إن تبلغني رائحته الحرِّيفة.. لكنني أخشى كثيرًا، خصوصًا في أيام الصمت الثقيل، والجسد يخونني بكيميائه متفلِّتًا من ربقتي، أن يبلغني هو.. المرض العقليُّ في عائلتنا وراثيٌّ.. أحسب أنني سأنتحر حينها.. حين ينغلق عليَّ اليأس والمرض.
3
الجامعة خاصَّةٌ دوليَّةٌ غالية المصروفات.. رسميًّا لا آخذ مصروفًا منذ أعوامٍ بعدما منعه أبي عني، لكني أخنصِر من نقود البنزين والورق الذي لا بد أن يُطبع لسببٍ لا أعرفه، بجانب دعم أمي الماديِّ لي.. لم يحاول أبي مواصلة الارتقاء الطبقيِّ بعد الرجوع من الخليج حيث ولدتُ هناك.. بقي جالسًا في المنزل كأنَّ حياته قد انتهت عند هذه النقطة.. تعرفين.. لدينا سيارةٌ يابانيَّةٌ موديل 76، تعطل خمسة مراتٍ أسبوعيًّا – وهنَّ المرات الخمس التي أذهب فيها إلى الجامعة – في دخولنا العام الدراسيِّ الجديد – السادس بالنسبة لي لأني رسبتُ في موادَّ عديدةٍ على مدار الفصول السابقة – رأيتكِ.. فتاةٌ سمراء محجَّبةٌ بلا شيءٍ خاصٍّ يميِّزها، تمشي بهدوءٍ حاملةً كشاكيل السلك على ذراعها المثنيِّ وتتحدَّث باسمةً مع صديقتها، وفي عيونهما حماسة المستقبل واستقبال مرحلةٍ جديدةٍ على وشك الحدوث.. دومًا نفس نظرة الشغف والتطلُّع في السنة النهائيَّة من الدراسة.. الملل ممتزجٌ بالتطلُّع وحالة الوشوك على إنهاء مرحلة انتظار مُجهِدٍ.. كيف لم أركِ من قبل؟ أو أنني رأيتكِ ولم أنتبه؟ قلت لنفسي: صدرٌ صغيرٌ لكن هناك احتمالًا كبيرًا لأن أحبك.. ما المسافة بين رؤية شخصٍ والإعجاب به، وبين السكون إليه؟ إنها مسافةٌ مكوَّنةٌ من الرقص الطقسيِّ الحيوانيِّ والتعقيدات الإنسانيَّة وكميَّةٍ لا نهائيَّةٍ من المخاوف والشكوك والتردُّد وعدم الثقة.. في تلك الحالات التي أعرف مُسبقًا أنها فوق قدراتي.. أتخيل أنا بديلةً لي تعيش في مدينة باريس.. مختلفةً كلَّ مرَّةٍ: كلانا في نفس المرحلة العمريَّة تقريبًا، إلا أنه يتصرف بشكلٍ أكثر حنكةٍ وخبرةٍ: يجلس في مؤخِّرة المقهى، بعيدًا عن أعين الناس.. تحيط به مرايا كبيرةٌ، إضاءةٌ خافتةٌ ومقاعد مغطاةٌ بقماشٍ شبيهٍ بالجلد.. المقاهي هي أفضل شيءٍ في باريس، لا المتاحف ولا المعارض.. فريدريك.. نعم، دعينا نسميه فريدريك.. يجلس فريدو في مقهى قريب من محطة سان لازار.. قميصًا أبيض.. غرة طويلة.. بنطلون جينز بأزرارٍ فضيَّةٍ.. وشعره متموِّجٌ كبطلٍ أغريقيٍّ مهمومٍ.. نحافةٌ تبدو زائدةً عن الحدِّ.. عيناه سوداوتان بطريقةٍ غريبةٍ تحت إضاءة المقهى الخافتة، رغم أن الوقت نهارًا.. ذلك لأن ضوء الشمس لا يصل في العمق إلى الطاولات والمقاعد.. “استلقينا في حجرات البحر / بجانب الحوريات المكلَّلات بالأعشاب: أحمرٌ وبنيٌّ / حتى أيقظتنا أصواتٌ بشريَّةٌ، وغرقنا”. هكذا يقرأ فريدو نهاية قصيدة لإليوت ويغلق الكتاب ويقوم.. يحاسب الشابة وراء الكاونتر بتنورةٍ قصيرةٍ وسيقانٍ طويلةٍ، ويضع الجاكيت الجلد البنِّيَّ على كتفه الأيمن ماسكًا إياه بأصبعٍ واحدٍ ويخرج إلى الشارع بعد أن يدفع الباب الزجاجيَّ بيده الأخرى، فيصدر بملامسته أجراسًا صغيرةً مُعلّقة بجانب ملاكٍ جصِّيٍّ صغيرٍ أبيض، صوتًا حميميًّا لطيفًا.
4
في الجلسة التالية حكيتُ لمحلِّلتي الشابة عن التي كانت تجلس أمامي على كرسيٍّ كبيرٍ من الطراز القديم، وأنا جالسٌ على الأرض فوق وسادةٍ حمراء هي كيسٌ كبيرٌ محشوٌّ خرزًا فيلِّينيًّا يبدو كعوَّامةٍ بلا فتحةٍ، وفي يدها سيجارةٌ مشتعلةٌ؛ تقول إن الإنسان إذ ما وصل إلى ما يفترض الوصول إليه، يكون لديه دافعٌ مقنعٌ للانتحار.. كانت خرِّيجة كلية الفلسفة وتقول بطريقةٍ عاديَّةٍ إنها ستنهي حياتها في الـ37.. أذهلني التماثل بينها وبينك.. نفس الرقم الذي طرحتيه بعفويَّةٍ.. ارتجف عقلي المتشرِّب كئوس الفودكا والمارتيني حينها.. سألتني المحلِّلة هل أفكر في الانتحار؟ فشرحت لها أن مَن على هامش الحياة يُدرِك أنه لا يحتاج إلى فعلٍ إراديٍّ لتركها.. من يصيبه نوبات الفزع، يعرف تمامًا كيف تنسحب الحياة من حلقومه، ويرى الخطَّ الفاصل المُرَّ بعينيه.. حينها يرى الحياة بطريقةٍ مختلفةٍ، تجعل من السُّخف أن يحدِّد لها حدًّا معيَّنًا دون غيره.. فهي ثعبان أناكوندا ضخمٌ يلوي جذعه باستمرار.. ليس عليكِ ترويض الوحش.. دعيه ينقضُّ عليكِ بهدوءٍ ويرحل.. أظن هذا بالفعل.. إذا تركت نوبة فزعٍ دون مقاومةٍ، سأموت.. طبعًا قبل أن أدرك أن أسوأ شيءٍ أثناء نوبة الفزع هو مقاومتها.. الخبرة لها ثمنٌ.. والانتحار – في النهاية – رسالةٌ، رسالةٌ مثل تلك التي أكتبها لكِ الآن بعد الثالثة صباحًا.. فعل الانتحار إشارةٌ أخيرةٌ لحلِّ الموقف، رسالةٌ مُضمَّنةٌ لشخصٍ آخر كي يكمل دائرة الموقف: يعذره أو ينفعل به أو حتى يشتبك مع مَنْطقه.. الانتحار هو أعلى طريقة للتكيُّف، حيث الواقع يبقى موجودًا، والأنا غير موجودةٍ للتأثُّر به، تعاملٍ قاطعٍ مع الموقف الوجوديِّ وأعلى نوعٍ من التواصل؛ علانيةً فجَّةً، جذب انتباه واهتمام، إعلان بوضوح عن رسالةٍ أو هدفٍ لأكبر عددٍ ممكنٍ – نقل الذات للآخرين حرفيًّا.. يجول بخاطري انتحار جيل دولوز.. قفز من شباك نافذته بالدور الرابع، وهي الطريقة التي احتاجت الكثير من المجهود نظرًا لحالته الصحيَّة المتدهورة، في حين كان بإمكانه أن يتَّخذ وسائل أكثر هدوءًا وأقل عنفًا للموت.. أنا أخذت الحدث كفعل اعتراضٍ وجوديٍّ بسبب المرض المهين والقاتل الذي تعرَّض له، فالجميع يعرف أنه رفض أن يقابل أحدًا في فترة مرضه حتى لا يُرى في هذه الحالة من الضعف والمهانة وقلة الحيلة.. أما ما أفكر فيه الآن فهو على النقيض تمامًا: هو لم ينتحر اعتراضًا، على العكس، أراد في فعله الأخير، فعله الذي يتحكَّم به في وجوده وميعاد موته، أن يكون فعلًا حيويًّا نشطًا، جسمانيًّا: أن يفتح الشباك للنور ويقفز منه. أراد في فعله الأخير أن يشعر بنفسه وهو يطير.