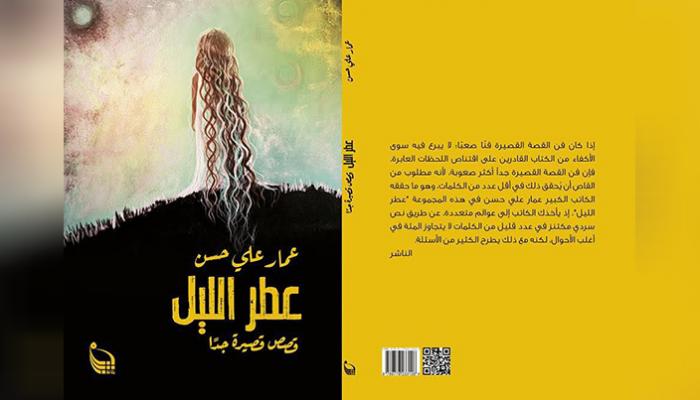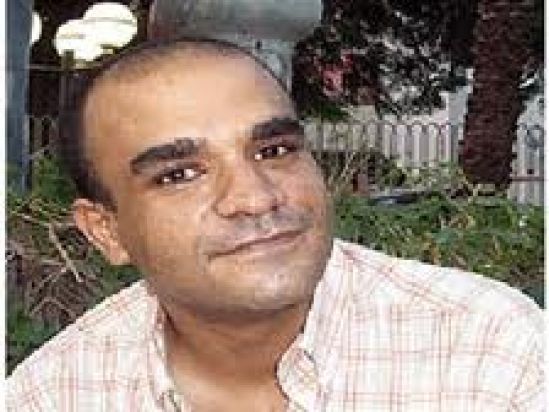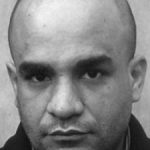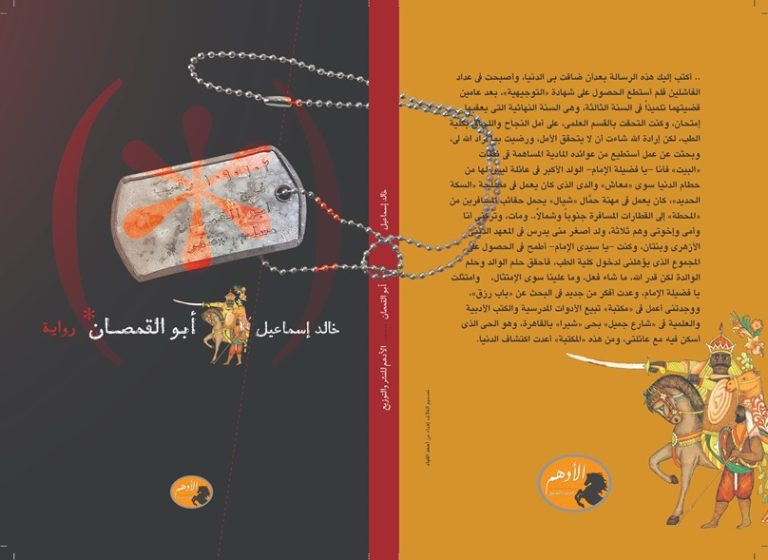د. شيرين أبو النجا
هل كتب أشرف الصباغ في روايته مقاطع من سيرة أبو الوفا المصري أم كتب مقاطع من سيرة حيوات أخرى عاشت تقطع الطريق بين القاهرة وموسكو لتكون صورة أخرى فتولد من جديد ظاهريا، أو تنسى ماض ما لتنشأ حاضرا وهميا، أو لتهرب من فشل مقيم أملا في تحقيق نجاح مبهر، أو لتهرب من شعارات النضال إلى نانسي عجرم. ماذا كتب الصباغ في روايته؟
يبدو من السهل القول أن الصباغ حاول رسم عدة شخصيات مأزومة- في القلب منها ابراهيم عفيفي- في الترحال من واقع سىء (القاهرة) إلى واقع لم يتماسك كثيرا في مواجهة الانهيار (موسكو)، ويمكن القول أيضا أن الصباغ كان يحاول طرح شخصيات تتعامل مع مكان آخر بوصفه نقطة جديدة لا قبلها ولا بعدها، وقد يحلو للبعض القول أن الرواية ليست إلا عن السفر من أجل العودة (للذات عبر اكتشافها أو للوطن عبر التصالح معه). لكن يبدو لي أن الكاتب ذاته قد حسم كل هذه التفاسير النقدية عندما أكد أن روايته- سيرة أبو الوفا- لا تسعى إلى أى من هذه الأشكال والقوالب، وذلك عندما قال:
… من الصعب تماما أن نعقد أية مقارنة بين ابراهيم عفيفي ومصطفى سعيد مثلا (صديق الطيب صالح في رواية “موسم الهجرة إلى الشمال”). بل ومن الأصعب أن ندفع بعفيفي البسيط والمسكين في مقارنة غير عادلة مع بطل “حب في المنفى” لبهاء طاهر، أو بطل “قنديل أم هاشم” ليحيى حقي، أو حتى مع بطل “عصفور من الشرق” لتوفيق الحكيم. فمن الواضح أن عفيفي اكتسب خبرته الحياتية من مصادر أخرى، بصرف النظر عن كونها نظرية أو عملية، وسلك طرقا مختلفة بعض الشىء، أو كل الشىء، عن أولئك الأبطال الوهميين- الروائيين (ص76).
لا يمكن إذن قراءة أى من الشخصيات سواء كان ابراهيم عفيفي- الصوت الرئيسي في السرد- أو أحمد جمعة أو آدم ادريس أو سعيد عبد النصير أو محمود الخضري أو عنتر أو محروس باعتبارها تحمل سمات أو حتى بعض من سمات شخصيات أى من الروايات المذكورة في الاقتباس. فتلك الشخصيات كان أزمتها منحصرة في فكرة الشرق والغرب، بكل معايير الصدمة والاحتكاك والتفاعل على مستوى التصالح والتفاهم أو النفى والتصادم. في حين أن ابراهيم عفيفي، على سبيل المثال، ما كان إطلاقا يهمه شكل العلاقة بين القاهرة وموسكو، أو تأثير المكان والثقافة عليه هو ومن حوله، إذ كان “لا يضع أى خلفيات في تقديراته لتصرفات الناس وسلوكياتهم. بل وأقلع- لحسن حظه، أو لسوئه- عن الشعارات الكبرى والعبارات المنمقة منذ زمن طويل” (ص 77). وكأن شخصية ابراهيم عفيفي تستند على المفارقة التي تتجلى في الأفكار، في رؤية الذات لنفسها وللعالم من حولها. وهي المفارقة التي تستند عليها الرواية بأكملها، في شكل يشبه ما قام به إميل حبيبي في “الوقائع الغريبة في اختفاء أبى سعيد النحس المتشائل”. ورغم أن الكاتب لا يأتي على ذكر المفارقة كتقنية شكلية وكأساس وجودي إلا أنه يعي تماما أن “المواطن إميل حبيبي” بكتابته المعتمدة على المفارقة الإنسانية “يروي الذاكرة، فتنمو وتترعرع وتظل في حراك دائم وأبدي” (ص 53).
تتجلى المفارقة الأدبية بداية في تأكيد الكاتب على أن ابراهيم عفيفي سلك طرقا مختلفة عن “أولئك الأبطال الوهميين الروائيين”، وبذلك يخرج الصباغ شخصياته من مدار البطولة أو حتى ادعائها- وهو ما يظهر في مفتتح الرواية حين قال آدم إدريس “في تواضع مصطنع: جلست مع فيدل كاسترو ودخنا سيجار هافانا. تحدثنا عن جيفارا والثورة، ومهام الاشتراكية الكوبية في المستقبل” (ص 5)، ليكتشف القارىء سريعا أن “للخمر قوانين لا يخالفها الا الجاحد بالنعمة” (ص 6). أما التجلي الثاني للمفارقة فيبدو في محاولة الكاتب إخراج روايته من مضمار الرواية، -“الأبطال الوهميين الروائيين”- وإدخالها في مضمار “ما حدث فعليا” بوصفه “مقاطع من سيرة”. كأن الصباغ يعلن أن أبطاله (الأبطال الضد بالأحرى) ليسوا إلا شخصيات عاشت فعليا وتحولت إلى جزء من نسيج السيرة المذكورة في عنوان الرواية. وليؤكد على ذلك يستعين ببعض الوقائع المعروفة مثل موت مجدي حسنين وسيد عويس (ربما يقصد سيد خميس)، ويستخدم أسماء حقيقية بشكل مباشر مثل بهيجة حسين وأحمد الحصري (وهو ما فعله العديد من الكتاب من قبل ومنهم بهيجة حسين في روايتها “رائحة اللحظات”)، بالإضافة إلى الأماكن بالطبع والتفاصيل التي يشترك في معرفتها القارىء مع الكاتب. تتعاظم المفارقة عندما يشحذ الكاتب كل التقنيات التي تحاول دعم مصداقية العنوان- مقاطع من سيرة أبو الوفا المصري- ليكون الاستنتاج البديهي أن أشرف الصباغ يكتب سيرته! وهو استنتاج يحلو للنقاد والقراء على السواء الوصول إليه بوصفه اكتشاف يقلل من القيمة الروائية للعمل. وتبدأ محاولات تركيب الشخصيات ورصدها في الواقع، متناسين تماما المفارقة التي يقوم عليها العمل في تحويل الحياة إلى سرد عبر توظيف الذاكرة. فواقع الأمر أن الرواية ليست بسيرة ذاتية كما أن الوقائع الغريبة لإميل حبيبي ليست بسيرة لمواقفه الفكرية كما حاول بعض النقاد إثبات ذلك، بل قد تكون دليلا على البؤس الفلسطيني كما ذهب الناقد فيصل دراج.
لا تتوان “مقاطع من سيرة أبو الوفا المصري” عن وضع البؤس المصري تحت المجهر، ذلك البؤس الذي يتشكل في “المراوحة بين الـ (هنا) والـ (هناك)”- القاهرة وموسكو- حيث “الـ (هنا) لا يقبلك، ولم يعد يتقبلك. والـ (هناك) لم يتقبلك أصلا، ويبدو أنه لن يتقبلك” (ص 78). في هذه الحركة الدائمة بين قطبين وفي محاولات العبور تسقط كل الشخصيات في مصائر غائمة تعتمد على تلفيق بعض الأفكار (إطلاق اللحية أو انتهازية الصعود أو ادعاء النضال) من أجل محاولة النهوض بصورة جديدة توازي محاولة الاتحاد السوفيتي النهوض من حالة الانهيار الكامل، إلا أن كليهما لا ينهض، ولا تساعد القاهرة بكل انهيارها وفسادها على ذلك أيضا. تبقى الشخصيات كلها في منطقة الما بين الرمادية التي يصفها الكاتب بأنها “المعادلة العنكبوتية” التي تهم بعض المتفائلين الذين يرغبون في أداء أدوار ما”. نسجت الرواية أحداثها من محاولة هذه الشخصيات في القيام بأى دور حتى ولو كان مجرد دور الحياة. هؤلاء الذين يسميهم الكاتب “المتفائلين” (أم المتشائلين؟) “أما بسطاء الناس الذين فرضت عليهم أدوارهم، يعيشون هنا وهناك، وبينهما أيضا، في هدوء واطمئنان” (ص 78). تصل المفارقة إلى الذروة عندما يكتشف القارىء أن أبو الوفا ليس الا طفل من أطفال الشوارع الذين يقضون ليلهم بالمدافن، وتسير حياته “في هدوء” رغم أنه “يصرخ ولكن لا أحد يسمعه- كلهم يشخرون” (ص 66). وشخصية أبو الوفا ليست الا اختصار شديد لشخصية كريم التي حولها مكاوي سعيد في “تغريدة البجعة” إلى عصب رئيسي وغاص في تفاصيل حياتها، واتضح بعد ذلك أنها شخصية حقيقية حتى أن جريدة “المصري اليوم” أجرت مع كريم حوارا آنذاك! أين سيرة أبو الوفا إذن إذا كان لا يظهر الا في مشهد واحد مع بعض المثقفين على المقهى؟ لا يفصح الكاتب الا بعد الثلث الأول من الرواية، “تجلس مع أبو الوفا قليلا. تطمئن على إنه أكل وشرب. وأثناء ذلك تتحدث معه في شؤون الكون. وعندما يتحول هذا الكون إلى (أبو وفا) ضخم، تواري دمعة سقطت سهوا، وتنتزع جسدك، من المكان قبل أن يغادرك أبو الوفا” (ص 69). يعد هذا الاقتباس بمثابة لحظة كشف للكاتب ولإبراهيم عفيفي وللقارىءن فتتحول الرواية إلى سير متعددة وحيوات متداخلة لا يجمعها سوى البؤس الكامل، لا يشبه بؤس الأبطال، بؤس لا يشبه الا نفسه.
يتعين المكان في الرواية- إن كان موسكو أو القاهرة- بالرحابة أو الضيق. فموسكو “باردة والشمس مثل لمبة الثلاجة”، وهو ما يجعل كل الشخصيات محاصرة في حجرات ضيقة أو مقاهي أو مطاعم. أما القاهرة فتظهر بكل شوارعها وأحيائها، بكل اتساعها الذي يشمل أيضا مقابر الدراسة، والمقارنة بين المكانين لا مجال لها فقد “تركبك عفاريت الدنيا والآخرة عندما تحاول التفكير- مجرد التفكير- في العثور على جبل من الجليد في شبرا أو الدرب الأحمر” (ص 76). في موسكو تسمح المساحة المحاصرة لإبراهيم عفيفي بمحاصرة الذاكرة ومنعها من الانفلات حيث التلحف “بالصمت والخمر والتأمل” (ص 91)، أما القاهرة فهى التي تدفعه إلى إخراج كل المخزون النفسي المتراكم من الذاكرة المتقطعة، الذاكرة التي تنتفض لموت الأب (وهو حدث دال على المستوى النفسي والنقدي)، فما كان من إبراهيم عفيفي إلا أن “توقف عند أول مقبرة. ركع. أنزل رأسه وراح يمرغها في التراب، ويبكي” (ص 107). ما بين القاهرة وموسكو، ما بين ماشا وصباح، تبقى القاهرة الخلفية التي تحتل صدارة المشهد بشكل مفارق، في حين تبدو موسكو- رغم أنها مكان الإقامة- في حالة مؤقتة دائمة، “مثل المقهى أو محطة القطار. زبون يأتي، وآخر ينصرف. وراكب يصل من محطة ما، وآخر يرحل إلى اتجاه ما. ويبقى المقهى وتظل محطة القطار” (ص 98). ما بين انهيارين- موسكو والقاهرة- كل منهما أعظم من الآخر، ينقطع السند الأخير للذاكرة بموت الأب، ولأن السيرة، روائية كانت أو ذاتية، تستمد حياتها من الذاكرة، فكان لابد أن يموت ابراهيم عفيفي بجوار إحدى المقابر بضواحي موسكو، “وكانت بعض زجاجات الفودكا الفارغة متناثرة حول المقبرة، وكان هو جالسا على خازوق” (ص 136)، وهو المشهد الذي يستدعي (يتناص؟) ما حدث لأبي سعيد النحس المتشائل.
لا يترك أشرف الصباغ العنوان- “مقاطع من سيرة أبو الوفا المصري”- دون أن يوظف كل إمكانياته الإبداعية. فقد ذكر إبراهيم عفيفي أنه في أواخر أيامه كان قد بدأ “يكتب مذكراته التي لا تتجاوز هلوسات السكر والانكسار وتضخم الذات” (ص 135). بهذه النهاية يبدو وضع ثلاثة مقاطع بعنوان “هلاوس” في النهاية مبررا على المستوى الفني. فالهلاوس ليست إلا مقاطع من سيرة إبراهيم (أبو الوفا؟)، وهي مقاطع يبدو فيها الانكسار الجمعي الضارب بجذوره في الجميع، مع محاولة استعادة بعض الجمال في وسط كل ذلك الانهيار. تتراوح الهلاوس (وهي ليست بهلاوس) بين السخرية المريرة والألم من شدة الإحساس بالعجز تجاه الانهيارات التي توجت بالحرب على العراق، ويجلجل صوت نانسي عجرم “أخاصمك آه، أسيبك لأ” ليؤكد إبراهيم عفيفي أن هذه الجملة تحولت إلى أحد أهم شعارات السياسة العربية.
ولأن إبراهيم عفيفي يؤمن أن “الحماقة هى أقصر طريق لإلغاء جميع الخيارات التي منحت للإنسان” فقد توخى الصدق في سرده لمقاطع سيرة أبو الوفا، وابتعد تماما عن الأبطال الوهميين، واختار أن يعرض هلاوسه كما كتبها. وكأن تلك القناعة كانت البداية، إذ “أعجبته العبارة كثيرا، فأخذ يرددها عدة مرات، ثم راح يضيف إليها كلمات وجمل وعبارات، إلى أن تولدت في ذهنه فكرة لطيفة حول البشر” (ص 112) فكانت رواية “مقاطع من سيرة أبو الوفا المصري”.