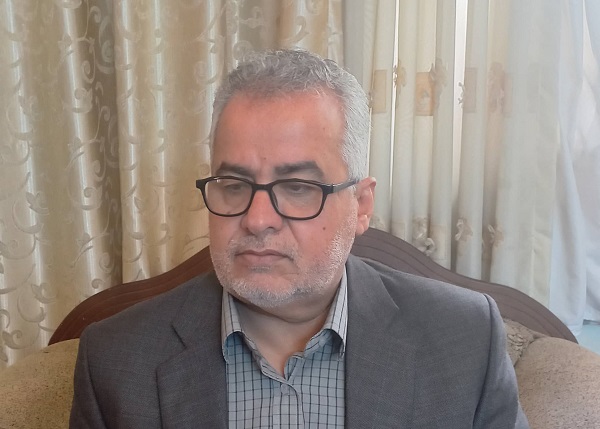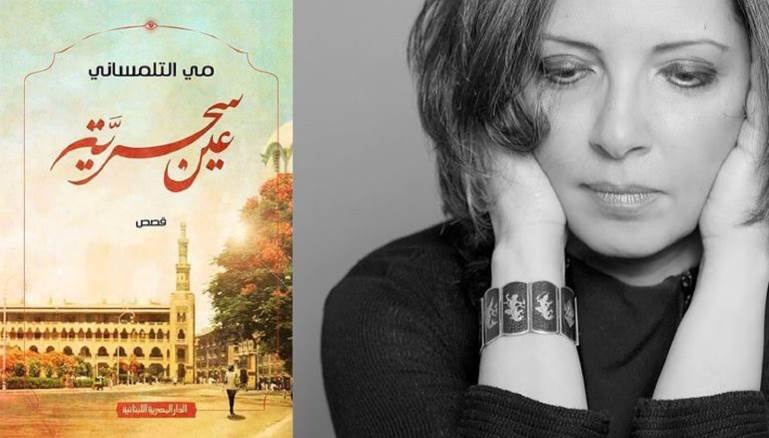يمامة أبو حمدان
امتد الرصيف أمامها. بدأت تشعر بالألم يلوي ساقيها، بالعرق يحرق عينيها، الرطوبة تعصر رئتيها، ولكن رشمي استمرت بالجري.
في الرابعة صباحاً، كانت شوارع الحي فارغة. دبي نائمة، ورشمي وحدها فقط تركض، تقترب من إنهاء الدورة، تصل إلى آخر منعطف وبعده الطلعة الأقسى، وبعده البيت. ستصله، ستبدأ بإعداد الفطور لأولادها قبل المدرسة، ستوقظ زوجها. سيضج البيت بخمس أصوات مختلفة، ولكن ليس الآن. الآن سكون. فقط صوت ضرب قدميها على حجر الرصيف، الإيقاع المتوحد لنفسها، الامتداد في العتمة لا تظهره إلا أنوار الشارع الخفيفة.
سكون، والطلعة الأقسى، وشيء ما على الأرض أرغمها على التوقف.
نصفه تحت ضوء عامود الإنارة ونصفه الآخر في العتمة. كومة ثياب؟ التقطت عينها يداً بارزة من تحت كم ممزق مغبّر. فكرت أنه رجل نائم واستنكرت استلقاءه هنا على الملأ، قاطعاً عليها الطريق، مفسداً المنظر، متعدياً على القانون والحيز العام. هل توقظه؟ وما دخلها؟ فتحت الشنطة الصغيرة على خصرها لتخرج جوالها، وشغّلت الكاميرة. انحنت مادّة يدها بنية إيقاظه وقد بدأت التسجيل، ولكن اليد جمدت قبل الوصول إلى كتفه.
الرائحة امتزجت مع رطوبة الهواء لتخنق صوتها.
الرائحة، والدم.
كتمت صرخة وتراجعت إلى الوراء، جوالها يهتز في يدها، يكاد ينزلق من بين أصابعها المتعرّقة، يصوّر. أحست بالدم الجاف على وجهه وكأنه لطّخ يدها وهي لم تلمسه، أحست بجلده المتفسّخ يتّسع، يبتلع الرصيف؛ تحدق في جروحه وترى الشارع، والليل، والطلعة الأقسى، وفي رأسها تصرخ «جثة، جثة، جثة!»
أغمضت رشمي عينيها وركضت من جانب كومة الثياب. ركضت وصرخت، والجوّال ما زال يصور.
كانت الباحة أمام مدخل الشركة على غير عادتها.
بعد تثاؤب طويل، أجال عامر نظره في تجمع ظنه لرجال البلدية من الهنود كانوا متحلقين حول زاوية أمام باب البلور الكبير، وبينهم أليكس، أحد حراس المبنى. عندما التقت عينا عامر بعينيه، ابتسم الرجل الأسود وحثه على دخول المبنى. مشى عامر من جنبهم، متنفساً هبة الهواء البارد داخل قاعة الاستقبال. أمام المصعد، كان الناس يتحادثون بأصوات منخفضة، مقرّبين الرؤوس.
«ماذا حدث في الخارج؟» سألهم، منضماً إلى الجوقة وهي تخطو داخل المصعد.
ابتسم له أحد الزملاء الفليبينيين، ممن ينسى أسماءهم دائماً. «يقولون مشرّد.»
ضحك عامر. «مشرّد هنا في الإمارات؟»
«ليس مشرداً،» قالت كاتيا، إحدى موظفات الموارد البشرية. «سألت أليكس واعترف لي أنه—» فُتح باب المصعد، ولعلها وجدت ذلك فرصة مواتية لتصمت. «سنرسل إيميلاً للجميع.» خرجتْ، تاركة البقية مع فضولهم.
داخل المكتب، كان الجو مشحوناً بالفضول، وتحسس عامر ذلك من دون التحدث مع أحد حتى. على شفة كل واحد السؤال نفسه الذي طرحه قبل خمس دقائق. في المطبخ، كان الناس يتنازعون التأويل.
«سمعت أنهم سيبعثون إيميلاً ليشرحوا الوضع.» قال عامر للمتجمعين حول مكنة القهوة.
«يعني الأمر جدي.»
«ليس بالضرورة.»
«لم إذاً يبعثون إيميلاً؟»
«ليطمئنوا الناس أن الأمر غير جدي.»
صار المطبخ يضج كعش فقست فيه الفراخ للتو، يدخله أناس، يخرج أناس، يكملون النقاش عن بعضهم، يهزون أكتافهم، يخترعون قصصاً، ينتظرون الإيميل.
في الاستراحة، مر عامر على أحد الزملاء العرب في المكتب، اعتقاداً منه أن الحديث بغير الإنكليزية مع بعضهما سيكشف حقيقة ما، أو أن ثمة معلومة خفت على غير العرب في المكتب وهم الأغلبية، لكن سرعان ما فتح عامر فمه رفع يزن يده.
«لا تسألني.»
«قرأت الإيميل؟»
ضحك يزن. «مسخرة.»
«رأيك مختلف؟»
نظر يزن حوله وكأنه يتأكد أنهما بعيدان عن أي آذان مصغية، ثم التفت إلى عامر وأشار له بالاقتراب.
رأساً على رأس، همس له: «يقولون جريمة.»
«ماذا يعني جريمة؟»
امتعض يزن من بطء فهمه. «يعني جريمة قتل.»
عامر من ضحك هذه المرة. «طوّل بالك.»
«والله.»
«مستحيل.»
«أكثر من شخص رأى الدم بعينه.»
«من؟»
«كريستينا بقسم تجديد الرخص.»
«وغير كريستينا؟»
هز يزن كتفيه. «الله أدرى.»
«قلت أكثر من شخص.»
عبس يزن. «فتحت معي تحقيق؟ اتركني أشتغل.»
«تعرفين قصة الباكستانية التي قتلها حبيبها؟»
كانت حديقة زعبيل مليئة بالبشر، وغطى صوت الأطفال على حديث شلّة النساء الجالسات تحت إحدى الأشجار على العشب، بينهن صحون البلاستيك وكاسات الكرتون.
بلعت رشمي ريقها ورجف قلبها. استحالت قطعة الكيك في فمها تراباً. صمتت، وأنصتت.
«لم تكن باكستانية، كانت فليبينية. الحبيب كان باكستاني.»
«المهم، أقصد بالقول إن الجريمة محتملة. يعني ليست شيئا مستحيلا.»
«هذه القصة واحدة من خرافات دبي.» قالت رشمي، متمنية إنهاء الموضوع.
«وكيف تعرفين أنها خرافة؟»
«لأنهم لم ينشروا شيئا بهذا الخصوص، لا على السوشال ميديا ولا بالجرائد.»
«من قصدك، الحكومة؟» ضحكت صديقتها. «الحكومة هنا يستحيل أن تنشر هذا النوع من الأخبار.»
«إذاً كيف تعرفين أن القصة حقيقية؟»
«الكل يعرف.»
«من الكل؟»
قاطعهم ابنها وقد هبّ راكضاً نحوهن ليريها حجراً أملساً وجده بين العشب. لم تكتشف رشمي أنها ترتجف إلا عندما أمسكت الحجر لتتميّزه. شعرت بضعف مفاجئ، بغثيان أثقل رأسها، أثقل الحجر في كفّها وهو خفيف. الحجر، يصوّر.
لقد مر على ذلك اليوم أسبوعان، ومنذ ذلك الحين أخذت إشاعات تنتشر عن جريمة قتل في دبي. حين سمعت عنها لأول مرة، كادت رشمي تنهار. ظنت أن القتيل هو ذاك نفسه الذي رأته ملقى على الرصيف في الرابعة صباحاً، ولكن الخبر أفاد أن الجثة عثر عليها في الخليج التجاري. بعيدة عنها. الجثة بعيدة عنها. يستحيل أن تكون الجثة نفسها، ولكن إن لم تكن نفسها، فذلك يعني أن ثمة جثتان، ولكن رشمي أعادت المرور بذاك الرصيف في سيارتها بعد عدة ساعات من جريها ولم ترَ الجثة وأقنعت نفسها أن نقص وصول الأكسجين إلى دماغها أثناء الركض جعلها تهلوس. أرادت المرور بجانب ذلك المنعطف لتؤكد لنفسها أن ما رأته مجرد كومة ثياب، ولكن لم يكن هناك على الرصيف شيء، لا رجل ميت ولا ثياب.
لا شيء أبداً.
لم تخبر أحداً وهي لا تدري لما لم تخبر أحداً. لم تخبر أحداً لأنها ليست مجنونة، وما زاد جنونها كان الغياب التام لأي خبر عن الأمر. تفتح الإنستغرام بحثاً عن أي شيء، أي أحد يؤكد ما رأته، ولا تجد. تبحث في مواقع الصحف الرسمية ولا تجد. تبحث في وجوه الناس ولا تجد، حتى أتى خبر قتيل الخليج التجاري.
لقد عاشت في دبي لما يقارب الثلاثين عاماً، ولأول مرة تشعر بأن المدينة مخيفة. لم تحذف الفيديو من جوالها ولكنها لم تجرؤ على مشاهدته. ظل هناك، تتجنبه متى فتحت ملف الصور، وكلما سمعت أن أحداً ما نزّل فيديو عن دبي ترتعد وتظن أنه الفيديو المخفي على جوالها.
«ماما؟»
«نعم.»
«الحجر.»
لزجاً بعرقها، أعادت رشمي الحجر لابنها. قرف من ملمسه ورماه، وأخذ يمسح يده بقميصه.
«على كل حال، رأوا الجثة تسقط من علو. الأغلب أنه انتحار.»
هز الجميع رأسه موافقاً.
كان الشاب في الفيديو يتحدث بإنكليزية سريعة، تظهر حوله صور يقارن بها مجريات الحدث، يتكلم عن فيديو آخر حُذف ويتوقع أن يحذف الفيديو هذا نفسه. تابعت عينا فانيسا الصور المتتالية وهي تتكاثر على الشاشة، تخفض صوت الجوال كلما سمعت أحداً يدخل الحمام.
«ذهبنا أنا وفريقي لنتحدث مع شاهدي عيان كانوا في المنطقة عند وقوع الحادثة، وطلبوا إخفاء هوياتهم حرصاً على إقامتهم في دبي.»
ظهر في الفيديو عامل هندي باسم مستعار وشريط أسود يخفي وجهه. حلف أنه رأى الجثة تسقط من فوق.
يسأله مصور الفيديو وصاحب المقابلة. «فوق من أين؟»
يهز العامل كتفيه. «من فوق.»
«يعني من السماء؟»
«نعم.»
قلبت فانيسا إلى فيديو آخر. كان هناك هاشتاغ بات كثر يستعملونه، “لغز دبي”، وانضمت الناس إليه وكأنه مقلب ضدهم جميعاً لا بد من معرفة مصدره، أحجية تبنّى فك شيفراتها متحرّون هواة.
ذكّرها كل هذا بأيام الجامعة في مانيلا، عندما كانت تنام على قصص الجرائم، وملأتها إشاعات الأجسام المتناثرة في أرجاء دبي بفضول لذيذ حد الهوس. لم تستطع الكف عن متابعة الأخبار لمعرفة المزيد، تنتقل من فيديو لآخر وتنبّش عن الفيديوهات المحذوفة والحسابات المغلقة وتنزل السلم لتصل إلى البذرة الأساسية في القصة كلها، يتضاعف عزمها كلما واجهت عقبة. اعتبرت نفسها خبيرة وكانت لتؤكد بكل ارتياح أن ثمة تعتيماً إعلامياً يحدث تحت أنف الجميع، فأحد الأخبار القادمة من خارج دبي تحدثت عن ترحيل قسري لعدد من الإنفلونسرز الذين نشروا مقاطع تظهر مما لا شك فيه أنه جثث، مدماة، يغطيها الغبار، بل إن بعض المقاطع تظهر أشلاءً لا أكثر. أقسم أحدهم أن يداً مقطوعة هوت في بركة السباحة في بنايته، وأخرى حلفت أن جثة ارتطمت بشبّاك عيادة طبيب أسنانها أثناء وجودها هناك، تاركة لطخات دم على الزجاج.
«يا جماعة، هذه ليست جثث! افهموا، ليست جثث!» قالت امرأة في فيديو آخر مترجم. كان الوصف المكتوب تحته بالعربية. «الأمر وما فيه أن مجموعة من الشباب قررت القيام بفعل توعوي عبر الفن التعبيري. يخططون الظهور في عدة أماكن بمظهر الجرحى والمصابين ليلفتوا الانتباه لأحداث غزة، يعني كله مكياج وتمثيل، وقد عثرت عليهم السلطات الإماراتية وشكرت جهودهم، حاثّة الجميع للتبرع لأهل غزة عبر القنوات الرسمية – الموجودة كلها في الوصف أسفل الفيديو بالمناسبة مع روابط التبرّع – مع الالتزام بقوانين الإمارات وعدم بثّ الخوف في قلوب المواطنين والمقيمين والسياح. رجاءً، توقفوا عن إرهاب الناس وتخويفها. هذا الكلام للمشاهدين الذين ينشرون الإشاعات وللفنانين، بين قوسين. الإمارات بلد الأمن والأمان، وإن شاء الله تبقى كذلك. ولا تتوقفوا عن الدعاء لأهل غزة. أنا تبرّعت للهلال الأحمر الإماراتي وأشجع الجميع على التبرع.»
بعثت فانيسا الفيديو لحبيبها صدّيق. رد عليها بسلسلة من الوجوه الضاحكة.
«شفت، طلعت القصة بالأخير مسرحية،» شخر يزن متهكماً. «مثل ما توقعت.»
أصرّ عامر. «معقول؟»
كان في قرارة نفسه معجباً بهؤلاء الممثلين ولكنه لم يعترف بذلك أمام زملائه. كان ثمة استنكار على نطاق واسع لهذا الفعل الاحتجاجي، والأغلب يؤكد أنهم اتبعوا أسوأ الطرق، بل فشلوا وأثاروا ردة فعل عكسية. كان يزن أمامه خير مثال.
«انشالله يتم ترحيلهم. يعني حتى عندنا جابوا غزة! أيه خلص!»
أضحكته كلمة “عندنا”. لم يكن يزن إماراتياً أصلاً. «طوّل بالك.»
اكتشف عامر أنه مع كل نقاش يدور حول الأمر، تضيق حلقة أصحابه. لم يعد يتحدث إلا مع قلة، وحتى بعد اتضاح خلفيات الحدث الغريب في المدينة، ظل يفكر بتفاصيله بشيء من الريبة. لقد أرته إحدى الصديقات فيديو يقارن بين صورة أحد هؤلاء الممثلين وصورة لأحد ضحايا غزة. لقد صُعق؛ الشكل نفسه، الملامح نفسها، بالرغم من الدماء والغبار والخلفية.
«مستحيل.»
بدت له تلك الكلمة وكأنها قد غزت قاموسه اليومي. كان يقول “مستحيل” أمام كل خبر، كل جملة. مستحيل، مستحيل. مستحيل أن يحدث هذا في دبي. مستحيل أن ما يحدث في غزة يحدث. مستحيل أن هذه الصور حقيقية. مستحيل.
حلفت له. أرته فيديو آخر يجمع كل هذه الصور للمقارنة. ممثلو دبي بجانب نعوة طويلة لآخر حصيلة شهداء غزة. انقطع نفسه، لم تعد لديه أية ثقة بما هو حقيقي وبما هو كذب. الزيف واقع، الواقع زيف. شعر بشيء يخرج من جلده، شيء يحس به ولا يراه، وكأنه يخلع عن جسمه طبقة وحالما تسقط عنه يبدأ جلده مجدداً بالانقشار. كان هذا الشعور يرافقه طوال الوقت.
عندما أراد رؤية ذلك الفيديو مرة أخرى، وجد أنه قد حُذف، ولكن حساب صاحبه ما زال موجوداً. نزل عامر ونزل، باحثاً في المنشورات واحداً واحداً عله يجد مقصده، ولكن مرت أشهر على الشاشة ولم يجد أي فيديو عن الموضوع. لقد اختفت من صفحة هذا المؤثر كل أثار الحوادث التي ضجت بها دبي لشهر كامل وكأن شيئاً لم يحدث أبداً. وكأن التاريخ خلع طبقة.
وحدها التعليقات وشت بأن أمراً غريباً قد حدث ويحدث. تساؤلات، اتهامات، احتجاجات. لم يكن ثمة رد على أي منها.
قال المؤثر في آخر فيديو له أنه قد خرج من دبي في إجازة. متى سيعود، سألت إحدى التعليقات.
«إنها إجازة طويلة.»
بعد أسابيع من العذاب، استطاعت رشمي أخيراً أن تضحك.
كان البيت مضيئاً، وأولادها حولها، وزوجها يرتب طاولة العشاء، والمساء خارج منزلهم هادئ.
بعد خروج بيان حكومة دبي الرسمي بشأن “الجثث”، شعرت أول ما شعرت بالغضب. لقد أحست بمهانة الخداع، وبالحرج من خوفها، والغيظ مما سببوه لها من رعب وهي غير مذنبة ولا علاقة لها بما يجري في غزة ولا غير غزة. إذا كانت هذه الفرقة الخبيثة تريد نشر التوعية لم لا تذهب إلى أحياء العرب والمسلمين؟ شعرت رشمي بأنها ضحية اعتداء نفسي، وقد دفعها الحنق لمشاهدة الفيديو أخيراً للمرة الأولى حتى تؤكد لنفسها أنها كانت حمقاء، أن آثار المكياج كانت واضحة وخوفها وحده ما أخفى الحقيقة عنها. شاهدت المقطع وتعجّبت من واقعية كل شيء فيه، كيف بدا جسم الممثل المستلقي ميتاً حقاً، كيف بدت الجروح مفتوحة تنزف، كيف كان الوجه مشوهاً. يا للبراعة.
يا للبراعة… ولكن، لماذا بعد لم تخبر أحداً بما جرى؟ أي رادع داخلها منعها من الإفصاح؟ إن كان الأمر كله كذباً، فلم لا تشاركه الآخرين لتستمتع بأمان السخرية الجماعية؟
شعرت أنها إن شاهدت الفيديو مرة أخرى، فسترى شيئاً مختلفاً، ولذلك، وأخيراً، حذفته.
«ماما؟»
«نعم.»
«سمعتي؟»
التفتت رشمي حولها ورأت زوجها واقفاً عند الشباك المفتوح يحاول مد يده على السطح الخارجي للزجاج. اقتربت منه. «ما الأمر؟»
ابتعد فجأة عن الشباك والجدار مفزوعاً، يحدق في يده. رشمي والأولاد والدنيا كلها تركزت في كفه.
دم. ولكن ليس الدم وحد، فقد صاح زوجها «جثة، جثة، جثة!»
بدأ الجميع بالصراخ، وإن صمتوا للحظة سمعوا صراخاً خارج البيت، وإن سكت صراخ الآخرين علا صوت ارتطامات وصدمات وكأن أشياءً تُلقى على السطح. اهتزت النوافذ، وارتفع صوت الخبط.
شدّت رشمي الستائر لتغلقها ودفعت زوجها ليغسل يده ولكنه عجز عن التحرك وتخشّب في مكانه، يحدق بيده، يتمتم مشدوهاً، ثم وكأنه يريد الدمار كله لا نصفه عاد إلى الستائر وفتحها وفتح الشباك بعنف وصرخ «الجثث تهطل من السماء! الجثث تسقط علينا!»
صاح الأولاد، وارتج الباب. ركض ابنها ليفتحه ولكن رشمي شدته من قميصه بقوة ألقت به على الأرض، حيث أخذ يبكي. أجالت عينيها في السقف وكأنها سترى الجثث، سترى ذلك الرجل المستلقي على الطريق، الملقى على الطريق.
بدافع أشبه بالغريزة، أخذت رشمي جوالها لتفتح الإنستغرام علها تعرف ما يجري. فيديو طبخ، شوكولا بفستق حلبي، إعلان من تيمو، إعلان عن مواعيد العطل الرسمية، صورة للإله غانيش مكللاً بالورود. انهارت على الأرض وأدركت أنها تبكي. تشبّثت بالجوال، بصورة الإله، وأخذت تصلّي.
استمر الهطول طيلة الليل.
«أعلنت حكومة دبي صباح الثاني عشر من مايو 2024 حالة طوارئ عامة على طول الإمارة، حيث حثّت السلطات المختصة المواطنين والمقيمين التزام بيوتهم حتى فترة غير معلومة إلى الآن تحددها الحكومة. وفي ظهور إعلاني غير مسبوق، خرج حاكم الإمارة يطمئن الناس وينفي الشائعات، مؤكداً حرص الحكومة على الحفاظ على الأمن والأمان وأنهم يعملون بلا كلل لإعادة الحياة الطبيعية إلى سكان المدينة في أسرع وقت ممكن، مضيفاً أن الحكومة لن تبخل بتعويضات لكل الشركات المتأذية من جراء توقف الأعمال وغياب الموظفين. يضاف في هذا الصدد كذلك أن بلدية دبي نشرت عمالها على طول الإمارة للقيام بأعمال تنظيف وتعقيم تجري توازياً مع تحذير وزارة الصحة من انتشار فيروس محتمل شديد العدوة ما زالت تدرس طبيعته. تحدث المسؤول في—»
أطفأ عامر التلفزيون وأعاد إلصاق عينيه بزجاج الشباك. كأنها مستعمرة نمل صُب فيها ماء مغلي، كان الشارع مليئاً بالعمال والشاحنات، لا أحد في الطرقات غيرهم. لو ركز لكان استطاع رؤية الآلاف مثله واقفين خلف نوافذهم، يشاهدون المنظر بين الفضول والفرح بإعلان العطلة الفجائية.
أيعقل أنه فيروس؟
مستحيل.
ظلت فانيسا تناشده نصف ساعة للعودة إلى السرير حتى ضجرت من النظر إلى شعر ظهره وهو مستدير. كان منغمساً في مشاهدة أحد الشيوخ الباكستانيين، رجل ملتح يصرخ بلغة لم تعرف منها فانيسا إلا بضع كلمات تعلمتها من حبيبها، ولكنها فهمت أنه يتحدث عما جرى في دبي منذ ثلاثة أشهر. تنهّدت متململة، واقتربت منه ملقية بذراعيها فوق كتفيه. لحسن حظّها، كان الفيديو مترجماً.
«… هذه دماء المسلمين في أعناقكم! لا بل إنها رسالة إلهية إلى حكام كل البلدان المسلمة! صُمّت الآذان فبعث الله دليلاً للعين، أرسل أجساد المستضعفين والأبرياء إلى شوارعكم، بعثها بقدرته سبحانه من غزة إليكم. أرأيتم الدماء تهطل كالمطر، أرأيتهم أشلاء الشهداء تنزل عليكم كحجارة الطير الأبابيل. نظفوا الشوارع ولكن لا والله لن ينظفوا الذاكرة، إنا سنذكر الـ –»
أطفأ صدّيق الجوال ممتعضاً ونظر إليها أخيراً. قبّلته. «عمّ يتحدث؟»
هز رأسه مستنكراً. «مجنون.»
20.10.2024