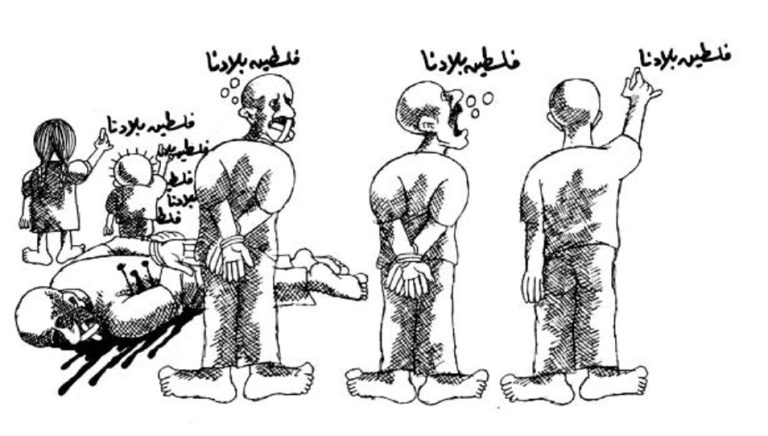عبد المنعم رمضان
1-
دخلت الشعر من بابه الضيق، دخلته من باب تراتيل أبي المصطفى، وغناء أمي فاطمة، وتنهدات جدتي عائشة، دخلت الشعر من محفوظاتي المدرسية التي لم أتقنها، ومن عينيْ هانم ذات الأصابع الستة، ومن باب الحارة، وبعدما عرفت مكتبة المدرسة وسور الأزبكية والفجالة دخلت الشعر من دواوين المازني وابن خفاجة والرومانسيين المصريين الأربعة على محمود طه وإبراهيم ناجي ومحمد عبد المعطي الهمشري ومحمود حسن إسماعيل، والرومانسيين العرب الأربعة أيضا أبي القاسم الشابي والتيجاني يوسف بشير وعبد الباسط الصوفي وعبد السلام عيون السود، حلمي سالم أبلغني ذات مرة أنه دخل الشعر من أبواب مماثلة.
دخلت الشعر من غناء محمد عبد الوهاب وفيروز ونجاة الصغيرة وصباح فخري وناظم الغزالي، ثم دخلته عبر أحلامي بأن أكون ابن سلالة عربية تصل بي إلى أحد الشعراء العذريين، أو أحد الصعاليك، أو أحد شعراء القرن الرابع الهجري، بعد انتهاء دراستي الثانوية وقبل الجامعة كنت وحيدًا إلى حد انتظار رسائل وهمية من وضاح اليمن وجميل بثينة لكنها لم تصلني، ذات مرة زعم حلمي سالم أن رسائل المجنون وصلته، وذات مرة أخرى اخترت قرية من قرى اليمامة، وبطنا من بطون بكر بن وائل بن ربيعة لأنتسب إليهما، وذات مرة ثالثة مشيت وراء عفراء وضبطني بنو عذرة وحبسوني ومنعوني، وعندما سألوني عمّن أحبها، قلت: مها، فأطلقوا سراحي، حلمي لم يكن محبوسًا، وذات مرة جديدة تعثرت في أوهامي وتمنيت أن أكف عنها، عن أوهامي، لكنني مازلت أتشبث بها، فأنا من الجزيرة أو اليمامة، أنا من البحرين أو اليمن، ولمّا التحقت بالجامعة وتعرفت على محمد خلّاف الذي زاملني لثلاث سنوات، وحكى لي عن أحلامه بالسفر إلى الغرب، باريس وروما، فابتسمت، وحكيت له عن أحلامي بالسفر إلى الأسلاف، فاستغرب وصمت، حقق محمد خلّاف أحلام سفره، ولكن بدلا من باريس وروما، سافر إلى المغرب وأقام في الرياض، فيما أخافتني أحلامي فأخفيتها واستترت عليها، لكنها مازالت تراودني، كان محمد خلّاف يشبه صورة الفنان في شبابه، كان كتوما يتكلم فقط فيما ليس شخصيا، ضبطته في الإسكندرية يعاشر صاحبة الشقة فحسدته، وضبطته في بيتي يختلس كتبي فأصابتني الرعشة، ومع ذلك لم أتوقف عن محبته، بعدها حدثني محمد خلّاف عن حلمي سالم للمرة الأولى، كان مفتونًا به، لم أصدق أن محمد خلاف يمكنه أن يقرأ القصائد بالطريقة التي قرأ بها أمامي بعض مزامير أدونيس في ذلك اليوم، فيما بعد سمعت حلمي سالم يقرأ شعره وشعر الآخرين، يقرأ قراءة ممثل، بعد أن تعرفت على أحمد طه وعبد المقصود عبد الكريم ومحمد عيد إبراهيم، حدثوني عن حلمي سالم وعلي قنديل وأمجد ريان، كانوا يلتقون أسبوعيا في ندوة سيد حجاب بمنظمة الشباب، التي كما أخبروني انقسمت إلى فريقين، الجيروند واليعاقبة، كان علي قنديل وحلمي سالم وأمجد ريان طليعة فريق الجيروند، وهو الفريق الذي سيؤسس فيما بعد موت على قنديل مجلةَ إضاءة 77، وكانت طليعة اليعاقبة تنحصر في أحمد طه وزميليه، الجيروند إصلاحيون، واليعاقبة جذريون، الجيروند قوميون، واليعاقبة أمميون، الجيروند يكسبون الأرض نقطة بعد نقطة، واليعاقبة روافض، الجيروند سيصبح وسيطهم مجلة إضاءة المفتوحة أكثر على الآخرين، واليعاقبة سيصبح وسيطهم كتاب أصوات المغلق تقريبا على أصحابه، الجيروند يقفون تحت مظلة التيار الثوري الذي كانت تسميه طوائف اليسار “طنط ثريا”، واليعاقبة يميلون جهة أقصى اليسار ويقرأون كراسات الثورة الدائمة وسيرة تروتسكي النبي المسلح والنبي الأعزل والنبي المنبوذ ويعكفون على بعض تراث السرياليين المصريين ويطبعون ديوانا شعريا لجورج حنين، ويتلقون بعض الأذى من سلطة الوقت مثل حبس أحمد طه ومحمد سليمان قبل مشاركة إسرائيل في معرض الكتاب الدولي بالقاهرة، استمرت الحمّى، حمّى الجماعتين وحمّى صراعهما، طوال الثمانينيات، ثم بدأ فك الارتباط بين أفراد كل جماعة على حدة، مات علي قنديل قبل إصدار إضاءة، فانفرد حلمي سالم فور إصدارها بالدور الأكبر، وانفتح على الجميع، كانت موهبته الاجتماعية أبرز مواهبه إلى جوار الشعر، في التسعينيات نفدت ريح الجماعتين فعدنا أفرادا، وتباغض بعضنا، وتحابب بعضنا، وأصبحت أنا وحلمي رفيقين دائمين فيما عدا الفترة التي تلت قصيدته (شرفة ليلى مراد)، كنت أراها قصيدة رديئة، وهي كذلك في رأيي حتى الآن، وأن الدفاع عن حرية التعبير لا يعني الدفاع عن قصيدة رديئة، وكان حلمي يرى ضرورة الدفاع حتى عن حرية الرداءة، فشكاني إلى كل المثقفين والشعراء، خاصة الشعراء العرب من أصحابنا، وبكى أمام بعضهم، ومنهم من تأثر وانفعل ولامني، خاصمني حلمي إلا أنه قبل عيد ميلاده، ربما قبل الأخير، ربما الأخير، تململ من مرارة الخصام، فقرر إنهاءه، وروى لأصحابه أنه سيدعونا، حسن طلب وأنا، لحضور مولده، لأننا، هكذا قال، مَنْ سنقف في مأتمه لتقبل العزاء فيه، ثم لاحقته الأمراض وداهمته، في مرضه الأخير، حدثني مرات عن أمه زاهية، حدثني مرات عن قريته الراهب، حدثني عن عفيفي مطر، لكنه قبل موته بأيام، عندما كنا وحيدين في عنبره بالمستشفى، هل كانت حنين قريبة منا، سألني: هل ستكتب عني؟.
لم أستطع أن أغالطه وأدعي عدم فهمي، قلت له: لا، سألني: لماذا؟ قلت: كي لا أُغضب أمل وحنين، زوجته اللبنانية وابنته، وتذكرت لميس ورنيم ابنتيه الأخريين، فقال: اطمئن، إنهما يحبانك، وبكى، وبكيت معه، وفي خيالي اختلطت دموعنا، فاحتضنته، ليلة موته، أخبرتني أمل أن مستشفاه الحكومية سمحت بخروج جثته آخر الليل دون تصريح دفن ودون شهادة وفاة، مما يعني الرغبة في التكتم على خطأ طبي أدى إلى الوفاة، اكترت أمل سيارة أجرة (تاكسي)، وساعدها الممرضون وأجلسوا جثة حلمي بالكرسي الخلفي كأنه حي، وجلست أمل إلى جواره لتمنعه من السقوط، في صباح اليوم التالي استدعينا طبيب الوحدة الصحية الذي قام بإصدار شهادة الوفاة وتصريح الدفن، أضعفني موت حلمي وأفقدني القدرة على إثارة هذا الأمر، خاصة أن الإثارة لن تعيده حيّا، مات حلمي سالم، مات حلموس، الخواجة لامبو مات.
2-
ضاع مني أن أقترب من صلاح عبد الصبور، كل أصدقائي ذهبوا إليه وعرفوه، لكنني خفت فظلّت صورته التي رسمتها في قلبي صورة أمير متسول في أسطورة بيضاء، يحمل تحت إبطه شعره ومقالاته ومسرحياته وترجماته وخيباته وحزنه، ويجلس على قهوة عبد الله بميدان الجيزة، وينصرف عندما يصبح قريبا من حافة الكلام، كانت المسافة بين شعره والكلام اليومي مسافة غامضة، حتى أنك لا تستطيع إلا أن تداوله بينهما، على العكس من أحمد عبد المعطي حجازي الذي أدرك منذ البداية أن الشعر حرفة، من واجباتها أن تمايز بين الاثنين، الكلام في الشعر والكلام اليومي، من واجباتها الجهر بالمعنى، من واجباتها الجهر بالإيقاع والموسيقى، وإذا امتزج الاثنان الإيقاع والكلام اليومي، وغالبا ما يمتزجان، كانت الموسيقى هي المتبوعة والكلام اليومي هو التابع، على العكس من صلاح، كان حجازي يفخر ببراعته العروضية ويفاخر بها، إلى حد أن يشير دائما إلى أخطاء العروض عند صلاح ووافقه في ذلك نقاده، خاصة لويس عوض، اتفقوا على تمييز غنائية حجازي عن حميمية صلاح، وعمومية حجازي عن خصوصية صلاح، وشفاهية حجازي عن كتابية صلاح، وعلى يقينهم من أنهم رأوا حجازي يقف على شواطيء بحوره ولا يجاوزها، فيما قدما صلاح تنزلقان وتضطربان أحيانا، فينزلق ويضطرب ولا يأبه، ودعموا آراءهم بتكرار القول عن أن فردية صلاح كانت أكثر عمقا، فيما كان لسان حجازي الجامع لألسنتنا هو أبرز ملامحه، حنجرة حجازي جماعية تزعم أنها حنجرة فرد، لذا هي خارجية أكثر، لذا هي مموسقة أكثر، لذا هي ذات ضجيج أحيانا، وحنجرة صلاح حنجرة فرد يتأذى إذا اكتشف أنه سيغني نيابة عن الآخرين، كان صلاح يهمس، وحجازي ينادي ويصيح، صلاح يصب حزنه في كأس ويضعه أمامه على مائدته ويشربه في هدوء وبطء، وحجازي يقف ويرقص ويدعو الآخرين للرقص معه، وإذا هتف يدعوهم للهتاف، وإذا كذب يدعوهم لتصديقه، صلاح لا يدعو أحدا إلى شيء، ويتجنب الوقوف في المقدمة، غناء حجازي كان يناسب قصائده عن عبد الناصر وعن الاتحاد الاشتراكي العربي وعن لاعب السيرك الذي هو حجازي نفسه، وكان يناسبني في أول أمري عندما كنت وحيدا، وشعر صلاح كان يشبه نبرة التهكم على السيد ذي الأنف الكبير، لعله عبد الناصر، لعله صلاح نفسه، أدرك صلاح خوف رجال الدين من الكوميديا فعكف على كوميدياه، وأدرك حجازي حب رجال السلطة للتراجيديا، فلم يسخر سوى من صافيناز كاظم والعقاد، وكتب مراثيه التراجيدية المتوجة بمرثية العمر الجميل، وعندما نظر حوله، ورأى الشعراء التالين عليه يقتربون من الوقوف على منصته، لم يستطع أن يقبلهم قبل أن يشير إلى أنسابهم، أحفاد شوقي أبناء حجازي، واكتفى بسلالة من شعراء قدامى اختارهم ليختلف عنهم، وظلت قوميته العربية في فترة، ثم المصرية في فترة تالية، وكلتاهما كانت محدودة الأفق إما بعبد الناصر وميشيل عفلق، وإما بالليبرالية قبل عبد الناصر، ظلت قوميته تعمل كحاجز بينه وبين شعراء عاصروه، وها هو قد أمهله العمر، ليجلس في حدائق شعرية تختلف عن حديقته، لكنه لم يفعل، عينا حجازي كانتا تنظران إلى الخلود، أما صلاح فلم يمهله العمر ليختبر كتاب تحولاته، عينا صلاح كانتا تريان الموت، كلاهما حبس شعره داخل باترون واحد، باترون صلاح متعدد الطبقات لذلك هو أكثر اتساعا لدرجة أن ذهب بشعره إلى المسرح، وباترون حجازي متعدد درجات الإجادة وإن كان أكثر ضيقا، يبقى أدونيس ويبقى الشعراء الذين بعدي ويبقى الشعراء القدامى، لعلني لن أستطيع الآن أن أوفيهم حقوقهم قبل أن أطمئن إلى لون السماء التي لم تعد زرقاء، فعندما ستكون السماء كذلك، سوف أستطيع أن أتمادى، أن أكتب بعض أسفاري، أن أُشهد المرأة التي تنتظر وقوفي على مسارح هؤلاء جميعا، لتراني كيف سأرقص، وكيف سيكسوني الشيب، وكيف سأخفي أمارات تعبي قبل أن أرى بصعوبة صورة الشعر الذي أعرفه، وهي تتسرب بالتدريج من المرآة، هكذا هكذا.
……………..
*تنشر هذه الشهادة بالاتفاق مع مؤتمر قصيدة النثر المصرية ـ الدورة السادسة