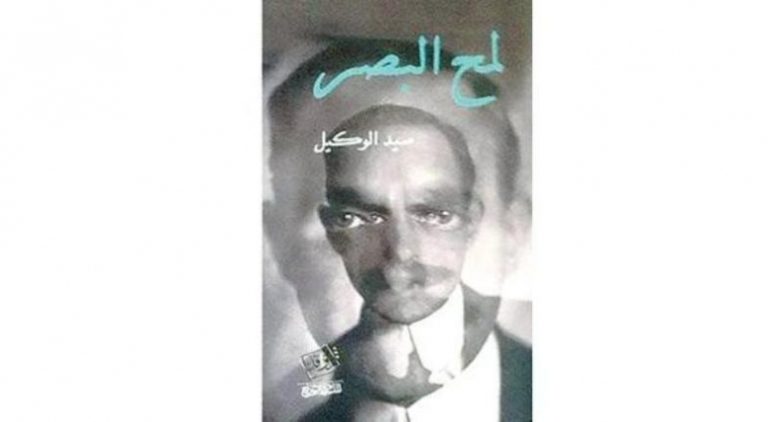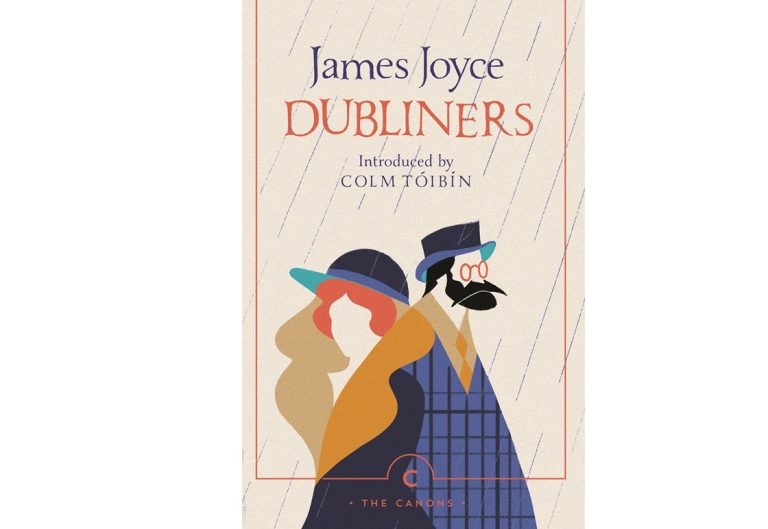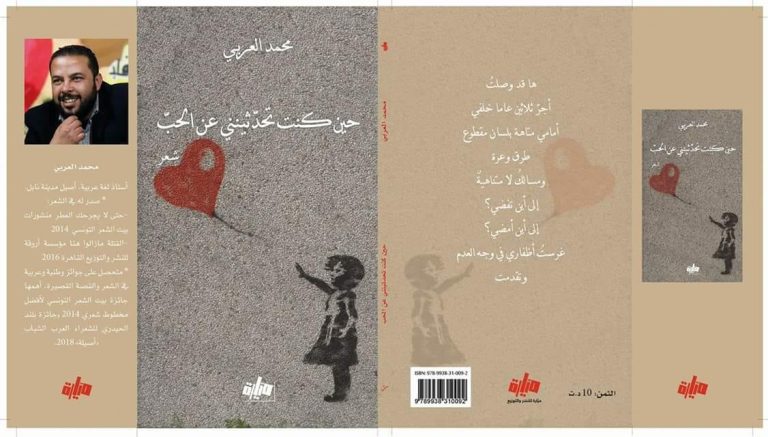د.خالد عاشور
مرحلة الحرافيش:
استغرق هبوط المنحنى الثانى فى إبداع نجيب محفوظ ما يربو على الخمس سنوات؛ إذ كان قد أخرج “ميرامار” فى النصف الأول من سنة 1967 ثم توقف عن الإنتاج الروائى حتى أخرج أولى رواياته “الحب تحت المطر” سنة 1973، ولقد أخرج خلال فترة التوقف بعض المجموعات القصصية وكتاب “المرايا”. والحق أن “المرايا” تثير جدلاً واسعاً بين النقاد كالذى أثارته من قبل “السراب”. فقد نظر بعض النقاد إلى هذا العمل على أنه رواية مكتملة فنياً، ونظر البعض الآخر إليها على أنها رواية تجريبية، واحتار البعض الثالث فى تصنيف العمل.
فلقد رأى نبيل راغب مثلاً أن الكاتب لا يقدم فى هذا العمل شخصيات بالمفهوم الدرامى، وإنما يقدم أنماطاً اجتماعية تجسد صراعات المجتمع المصرى وإرهاصاته منذ مطالع القرن وحتى مرحلة النكسة، دون رابط درامى بين تلك الشخصيات سوى شخصية الراوى الذى يقص علينا مدى معرفته وعلاقته بها ووجهة نظره فيها وفى تفكيرها وسلوكها([1]). مما يعنى فى رأيه أن العمل ليس رواية بالمعنى الفنى. غير أن الناقد يعود ويصف العمل بأنه “رواية” بل ويجتهد فى إيجاد صلة ما يربط بها بين هذه الشخصيات فى عمل واحد. فهناك محاور أربعة يدور عليها العمل: المحور الأول تجسد فى أصدقاء الراوى فى طفولته وصباه فى العباسية. المحور الثانى تمثل فى حياته الجامعية. المحور الثالث وضح فى حياة الراوى المصلحية ونظرته إلى أنماط الموظفين الانتهازيين أو المثاليين. المحور الرابع ارتبط بصالون الدكتور ماهر عبدالكريم([2]).
وربما كان تقييم محمد حسن عبدالله لـ”المرايا” أقرب إلى فهم الطبيعة المرحلية للعمل، حين وصفه بأنه “كناسة دكان نجيب محفوظ” بما يشى هذا التعبير من الرغبة فى التجديد والتنقية، وبما يعنى أن نجيب محفوظ يقبل على تغيير كبير فى متجهه الفكرى، بعد أزمة يونيو، التى يراها الناقد بدأت تنفرج ـ تعبيرياً ـ مع “المرايا”. وشخصيات هذا العمل يراها الناقد كتبت بصورة نهائية على النحو الذى قرأناها عليه، وربما تكون قد كتبت قبل النكسة، ويراها مرت بنا فى أعمال سابقة للكاتب على مدى الأعوام السابقة. غير أنه يوجد رابطة بينها تبعد عن العمل شبهة “الصورة القلمية”. وهذه الرابطة التى يراها الناقد تقترب بالعمل من رواية “ميرامار”؛ فثمة علاقة بين بنسيون الإسكندرية وصالون ماهر عبدالكريم فى المنيرة كحيلة فنية فى استعراض العديد من الشخصيات والآراء حول العديد من المشكلات والحوادث. فنحن فى “المرايا” كما فى “ميرامار” نستعرض الأحداث نفسها من وجهات نظر مختلفة، وبسرعات متساوية([3]).
ذلك نموذج من آراء النقاد يعكس الإرباك الذى أحدثه هذا العمل بغية تقييمه وتصنيفه بين أعمال الكاتب. ولعل فى علم نفس الإبداع ما يحل لنا إشكالية هذا العمل.
فكما قلنا إن هزيمة 1967 عمقت من التوقف الثانى لنجيب محفوظ بعد الشوط الإبداعى الذى انتهى برواية “ميرامار”. ولقد ذكر الكاتب فى أكثر من مناسبة أن الهزيمة كانت قاصمة الظهر بالنسبة له، وأنه يعجب كيف لم ينتحر أحد ولم ينفجر أحد كمداً يومها([4]).
ولقد انعكس ذلك على الكاتب تعبيرياً فى صورة تخبط إبداعى، عبّر عنه هو بقوله: “رغبة وانفعال شديد، ولا موضوعات. لهذا كنت أبدأ من الصفر، ولا أدرى كيف سأنتهى”([5]). وقال أيضاً عن الفترة نفسها: “بعد 1967 وجدت لدىَّ انفعالاً بلا موضوع محدد، واجتزت أزمة كتلك التى دفعتنى للتوقف سبع سنوات كاملة بعد قيام ثورة 1952، بعد 1952 كانت الموضوعات قائمة عندى لكن الانفعال قد مات، أما الآن فالانفعال قائم لكن الموضوعات هى التى تتسرب من بين أيدينا… لم تعد لدى تخطيطات لأعمالى كما كان الأمر فى الماضى. من يستطيع الآن مثل هذا التخطيط؟ .. الرواية فى حاجة لرؤية متكاملة تضم الذات والموضوع، تضم الماضى والحاضر وتستشرف المستقبل، وهذا مالا أستطيعه الآن”([6]).
وقد أنتجت هذه الحالة الغريبة من هبوط المنحنى أو التوقف لدى الكاتب مجموعة من الأعمال، طرق بها نجيب محفوظ عدداً من الأنواع الأدبية بعيداً عن الرواية بمعناها الاصطلاحى. فقد كتب عدداً من المسرحيات، أو كما يسميها البعض “حواريات قصصية”، مثل “التركة”، “المهمة”، “يحيى ويميت”، وغيرها ضمن مجموعة “تحت المظلة”، دون خبرة سابقة فى كتابة الحوار المسرحى، ولعله اعتمد فى ذلك على خبرته بالسيناريو السينمائى. وكأن نجيب محفوظ حقاً كان يبدأ من الصفر. إنها حالة تتجاوز حالة “الإغلاق” التى تصيب الكاتب وينشغل عنها فى عمل آخر كالتى مرت بنا فى “السراب”. وهى تتجاوز أيضاً التعثر الذى يصيب البداية من كل مرحلة. إنها بداية أولى مرة أخرى، أو كما قالت فاطمة موسى: “انهار الشكل المنتظم فى إبداعه انهياراً كاملاً”([7]). مما دفعه ذلك كى يجرب فى حقول إبداعية جديدة مثل القصة القصيرة والمسرحية، لعلها تستوعب حالته الإبداعية الجديدة والطارئة والغريبة فى وقت واحد.
هذا فضلاً عن أن مضمون إبداعه الجديد الذى أخرجه خلال تلك الفترة فى هذين المجالين لم يخرج عن وصفه له بأنه “لا موضوعات”، أو كما وصفه هو أيضاً فى موطن آخر: “فانتابته حمى كتابة بدون موضوع محدد”([8]). والتصدى النقدى لهذه الأعمال يكشف فعلاً عن ذلك؛ فقد دخل الكاتب فى متاهة إبداعية غير واضحة المعالم. ولقد التفت لذلك عبدالقادر القط فى تناوله لمجموعة “حكاية بلا بداية ولا نهاية” (المجموعة الثانية بعد “تحت المظلة”) حيث نبه للاتجاه الجديد الذى يسلكه نجيب محفوظ متخذاً شكل “القصة القصيرة الطويلة”، ومضموناً رمزياً غامضاً تخلّص به من واقعيته المعروفة بأشكالها المختلفة فى مراحله السابقة. ولقد نعت القط هذا اللون الجديد من الإبداع بأنه ينبنى على فهم خاطىء للرمزية يقدم من خلاله بديلاً للواقع يمكن للقارىء أن يرده إلى أصله الواقعى بشىء من التفكير كما يفعل المرء حين يحل بعض الألغاز، وليست الرمزية التى تنبع من تطور خاص للواقع، وتقدم معادلاً له([9]).
وما كتبه القط عن قصص “حكاية بلا بداية ولا نهاية” من الممكن أن ينسحب ـ فى رأى الباحث ـ على بقية القصص القصيرة والمسرحيات التى صدرت خلال تلك الفترة، من حيث غموضها، وعدم اتزانها الفنى. ولقد حاول بعض النقاد أن يفك غموض هذه الأعمال ويضفى عليها شيئاً من الرؤية الفنية للواقع، غير أنها محاولات نقدية غير مقنعة، ولا تستند إلى منطق نقدى بقدر ما تستند إلى مكانة الكاتب وتوقيره، الذى لا يصح معها أن يصدر عنه إبداع تنقصه رؤية فنية ناضجة(·).
مشكلة “المرايا”:
فى هذا السياق المرحلى خرجت “المرايا” إلى القراء، ولم تكن الحالة الإبداعية قد فارقت نجيب محفوظ، تلك الحالة التى شعر معها أنه ينتهى إبداعياً، أو على الأقل يبدأ من الصفر. وما دامت الرواية لم تزل عصية عليه، إذ “لا موضوعات”؛ فليتخلص من كناسة دكانه القديم رغبة فى تجديده وتنقيته ـ كما ذهب لذلك محمد حسن عبدالله وكما سيحدث فعلاً بعد سنوات ـ أو تأهباً لتصفيته وإغلاقه. لقد كان نجيب محفوظ يحتفظ لديه بحوالى ستين شخصية صالحة للدخول فى أعمال روائية أو قصصية، ربما كانت مكتوبة على صورتها التى خرجت بها فى “المرايا” وربما كانت مكتوبة بصورة أولية، أعاد تنقيحها، ورتّبها هجائياً، وجعل من صالون ماهر عبدالكريم مكان التقاءها الفنى. وأغلب الظن أن نجيب محفوظ لم يكن يعلم ماالذى يكتبه بالضبط هل هو رواية أم كتاب تراجم أم خواطر قلمية أم ماذا؟. إنه ـ مدفوعاً بحالته الإبداعية تلك ـ كتب عن هذه الشخصيات التى كان معظم أصحابها على قيد الحياة، ويشكلون جزءاً من سيرته الذاتية. يقول محفوظ: “ولعلك تلاحظ أن ثمة علاقة كبيرة المرايا وحكايات حارتنا من حيث الجزئيات والتفصيلات الصغيرة، ومن حيث أن كلتيهما تشكل لوناً أدبياً جديداً فلا هى قصة ولا هى رواية لكنها أخذت من القصة القصيرة جزئياتها، ومن الرواية معناها العام ويقيناً هى شىء بين بين”([10]).
وهو قول يشى بحيرة الكاتب نفسه إزاء تصنيف العمل كما قلنا. وهو أيضاً ما انتبه إليه ناشره؛ فنظراً لغرابة العمل، احتاط للأمر، وذكر أنه قد لا يكون “رواية” بالمعنى الاصطلاحى المحدد، ولكنه ينشره لجودته ولمكانة كاتبه([11]). ولقد كانت ملاحظة الناشر أكثر قرباً لروح العمل من حديث النقاد عنها، ومحاولة إيجاد مسوغ فنى لها يدخلها قسراً فى إطار “الرواية” كالذى فعله نبيل راغب مثلاً من الربط بينها وبين “القاهرة الجديدة”(·)، أو كالذى فعله محمد حسن عبدالله من الربط بينها وبين “ميرامار” .أو كمحاولة يوسف نوفل إضفاء طابع التجديد الفنى عليها، حيث عدّها ـ وحكايات حارتنا ـ “محاولة تجديدية” للمزج بين الرواية والقصة القصيرة، استناداً إلى ما قاله نجيب محفوظ منذ قليل([12]). والفرق كبير وواضح بين “المرايا” وكل من “القاهرة الجديدة” و”ميرامار” من حيث طبيعة السرد وتقنياته، واختلاف المراحل الفنية للأعمال الثلاثة. ولم يكن الكاتب مهيأً ـ فى ضوء ما سبق ـ للدخول فى غمار محاولة تجديدية، فضلاً عن أن “المرايا” لم تحمل من مقومات التجديد الفنى ما يؤهلها لذلك؛ فلم تكن أكثر من محاولة تجريبية اتسمت بكثير من عناصر القلق الفنى الذى صاحب هذه المرحلة من إبداع الكاتب.
ولم يكن النقاد بحاجة إلى هذا التوجيه النقدى المتكلف. وإذا كان لابد من التصنيف النوعى، فـ”المرايا” أقرب فى نظر الباحث إلى “اللوحات القلمية”؛ ذلك الفن الذى وصفه يحيى حقى بأنه “بين بين” أى فى منطقة وسطى بين المقالة والقصة القصيرة، غير أنه إلى الثانية أقرب. فالكاتب يرسم بقلمه ـ كما فعل نجيب محفوظ فى “المرايا”ـ شخصيات إنسانية يجد فيها مدعاة للتفكه أو مدعاة للتأسى، “وإلى هنا ينتهى عمله فلا تطلب منه فوق ذلك حادثة متطورة أو مواقف تتراكب، إنه إنسان كأنه خارج من قصة أو مرشح للدخول فيها، فإن لفظته فإن هناك قصة أخرى ترحب به هى قصة الحياة على مسرحها الدوار، الأبدى”([13]).
وتمثل “المرايا”ـ من ناحية أخرى ـ “شروداً سردياً” من الكاتب ـ إذا جاز التعبير ـ أو خروجاً على النوع الأدبى. وهو شرود له أسبابه التى أوضحناها. وهى ليست بدعاً من بين أعمال الكاتب فى ذلك، فهناك أكثر من عمل فنى له يمكن أن يدخل فى باب “شرود السرد” وربما يحتاج لدراسة خاصة تبين مكانها من مجموع أعمال الكاتب، والأسباب المرحلية والفنية وراء انصراف الكاتب فيها عن “النوع الأدبى” المحدد (القصة والرواية والمسرحية). وهى أعمال مثل “المرايا”، “حكايات حارتنا”، “أمام العرش”، “أصداء السيرة الذاتية”، “أحلام فترة النقاهة”. فهى أعمال تستعصى على التصنيف النوعى وتحتاج ـ مجتمعة ـ إلى وقفة نقدية خاصة.
وتتمثل عودة للكاتب إلى الرواية كفن أدبى فى “الحب تحت المطر” 1973 وإن لم تفارقه فيها السمات الإبداعية السابقة من مباشرة وغموض وعجلة فى التناول. ثم يخرج مجموعة قصصية بعنوان “الجريمة” 1973 ثم يخرج رواية “الكرنك” 1974 التى تبلغ فيها المباشرة مستوى يقترب بها من التقارير السياسية المباشرة. وهى تشكل عودة غير محمودة للشكل الفنى الذى اتبعه بنضج بالغ فى “ميرامار”. ونلاحظ فى المحاولات السابقة أنه عاد مرة أخرى إلى “الرواية” بعد أن ظل يكتب فى أشكال فنية مختلفة من القصة القصيرة إلى القصة القصيرة الطويلة إلى المسرحية. ولقد قال عن هذه المحاولات إنه وجد نفسه “فى حالة استطلاع ومتابعة وسط عالم سريع التغير … تعذَّر علىَّ مواجهته روايةً، أى تعذَّر علىَّ الانعزال عنه مدة طويلة تكفى لكتابة رواية، إذ أنه يدق على الباب كل صباح ومساء فوجدتنى أقدر على مواجهته ومتابعته بالأعمال المركزة القصيرة التى تناسب الرحالة لا الرجل المستقر”([14]).
ويبدو فى ضوء هذا أن حالة من الاستقرار بدأ يدخلها الكاتب عقب 1973 مكنته من أن يعود إلى الرواية مرة أخرى، وإن كانت عودة اكتنفها بعض التعثر كما يتضح فى “الحب تحت المطر” و”الكرنك”. ثم تبدأ ملامح هذه المرحلة الإبداعية فى الوضوح النسبى، وذلك فى “حكايات حارتنا”، حيث يتقدم بالمرايا خطوة ـ فى اتجاه السيرة الذاتية ـ و تبدأ منها بشائر “الحرافيش”، القمة الفنية لهذه المرحلة. فقد عاد نجيب محفوظ فى “الحكايات” إلى عالم الحارة مرة أخرى، واستخدم مفرداتها (التكية والساحة والقرافة والقبو والأناشيد والدراويش)، بل واستخدم الكاتب مقتطفات من الشعر الفارسى لأول مرة (فى الحكاية رقم 1، والحكاية رقم 78)، وهى كلها ستتحول إلى تيمات أساسية فى “الحرافيش”. بل إن ثمة مشاهد فى “الحكايات” ستتكرر بعينها فى “الحرافيش” مثل الحكاية رقم 72، حكاية “عكلة الصرماتى” وطريقة موته، هى نفسها حكاية جلال صاحب الجلالة (الحكاية السابعة) فى “الحرافيش”. هذا فضلاً عن أن الكاتب فى هذا العمل ـ الذى يصعب وصفه بـ”الرواية” ـ كان قد أمسك بالخط الأساسى لإبداع هذه المرحلة، وهو الخط الصوفى الذى سيبلغ قمته فى “الحرافيش”(·).
لقد لمس نجيب محفوظ الحل الصوفى فى أعمال تنتمى لمراحل إبداعه السابقة مثل “الشحاذ”، “ثرثرة فوق النيل”، “زعبلاوى”. ولكنها أعمال جسدت التصوف كحل على المستوى الفردى، كما يلحظ حمدى السكوت، أما فى “الحرافيش” فيجىء التصوف كحل على المستوى الجماعى، ليعقد عليه الأمل فى ملء الفراغ الروحى الذى يعانى منه كثير من مثقفى القرن العشرين، وفى تخفيف ويلات الضعفاء والمقهورين فى المجتمعات البشرية([15]).
ولقد شحذ نجيب محفوظ أدواته لهذا الطريق عبر “حكايات حارتنا” ـ كما سبق ـ و”قلب الليل”، و”حضرة المحترم” وصولاً لتجسيدها التجسيد الفنى الأكمل فى “الحرافيش”. فقد تحددت القضايا الفكرية الكبرى فى “قلب الليل” التى ناقشتها الرواية بشىء من الذهنية المفرطة. وهى قضايا مثل: النزاع بين العاطفة والعقل، والإنسان الإلهى والإنسان الدنيوى، والسعى إلى المدينة الفاضلة، والطريق إليها، وغير ذلك. ثم تجىء “حضرة المحترم” كمغامرة خاضها الكاتب ـ خلال هذه المرحلة ـ لتطويع لغته حتى توائم النهج الصوفى. فالقصة لا تحمل جديداً لإبداع الكاتب إلا فى مستواها اللغوى.
ولقد التفت إلى هذا الملمح الفنى معظم نقاد الرواية ومنهم الناقد رشيد العنانى الذى لحظ أن نجيب محفوظ يستخدم فى هذه الرواية ألفاظاً تنتمى إلى سياق الخبرة الدينية وخاصة حالات الوجد الصوفى، من قبيل: الأحلام المقدسة، الشعلة المقدسة، أبواب اللانهاية، سدرة المنتهى، طريق المجد…إلخ. وهو فى نظر الناقد اختيار مقصود من الكاتب ينقل به خبرة مبتذلة إلى مستوى أرقى من مستواها، وذلك من أجل خلق الإحساس بالمفارقة، أو التناقض لدى القارىء، يتولد لديه من التنافر القائم بين الموصوف وبين الأسلوب الذى يوصف به([16]). وتفسير الناقد للاستخدام اللغوى فى الرواية تفسير جيد، يضاف إليه ـ إذا نظرنا إلى الطبيعة المرحلية للرواية ـ أن “حضرة المحترم” مغامرة لغوية خاضها الكاتب فى سبيل إخضاع التعبير الصوفى، ذلك التعبير الذى سيشكل عماد إبداع المرحلة ممثلاً فى قمتها “الحرافيش” بعالمها الرحب وآفاقها الفنية المترامية.
ثم يجىء “هبوط المنحنى” أو التوقف الثالث فى رحلة نجيب محفوظ الإبداعية، والذى استمر أكثر من ثلاث سنوات (بدأت “الحرافيش” تنشر مسلسلة فى عام 1976). ويمكن تفسيره ـ مثل التوقف الأول عقب الثلاثية ـ بالتشبع الفنى والرغبة فى التقاط الأنفاس بعد شوط إبداعى مرهق ختمه بعمل فنى ضخم كالحرافيش.
…………
([3]) انظر محمد حسن عبدالله: كناسة الدكان فى مرآة الزمان. مجلة البيان الكويتية. العدد 70 يناير 1972
([4]) انظر: نجيب محفوظ صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على أدبه. مرجع سابق ص271
([5]) جمال الغيطاني : جيب محفوظ يتذكر- دار أخبار اليوم ص 138
([6]) من حوار مع فاروق عبدالقادر نشر فى روزاليوسف 29-6-1970 نقلاً عن: فى الرواية العربية المعاصرة ص 25
([7]) نجيب محفوظ وتطور الرواية العربية ص 162.
(96) فى الأدب العربى الحديث: مرجع سابق ص202
(·) انظر ما كتبته فاطمة موسى مثلاً عن مسرحية “التركة” و”حارة العشاق” وقصة “تحت المظلة”، من مجموعة “تحت المظلة”، وقصة “النوم” من مجموعة “شهر العسل”. نجيب محفوظ وتطور الرواية العربية ص161 وما بعدها. ومما يؤيد رأى الباحث ما ذكرته نهاد صليحة من أن مسرحيات نجيب محفوظ حينما مُثلت على خشبة المسرح فى الستينيات والسبعينيات لم تلق رواجاً كافياً. وذكرت أيضاً أن معظم المخرجين المسرحيين كانوا يقبلون على تقديم رواياته دون مسرحياته لأنها فى رأيهم أكثر درامية. انظر
Naguib Mahfouz as play wright by Nehad selaiha. From Naguib Mahfouz Nobel 1988 Egyptian Perspectives p.90
([10]) مجلة عالم الفن الكويتية: العدد 176 ص41 نقلاً عن: يوسف نوفل: الفن القصصى بين جيلى طه حسين ونجيب محفوظ ص 107وانظر أيضاً: نجيب محفوظ يتذكر ص 140 حيث يعبر عن هذه الحالة من عدم معرفة ماالذى يكتبه بالضبط.
([11]) نقلاً عن كناسة الدكان مصدر سابق.
(·)انظر: قضية الشكل الفنى ص 353
([12]) الفن القصصى بين جيلى طه حسين ونجيب محفوظ ص 106
([13]) يحيى حقى: فجر القصة المصرية. الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة 1986 ص176.
([14]) مجلة الفكر المعاصر سبتمبر 1968 ص78 نقلاً عن فاطمة موسى: نجيب محفوظ وتطور الرواية العربية ص 163، 164.
(·)وقد ذكر محفوظ أن “حكايات حارتنا” كانت تمهيداً لـ”لحرافيش”. انظر: نجيب محفوظ يتذكر ص 140