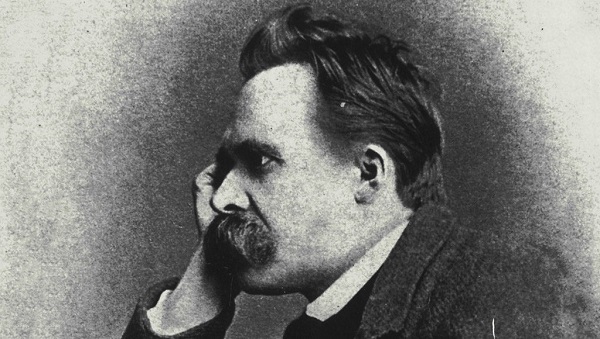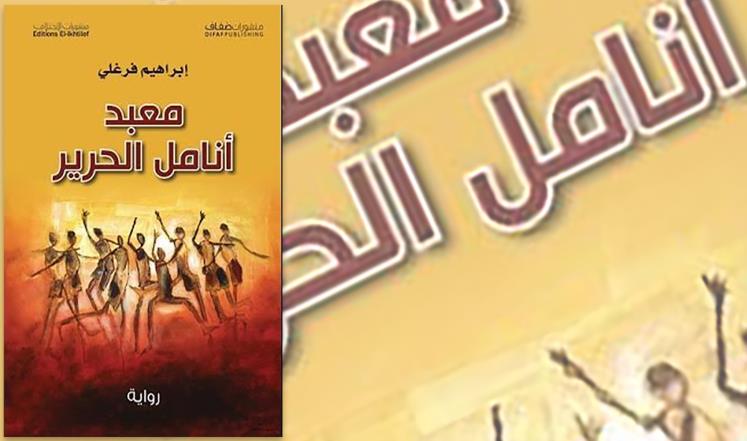د.خالد عاشور
مرحلة أولاد حارتنا:
لقد آثرنا أن نطلق على المرحلة الثانية من إبداع نجيب محفوظ “مرحلة أولاد حارتنا”، لأن هذه الرواية ـ بضخامة الفكرة وريادة الموضوع وجرأة المعالجةـ تمثل العباءة التى خرجت منها روايات المرحلة، فهى بالنسبة إليهم كالمتن إلى الشرح، على الرغم من أن تلك الروايات تجاوزتها فنياً فى الوقت ذاته. وإن كانت المرحلة الأولى قد انتهت إلى الثلاثية كقمة فنية لها استوعبت كل إمكاناتها الفنية والأسلوبية وكل أفكارها وقضاياها؛ فإن “أولاد حارتنا” قامت بالدور نفسه وإن اختلف موقع العملين: “أولاد حارتنا” فى البداية، و”الثلاثية” فى النهاية.
يقول غالى شكرى: “هكذا نستطيع أن نتلقف معظم الأفكار الواردة فى “أولاد حارتنا” حول الوقف والبيت الكبير والجبلاوى والنظار والفتوات وأخيراً عرفة وحنش فى بقية الأعمال التالية ابتداءً من “اللص والكلاب” حتى “ميرامار”. ولكننا حين نتلقف هذه الأفكار الرئيسية سوف نشهد ما طرأ عليها من تغيير كبير يحول كثيراً دون التعرف على الأصل البعيد”([1]).
وهذا هو المعنى الذى أشارت إليه لطيفة الزيات حين قالت إن “أولاد حارتنا” تحمل “الصورة الخام” للتناقضات التى تنطوى عليها رؤية نجيب محفوظ للحقيقة. وهى تقرر أن الرواية لم توفق فى تجسيد هذه الرؤية تجسيداً فنياً يتوفر له الشكل الذى يحتوى هذه الرؤية ويعكسها ويكشف ويعلق على طبيعتها([2]).
وأعتقد أن ما أصاب “أولاد حارتنا” من جوانب ضعف فنى راجع إلى كونها بداية شوط إبداعى، فاعتراها ما يعترى البداية ـ عادة ـ من تعثر وارتباك وقصور رؤية، مثلما حدث فى بداية المرحلة الأولى. ثم بدأت هذه الرؤية تتبلور ـ تعبيرياً ـ بدءاً من “اللص والكلاب” مروراً بقية روايات المرحلة حتى “ميرامار”. فقد تجاوزت روايات ما بعد “أولاد حارتنا” أحادية بعدها الفكرى وتجريديته إلى علاقة جدلية بين الفكر والواقع، فضلاً عن الدرامية التى أثرت التجربة وأبعدت عنها شبح التجريد، وإن لازمها هذا الشبح فى بعض تجلياتها كـ”الشحاذ” مثلاً. ولقد بدأت تلك الملامح فى الوضوح ـ كما قلنا ـ مع “اللص والكلاب”، وهذا هو ما أغرى جملة من النقاد بأن يبدءوا هذه المرحلة من “اللص والكلاب” دون أن يعودوا إلى الوراء قليلاً ليكتشفوا النبع الذى خرجت منه هى وبقية الأعمال التالية لها.
ولقد قدم صبرى حافظ ربطاً جيداً بين روايات المرحلة يتمثل فى تلك النقطة الفاصلة بين واقعين، التى تبدأ منها كل رواية؛ من الانطلاق من اللحظة المتأرجحة التى تشى بالماضى والحاضر معاً وتَعد فى الآن نفسه بطلائع المستقبل وتفاصيله. فرواية “أولاد حارتنا” تبدأ من لحظة جنوح الجبلاوى إلى الراحة واختياره أدهم ليدير الوقف، مفجراً بذلك الفعل شرارة الصراع المرير الطويل الذى يسيطر على الرواية كلها. وتبدأ “اللص والكلاب” من لحظة خروج سعيد من السجن ومواجهته للواقع الجديد المكتظ بالخديعة. أما “السمان والخريف” فإنها تبدأ من اللحظة الدامية التى أخذت فيها الأرض فى الفرار من تحت أقدام عيسى. كما تبدأ “الطريق” من اللحظة التى يتيقظ فيها صابر الرحيمى على موت أمه الدامى ويبحث فيه عن طريق يقوده إلى الحرية والكرامة والسلام. وكذلك “الشحاذ” تتفق معهم فى أسلوب البداية، فبدايتها متعلقة برؤى جديدة تستيقظ داخل أعماق البطل تدفعه إلى طريق طويل من الصراع([3]).
وقريب من هذا ما ارتأته لطيفة الزيات من وجود خط فنى واحد يربط بين روايات المرحلة ـ وإن كانت تبدأ عندها من “اللص والكلاب” ـ حيث رأت أن أسلوب الروايات واحد من حيث احتلال الحقيقة الداخلية نفس أهمية الحقيقة الخارجية، وما يترتب عليه ذلك من تداخل الحلم والواقع، وتشابه المستويات الزمانية والمكانية، وتعارضها فى وعى الشخصية التى نتلقى منها الحدث. كما أن بناء روايات المرحلة ـ باستثناء “أولاد حارتنا” ـ واحد من حيث تضمنه رحلة لها بداية حاسمة محددة ونهاية حاسمة محددة، يضم ما بين البداية والنهاية تعرف الإنسان على بعض الحقائق الأساسية فى الحياة([4]).وحضور أسلوب تيار الوعى بقوة فى هذه المرحلة هو ما دفع محمود الربيعى لأن يسمى هذه المرحلة “مرحلة تيار الوعى”([5]). وهو محق فى هذا إلى حد ما؛ إذ تشكلت هذه الروايات فنياً بأسلوب تيار الوعى، وتجاوز هذا الأسلوب دوره الشكلى إلى كونه ضرورة فنية حتمية.
ولقد استمر إبداع هذه المرحلة محافظاً على مواصلة الاتجاه دون أن تطرأ عليه معوقات أو اضطرابات فى صورة تفريعات جانبية، من قبيل الانشغال بأعمال أخرى على غرار تجربة “السراب” فى المرحلة الأولى. وإن كان ما أصاب بعض روايات المرحلة من ميتافيزيقية مفرطة كادت تعصف بدرامية التجربة؛ يمكن أن يعد اضطراباً تعبيرياً فى إبداع المرحلة لم يصل لدرجة “الإغلاق”.
ولعل السبب فى هذا يعود إلى قصر عمر إبداع المرحلة، فهى تبدأ من 1959 حتى 1967 (بدأ فى كتابة “ميرامار سنة 1965 كما قال بذلك محفوظ لمصرى حنورة) وهو زمن إبداعى ربما يستغرقه عمل إبداعى واحد، مثلما استغرقت الثلاثية مثلاً. ولقد اقترب إبداع المرحلة بعد “أولاد حارتنا” من العمل الواحد الكبير.
أما من قال بأن “ثرثرة فوق النيل” و”ميرامار” مرحلة بذاتها، أو أن “ميرامار” بداية مرحلة لم تتكون بعد؛ فراجع كما تقدم إلى النظرة الجزئية التى نظروا بها إلى أدب الكاتب فى فترات لم يكن الكاتب قد أتم مشروعه الإبداعى، فضلاً عن الاختلاف الظاهرى لـ”الثرثرة” و”ميرامار” من حيث البطولة الجماعية بعد البطولة الفردية فى بقية روايات المرحلة. غير أن هذه فروق ظاهرية لا تنفى عن هذه الروايات اشتراكها فى رؤية فكرية وفنية واحدة، فما هى إلا تنويعات مختلفة على لحن واحد هو لحن “أولاد حارتنا”. وكل ما فعله الكاتب أنه تخفف قليلاً فى الروايتين الأخيرتين من غموض الرمز الذى لازمه فى “الطريق”، ومن جفاف الفكرة الذى لازمه فى “الشحاذ”، ليعبر عن الفكرة نفسها بشىء من الوضوح. أو فلنقل إنه ألبس الميتافيزيقية الباردة فى هاتين الروايتين ثوباً اجتماعياً، كان قد نزعه عما قبلهما من روايات.
ويحسن هنا أن نستشهد بما قالته لطيفة الزيات فى هذا الشأن من أن “ميرامار” تعبّر فنياً عن نهاية مرحلة استنفد فيها أدواته الفنية، مما يؤذن ببداية مرحلة جديدة. تقول الناقدة: “وأنا أكتب هذا الكلام (عام 1970) ورحلة نجيب محفوظ قد اكتملت فى هذا الاتجاه أو كادت، وهو قد تخفف ما بين “اللص والكلاب” و”ميرامار” من الكثير. والإطار الروائى الذى اتسع له طيلة هذه الرحلة قد بدأ يضيق. وهو يبحث الآن جاداً عن إطار جديد، تفرضه رؤية للأشياء قد تغيرت فى مسار الرحلة وتجددت، ورؤية للأشياء عانت اهتزازاً عنيفاً مع أحداث يونيو سنة 1967″([6]).
وعطفاً على ما قالته لطيفة الزيات، فإن هزيمة 1967 لم تكن السبب الأساسى فى التوقف لأن الكاتب انتهى من “ميرامار” كتابةً ونشراً قبل الهزيمة (النصف الأول من 1967). فالتوقف يعود فى أصله إلى بلوغ الشوط الإبداعى نهايته، مثلما حدث بعد الثلاثية، فكان لابد من البحث عن إطار فنى جديد يصلح للشوط التالى. وربما عمقت الهزيمة من هذا التوقف، وألقت عليه ظلاً سياسياً ونفسياً صاحب الكاتب فيما بعد.
………………..
([2]) الصورة والمثال ص 44 ولقد مر بنا بيان المشكلة الفنية فى الرواية انظر “المنظور الدينى” من فصل النقد الأيديولوجى فى كتاب البحث عن زعبلاوي
([3]) صبرى حافظ: استجداء الحقيقة. مجلة “المجلة” أبريل 1966. ص 53، 54