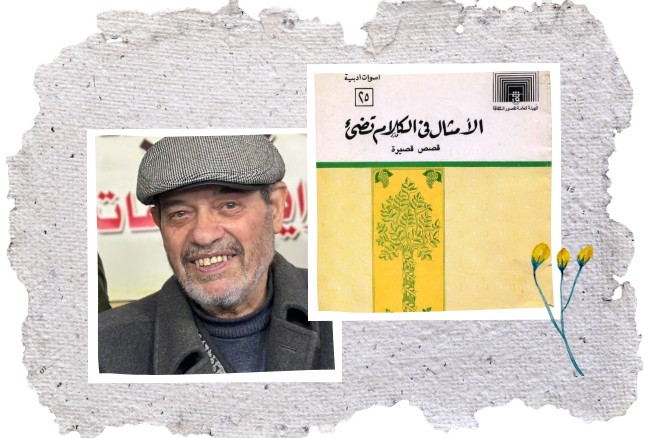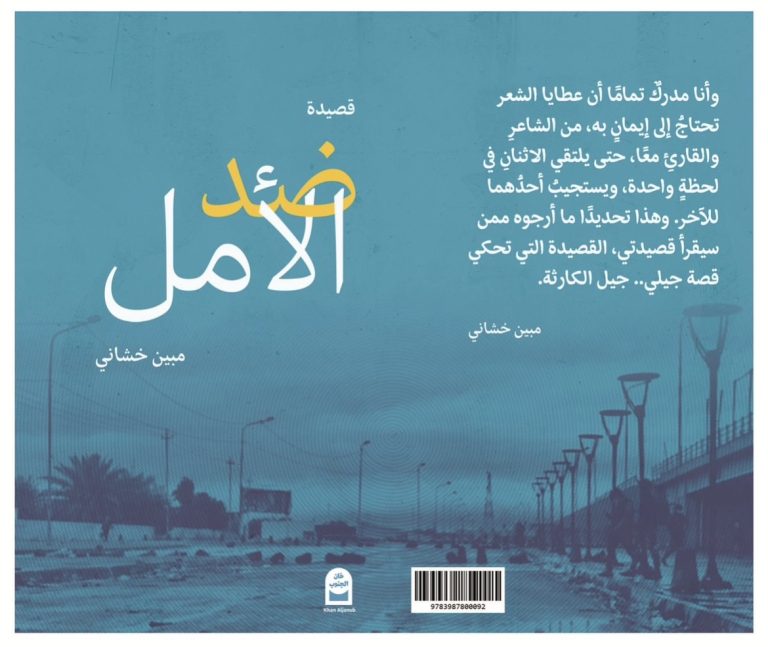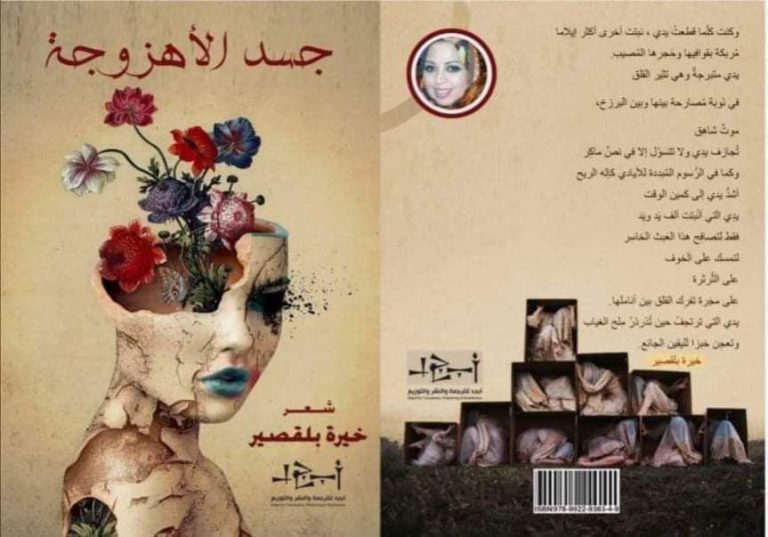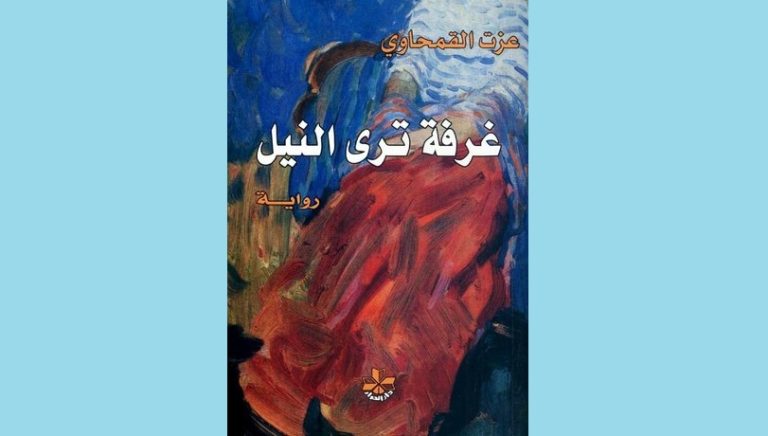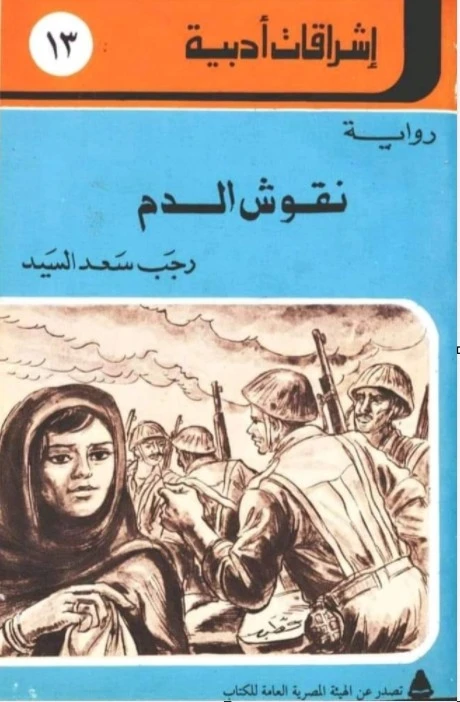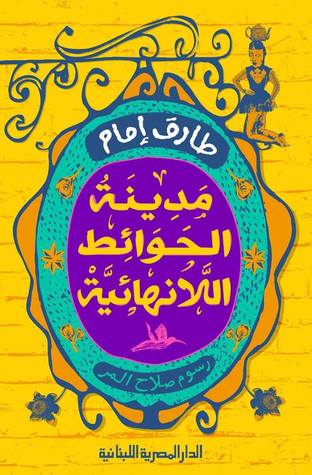أسامة كمال أبو زيد
لم يكن محمود درويش شاعرًا فحسب، بل كان قارة كاملة من الذاكرة تمشي على قدميها، كان لسان المنفى وحارس الذاكرة الفلسطينية، ومرآة لجرح عربي لم يندمل، لكنه أصرّ أن يجعل من الألم بيتًا للغة، ومن الفقدان جناحًا يطير به نحو أفق الإنسانية كلها. ولد في البروة عام 1941، في حضن قرية تفتح نوافذها على البحر وحقول الزعتر والقمح، ولم يكن يدري أن طفولته القصيرة بين حجارة البيوت وجرس الكنيسة وأذان الفجر لن تكتمل، وأن السابعة من عمره ستدخله إلى جحيم النكبة، حيث يتحوّل البيت إلى خيمة، والسماء إلى جدار مائل، والمطر إلى ضيف ثقيل يتسرب من أقمشة البؤس. في لحظة واحدة مُسحت قريته من الخريطة، وصار اسمه واسم أهله مدونًا في سجلات “الحاضر الغائب”، تلك العبارة الباردة التي تترجمها القصيدة إلى شظايا قلب ممزق: أن تكون هنا وغريبًا في آن واحد، أن تعود إلى أرضك فلا تجدها، أن تقف في مكانك فلا ترى سوى الأطلال وقد تحولت إلى غياب مضاعف. منذ ذلك الوقت صار درويش يعرف أن الكلمة هي بيت آخر، وأن القصيدة يمكن أن تعيد بناء القرية التي سُوّيت بالأرض، وصار الطفل الذي يقرأ المتنبي والبحترى يعرف أن الشعر ليس ترفًا بل مقاومة، وأن بيتًا واحدًا قد يكون حجرًا في وجه محتل. وعندما وقف في الثالثة عشرة يلقي قصيدة عن الأرض فاستدعاه ضابط إسرائيلي وحذّره من “تأجيج المشاعر”، فهم أن الشعر جريمة في نظر الجلاد، وأن لغته ستكون منفىً آخر لكنه منفى طوعي يختاره ليبقى حرًا.
منذ قصيدته الشهيرة “بطاقة هوية”، التي صارت نشيدًا على شفاه الناس، خرج درويش من دائرة الشاعر الفرد إلى رحابة الصوت الجماعي، وصار رمزًا لشعر المقاومة إلى جانب رفاقه زياد وسميح القاسم وراشد حسين. لكن ما ميزه أنه لم يكتف بالهتاف، بل كان يعرف أن الهتاف يبهت إذا لم يتكئ على صورة باقية. لذلك، حتى وهو يهتف، كان يغرس في القصيدة رائحة الزيتون وصوت الأم وحنين البيت الذي لم يعد موجودًا. وحين عبر الحدود إلى القاهرة ثم بيروت، وتجوّل بين المنافي، وسكن المدن التي لا تسكنه، اتسع أفقه الشعري، فلم يعد “شاعر البندقية” بل صار شاعرًا للإنسان وهو يقاوم الفقد، شاعرًا يزاوج بين الجرح الفلسطيني والجرح الإنساني، بين نيرودا وأراغون وذاكرة الجدة، بين الأسطورة الإغريقية والخبز على التنور.
كان الحب في حياته منفى آخر، لم يكن خلاصًا من الجرح بل وجهًا آخر له، فالحبيبة مثل الوطن: بعيدة، محظورة، ظلّ على الجدار. “ريتا” التي خطفت قلبه صارت استعارة للفلسطيني الذي يمد يده إلى الآخر فيجد بندقية تفصل بينهما. الحب عنده لم يكن نزهة، بل مقاومة ضد القسوة، دليلاً على أن الإنسان لا يزال إنسانًا. وفي سنواته الأخيرة تحوّلت المرأة في شعره إلى رمز كوني، زهرة أو غيمة أو صوتًا يأتي من بعيد، حتى صار الحب عنده شبيهًا بالزمن: يتقاطع مع الموت كما يتقاطع مع الحياة، يضيء ليؤكد أننا لم نتحجر بعد.
أما المنفى فكان قدره الأكبر. لم يكن مجرد انتقال قسري من مكان إلى آخر، بل كان جغرافيا للروح، مختبرًا للغة جديدة، ساحة مفتوحة يتقاطع فيها الحنين والغياب، حضور الغائب وغياب الحاضر. حمل فلسطين في حقيبته، لا كخريطة بل كحديقة متحركة بالكلمات، وعرف أن الوطن قد يُمحى من الأرض لكنه يبقى في الذاكرة، وأن القصيدة قادرة أن تكون بيتًا، والبيت قصيدة. المنفى عنده لم يكن نوستالجيا ميتة بل جذر ممتدّ في فضاء آخر، جذر يُثمر صورًا ورموزًا ولغة لا تموت. عاش في الوسط بين العودة والمغادرة، بين “هنا” و”هناك”، وكان قدره أن يظل معلّقًا في البرزخ، حيث تصبح الهوية مشروع بحث لا ينتهي.
وحين نطوي صفحة من شعره لا نغلق نصًا مكتملًا، بل نغلق على كون بأكمله، على ذاكرة ما تزال تنبض في كلمات تتحدى الغياب. محمود درويش لم يكتب قصيدة فقط، بل كتب حياة بأكملها، جعل من اللغة خيمةً تحمي الحلم من الرياح، ومن الشعر وطنًا لا يُحتل. هو شاعر نصف قرن وأكثر، لكنه قبل ذلك وبعده، هو من علّمنا أن اللغة يمكن أن تكون بيتًا، وأن الشعر ليس كلامًا يُقال بل حياة تُعاش، وأن الجرح حين يُكتب يصبح أجمل من انتصارات كثيرة. لقد رحل الشاعر، لكن قصيدته لا تزال تمشي بيننا، مثل شجرة زيتون لا يقطعها الزمن.