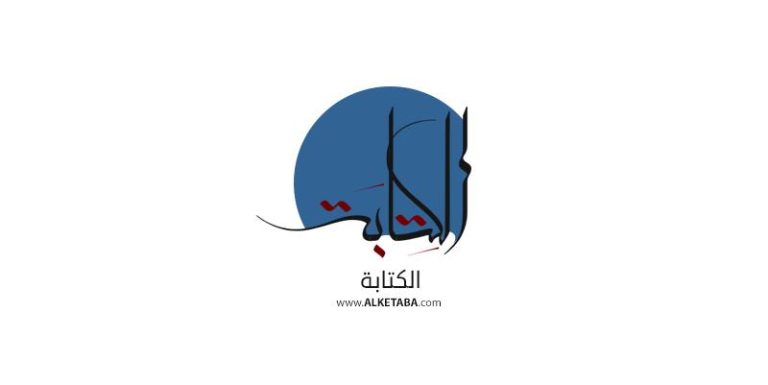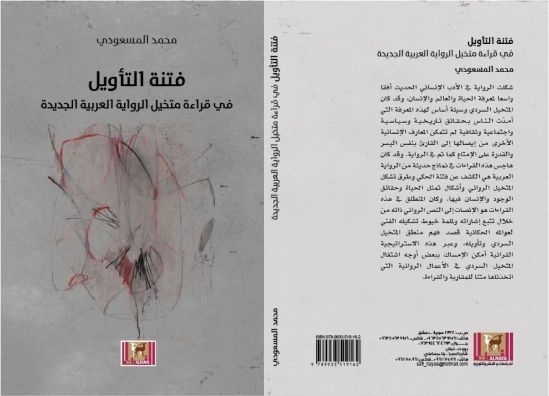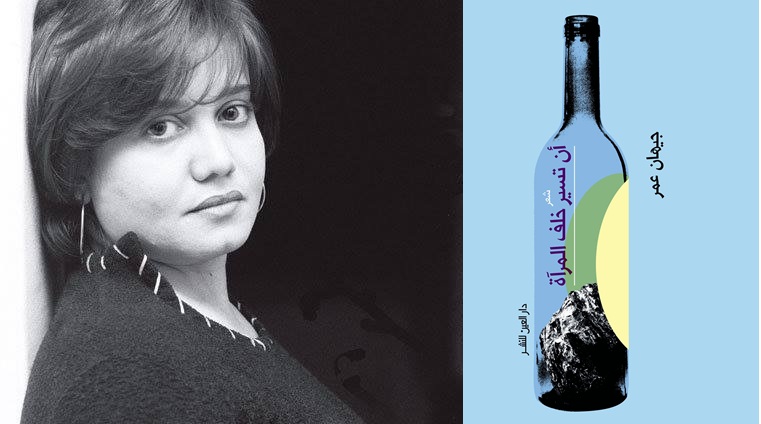محمد إبراهيم طه
يحضرني الآن بطل روايته القصيرة ” نجم وحيد في الأفق”، يتجسد أمامي كأنه محمد جبريل، لا فرق بينهما، قرأتها قبل 25 سنة، لكنها قفزت على كل الأعمال التي قرأتها له؛ إمام آخر الزمان، النظر إلى أسفل، قاضي البهار ينزل البحر، زهرة الصباح، الشاطئ الآخر، اعترافات سيد القرية، الصهبة، من أوراق أبي الطيب المتنبي، ورباعية بحري، ويمكنني الآن أن أجزم أنه بطل الرواية التي كانت بروفة لحياته الحافلة بالكتابة والقراءة والعزلة حتى رحيله، إنه الأستاذ صاحب ندوة المساء الأسبوعية التي تربيت فيها بين تلاميذه ومريديه، وصاحب البيت المفتوح في سليمان عزمي بمصر الجديدة لكل محبيه ومريديه، وصفحة قضايا أدبية في المساء، النافذة الأسبوعية التي يطل بها على الواقع الثقافي والأدبي، وصاحب رباعية الإسكندرية في نسختها المصرية، رباعية بحري (أبو العباس، ياقوت العرش، البوصيري، وعلي تمراز) التي يهيمن فيها الحضور الصوفي لوجود مساجد الأئمة، والموالد الدينية، والحضور الباذخ للشخوص البسيطة من الصيادين والفرانين والبسطاء الذين يمثلون الشخصية السكندية الأصيلة في أحياء الأنفوشي، والسيالة وحلقة السمك، الرباعية التي كتبها في مواجهة رباعية داريل الكوزموبوليتانية الشهيرة: (جوستين، وبلتازار، ومونت أوليف، وكليا) حين رأى أن مشاعر لورانس داريل لم تكن أخوية ولا حميمية، كان ككل الفنانين والشعراء والروائيين الأجانب الذين كتبوا عن الأسكندرية، مجرد أعين راصدة، تنقل المغاير والمدهش والمثير، وإن تخللتها بعض المواقف الشخصية، فاحتفلوا بالجاليات الأجنبية واهتموا بالحي الأجنبي وهمشوا الشخصية السكندرية في الأحياء الشعبية.
لقد عرف محمد جبريل منذ وقت مبكر أن الكتابة فعل فردي، وإهدار الوقت فيما لا يفيد خطأ كبير، فلزم بيته، وعكف على القراءة والكتابة، لا يفرح بشيء من الدنيا، ولا يأسف على ما ضاع منها، ابتعد عن الشللية، واكتفى بمظاهر المحبة التي تأتيه عبر الهاتف، وزيارات أصدقائه وتلاميذه لبيته، كان يدرك أن الكتابة هي الأبقى والأخلد، فكتب روايته القصيرة “ نجم وحيد في الأفق” الرواية التي تمثل فيها الحس الصوفي أجمل تمثيل، فسافر بطلها مع الأصوات إلى أرض بعيدة، إلى رؤى وأحلام وذكريات قديمة:
مشاهد البحر والشاطئ والبلانسات وطريق الكورنيش والمينا وقصر رأس التين وقلعة قايتباي والصيادين وغازلي الشباك وحلقة السمك وحاجز الأمواج ومباني السلسلة وشارع الميدان وميدان المنشية وسراي الحقانية والجندي المجهول والمشايخ والبحارة وعساكر السواحل والمرسي أبو العباس وياقوت العرش والبوصيري وعلي تمراز ونصر الدين وميدان المساجد ومعهد الأحياء المائية،
تجتاحه الذكريات، فيناوشه حلم الرحيل، لكنه يتذكر زوجته مديحة وابنيه مدحت ويسري، فيمتلئ نومه وصحوه بأصوات لا يدري مصدرها، لا يجدي معها أطباء ولا تحاليل ولا إشاعات، ولا أدوية، فينصحه الشيخ نجاتي الصوفي الزاهد بالبحث عن نجمه في جزيرة بالبحر:
إذا عرف ابن آدم نجمه، اتصل ماضي حياته بملامح الآتي، وكلما رآه مبكرا كان ذلك أفضل، فالنجوم يقلُّ لمعانها بتقدُّم العمر، وإذا مات ابن آدم مات حالا نجمه وذوى، امضِ في الطريق إلى نهايتها، لا تعدْ قبل أن تلتقي بنجمك. لم يعرف ما هو النجم، لم يعرف هل هو نجم حقيقي كهذه النجوم التي تظهر في السماء، أم أنه نجم رمزي؟
كان يخلو إلى نفسه فترات تطول أو تقصر، للقراءة والتأمل، والبحث عن إجابات لأسئلة تشقيه، لكنه ظل مشدودا إلى فكرة الرحلة، وتحولت الرغبة الضبابية إلى عزم ثابت، ولد النجم يوم ولادته، والبداية الواحدة تمضي نحو نهاية واحدة، هو قادم من نجمه ولابد أن يذهب إليه، أخذ كافة الاستعدات للرحلة، تعلم السباحة والغوص والصيد وتعلم مفردات البحر من سباحة وغوص وتجديف، ليقود القارب بمفرده ناحية الجزيرة، وقد استقر في أعماقه طلب النجم الذي أطال التعلُّم حتى يجده، أصبح ما يفعله ليس تلبية لمطالب الشيخ نجاتي، إنما تلبية لنداء سماوي لا يقوى على رده، لا شيء يمنعه من الوصول إلى ما خرج للقائه، وعليه أن يواجه كل من يلقاه وحيدا أعزل، وعزاؤه أنه كان يحيا الوحدة قبل أن يبدأ الرحلة، لقد أعد نفسه لينصت إلى ما يقوله النجم، يتذكر كل حرف وكل كلمة وجملة، حتى ما قد يعجز عن فهمه، يطبعه في ذاكرته ويستعيده متأملا، لم يعد يشغله هدف الرحلة، هي هدف في ذاتها، لا صلة لها بما قبل ولا بعد، أين يجد النجم؟ في أي مكان يظهر له ويعرفه؟ يبدو النجم نجما أو متحولا في هيئة تغيب عن تصوره؟ هل يفلح في تبين الهيئة المتحولة؟ وما تصرفه إن تيقن مما رأى؟ هل يسألُ أم يُعفيه النجم ويردُّ من نفسه عن أسئلة تشغله؟
بدأت الرحلة وهو الآن وحده على قارب في وسط البحر، تعاقب عليه الليل والنهار، وطالت لحيته، وتبدل القمر في مراحله أكثر من مرة، وليست حوله إلا امتدادات الأمواج بلا نهاية، من كل الجوانب، لا شَمال ولا جنوب، ولا شرق ولا غرب، والقارب بقعة في مساحات المياه التي امتزج فيها الأخضر بالأزرق، وثمة فلوكة خالية وبعيدة يجرفها التيار، انتابه الخوف، وقهره الإحساس بالعزلة والوحدة والضآلة في اتساع الأفق حوله من كل الجوانب، حرٌّ في الفراغ المطلق، ومقيدٌ في الفراغ نفسه،
ثم يدفع القارب كائن بحري ضخم، فينقلب، يتشبث به، وتندفع نحوه آلاف الطيور التي لم ير مثلها، لا يعرف من أين ولا كيف أتت، تحوم فوق رأسه وتتقافز، وتنقر جسده، كائن بحري أم نوة هبت فجأة بلا نذير؟ تذكر أنه لو أن كل النوات أعطت إنذارا فلن يغرق أحد. حالت السبل دون فعل أي شيء، لا بوصلة ولا قفز في الماء، تذكر تعليمات مدربه: لن تعرف البحر إلا إذا سبحت فيه والمهم أن تصل في غوصك إلى الجوهر، والغوص ليس نزولا إلى الأعماق فحسب، لكنه صعود إلى السطح أيضا، مسافتان لا مسافة واحدة، تذكر تأكيد الشيخ نجاتي بأن الرحلة لا معنى لها إذا صحبك إليها أحد،
ولن تكتمل إلا إذا كنت بمفردك.
هو الآن بمفرده وسط البحر، والكائن البحري أو النوة قلبت القارب، فماذا يفعل؟ تذكر كلام الشيخ نجاتي بأن السعي إلى لقاء النجم هو الرحلة الوحيدة التي يجب على المرء ـ حين تبدو مشكلاته بلا حل ـ أن ينطلق فيها، تشبث بجدار القارب، فتحركت شفتا الكائن البحري،وبدت كلماته واضحة ورائقة: أنت لا تملك من الأمر شيئا، إذا وجدت ما يخيف، فاقذف بنفسك في البحر. ترك القارب، فتقاذفته الأمواج حتى بداية اليابسة، وجدها جزيرة، استأذن من شيخها فأذن له بالدخول
أحس وهو يسير كأن قدميه لا تلمسان الأرض، وأنه يطير
لم تعد الشمس اللاهبة كما كانت، تحولت إلى قبس أضاء الموجودات، تداخل الضياء في الضياء، فتألقت الموجودات بما لا يتصور أنه سيطالعه، نور فوقه وأمامه وحوله، لا نهاية لآفاقه، لا سماء ولا أرض ولا ضفاف، ضياء مسكون بقداسة علوية، لم يسبق له رؤيته، ولا تصور أنه بكل هذا الجمال، تصاعدت النشوة وتوحد مع الكائنات، ذاب فيها وذابت فيه، فلم يعد هو هو، إنما قطرة في البحر الهائل، نجمة في ملايين النجوم، لم يعد الجزء، إنما الجزء ملتحما بالكل، غابة خضراء تغيب مساحتها في امتداد البصر، غزلان وظباء وبجع وطواويس، وأشجار دانية قطوفها، وقصور يرى داخلها من خارجها وظاهرها من باطنها، فتيات يرفلن في ثياب من حرير، ويتحلقن حوله، زال التعب والمرض والألم، وصفا الذهن وتصاعدت من داخله موسيقي علوية، وبدا المشهد أكبر مما يستطيع تحمله والوقوف أمامه، فسجد في موضعه، والفتيات من حوله يدلكن جسده بالأعشاب والزهور، ويروين له الحكايات، ويشغلن أوقاته بالأحاجي والفوازير والألغاز.
الحياة في الجزيرة تختلف عن الحياة في بحري، هناء ونعيم لا ينقطع، لم تعد تشغله سوى اللحظة، مقطوعة الصلة بما قبل وبما بعد، كل ما يفد إلى ذهنه يتحقق، فكر في أن يزرع، يرقب البذرة حتى تنمو وتصبح ثمرة، لكنها نمت في لحظة وحان حصادها، التقى في الجزيرة بمن كان يعرفهم ويعرفونه في بحري، أكثروا من الأسئلة حول أحوال الناس في بحري، وتحدثوا عن ميادين وشوارع وبيوت، وجوامع ومقاه وأسواق، ولاحظ أنه لا تصله أنباءٌ عن موتٍ ولا موتى، ولا رأى جنازةً في الطريق، ولا وصله ذات لحظة بكاءٌ أو عويل، فأدرك أنه لن يعود ثانيةً إلى بحري، وشعر بوحشة لأبي العباس، والبوصيري وياقوت العرش، ونصر الدين والسيالة، وشارع سيدي العجمي، وميدان الأئمة والموالد، وحلقات الذكر، وسوق العيد وتسابيح الفجر، والمينا الشرقية والكورنيش، وخليج الأنفوشي، وضوء الفنار وقلعة قايتباي، وسراي رأس التين والمسافر خانة، والحجاري والموازيني وشارع الميدان، وزنقة الستات وسوق الخيط، وصيد السنارة والطراحة، وحلقة السمك ونداء الباعة، وابتهالات الصوفية و تشابكات الأذان من جوامع الحي، أوحشه كل ذلك حتى أصبح ذكرى وبهتت الملامح حتى غابت تماما.
في مفتتح كتابه “مقصدي البوح لا الشكوى”، يقول جبريل: لا يموت الإنسان دون أن يوافق على موته، مفتتح صوفي، يعني أن العارف تؤخذ موافقته، قبل أن يأتيه ملك الموت، فهل أومأ جبريل بالموافقة؟ أغلب الظن أنه وافق، فالأديب هشام قاسم طبيب الصدر أخبره بأن صعوبة التنفس لا تعني أن التعب في الجهاز التنفسي فقط، ونصحه بالخروج لإجراء فحوص على القلب لدى طبيب قلب، لكنه رفض الخروج بشدة، وبالكاد وافق على فحص بالإيكو في المنزل أكد أن التعب مصدره القلب، وفي اللحظة التي وصلت سيارة الإسعاف لنقله على غير رغبته، فارقت روحه الحياة، كأنه كان يعلم، وكأنه استشير، وكأنه رأى بأم عينيه نجمه الوحيد في الأفق يذوي، فوافق على الاكتفاء بهذه الرحلة الزاخرة بالإبداع.
لم تكن رواية “نجم وحيد في الأفق” سوى بروفة لحياة محمد جبريل كتبها قبل ربع قرن، وخارطة طريق تطابقت بحذافيرها مع كل خطوة له في هذه الحياة، حتى أنه سيخلد في جزيرته المنعزلة، يتمتع بكل ما عليها من هناء وموسيقى وفواكه، لكنه بلا شك سيجلس على حافة الجزيرة على جذع شجرة، مثلما فعل بطل الرواية، يهاجمه الحنين، فيستعيد ملامح الذين فارقهم وفارقوه، ويتأمل الأمواج وقد تضاءلت النشوة، وفقد الدهشة التي رآها لأول مرة حين وصل إلى الجزيرة، ولم يعد ثمة ما يجتذبه أو يثير اهتمامه، فيتوق للعودة إلى شقاء الحياة اللذيذ.