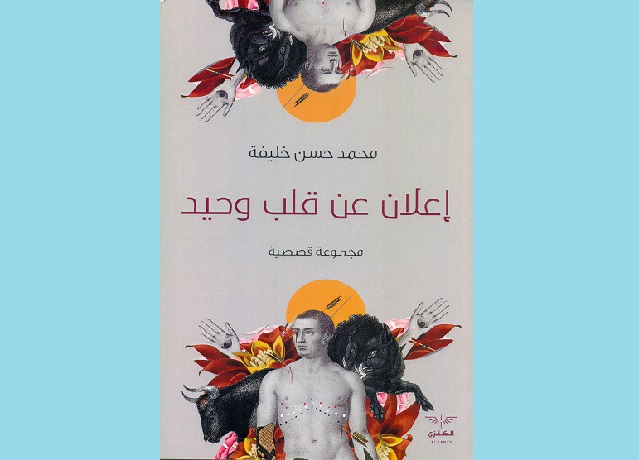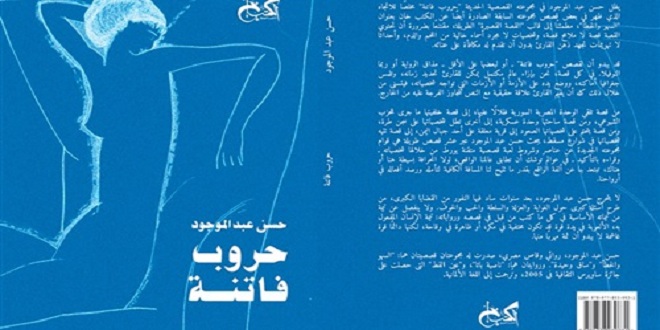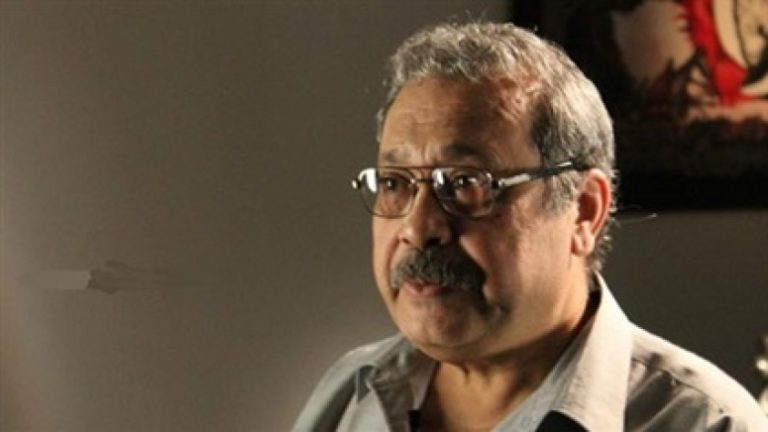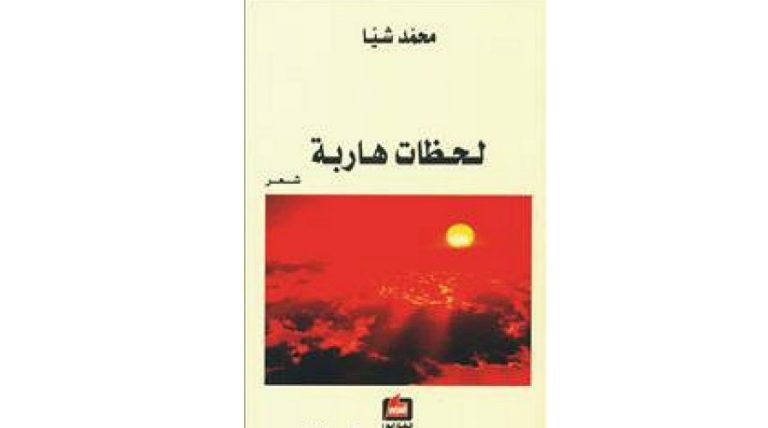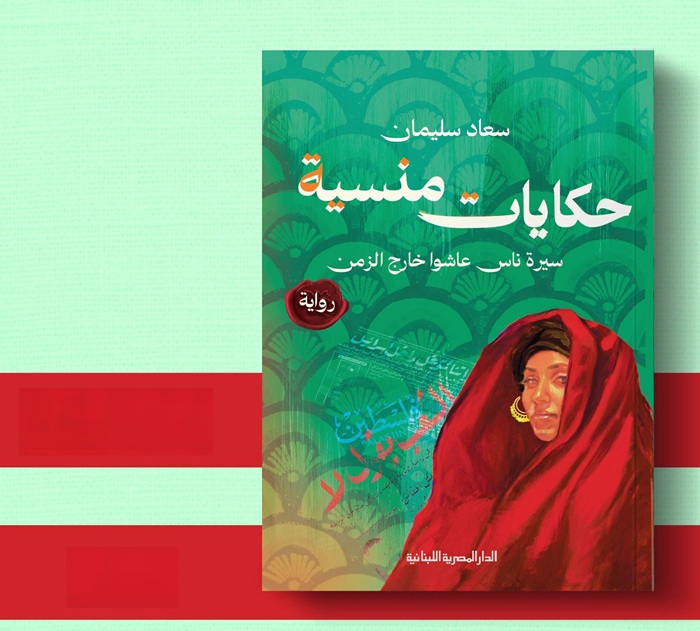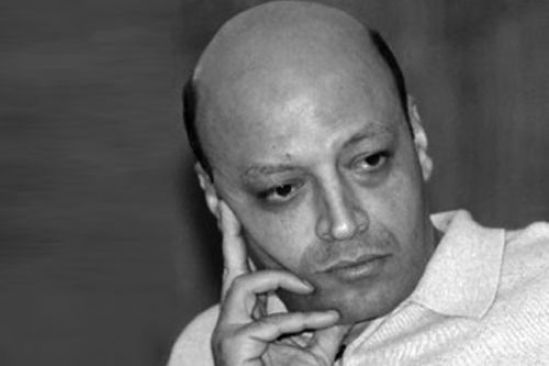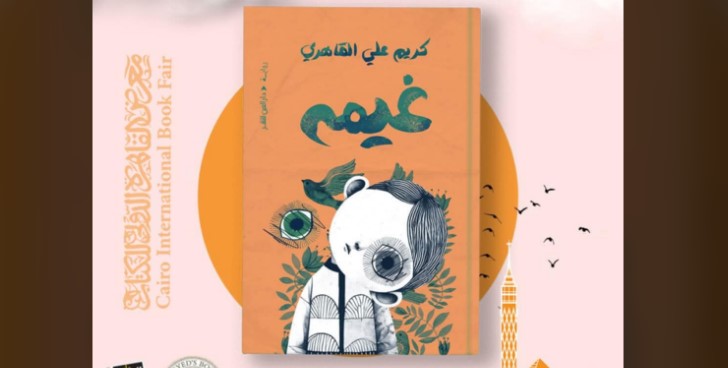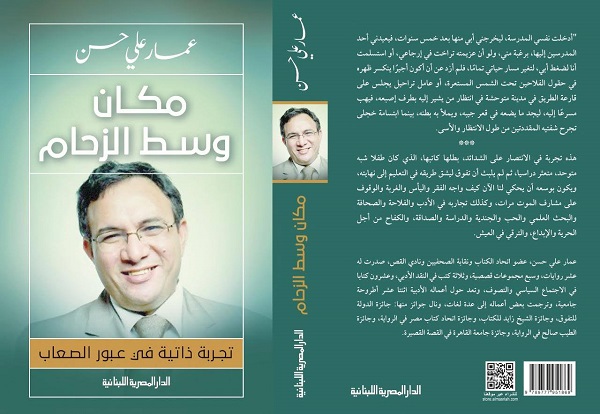شوقي عبد الحميد يحيى
محمد الفخراني، صوت مميز، سواء في القصة القصيرة، أو الرواية، لم يشأ – وربما كان ذلك بإرادته، أم بدون – أن يكون كالأخرين، ينغرس في المشاكل التي تواجه المجتمع، في مصر، أم في الدول العربية، بحكم تواجده فيها، وإنما – وربما أيضًا نتيجة دراسة العلوم، التي تنظر إلى الذرة، من جانب، ومن جانب آخر تنظر إلى الكون وكيف يتسع، وما حجم الإنسان فيه – ليكتشف أن الإنسان يمثل الذرة إذا ما قورن بحجم الكون الهائل – فتساءل مع نفسه: يا هذا الشيء الذي لا يقارن بمحيطه الهائل، لماذا تثير كل تلك الزوابع، والحروب، والاقتتال؟ إن حياتك على هذا الحيز الضئيل جدًا، والمسمى بالأرض، لا يعدو أن يكون لحظة، فلماذا تضيعها في القتل والهم والغم؟ وأسمعك تتساءل: هذا ما تفرضه عليَّ طبيعة هذه الأرض، ومحدودية الأرزاق. فانظر يا أخي، كم هي الأرض واسعة، والحياة قصيرة، فاستمتع بها، قدر ما تستطيع، وإذا لم تكن تعلم، فاتبعني أعلمك كيف تستطيع أن تستمتع بالحياة.
وراح الفخراني يجمع العناصر التي تُبعد الغم، وتجلب الاستمتاع والإحساس بالحياة، فحمل الورود، وعزف الموسيقى، وتجول على شواطئ المياه الممتدة، واستمتع بالراحة، وبكل ما يجلب المتعة الإنسانية (والحياتية في كل الكائنات الحية)، وتقدم الركب ليسير خلفه (الإنسان)، متخليًا عن المكان، ومتخليًا عن الزمان، اللذين يشكلان السجن للإنسان، فجاءت رحلته – الإبداعية – متخلية عن الزمان وعن المكان، وعن جاذبية الأرض، فانطلق في الكون الفسيح، وليس لديه هدف غير “الإنسان على الأرض”. وقد يتصور القارئ أننا بذلك نُخرج الفخراني من وجوده البشري في الوطن أو في المجتمع، ولكن تمهل يا أخي القارئ، لا الفخراني، ولا غيره من المبدعين، مهما حلقوا في الفضاء، وابتعدوا عن الوجود في مكان معين، وبيئة معينة، إلا ونجد تلك البيئة، وذلك المجتمع، موجودين بعناصرهما، وطبيعتهما في المعيشة، وعلاقاتهما، لكنه يستخدمها – غير متعمد – كعناصر غير منظورة إلى الجسد الإنساني، مثلما القلب، لا يستطيع إنسان – أو أي كائن حي – أن يعيش بدونه، لكن الغير لا يرى ذلك القلب، الذي جُعل مكانًا سريًا يحمل الحب والكره، ويحمل الميل أو النفور، مثلما هو المكان الرئيس لسر حياة الإنسان، هو الدم الذي يقوم بدور الحارس الأمين، ويوزع ذلك الدم على كل الأعضاء، بقدر ما يحتاجه كل عضو. وهو – أيضًا – الذي اتخذه الفخراني بساطًا في رحلته الكونية، مستعينًا بالخيال عوضًا عن الوقود. فلنربط الأحزمة، ونبدأ الرحلة.
تبدو مجموعة محمد الفخراني “حفلة الإنس والشياطين”، كما لو أنها متوالية قصصية، إذ إن قصصها تترابط، ويسري في عروقها دم واحد، وتحمل في أعماقها (روحًا) واحدة، بحيث إنه لو قرأ القارئ قصة واحدة منها، لعرف مباشرة أن القصة لا يكتبها إلا محمد الفخراني. وكما تتكامل في رؤيتها، فهي أيضًا تدور في فلك إبداعاته الروائية، ليصبح هناك هم عام يتسلط على فكر ورؤية الكاتب، يسعى لتوصيله، كرسالة إلى القارئ.
ويستطيع القارئ استخلاص السمات العامة والمميزة لكتابة الفخراني، من خلال قصة “ستاند أب، حب”:
1ـ رغم التهويمات، وعدم وجود الزمان والمكان، والطول النسبي للقصص، إلا أن القصة (القصيرة) تقوم على المعنى المتعارف عليه في القصة القصيرة، من حيث إنها حديث إلى النفس – فهي أقرب للشعر – أو الخاطرة التي تقوم داخل النفس البشرية، والتي لا تستغرق إلا الوقت الذي لا يخرج عن مفهوم القصة القصيرة: {وتبتسم ثلاثينيتي في الكراسي الخلفية فأبتسم لضحكتها، ويبتسم لها قلبي}. فالسارد هنا لم ير الفتاة التي أحبها، ولكنه بمجرد أن سمع ضحكتها وهي جالسة في الكراسي الخلفية، شعر أنه يحبها.
2ـ وتتطلب تلك الحالة العديد من التصورات التي لا تعترف بالحدود أو القواعد الأرضية، المنطقية: {رأيت وقوعي الرائع قادمًا نحوي}، حيث تجسيد المشاعر، ومنحها الحركة والتحرك. وفي ذات الوقت هي تخاطب العقل (الفكر) والعاطفة (الوجدان): {حس السخرية دليل على أن العالم عقله كبير، وقلبه كبير، بالمعنيين الحرفي والمجازي}.
3ـ نسبية العالم، فلا شيء فيه مؤكد: {متأكد، في واحدة من مرات نادرة أكون متأكدًا من شيء، رأيت إنسية تعزف على بيانو دون أن تلمسه أو حتى تجلس إليه، كانت منه على بعد ثلاثة أمتار تقريبًا، حركت مفاتيحه بقوة مشاعرها، نحن الشياطين أيضًا نفعل أشياء باستعمال قوة مشاعرنا}.
4ـ وإذا كان الشيطان قد خلق في الوجود – ولم يره أحد – فإنما خلق للخروج عن المسيرة الحسنة، أو لإغواء الإنسان والسير به نحو الهاوية، لكن الكاتب يؤمن بغير ذلك، ويجعل الشيطان يحسد الإنسان على ما منحه، وهو لم يُمنح ذلك، وليصبح الشيطان ندًا للإنسان، فجعل الكاتب معظم القصص، السارد فيها شيطانًا، وكأنه يساوي بين الشيطان والإنسان: {كنا نحن الشياطين نصنع مواقف مضحكة، ونطلق تعليقات للضحك، لكن النكتة، تلك الصغيرة المدهشة، اختراع إنسي}.
5ـ للقصة رؤية محددة، حيث يرى الكاتب أن الدهشة هي التفاعل، والحياة الحديثة بما فيها من سيطرة الحروب والصراعات، والاقتتال، والأصوات العالية، أفقدت الإنسان عنصر الدهشة، والذي يعني التفاعل مع سير الحياة، والبحث عما وراءها، ليكتشف أن الفرح مرتبط بالاكتشاف: {وبخصوص جدي، هو يتمنى أن يموت من الدهشة، فيظل يمشي في العالم ويندهش حتى يقابل دهشة كبيرة ويموت}. ويقول جد الشيطان: {الإنسي يستحقون الفرح}. وكأن (الشيطان) يعترف بأن الفرح هو ما يستحقه الإنسان، ويتمنى لو يستطيعه.
6ـ 6- يسعى الكاتب، وكأنه يخشى على قارئه من ألا يصل إلى الرؤية (الكلية) لكل قصصه، فيبلور رؤيته في النهاية، بطريقة بعيدة عن المباشرة، والتي تبدو كالوعظ أو العقلانية البحتة، وهو هنا يكثفها في: {ولأنها نادرة في حياتي، فأنا أتذكر كل مرة كنت فيها متأكدًا من شيء ما، وفي هذه الليلة، هذا المكان، أنا متأكد من ثلاثة أشياء دفعة واحدة، وهو ما لم يحدث معي من قبل:
1ـ أني وقعت في الحب بشيء بسيط.
2ـ هذا الشيء ضحكة حلوة.
3ـ سأخرج ومعي هذه الضحكة الحلوة في حياتي.
وقفت بمكاني، تنفست بعمق، سأستدير إلى ثلاثينيتي خلال لحظات، لكن قبلها، سأقول مع نفسي بصوت مسموع: “أنا أحبك”}. فالحب، والتعايش بين الكائنات، هو ما يسعى إليه الكاتب اللاعب مع الحياة، بكل ما فيها من مرئي وغير مرئي.
التسكع في الحياة
من القناعات التي يمكن ملاحظتها في إبداعات محمد الفخراني، أن الحياة مشتركة، ولسنا فيها وحدنا، فيها الإنس والشياطين، والملائكة، والجمادات، والحيوانات، والطيور، وغيرها مما نعرف، ومما لا نعرف. وأن الإنسان فيها، يهيم دون وجهة محددة، ولكن عليه أن يقبل التحدي، وأن يتعايش مع كل تلك الكائنات، وهو ما عبر عنه في أولى قصص المجموعة “أغنية التسكع” والتي بدأ قصته بما يشبه التعريف، ولكنه ليس بتعريف، وإنما من خلاله، يضع الأسس التي تدعو القارئ للتدبر والتأمل، عما إذا كان التسكع صفة تخص الإنس أم الشياطين، وكأن الحياة هنا تشمل الاثنين معًا، فلا وجود لأحدهما دون الآخر، أي أن الإنسان يتسكع للبحث عن لقمة العيش، والبحث عن الحياة، وفي ذات الوقت يتسكع وراءه الشياطين، لتغويه، وهو في ذلك أيضًا يؤدي مهمته في الحياة.
ثم يتسكع السارد في وسط البلد، حيث يصبح الوسط هو ممثل المدينة كلها، أو هو المركز الذي تدور حوله الأشياء والكائنات. وفي هذا المركز، يقابل السارد العديد من الوجوه، المتفاوتي الأعمار، والمتنوعة الأعمال، والأغراض، ويتفاعل السارد مع كل منها. بحيث أننا لا نجد القصة التقليدية، أو الحدوتة المتصاعدة، إنما نجد رسمًا للحالة، وأمام الرسم، نقف ونتأمل، ونحاول الوصول إلى الرؤية الكلية التي أراد الكاتب توصيلها، أي أن الشكل هنا هو المضمون.
ولكن الكاتب أيضًا يُشفق على قارئه غير المدرب، والذي بالضرورة يبحث عن المعنى وراء ما يقرأ، أو عن الرسالة التي يريد أن يبعث بها، فيأتي في نهاية الرحلة، ويمنحه رؤية الإنسان عامة، أو فعل الإنسان عامة، مركزًا ومكثفًا في شخص السارد:
“وأتسكع من شارع إلى ممر إلى رصيف إلى زقاق إلى شارع، وما زلت أريد، وأريد أكثر، وأراني داخل كل ما هو حولي وخارجه في الوقت نفسه، ولا أريد الخروج من هذا العالم، لا أريد الخروج من اللحظة، رغم أني أيضًا خارجها، أنا داخل المكان والوقت وخارجهما، معهما وحر منهما، ولست مهتمًا، من قالها أولًا، الإنس أم الشياطين أم غيرهم”
فرغم الإشباع من كل شيء حول الإنسان، فإنه لا يريد الموت، ولا الخروج من الحياة، رغم أنه لا يدري حقيقة إن كان فيها أو بها، رغم أنه موجود في زمان معين، ومكان محدد.
وإذا كانت هذه الحياة، بهذا الاتساع، واتساع التجربة فيها، فلماذا نعيشها ونحن نفكر بالموت، ولماذا لا نعيشها ونبحث عن الجمال والحب والفرح فيها؟ ذلك ما يتخفى وراء سؤال الشيطانة في قصة “بالمناسبة، ما الذي تتكلفه حفلة؟!”، ذلك السؤال الذي يتكرر كثيرًا فيها.
حيث نعيش حالات من الحب (المجهول)، لكنها الحالة، حالة الحب. فنرى الورد فيها بما يحمله من طيب الرائحة، وتلك التي نحب فيها الشوكولاتة، التي تشبه الحياة في علبتها الحاوية على صنوف الشوكولاتة، فنفتحها مثل الحياة، لا نعرف ما يمكن أن يكون فيها مما نحب. وتلك التي يكثر فيها شرب القهوة، التي تجعلنا يقظين وندرك ما يحدث ونستمتع به، ويستخدمها الناس في عديد المواقع، وتلك الحياة المليئة بألوان الطيف المرئي، وتتعدد فيها تلك الألوان المتعددة، من الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق، والنيلي والبنفسجي، ولا نرى فيها اللون الأسود، الذي يمتص الألوان الأخرى، وكأنه يمتص الألوان الزاهية الداعية إلى الفرح.
حتى الشيطانة تكرر سؤالها عن تكلفة (حفلة) دون أن تستخدم “أل” التعريف، ليظل البحث عن (حفلة) أي حفلة، فالمهم أن يكون هناك رقص، وهناك غناء، وهناك بهجة.
فإذا ما نظرنا إلى العنوان الذي يبدأ بـ (بالمناسبة) فكأنه يعطف على ما سبق في قصة “أغنية للتسكع” والتي استخدم فيها كلمة “أغنية”، وكأن الكاتب يصنع من القصتين قصة واحدة، فضلًا عن أن الروح واحدة، والصيغة واحدة، إلا أن حركة جديدة في سمفونية (الحياة). فإذا كانت كل منهما لها خصوصيتها، إلا أن السيمفونية تمنح السامع في النهاية تجربة حياتية تستحق التأمل.
وإذا كانت الحالة الزوجية – في الحياة – هي الأكثر تقلبًا وهي الأكثر عراكًا وتحولًا، فقد استخدمها الكاتب في قصته “اللعب مستمر” حيث عاش الزوجان في أعمار متفرقة، لكل منهما، فبينما هو شاب أصبحت هي في السبعين، وبينما كانت هي في الثامنة عشرة، كان هو في الثالثة والعشرين، وتنوعت الأعمار، من خلال الخدعة أو (المقلب)، وظلا يمارسان الجنس في يومهم مرات كثيرة، وظلت الزوجة تقول {أحبك}، وظل الزوج يقول {أحبك}. حيث تتجدد الحياة مع كل مقلب يظهر كلا منهما بشكل جديد، فظلت الحياة تتجدد، حتى: {الآن أنا وأنت في عمرنا الحقيقي، قال: “أنا أحبك في أي وقت في أي مكان”، غمزت بعينيها، وقالت: “اللعب مستمر”}.
وكأن الكاتب يعزف حركة ثالثة من سمفونية الحياة، أو يضع الكتالوج الذي يجب أن تكون عليه الحياة.
تداعي المعاني
كما أكدنا من قبل على أن الإنسان هو الهم الأول للفخراني في إبداعاته، حريته وفرديته وتكوينه الخاص، يتحتم أن يُعامل على هذا. إلا أن الإنسان ليس هو الحرية فقط، أو أن للإنسان ما يطلبه فقط، ولكن رؤية الواقع تجعل من الإنسان أستاذًا للشيطان ذاته. إلا أن قول هذا، قد يتصور القارئ أن الكاتب يناقض نفسه، فسعى لاستخدام أساليب الإبداع المتنوعة، والتي يأتي من بينها “تداعي المعاني”.
ففي قصة “أوضاع للحب والطيران”، التي يجمع العنوان فيها بين البعيد من الأشياء، فما الحب والطيران؟ لكنه يستدعي هنا شعور الإنسان عند ممارسة الحب، حيث يشعر بالطيران من السعادة والنشوة، حين ممارسة الحب. ومن هنا كان استدعاء أسلوب تداعي المعاني من جديد، الذي يشير إلى استحضار الأفكار أو المعاني أو المشاعر، حيث يشير إلى استحضار فكرة من منظر أو مقولة ما، إلى غيرها وغيرها. وفي علم النفس تشير عملية التداعي إلى ارتباط الأفكار في الدماغ، بحيث أن ظهور فكرة معينة يتبعها ظهور أفكار مشابهة أو مرتبطة بها. هذا الارتباط يمكن أن يكون بناءً على التشابه، أو التضاد، أو العلاقة السببية بين الأفكار.
وقد شاع هذا الأسلوب لدى كتاب الستينيات – في مصر – وخاصة بعد نكسة 1967 التي أدت إلى التشتت والشك في كل شيء. وتتجلى تلك الصيغة بشكل أكبر في مجموعتنا، في قصة “أوضاع للحب والطيران”، فنقرأ في بداية القصة: {منظر أحبه: طيور تأكل من حبوب وضعها أحدهم على رصيف أو في الميدان أو بجوار شجرة، سأعود للكلام عنه، أنتقل الآن لصديق له حبيبة يسميها “مخترعة القبلات”}. حيث تسير القصة بين الحالتين، التقاط الحب عند الطيور، والقبلات عند البشر. حيث تلتقط الطيور الحب، وكأنها تقبل الحبة. أي أن هناك ارتباطًا بين الحالتين، رغم بعدهما. ويستخدمها الكاتب وكأنها لعبة للربط بين الأشياء.
ولأن القصة تتعامل مع العقل – هنا – فإن الكاتب لا يخفي نفسه، بل يُصر على أن يكون موجودًا، حيث تأتي كلمة، وكأنها عفوية، إلا أن استخدامها يكون مقصودًا، فيتحدث عن المقاهي: {وهناك مقاهٍ مخصصة للفكاهة، أو المُفاكهة، مُفاكهة؟ يعجبني إيقاع الكلمة، مفاكهة، كلمة ظريفة، ربما أذهب اليوم لمقهى مُفاكهة، والبعض يتذكرون أول قبلة، والبعض ينساها}، حيث يتحدث عن المقاهي، التي لابد تذكره بجلساتها، وما يدور عليها من أحاديث، والتي من بينها الحديث عن أول قبلة، من يتذكرها ومن ينساها، فيستخدمها الكاتب هنا وكأنه يقوم بعملية تمويه عن الرؤية المباشرة، ويترك القارئ للتفكير والبحث عن الرابط.
وربما يستخدمها للسخرية، فإذا كانت العامية تقول عن الحب “وقع في الحب”، فيلعب الكاتب مع نفسه، ومع قارئه بروح السخرية: {لا أحد، البتة، “البتة” كلمة أخرى أظن أني أستعملها للمرة الأولى، الوقوع في الحب؟؟ هل يشبه الوقوع في كومة قطن، حفرة من فوق جبل، أو شجرة، الوقوع في ماء، أو على مسامير؟ أم فقط هو الوقوع في الحب؟}.
وعندما يريد أن يتهم الإنسان، الذي غلب الشيطان في خداعه، فيقول على لسان الشيطان: {والإنس لم يتركوا شيئًا إلا اصطادوه، طير في الهواء، سمك في الماء، وحوش في أي مكان، حتى إنهم يصطادون بعضهم بعضًا}. فاستخدام أسلوب التداعي، يسعى به الكاتب إلى السخرية، أو المطابقة، أو التضاد، وفي كل الحالات، يستخدمها الكاتب لمحاولة إدغام رؤيته، في العديد من صور التداعي، ليصل في النهاية إلى أن الإنسان قد غلب الشيطان في ألاعيبه، بل أصبح الإنسان أستاذًا للشيطان. فالإنسان أمامه العديد من الاختيارات، ويمكنه اللعب بهذه الاختيارات، إلا أن الشيطان لا يملك هذه الاختيارات.
القصة التنويرية
عندما تناول إحسان عبد القدوس المرأة، أو الفتاة، في رواياته الكثيرة، قالوا عنه إنه “أديب الحب” وتناسوا أنه السياسي الساعي للتنوير، متخذًا من المرأة، أو الفتاة تحديدًا، مصباحًا يضيء به الطريق، لمن لم يرَ الطريق. وها هو محمد الفخراني، يتتبع منهج عبد القدوس، دون تقليد أو محاكاة، حيث عُرف الفخراني بأسلوبه المميز، والجمع بين الخيالي والواقعي، الذي يرسو عليه بقدم ثابتة.
فهنا في قصة “ماشية على حل شعرها” نعيش مع فتاة خرجت عن المألوف، فكانت اللعنات تُصب عليها من كل الجهات، وخاصة أمها التي تمثل الموروث المُكبِّل للحركة، والغارق في الظلامية. جمع فيها الفخراني بين الإنس والجان، ليقول لنا إن الجان والشياطين لا يفعلون فعل الإنسي، الذي له نكهة خاصة محببة: {تثير علاقتها بأولاد الإنس غيرة أولاد الشياطين، غيرة حلوة بلا ضغينة، هي لا تتعمد تجاهلهم أو البُعد عنهم، تتعامل معهم في مواقف عابرة، ويتمنون لو يتعرفون إليها أكثر، لكنهم يتفهمون مزاجها ويقبلونه، ببساطة: هي تفضل أولاد الإنس}.
وتقبل الابنة من أمها أي وصف (سيئ)، إلا أن تقول لها (أنا بقرف منك). ذلك الوصف الذي يتهمها بالقذارة، وهي تعلم جيدًا – الفتاة – أنها ليست كذلك، أي أنها تثق فيما تفعل، وتظل الحرية الشخصية هي الكامنة في الداخل. تلك الفتاة التي لم يكن الرجال يعلمون لماذا يحبونها، رغم أنها ليست جميلة، وليست دميمة، لكن: {كان بها شيء ملهم لنا جميعًا، لكن لم يكن أحد يتكلم عنه لأننا لا نعرف طبيعته تحديدًا، أو لأنهم لم يريدوا الاعتراف، أو لأنها لم تهتم، عرفت فيما بعد أن مصدر إلهامها لنا هو روحها الحرة، وحتى أسلوبها في الاستهتار، خصوصيتها وتفردها ومشاعيتها معًا، كانوا يشعرون بأنها قريبة وفي الوقت نفسه بعيدة، المحبوبة في السر، الملعونة في العلن}.
حيث تأتي الغرابة والغربة في فهم ما تفعل، الأمر الذي يحيل إلى ضوء خافت وسط الظلمة الدامسة. وتموت الفتاة بعد أن أخبرتهم أنها ستموت في الصباح، وكان موتها: {موت مفاجئ للبعض: لأنها صغيرة السن، ومتوقع للبعض: لأنها ما هي عليه}. فالموت لا يتطلب شروطًا معينة.
وبعد أن كانت الأم في ثورة غضبها عليها، قد خلعت خصلة من شعرها، وبعد أن فقدت – الأم – القدرة على تذكر اسمها الحقيقي من طول ما نادتها بألفاظ جارحة، وبعد موتها، يحدث التغيير في حياة الأم، والمجتمع، فتدور الأم على أصدقائها، أصدقاء البنت، وكأنها قد أدركت أن ابنتها لم تكن عاصية، ولم تكن شاذة، فتلعنهم: {تمر الأم على بيوت أصدقاء البنت، بيتًا بيتًا، صديقًا صديقًا، وتسأل كل واحدٍ منهم: “لم تُقبلها؟ ولا قبلة واحدة؟”، تشتمهم لأن أيًا منهم لم يُقبل البنت، تضرب وجوههم وصدورهم: “كانت محبوبتكم وفرحتكم، ولا قبلة واحدة يا عديمي الذوق والرحمة؟ حاولتم على الأقل يا مخنثين؟”، وتخبط على أبواب أولاد الشياطين: “ولا قبلة واحدة؟ كانت حلمكم، يا عديمي الحس”}.
وتأتي جملة تستدعي القارئ أن يتأملها: {اثنان فقط انتبها، وصدقاها: أبوها، وأنا}. فيلعب الفخراني لعبته المحببة، فيؤنسن الموجودات، وينطق الجن والعفاريت، فيختلط المعقول باللامعقول، فيتحول الصبح إلى كائن حي، يسعى الأب لمفاوضته: {لم يكن قد تبقى على الصبح غير ساعة أو أكثر قليلًا، حاول خلالها الأب أن يمنعه عن الحضور، مرة بالقوة، ومرة بمفاوضات، وتعاطف الصبح معه، وكاد يقتنع، لكنه لم يفعل شيئًا غير أنه تأخر دقيقتين، وفي الوقت نفسه لم يتصرف ضد البنت، هو فقط: حضر}.
ويصبح الأب، مع السارد، كممثلين لنظرة الرجل إلى الفتاة. ليس لأنهما فقط المستفيدين، بل لأن الرجل يمثل – بالدرجة الأولى – العقل والحكمة. كما أن حضور السارد هنا، لم يكن دخيلًا على النص، وإنما منسوجًا ومضفرًا في نسيج العمل، حيث تهفو نفسه إليها، وكأنه الداعي إلى التنوير، أو الحرية، ليس للفتاة وحدها، وإنما الداعي إلى الحرية للجميع، فهو هنا ممثل للفكر التنويري، فليس إلا واحدًا من الجميع، فيتحدث باسم الجميع: {كان بها شيء ملهم لنا جميعًا}.
وتفتح جملة واحدة نوافذ على الطبيعة العربية التي تأخذ بالظاهر فقط، دون التعمق في الباطن: {المحبوبة في السر، الملعونة في العلن}. وهو ما يؤكده الكاتب عندما يكشف بعدًا آخر، يكشف تلك الازدواجية في الفكر الإنساني عامة والعربي خاصة: {كثيرات وقتها تمنين لو أنهن صاحبات البز المعضوض، وكثيرون تمنوا لو أنهم صاحب العضة}. وهو ما يفتح الرؤية ويوسعها، لتخرج من الحيز الفردي، إلى الحيز المجتمعي.
والأمر هنا لا يؤثر على أحد، إنما الحرية هنا تأخذ معناها الصحيح، فالبنت حرة، وحريتها كما أنها لا تصيبها بما يعيبها، فهي أيضًا لا تضر أحدًا: {على فكرة، البنت وأصدقاؤها لا يؤذون أحدًا ببذاءتهم، لا يوجهونها لأحد، إنما هكذا في الهواء، يستعملونها بمهارة تخصهم، للمرح واللعب، ويتجاوب أهل الحي معهم أحيانًا ويدخلون اللعبة، لعبة البذاءة اللذيذة، للتسلية والضحك}.
وكان طبيعيًا أن تموت مثل هذه الفتاة، فيخرج الكاتب المونولوج من أعماق السارد إلى العلن: {طمأنت نفسي قليلًا، قلت لي إنها بنت لا تموت بهذه السهولة، لكن.. اتضح أن موتًا بهذه السهولة يليق بها}. فقد كانت صوتًا نشازًا في موروث متراكم وضاغط على الأنفاس، فحوّل الأم التي هي مصدر الحنان، إلى أم ساخطة وغاضبة على ابنتها، وكأنها تعيش سنوات وسنوات، تحت ضغط هذا الموروث. فقد علمنا مما ساقه الكاتب في قصته، أنه كان في الرابعة عشرة من عمره، عندما تمنى أن يصادقها، وقد أصبح الآن في السبعين من عمره. فكأن البنت بما تمثله من صحوة ويقظة داعية إلى الخروج للنور، لا تأتي إلا كل عدد من السنوات، لإرث ظل قابعًا لعدد من القرون. وليصبح ما تعيشه المرأة، من ذلك الإرث، في حالة موات، ولكنه هنا الموت المعنوي، القابع في النفوس.
حيث استطاع الفخراني أن يكون خليطًا إبداعيًا، أضمر فيه الرؤية الكلية وراء العديد من التهويمات، التي تمنح القارئ المتعة القرائية، إلى جانب الحشد المعنوي الداعي إلى تحطيم الموروث المُكبِّل للحركة، وكأنه يدعو لأن نعيش الحياة، دونما قيود، طالما أننا لا نضر غيرنا. وأن ننظر للمرأة (نصف المجتمع) باعتبار أن لها مشاعر، فبدّل الفخراني القول المشهور عن (المنحرفة) “ماشية على حل شعرها” إلى “ماشية على حل مشاعرها”.
الشكل هو المضمون
دأب الفخراني أن يخبئ الحركية في القصة، أو ما يمكن أن يكون “الدراما” داخل الكثير من التهويمات. غير أنه في قصة “بقدونس”، التي توحي للقارئ مباشرة بـ(الحشرية)، بمعنى الدخول في كل شيء، وكالعادة، نعلم أن السارد شيطان، لكنه بالرغم من حشريته، إلا أنه يعدد الأقوال التي تجعلهم – معشر الشياطين – أفضل من الإنسان: {شيئان لا يفعلهما الشياطين أبدًا: دس السم في الطعام، والقتل المأجور}.
“أتعجب أن الناس بعد هذا كله يتبادلون القتل فيما بينهم، ينسون أو يتجاهلون أكلهم معًا؟ يعجبني في الوقت نفسه أنهم رغم حالات دس السم ما زالوا يتبادلون دعواتهم”
كما جاء لقاء الشيطان بـ “الجدة حبيبة” وهي تطعم العنقاء، رغم أن “الجدة حبيبة” لم تذكر القصة أنها تطعم غير الإنس، يدفع القارئ للتساؤل عن جدوى تلك الإشارة. وأيضًا دخول الشيطان مع الطباخ إلى المطبخ، دون أن يكون هناك تفاعل محدد بينهما، كأن يدس الطباخ السم لشخص معين، وبإيعاز من الشيطان، أيضًا لم نجد له مبررًا، غير دخول المطبخ. الأمر الذي يحيل (القصة) إلى مقال، يحوي الكثير من الإشارات التي تؤكد أن الأكل، رغم أهميته في الإشباع المادي، يكون سببًا للتعبير عن السعادة: {حالة أحبها: طعام مجاني، من طبخه لا يعرف من سيأكله، ومن يأكله لا يعرف من طبخه. مجهولا الطرفين ظاهريًا، لكنها في عمقها معلومة بالكامل على طريقتها، طرفان يبدو أنهما مجهولان لبعضهما بعضًا. لكنهما في الحقيقة أقرب ما يكون، أحدهما يطبخ ويسعد، وأحدهما يأكل ويسعد. كل منهما سبب لسعادة شريكه، شركاء سعادة}.
إلا أنه يُستخدم أيضًا للقتل، وهو ما يقوم به الإنسي دون الشيطان: {لم يمتلئ العالم بالطعام والجنس والمال لهذه الدرجة إلا مع “الإنس”، لم يمتلئ العالم بالفقر والجوع إلا مع الإنسي، الجملتان من مقولات الإنس}. ولتتوقف (القصة) عند حدود المقال، المشحون بالرؤى حول الطعام واستخداماته، ولم يبق منه للقصة سوى تلك الإحالة إلى تلك الرواية البديعة لذات المؤلف “غداء في بيت الطباخة”، والتي جعل السارد يتعرف على جندي من الخصم في خندق، ويتم التواصل بينهما ويحب أحدهما الآخر، فيدعوه إلى الغداء في بيت والدته التي تجيد صنع الطعام، وهو ما نفتقده هنا في هذه القصة.
وفي قصة “لا تدفعوا الحساب”، التي تخلو أيضًا من الديناميكية التي تحرك الحدث، أو الأحداث في اتجاه لا يجمع الشتات، ويضعه في بؤرة معينة، حيث نصادف الإنسي يجلس مع الجن على المقهى، ويقتحم شيطان سبعيني الجلسة ويحكي عن الحب والجنس والمال، حكايات مبتورة، تنتهي قصة المال بقول السبعيني “لا تدفعوا الحساب”، الذي يحتمل إما أنه سيقوم بدفع الحساب هو، أو أنه تحريض على السلوك غير السوي.
وكان – في تصوري – يمكن أن تقوم القطة، التي ظلت تلعب بالعدسات اللاصقة للإنسية الجالسة معهم، بدور الربط بين الحكايات والأحاديث، غير أنها أيضًا اختفت دون أن نعلم لها دورًا. كما يمكن النظر إلى القصة على أنها الصداقة بين الإنس والشيطان، وأن من البشر من يقومون بدور الشيطان: {ماذا فعلتم بكم يا مساكين؟ قالها شيطان سبعيني يجلس إلى طاولة قريبة، يقول: ماذا فعلتم بأنفسكم؟ أعجبتني “فعلتم بكم”، جعلتني أحس خيبتنا أكثر}.
ولكن يظل هناك العديد من المواقف التي تحتاج للربط. وكان – أيضًا – يمكن أن نقرأها على أنها شريحة من الحياة، وأن الشيطان هو من يوقع الإنس في الخطيئة بأساليب الحب والمال والجنس، غير أن البداية، وخاصة العنوان، لا يقفل مع النهاية، الدائرة المفتوحة، التي ينحصر فيها القارئ بحثًا عن الرؤى التي يمكن استخلاصها من (القصة). غير أن (الفكرة) تظل لها الأولوية في التفكير، مع فقدان المتعة التي عهدناها في قصص كثيرة غيرها.
هذا إذا نظرنا للقصة في شكلها المعروف، ولكن هذا النوع من القص، يعيدنا إلى كتابة الإسباني “بورخيس” الذي تحولت قصصه إلى الشكل المقالي. وهو ما يجعلنا نتساءل: وإلى أين وصل بورخيس في عالم الأدب؟ لنجد أنه لا يعرفه – تقريبًا – إلا المتخصصون في الأدب والإبداع. ولم يكن يومًا – إلى حد علمي – مرجعًا في كتابة القصة، وليظل “بورخيس” و”الفخراني” أيضًا لا يكتبان للعامة، وإنما للمختصين، والباحثين عن النظريات الفلسفية، التي يمكن أن تشغل المشتغلين بها.
كما يمكن النظر إلى مثل هذه القصص على أن الشكل فيها هو المضمون، مثلما كانت الصيغة عند معظم كتاب الستينيات في مصر، وكان الظرف التاريخي يعطيهم المبرر لذلك، فالحياة مضطربة، والمفاهيم الأساسية ضاعت وأصابها الشك الذي يصل لليقين. فهل يعني هذا أننا نعيش الآن مثل تلك الظروف؟… والإجابة – في يقيني الشخصي – بالإيجاب. وإذا كان الإبداع عامة، يقوم بجناحين اثنين، الواقع والخيال، فإن طغيان أحدهما على الآخر يؤدي إلى اضطراب في تكنيك العمل. كما أن المتعة والعقل، هما عنصران – أراهما أساسيين في العمل – وغياب أحدهما يؤثر بالسلب على العمل أيضًا. وإن كانت تلك الرؤية تثير قضية الأنواع الأدبية، والعلاقة بينها، إلا أن هذا حديث آخر.
تعمد الفخراني أن يستدعي بعض أعماله في التالي منها، وكثيرًا ما يحمل الإشارة الضمنية بأن الرؤية هنا كرؤية هناك، وهو ما يعني أن هناك همًّا يحمله الكاتب، ويؤرقه، فيعبر عنه في أكثر من مناسبة، أو أكثر من عمل.
فهاهنا في “قصة الشغف”، يبدأ قصته: (الشغف شعوري المفضل) وكأنه يستدعي أحدث رواياته “حدث في شارعي المفضل” والتي خلط فيها الواقعي بالفانتازي، والهم العام بالهم الشخصي. وهو ما يختم به الكاتب مجموعته، وهي – كالعادة – يلعب الشيطان فيها دور السارد، حيث تقوم الشيطانة ببحث حول كلمة الشغف: {الشغف شعوري المفضل، ما أول قصة شغف في الدنيا؟ أول قصة ظهر فيها الشغف؟ أول من شعر به، أو جعل غيره يشعر به؟}.
وهو ما يمكن أن نستخلص منه أن الشغف هو البراءة. فإن يقابل الإنسي كل شيء، كما يستقبل الطفل الأشياء بالبراءة، بالدهشة، بالاستغراب، بالشوق للمعرفة، فسيظل العالم بكرًا، وسيدرك الإنسي أنه ليس وحده على هذه الأرض. ولا يملك طرد الآخرين، فعليه أن يتعايش مع هذه الكائنات، ليعيش في سلام وحب، ويغني في حفلة الإنس والشياطين.
وتظل تجربة محمد الفخراني تجربة تستحق الدراسة والبحث، في ظل مفاهيم القصة القصيرة، بطول تاريخها، والتي تعطيه كل الحق في التجربة، التي لا تتوقف عند شخص معين أو حقبة معينة.