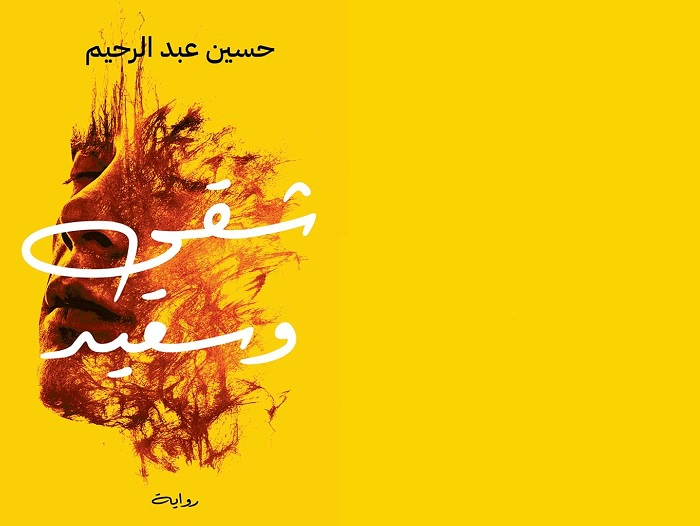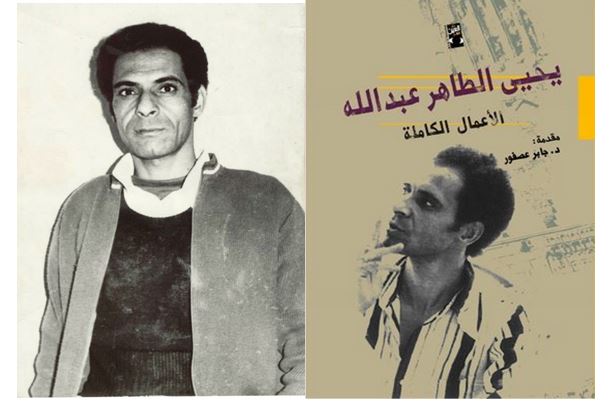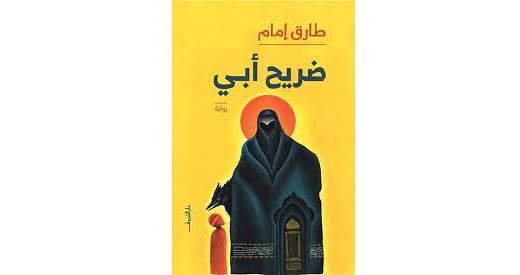شوقى عبد الحميد يحيى
تعددت الروايات التى تناولت الحرب، سواء تلك التى تناولت مآسى الحرب وويلاتها، من قتل، وبتر وتشريد، وخراب، والتى كُتبت تحت تأثير حرب معينة، عايشها الكاتب/ة، أو قرأ عنها فى كتب التاريخ، وما أكثرها فى عالمنا العربى الموبوء، والعائش فى حالة حرب مستمرة، حيث نجد الأمثلة على ذلك فى العراق واليمن وليبيا، ولينضم إليهم السودان. وكثيرة –أيضا- تلك التى تتحدث عن الآثار النفسية التى تخلفها الحروب، خاصة تلك التى تدفع الملايين للهجرة، بما تحمله من غربة وتشتت، وضياع، ومثلها –أيضا- فى عالمنا العربى ما نستطيع بيسر أن نجده فى لبنان وسوريا، وليبيا والسودان وفلسطين، وما أصبح مطلبا فى مصرنا كذلك[1]. ولٍيَضيع صوت العقل، الذى حاول أن يستحضره مبدع الرواية – بصفة خاصة- على مر التاريخ. إلا انه لم ييأس طول العصور وتاريخ البشرية، ليأتى به محمد الفخرانى، مجسدا فى روايته “غداء فى بيت الطباخة”[2]، ممثلا فى الحرب التى حولها من المعنوى إلى الوضع البشرى، لتكشف عن رؤيتها للعالم الذى يستخدمها فى كل مكان على الأرض، وللتبادل الأدوار –السردية- مع مدرس التاريخ والطباخ، ولتعلن براءتها، بل واستهجانها، من ذلك الذى يحدس، ولتضع أمام أعين الإنسان فى كل مكان، أن هناك ما يمكن أن يحكم العالم، حتى وإن كان يحمل المعنى العكسى لها، فهناك شئ اسمه.. السلام.
وإذا كانت الرواية- فى رؤيتها المباشرة- تبدو أُحادية الاتجاه، حيث لا يختلف قارئ على أنها – الرواية- تنبذ الحرب وتدعو للسلام، إلا أن معرفة الإبداع عند محمد الفخرانى، ترفض هذه الرؤية السطحية. ذلك الذى حاول فى كل إبداعاته السابقة، أن ينفذ إلى جوهر الحياة، وجوهر الإنسان فيها، حين حاول أن يخلق “كوميديا إلهية فى “للعالم ألف جناح”، وهو الذى كتب رواية “لا تمت قبل أن تُحب”، وهو يدعو للحياة، بالحب، لا بالحرب. فاخذت الحرب – فى رواية “غداء فى بيت الطباخة”- تكرر كثيرا {طفلة جوَّانِيَّة في مكان جوَّاني بداخلي}حيث تعنى الطفلة، هنا، البكارة ، والطفولة، والصدق. بينما تعنى “جوانية”، العمق، والداخل، والاختباء. ولم يكتف الكاتب ب”الجوانية” فقط، بل وضعها داخل الداخل (فى مكان جوانى بداخلى) وكأنى بالكاتب يدعو القارئ للبحث داخل الأعماق البعيدة، والتى تمنح المتعة فى الوصول بعد التعب والمجهود، كما يلح ويكرر الكاتب الجملة، وكأنه يقود القارئ إلى النظر فى الأعماق، وإلى طبيعة الإنسان -السوى- الذى يطرب للموسيقى، ويستغرقه الغناء، ويلفته ما فى الطبيعة من الخضرة والنماء، فإنما هو يلفظ الحرب، وأنه ليس إلا مُجبر عليها، بل هو مُجبر أمام سلطات السادة، وما يحمل تبعاتها غير أؤلئك العاديين، والذين يقول عنهم مدرس التاريخ {أنا أعتبر أن التاريخ الحقيقى، تاريخ البشر الحقيقى، موجود فى حكايات الناس العاديين، أشخاص نصادفهم فى شارع أو صحراء أو غابة أو مقهى أو قطار، رحالة أو مسافرون عابرون أو حتى أشخاص لم يغادروا بلدتهم الصغيرة، أُفضّل أن أعرف التاريخ من مثل هؤلاء الناس، هم يعرفونه أكثر.. وأنا أصدقهم، والحرب .. يعرفها الجنود العاديون، الأفراد على الأرض، يعرفونها أكثر من أى أحد آخر}ص23.
فقد جسد رؤيته فى جنديين، مجهولى الهوية، بل اكتفى بوصف أحدهما ب(البنى)، والآخر ب (الرمادى)، وهما اللونين القريبين من الأرض، من التراب، أو من وقود الحرب. التقيا فى خندق بمكان وسط الحرب القائمة، وكل منهما يحاول قتل الآخر، وأدمى كل منهما الآخر.. لكنهما يتوقفان، لشئ داخلى فيهما معا، ولا يعرف أيهما الآخر، وليبدأ كل منهما فى تضميد جرح الآخر.. ويبدآن فى التقارب الحذر، ويتعرفان، لا بالاسم، ولكن بالصفة، وكأن الاسم ليس له أهمية هنا، لتفتح الرواية قوس الرمزية، وتبتعد عن التجسيد المحدد، ولتتسع الرؤية لهما كإنسان فى مقابل إنسان، يتعايشان معا. ونتعرف على أن أحدهما يعمل مدرسا للتاريخ وزوجته مدرسة للموسيقى، وكأن الارتباط تاريخى، بين التاريخ والموسيقى. والآخر يعمل طباخا تعلم الطبخ من أمه التى يعتبرها معلمه الأول. ولا أتصور أن ذلك جاء عفويا، وإنما تكمن فى (الأعماق) رؤية يراها الكاتب، وتثبتها الطبيعة، أن المرأة هى أساس الوجود على الأرض، بل إن شئنا، فإنها الحاكم الفعلى عليها. فما من شئ جاء بالرواية عفويا، فالأم، والزوجة والإبنة، هن المتحكمات فى فعل الإثنين، بالحب، لا بالقوة، وإن كن مستترات خلف الظاهر، وهو ما يُنشئ القصدية التى ابتغاها الكاتب، فى رؤيته العاة. ويبدأ التعارف من خلال تلك الحاجيات التى توحى بكونهما من الجنود العاديين، لا من عِليَة قواد الحرب{المدرس يسحب نصف كوز الذرة، ويقول للطباخ “جوعان؟ ويسحب من جيب آخر قطعة قماش معقودة على شئ ما، يفكها، بها خمس حبات من تين مجفف، يمد يديه بالذرة والتين إلى الطباخ، ويسأله: ذررة أم تين؟ . يخرج الطباخ من جيبه قطعة القماش البنية وفيها كرة الخبز: معى خبزى الحجرى. يفتح القماشة، يمسك كرة الخبز، وينحتها بأسنانه}ص39. حيث يبدأ التعارف بالطعام، رغم قلته، وكأن الكاتب، منذ البداية، يقدم لنا التمثيل العملى لاستدعاء (الطباخ) ليكون أحد طرفى المعادلة –إن لم يكن الأوحد- التى أراد بها الربط بين الطعام والتاريخ.
وتتناوب الرواية الفصول بين (الحرب) التى تبرز سوءات الكلمة واستخدامها (الحرب)، وتلقى بالائمة على البشر، ولكنها لا تفقد الأمل، فبداخلها علبة، مكنونة فى الأعماق، والبشر هم من يُعيقونها عن الوصول إليها {أعرف أن العلبة لى، يخصنى، وفيها تذكار ينتظرنى، وسيعرفنى بنفسى، حقيقى، لكنى لا أعرف طبيعة هذا التذكار، وفى الوقت نفسه أنا غير قادرة على الوصول للعلبة بسببكم.. غصبا عنى بسببكم، أنتم البشر، وأشعر أن المسافة بينى وبين علبتى وتذكارى بعيدة، لكن يُهدئ قلبى أنى حتى وسط الدخان والغبار والحيرة أرى العلبة، وأعرف أن بداخلها تذكار يخصنى}ص34. حيث تشير الكلمات إلى البحث فى الأعماق، إلى تقشير الخرشوف من الأوراق وصولا للجوهر.
وتواصل-الحرب- {لم أتوقف يوما عن العمل معكم أنتم البشر، يوم واحد أجازة لم تعطونى، كل يوم أنا أعمل فى مكان ما)ص36. وتسخر الحرب من التناقض الذى يقع فيه الإنسان، بما يُستخدم للحرب.. اللغم{ فى بعض اللغات أو الثقافات تستعملون مع اللغم كلمات مثل: “حقل ألغام”، “زراعة اللغم”. حقل ؟ زراعة ؟ فعلا؟}ص61. وحيث أن الجنديان يعيشان حالة الحرب، فحتما ستكون موضوعا لبعض حواراتهما، وكأنهما يتأملان ما هم فيه، وكأن الرفض المبطن هو ما يشعران به، فيقول مدرس التاريخ، والمدرك لحركته{ تبدو الحرب وكأنها شئ أساسى فى حياة البشر، يبتسم المدرس ويكمل: إنظر إلى الجملة.. شئ أساسى فى حياة البشر، كأنهم لا يستطيعون العيش إلا والحرب حاضرة فى حياتهم، رغم أنه وسيلة لإنهاء حياة أكبر عدد منهم..}ص54. حيث التناقض الضمنى بين الحرب والحياة، وعلى الرغم من ذلك، هم .. يعتبرون الحرب وسيلة الحياة.
غير أن الحرب لم تكن هى المادة الوحيدة للحوار.. حيث تبادلا الأحلام والذكريات، والموسيقى والغناء. ليتم التحول من حالة الحرب إلى حالة السلم، بارزة فى بداية الرواية التى تصف أجواء الحرب {يجرى الجندى، تنتهى التلال، ربما زملاؤه فى الغابة، مقتولون أو أحياء، أو خليط من الجميع}ص7. حيث نعيش الجمل المتقطعة، والمعبرة عن اللهاث والترقب والخوف.
. وتنتهى بأجواء السلم (لمع بينهما شعاع ضوء الشمس .. يا طباخ … يا مدرس التاريخ ….
وتصافحا … سلام … سلام}ص140. حيث تنفتح النهاية على الإشراق، مع شعاع ضوء الشمس، واتجاه كل منهما إلى حال سبيله، فأحدهما إلى الغابة، والآخر إلى التلال، بنفس راضية. وحيث يتجسد الانتقال النفسى من البداية إلأى النهاية. من القلق والخوف إلى الاستقرار والسلام.، والذى ينتهى بدعوة الطباخ، للغداء فى بيت الطباخة، والعنوان.. لابد سيصل إليه ومعه كل من يريد أن يتذوق طعامها، أو يتذوق طعم السلام. ولتكشف الرواية أن المساحة الكتابية، رغم صغرها –نسبيا- ووضوح رؤيتها، إلا أن تقنيتها تعنى تمكن الكاتب من خيوط عمله، فصنع رواية مشحونة بالدلالات، والأدوات التى تسهم كلها فى صناعة الرؤية الكلية، فى جوانية الجوانية.
التقنية الروائية
أتصور أن الرواية كان يمكن أن تشكل مجموعة قصصية، او متوالية قصصية، فكل وحدة منها، تمثل عالما مشحونا بالكثير والكثير من الانفعالات، خاصة الفصل الأول، عندما تلاقى كل من مدرس التاريخ، والطباخ، وكل منهما يسعى للقضاء على الآخر، فهما يواجهان الموت، بكل تداعياته، من الخوف، والشجاعة، وكلا منهما يرى أنه إن لم يقتل صاحبه، فإن صاحبه سيقتله، وكلا منهما قد أصيب، إصابة لا يتوقع معها غير الموت. فهى لحظة مشحونة، يمكن أن تخلق قصة قصيرة فى حد ذاتها. وهو ما يدعو للتساؤل حول إختيار مدرس التاريخ، والطباخ ليصبحا فى المواجهة؟ وهو ما يمكن أن نفهم لماذا تخير الكاتب هذا الاختيار، الذى نراه موفقا إلى حد كبير. فمدرس التاريخ، هو من يعرف تاريخ البشر على الأرض والذى يبدأ من آدم وحواء. والرواية تتناول تاريخ البشرية عامة، والمقرون بالحروب، بداية من قابيل وهابيل. كما أن ذلك الإنسان منذ وجد على الأرض، وهو لايستطيع العيش بغير الطعام، فهو أساسى لحياة البشر، ومن لا يجده، فإن الموت هو مصيره الحتمى. ووجودهما معا، يمثل مسيرة الإنسان على الأرض.
كما تخير الكاتب مكان اللقاء، ليكون خندقا مساحته متر ونصف المتر فى اثنين متر.. أى أن المساحة ضيقة ولا تتسع لأكثر من اثنين، ورغم ذلك كان كافيا، لتتسع لأحلام كل منهما، حتى نرى فيه الأم (الطباخة) والزوجة والابنة. ونرى فيه البنت التى تلعب على الدراجة، ونرى فيه الأنهار والزروع، حتى لو كانت فى خيالهما معا. ثم إن الخندق يتوافق وحالة الحرب، حيث لا يجد الجندى فى الحرب غير الخندق يحتمى فيه من الأعداء. إلى جانب أن تلك المساحة، وذلك الضيق، هو ما يمكن أن نتصوره محيط الأرض عندما نزل إليها آدم وحواء، فلم يكونا قد تعرفا على الأرض بعد، – فيمكن القول بأنهما تصوراها كذلك- وحيث الرؤيا جميعها تدور داخل النفس البشرية، أحلام مدرس التاريخ والطباخ، أو ما رأياه من تصورات، كلها تدور فى (جوانية الإنسان)، خاصة أن الرواية تتناول جوهر الإنسان، عامة، ذلك الذى بدأ منهما، وبهما. وهو ما كان أحد الأسباب الناجحة فى الاعتماد لديهما على الحواس فى إدراك الأشياء، خاصة أن الحاسة لا تحتاج التعلم، ولكنها بالفطرة، يُدرك بها الإنسان الأشياء، وهو ما أكده الطباخ لزمليه مدرس التاريخ، ليكون أحد الأسباب المنطقية فى استحضار الكاتب لشخصية الطباخ فى هذا الخندق العشوائى البدائى {“أنت طباخ”.. قالها المدرس كأنما يتذوقها داخل عقله وكان فى صوته إعجاب خفيف: لكن لماذا لم تدرس الطبخ؟ لا أعرف، كان عندى إحساس كبير بأنى طباخ بالفطرة. ابتسم وقال: أنا تعلمت المهنة من أحسن طباخ فى العالم والدنيا كلها ، لمعت عيناه وهو يحدد: طباخة فى الحقيقة}ص40. بل ويكاد الكاتب أن يقولها واضحة، أن الطبخ حاسة، مثلما يقول العرف الشعبى (الطبيخ نفس)، حيث يواصل الطباخ أفكاره {أى طعام يمكنه أن يُشبعك، لكن ليس أى طعام يمكنه أن يسعدك.. فتح يديه، ينظر فيهما ويقول: حواس الطباخ فى أطراف أصابعه، وأغلق يديه وعينيه… تنفس الطباخ بعمق، ابتسم وقال: الطبخ هو أن تطهو بعض السعادة لغيرك}ص103. ومن هذا المنطلق، يمكن فهم ذلك التحول الحريرى، من العداوة، إلى الصداقة، والخوف على الآخر. كما أنه يعطى المعنى الذى عنيه الكاتب باختيار الطباخ، كأحد فرسان العمل.
ولم تكن حاسة (التذوق-كأحد الحواس الخمس- وإن رآها البعض سبعا) هى الحاسة الوحيدة المستخدمة فى العلاقة بين الإثنين، بل هى وسيلة التواصل بينهما، ذلك التواصل الذى وحد بينهما فى النهاية، فيتحول السمع إلى شئ من الذكرى البعيدة {صوت انفجار بعيد، كأنه صدى من عالم آخر} و{“الطبخ”.. أفلتت الكلمة من البُنىِ كأنما نطقها شغف ما بداخله، أطبق شفتيه بعدها كأنما يحبس شغفه}ص24.
وكذلك كانت حاسة (الشم) ليس للرائحة الطيبة، وليست الرائحة الكريهه، بل إن الإنسان ذاته، له رائحة، وكل إنسان له رائحة، يُدركها من حوله، ويمكن أن تكون أحد أوصافه، وهى إحدى خواص التوحد بين البشر، فتقول (الحرب): {يمكن لكم، أنتم البشر، أن تروا رائحتكم الإنسانية تتصاعد منكم مثلما يتصاعد البخار من النباتات فى الصبح، ولا يكون معروفا أى نفس يتصاعد من أى نبات، تُغطيكم سحابة رائحتكم بغطاء شفاف يجمعكم معا، الرائحة الإنسانية، يشعر بها كل منكم وهى تتصاعد منه ومن الجميع فى الوقت نفسه، كأنكم كائن واحد}ص122. ثم ينتقل السرد من العام إلى الخاص، فيتحدث الطباخ عن رائحة أمه {أنا أشم من أمى رائحة خاصة وهى تطبخ، لا أقصد رائحة الطعام، أقصد رائحة أمى نفسها وهى تطبخ، أشمها وأنا أطبخ معها، أو وهى تطبخ بمفردها، أحبها وأعرفها…}ص42.
كما يتحول الصوت، والضوء، أيضا، إلى شئ ملموس {يمكنهما أن يسمعا صوت الشروق، وصوت اللون البرتقالى الشفاف وهو يسيل على جسم الشمس}ص93 و{عَبَرَهُما الضوء، فاستدارا إليه يُتابعانه وهو يلمس النبتة فى أرض الخندق، فترتعش به، ويُكمل الضوء طريقه باتجاه الغابة، فيرى أنه يُضيئ الأشجار، وتستعيد الغابة حياتها أمامهما لمدة خمس ثوان، تكون فيها كلها بلون برتقالى…… يمشى الضوء فى عنق الغابة…}ص94. ورغم هذا التوحد فى الرؤى، واستدعاء الذكريات، لا ينسيا أن كلا منهما، كان المفترض أن يقتل الآخر{الجنديان يجلسان متقابلين، ساق البنى اليسرى، المصابة، ممدودة أمامه.
الرمادى: كيف حال ساقك؟
البنى: لا تهتم. أنا من أصبتك.
وأنا طعنتك…. يبتسم الرمادى}ص22. وكأننا فى لحظة قمة العداوة التى تتحول إلى الصداقة .. والمحية.. والتوحد.
كما أن هناك خاصية اختطها الكاتب ، ليست عفوا، وإنما كانت لحقيقة (جوانية) بداخله، لم يُفصح عنها مباشرة، وإنما تركها كأحد العلامات التى تقود القارئ إلى (جوانية العمل). وهى جعل الفصول التى تتناول العلاقة بين الجنديين داخل الخندق، تقوم على التحديد الدقيق للمواعيد بالدقيقة، حيث يمثل الوقت –بالدقيقة- أهميته فى جو الحرب- على المستوى الخاص-، حيث يمكن أن تمثل الدقيقة، حياة بشر، أمام ما يتهدده من مخاطر الحرب. فضلا عن كونها تعبر عن مرو الزمن –على المستوى العام-، والذى يُعبِر عن مسار التاريخ، وكأن الزمن يسير، منطلقا من داخل الخندق إلى إتساع العالم من حولهما. وقد يؤكد تلك الرؤية، تلك الحبة التى زرعاها داخل الخندق، وراحا يسقيانها بقطرات من زمزميتيهما، لَتْنبُت فى اليوم التالى، وهى التى تستغرق الكثير من الوقت حتى يتم بزوغ برعمها، وكأننا أمام كبسولة صغير تمثل العالم الخارجى، ولتترك تلك النبة أثرها أيضا فى التوحيد والتوحد بينمهما{مد كل منهما يده إلى النبتة، يلمسها بإصبعه، وفى الوقت نفسه يلمس ذلك الشعور المرتبك بداخله}ص66. وهذا الشعور المرتبك، والصراع (الجوانى) بين ما كان، وما هو كائن {سنتان وستة شهور وخمسة أيام.. إن كنت تسأل عن بداية الحرب. صوت أشجار تئن فى الغابة، وضوء يبرق بعيدا فى جانب من السماء، ويطفئ.
ما كنت ألومك لو قتلتنى وأنا نائم. اتفقا أن من يبقى مستيقظا له حرية الاختيار.
لماذا اخترت أن تحرسنى؟ .. لم يكن هناك خطر بالأساس لأحرسك منه، كما أنى استمعت إلى الكمان دون أن تزعجنى كل دقيقة وتطلب أن نستمع للأخبار.. قال الرمادى.
نقل البُنى سلاحه من ركبتيه إلى الأرض بجواره، وقال: فعلتها .. يا مدرس التاريخ}ص31.
ويستمر الانتقال من حالة إلى حالة، بين الإثنين، حيث تسرى نغمات أغنية تخيلانها معا. وقد أبدع الكاتب فى تصوير الحالة الإنسانية –المصرية-، حين يطرب للحن الشجى، فيركن رأسه ويهيم مع النغمات، وحين لا يدرى إن كان بائسا أم فرحا، أيضحك أم يبكى، ليستحضر الإنسان فى أعز ما يملك من مشاعر، مستخدما –أيضا- الحاسة السمعية، (فيلمسها) –بأحاسيسه- نافذا بها إلى الأعماق {يلمس الصوت مساحة مبهمة داخل الطباخ، فيشعران يمزيج خفيف من الحزن والشجن، يُمرران أعينهما على الجدارين، وتتحول الهمهمة إلى ما يبدو أنها كلمات لها إيقاعها الخاص، عميقة وهادئة، لا يفهمها الطباخ والمدرس لكنهما يشعران بها، لفهما اللحن، واستند الطباخ والمدرس كل منهما بجانب رأسه إلى جدار الخندق، والأغنية تمشى بداخلهما على مهل، شجية ومريحة، حزينة بغير حزن.. هل كانا يبكيان ويبتسمان فى الوقت نفسه؟}ص52. حيث تقود تلك الحالة، إلى مشكلة فلسفية، وهى النسبية، فقد يفسر إنسان بأن حالة من الذكرى النشوانة قد أصابت الإثنين، بينما يرى آخر، أنه فرح الذكرى التى يولدها اللحن، لتفضى فى النهاية إلى حالة من الإلتباس التى تغلف حالة الإنسان –بصفة عامة- ويتم استحضارها هنا، حيث يجمعهما معا شعور بأن عليه أن يقتل الآخر، كما يُحتم الواجب. وفى نفسه يشعر برفض ذلك الواجب المفروض عليه. فحين يرى كل منهما شكلا ما، يراه أحدهما كلمات، بينما يراه الآخر رسم {أو الإثنان معا، فيمكن رؤيتها من زاويةعلى أنها كلمة، ومن أخرى تكون رسم}ص115. بل يصل اختلاف فى رؤية كل منهما للأخر، حيث يقول المدرس للطباخ، فى نقاشاتهما واستكشافهما كل للآخر{وأنا أيضا لاحظت.. أن بداخلك إنسانا رومانسيا.
رومانسى؟ أنا؟ لا أتوقع}.
وفى ذات الوقت، كان الأمل النابت، والمتخطى لكل القوانين والأعراف المتداولة، كانت {النبتة تهتز كأنما تقول لهما شيئا لاحظته فيهما}ص130. فرغم التقارب، ورغم ما تم زرعه فى أعماقهما، من محبة، فإنه يظل كل منهما له رؤيته، وله استقلاليته، وليظل الأمر إختلاف فى الرؤية ….. دون الوصول للحرب.
حيث يمثل ذلك كله، الانتقال، أو التحول (الحريرى) من حالة الحرب، إلى حالة السلم، دون أن يعنى السلام، محو الشخصية.
فإذا كان الإبداع عامة، يبحث عن الحرية والعدل والخير والجمال، فإن محمد الفخرانى، فى إبداعاته عامة، يأمل أن تكون هذه هى مقومات الحياة المبتغاه، والتى يأمل أن يعيشها الإنسان، بالحب والعدل والسلام، وكأنه يبحث عن المدينة الفاضلة، حيث استطاع أن يرسم، ويُهندس ذلك المعنى، فيدعو فيها القارئ، فى أى مكان كان، وفى أى زمان كان، إلى “غداء فى بيت الطباخة”.
…………………………..
– يرجع فى ذلك لكتاب “دور الرواية العربية فى الربيع العربى” (2014) وكتاب “الهم السياسى فى رواية المرأة العربية” (2024) الصادران عن الهيئة العامة للكتاب بمصر لكاتب هذه السطور. -[1]
محمد الفخرانى- غداء فى بيت الطباخة- دار العين للنشر –ط1 2023. – [2]