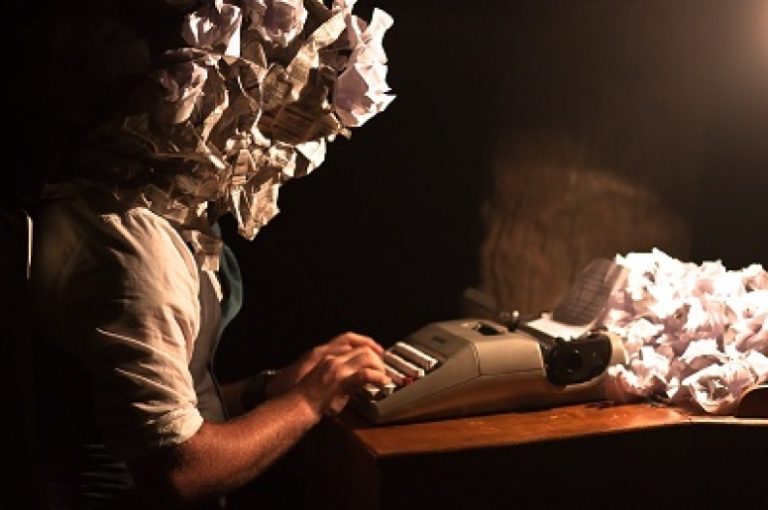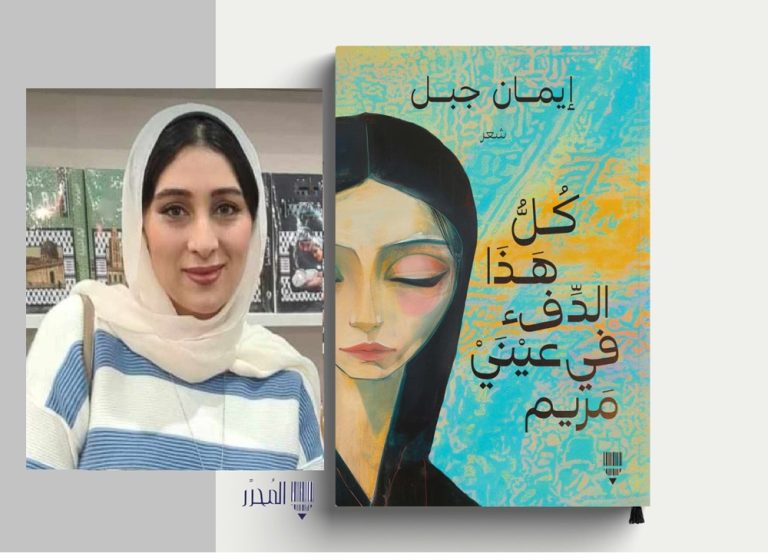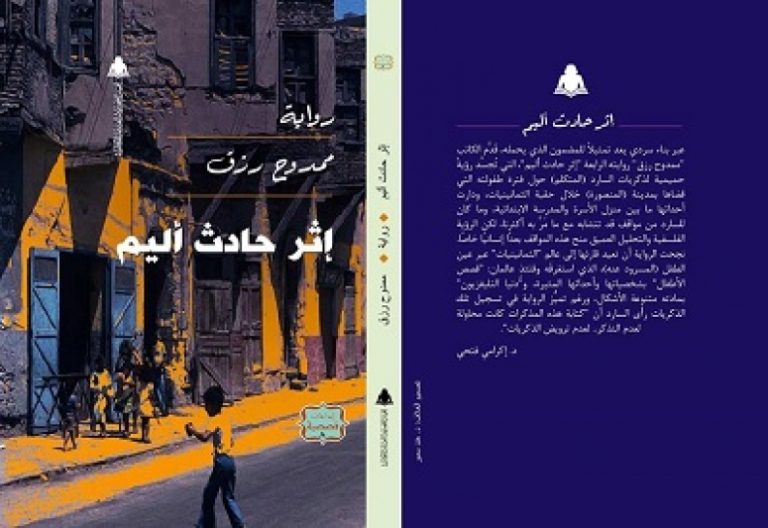إنجي همام
صدرت مجموعة «المنزل» للكاتب وليد خيري عن دار العين للنشر عن هذا العام 2025، وتتألف من ثلاثة أقسام/ «داخل المنزل»، «خارج المنزل»، و«منازل الآخرة». هذا التقسيم ليس شكليًا فقط، بل يوجّه القارئ إلى بنية معمارية واضحة: البيت وما يجاوره وما يتجاوزه. نحن إذن أمام مشروع سردي يشتبك مع التفاصيل اليومية والذاكرة العائلية، لكنه لا يكتفي بها، بل يمدّها إلى فضاءات الخارج وإلى تخيّل الموت وما بعده من حياة أخرى ..
منذ القراءة الأولى ندرك أننا أمام لوحة متكاملة يحاول فيها الكاتب أن يجيب عن سؤال: ما الذي يعنيه أن يكون لنا «منزل»؟ وهل البيت مجرد جدران وغرف، أم أنه الذاكرة التي تسكنها الأرواح والأصوات، ويمرّ بها الموت كما تمرّ بها الحياة؟
الجو العام مشدود بين قطبين: الحميمية البيتية والغرابة السريالية ..
“داخل المنزل” هو قلب المجموعة وأطول أقسمها، تفاصيل الأسرة والطفولة،مشاهد المطبخ والسرير وأبواب الغرف، لكن هذه التفاصيل لا تُقدَّم بصفاء نوستالجي، بل نجدها محمّلة بطاقة الممارسة العادية والغرائبية أحيانا، الأب الذي يظهر بعد موته بطرق فانتازية، نقش الاسم بدم الدجاجة على الأبواب، الأم المخدوعة في بيضة الثعلب المزعومة، الجدة التي تُمنح «حلوى الكبار». هنا البيت يتحول إلى مسرح للطقوس الغامضة أحيانا، ويتجاوز حدود المألوف، هذا القسم هو الأكثر كثافة وتفصيلًا في المجموعة، وفيه تتجلّى براعة الكاتب في تحويل تفاصيل صغيرة إلى رموز عميقة المعنى ..
الأب مثلًا، حاضر دائما، رغم موته. يظهر في تفاصيل بسيطة: كلما استغني البطل عن الميكرويف وسُخّن الخبز على البوتاجاز، يعود الأب ليشارك في الإفطار. صورة تجمع بين الطقس اليومي والحنين السحري. وفي «أبواب الغرف» نراه ينقش اسم ابنه على الأبواب بدماء آخر دجاجة في البيت، في مشهد يجمع بين الفخر والفقر، بين المحبة والغرابة، في غرفة ضيقة نعيش معه حشرجات الموت الأخيرة وفي طاولة الغسل نرافقه في أولى لحظات ولوجه العالم الآخر.
الأم بدورها تظهر في صور تجمع الطرافة بالبراءة المطلقة ، كما في «الثعلب لا يبيض»، حين تُصدق أن الأب وجد بيضة ثعلب، أو حينما توافق على عريسها وتعود بعدها لاستإناف اللعب مع الصغار وعلى وجهها ضحكة سُكر استعارتها من عريسها، أما الجدة تتجلى بوصفها طيف حنون يخفي الحقيقة خلف ادعاءات ساحرة. الأخ والخال والجدّات والحيوانات المنزلية، جميعهم يحضرون في النصوص كأنهم شظايا ذاكرة متفرقة تُبنى بها صورة البيت الحميمية.
ولعلّ أقوى رمز يظهر هنا هو طاولة الغُسل. الراوي يصف دوره في غُسل أبيه على الطاولة، محاولًا تجنيب إصبعه المكسور من الألم. الطاولة تقف إذن إلى جانب السرير والمطبخ كجزء من جغرافيا التفاصيل الحياتية المنزلية : للنوم فراش، وللطعام مطبخ، وللموت طاولة خاصة به. إدخالها في نصوص المنزل يجعل الموت ساكنًا داخل المنازل، حتى وإن لم يكن بشكل يومي ..
قصص الحيوانات والجمادات فيما بعد تكمل الصورة. الدمية «لولي» تتحول إلى معشوقة تُقتل غيرة، الصراصير تصبح محور دعوة لحقوق الهامش، والكلب «رعد» يُمنح جناحين متخيلين في قصة حزينة الآخر. هنا يتقاطع اليومي بالغرائبي، في خليط يجمع بين السخرية السوداء والحزن العميق..
في قسم خارج المنزل ، يخرج الراوي إلى العالم الأوسع: الشارع، المدرسة، الأتوبيس، الاستاد، المشفى، لكن الخيط الذي يربط الخارج بالداخل لا ينقطع. الخارج ليس نقيضًا للبيت، بل مرآة له، وظلاله تتكرر في كل تفصيلة.
في «خريطة العالم» مثلا يستعرض الكاتب برشاقة ذهنية ومشاعر مرهفة علاقة المسيحي بالمسلم داخل الوطن، براءة الطفولة التي يمكنها أن تعلو فوق كل شيء، فيحمل الصغير نحو زميله تعاطف كبير لأنه لا يحمل فوانيس رمضان ولا يحتفل بأعياد كثيره مثله والأهم من ذلك أنه محروم من تناول قطائف تنز بالعسل في رمضان، ويستبدل معه مقلمة خريطة العالم بسلسال يحمل صورة السيد المسيح أما قصة “في الأتوبيس قابلتني” فتدور حول تحولات الزمن وشهوة إصلاح العالم عند الجموحين من المراهقين التي تغدو مع الوقت حملا ثقيلا لا يمكن للمرء بعد عقدين ونصف من الزمان حمله، “بسطة السلم” تحمل شحنة حنين مركبة ومربكة في نص قصير يحمل شحنة كبيرة من العاطفة.
في «دنيا نجيب محفوظ»، يحضر محفوظ كأيقونة ثقافية. القصة ليست عن الكاتب الكبير فقط، بل عن أثره في تشكيل وعي أجيال بأكملها،. النص هنا احتفاء بالذاكرة الأدبية وتأثيراتها، وكذلك عن تحولات العالم التي باتت مرعبة في سرعتها، وأيضا استدعاء زمن في زمن آخر بتفاصيله وثقافته، وهو ما استخدمه الكاتب في عدة نصوص داخل المجموعة.
ما يميّز قصص هذا القسم أن الخارج يُصوَّر بوصفه امتدادًا داخليًا: الشارع ليس إلا بيتًا أكبر، تتسع التفاصيل .. تتكاثر وتنمو وتمتد، لكنها تظل آتية من جذر المنزل.
أما منازل الآخرة فهو القسم الأكثر تكثيفًا ورمزية. هنا لا نعود في البيت أو في الشارع، بل ندخل في فضاء ثالث: الآخرة كبيت جديد.
في قصة تعالى بسرعة وانظر التي جاء عنوانها بالفرنسية، ربما لتعبر أن للموت لغة أخرى غير التي نعرفها، يقابل البطل والده كذلك في بلد غريب، لكنه كان يمارس طقوس سعادته الدنياوية كما كان يعرفها البطل فيعزف أغنية من غير ليه لمحمد عبد الوهاب التي كان يحبها ويسمعها من شريط عالم الفن الأخضر في الكاسيت أبو بابين .
أما في «بريد الوحدة»، يخاطب البطل والده الذي يستأثر حضوره بمعظم نصوص المجموعة، يحكي له عن غيابه، عن العالم من دونه، يواجه موته صراحة، لكنه يعود ليختم النص بطلب مادي هدية للحفيد طلبها بنفسه، كما يذكًره كم إنه حفيد لحوح !
أما القصة الختامية «منازل الآخرة، فيتقمص البطل شخصية الميت هنا، الميت الذي كان بطلا مخاطبا في عدة نصوص، الآن جاء دور البطل ليقوم به، بعد أن كتب للآخرة وانتظر منها الردود بكل ثقة وثبات، هو الآن يكتب من هناك، يرى كل شيء، يفرح بكل من ودعوده وداعات حارة، اللافت أن هذا القسم مكتوب بكثافة لغوية أعلى، بجمل قصيرة مشحونة بالرمزية، كأنه يبتعد عن اليومي ليتماهى مع المطلق.
هذا المزج بين الحميمي واليومي والغرائبي يمنح المجموعة جوًا فريدًا: مزيج من الطرافة والوجع، من السخرية السوداء والحزن العميق.
اللغة
في مجموعة المنزل لم تكن اللغة واحدة .. فكان هناك: لغة الداخل
في «داخل المنزل»، اللغة مشبعة بالحميمية والذاكرة. الجمل طويلة نسبيًا، مشحونة بالصور البلاغية التي تحول التفاصيل الصغيرة إلى رموز. «كلما استغنيت عن الميكرويف ووضعت الخبز فوق البوتاجاز يظهر أبي»؛ جملة تجمع اليومي بالأسطوري في إيقاع شعري.. لغة هذا القسم تحتضن الحكي الشعبي أيضًا. الحوار مع الأم أو الجدة أو الأخ يلامس العامية المصرية في مواضع متعددة، فيُعطي النصوص نكهة محلية حقيقية. هناك طرافة لغوية تظهر في القصص الساخرة مثل («الثعلب لا يبيض»)، حيث يستخدم الكاتب نبرة أقرب إلى النكتة.
وهناك لغة الخارج:
في “خارج المنزل”، اللغة تميل إلى الوصف الواقعي، مع نبرة ساخرة أو تهكمية. في «في الأتوبيس قابلتني»، لغة تقارن الماضي بالحاضر، الماضي القريب بحاضر جاء فجأة مسرعا، يخبر البطل الفتى الكامن فيه أنه لن يغير العالم ويلعن صلف الماضي وضعف الحاضر في الأخير
وفي «دنيا نجيب محفوظ»، اللغة تتحول إلى خطاب ثقافي، مزيج بين السرد والتأمل النقدي، لتستحضر محفوظ كخريطة بديلة للمدينة
لغة الآخرة
اللغة في هذا القسم الأخير تتجه إلى التكثيف الشعري. إذا كان «داخل المنزل» مشبعًا بالتفاصيل اليومية، و«خارج المنزل» يميل إلى الوصف الواقعي، فإن «منازل الآخرة» يقترب من التجريد. الجمل قصيرة، متوترة، أقرب إلى مقاطع شعرية منها إلى قصص. هذا التنويع في الأسلوب يبرهن على وعي الكاتب بضرورة تغيّر النبرة وفقًا للفضاء السردي
الخيط الجامع
الخيط الجامع للغة المجموعة هو المزج بين الفصحى السردية ولمسات العامية المصرية، وبين النبرة الساخرة والنبرة الحزينة. يعرف خيري كيف يُغيّر إيقاع لغته وفقًا للمكان: من دفء البيت إلى ضوضاء الشارع إلى وجل الموت. وهذه المرونة الأسلوبية هي واحدة من أقوى مزايا المجموعة
الجغرافيا في مجموعة «المنزل» هي معمار سردي بحد ذاته
داخل المنزل: البيت هو مسرح الذاكرة والطقوس. الأبواب ليست مجرد خشب، بل شواهد تحمل الدم والأسماء. المطبخ ليس مكانًا للطعام فقط، بل بوابة لعودة الغائب. السرير وغرفة النوم مسرح للحب والعنف. والأهم: طاولة الغُسل، التي تضع الموت جانب الحياة في جغرافيا المنازل.
خارج المنزل: المدرسة والحافلة والإستاد والمشفى تُصوَّر كغرف كبرى. الخارج هنا إنعكاس للداخل، منزل عملاق أو منفتح على الشارع، لكنه في الأخير منزل، ربما كان مختلفا، لكنه يظل منزلا بصيغة ما.
منازل الآخرة: هنا الجغرافيا مجردة. الموت يُقدَّم كبيوت جديدة: «بريد» له صناديق، «غرف» لها رائحة المسك، «أبواب» تُفتح على غياب. الجغرافيا هنا شعرية أكثر منها واقعية، لكنها تكمل الدائرة: من الداخل إلى الخارج إلى ما وراءهما.
بهذا يصبح العنوان «المنزل» دالًا على أكثر من مكان: البيت الحقيقي، العالم كبيت أوسع، والآخرة كمنزل أخير.
المجموعة في نظري أو قراءتي تنحو إلى التداعي الحر الذي يجسد صورة رواية أو نوفيلا مبعثرة الأجزاء، لكنها على الأغلب لبطل واحد استدعى طوفان تذكاراته ووضعه في المنزل، وكثير من نصوص المجموعة تعتمد هذه الروح، ربما أهمها بالنسبة لي كان نص “خالي”، الذي قدم فاصلا من الحنين السينمائي والموسيقي والصحفي يحمل في طياته زمنا آخر كان يستدعيه البطل، أجمل وأقوى ما في هذا النص هو تقديمه للموت وتخليله للسياسة والحرب برهافة عالية، لم يعتمد مليودراما بكائية، بل نبرة حنون لازالت تسترشد بروح الخال في الحياة والحب والعمل، وكذلك نص “طاولة الغُسل” التي أخذتنا أيضا من قتامة الموت لبهجة الإعتداد بالنفس، حتى أن البطل طلب الإختلاء بجثمان أبيه المتوفى منذ قليل، فقط من أجل تمشيط شعره كما كان يحب أن يفعل، بل ومشطه ومشط نفسه أيضا بفرشاة كانت في جيب الأب لا تفارقه.
أهم نقاط القوة في المجموعة
تنوع البنية: التقسيم الثلاثي (داخل/خارج/آخرة) يمنح المجموعة وحدة معمارية
القدرة على تحويل التفاصيل إلى رموز: الخبز، الأبواب، الطاولة، كلها تتحول إلى علامات سردية
الجرأة في توظيف الحيوان والجماد: الدمية، الصراصير، الكلب، الثعلب، كلها شخصيات فاعلة بل وأبطال في بعض النصوص
مرونة النبرة: التنقل بين السخرية السوداء والحزن والتهكم يجعل النصوص متعددة المستويات
حضور الذاكرة الثقافية: الإشارة إلى نجيب محفوظ أو إلى الطقوس الشعبية تربط الفردي بالجمعي
تشبيك تفاصيل العالم الجديد لتصبح تفاصيل أدبية فنية، في نصوص مثل الصراصير وغرفة النوم و أخي ، حيث تتصدر الصراصير التريندات وتُنشأ من أجلها جمعيات حقوقية! في نص الصراصير.
أما في غرفة النوم فتظهر الدمية الجنسية التي تُشارك البطل سنوات متتالية من حياته مكتفيا بها ومستغنيا عن زوجة من دم ولحم
وكذلك في نص أخي نجد الشقيق الذي يتاجر في العديد من الأشياء شديدة الحداثة ومنها أيضا تلك الدُمى، وذلك ينم عن رغبة وقدرة في دمج اللحظة الراهنة بوضوح كامل يعبر عن زمن الكتابة الكلية للمجموعة، كما يدل على براعة الكاتب في دمج الحداثة مع موجات حنين متدفقة ومتفاوتة داخل العديد من الأزمان الماضية داخل نصوص المجموعة.
هناك أيضا براعة الاختزال في نص “كل الجمال التائهة” الذي اعتبرته لحن قصير عبقري كألحان منير مراد مثلا.
بعد هذه القراءة المتأملة والتي وددتُ لو تحدثتُ فيها عن كل نص على حدا، فالمنزل ليس مجرد مجموعة قصصية، بل بناء سردي يطرح سؤالًا وجوديًا: ما معنى أن يكون لنا بيت؟ البيت هنا ليس جدرانًا نحتمي بها، بل ذاكرة وطقوس وأسرار. الخارج ليس نقيضًا له، بل امتداد والموت ليس قطيعة، بل منزل جديد في سلسلة منازل لزامالا علينا أن نسكنها ولو لبعض الوقت ، نجح “خيري” في أن يجعل من التفاصيل الصغيرة رموزًا كونية: خبز على البوتاجاز يعيد الأب من غيابه، أبواب تحمل دماء الدجاج، صراصير تصبح ترندًا، كلب يطير من السطح، هذه الصور، على تنوعها، تنسج عالمًا متماسكًا يمزج بين الطرافة والفزع، بين الحميمية والكونية
ورغم بعض المآخذ على المبالغة في العنف أو على تفاوت المستوى بين القصص، تظل المجموعة إضافة لافتة تؤكد أن القصة القصيرة ما زالت قادرة على الإمساك باللحظة اليومية وتحويلها إلى نص يحمل معنى أبعد من اللحظة.
«المنزل» عمل يعيد للأدب سؤال البيت: هل هو مكان للإقامة، أم معمل للذاكرة، أم بوابة إلى منازل أخرى في الحياة وما بعدها
وأخيرا لم أنسى التصدير اللافت للقسم الأول أو الذي اعتبرته أنا كذلك
مُصلًى البيت …
“كل صباح أبكي حتى تبتل سجادة صلاتي تحت إلحاح دعائي بأن يرزقني الله كتابة جميلة لهذا اليوم”
لقد رُزقت كتابة جميلة لكل الأيام .
…………………..
*روائية وناقدة مصرية