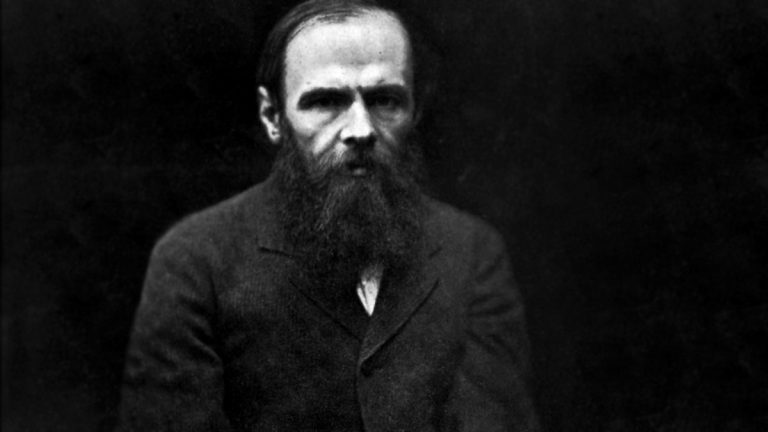ـ البيولوجي: فرغم أن الخلق من الضلع أو الجنب، يعني بيولوجياً، التطابق إلى حد ما، لكن أسبقية خلق آدم تجعله أكثر من زوج أو شريك، فهو له “أبوة” رمزية، وامتياز بيولوجي. ورغم أن التطابق الجسدي بينهما، قد يصل إلى 90%، لكن الفروق وظفت للتمييز، أكثر ما أسست للشراكة والتكامل.
ـ الاجتماعي: حواء همست وأوعزت، أما القرار والفعل فكان من اختصاص آدم. هكذا يتأسس المفهوم الأولي للأسرة، والقوامة الاجتماعية للرجل. فالشراكة بينهما لم تبدأ من المساواة الصفرية، بل من امتياز الرجل بإدارتها قراراً وفعلاً.
ـ الديني: حواء يسهل إغواؤها عن طريق الشيطان/الأفعى، وهي أكثر استهتاراً بالأمر المقدس، وطمعاً في الملذات، ونيل الممنوع المرغوب.. أما الرجل فيكاد أن يكون معصوماً من ذلك كله. لماذا فضل الشيطان/الأفعى أن يغوي حواء وليس آدم صاحب القرار؟ ألا يمكن أن يكون الإغواء حدث للاثنين معاً؟ لماذا استجاب آدم بهذه البساطة لإغواء حواء؟ هذه مجرد أسئلة افتراضية، وقد تحتمل القصة تفسيرات رمزية أخرى. لكن المهم أن جريمة حواء “الذهنية” مجرد خاطرة سيئة ورغبة وإيعاز لفظي لشريكها، لكنها اعتبرت “أصل الخطيئة”، وحافزها… أما آدم الذي قرر وفعل، فالتصور العام أنه كان “ضحية” لرغبة حواء التي تكاد أن تتحمل وحدها إثم الطرد من الجنة.
هل تغير التمييز البيولوجي، الاجتماعي، الديني، ضد المرأة، منذ قصتنا الأولى وحتى اليوم؟ الإجابة ببساطة:لا، فقصتنا الأولى تملك من القداسة والهيمنة، ما يجعلها أقوى من الحقيقة ذاتها.
وإذا عدنا إلى فكرة “العُري”، وهي تمثل العادي والمباح في الجنة، فقد تغيرت عقب ارتكاب الخطيئة. وهنا مفارقة بالغة الأهمية، فالمعصية كانت عدم الامتثال لأمر مقدس، أي كانت سلوكاً سلبياً “عصياناً”، وتمرداً عقلياً على منع “غير مسبب”، لكن الإحساس بالذنب لدى الاثنين دفعهما إلى “ستر عورتهما” بورق الشجر. هنا ما يسميه علماء النفس “الإزاحة”، حيث نقلت شدة الانفعال والشعور بالذنب، مفهوم “العورة” من إدانة سلوك واختيار عقلي معين، إلى إدانة الجسد واعتباره “عورة”. ولا تحدد القصة بدقة ماذا ستر كل منهما من جسده.. لكن التطوير الديني لمفهوم “العورة” ـميز الرجل بجزء يسير من جسده، فيما اعتبر جسد المرأة كله “عورة”، والأمر أقرب إلى الإدانة المطلقة لها فيما جرى، وسجن جسدها عقاباً لها على طيشها العقلي، على فكرتها ورغبتها! كان من المفترض حسب المنطق أن تتساوى العورتان، طالما أنهما شريكان في “الخطيئة” وفي العقاب ذاته “الطرد من الجنة”، خصوصاً أن الخطيئة كما أوضحنا لم تكن “العري” بل السلوك، لكن الإدانة الدينية للمرأة التي تماهت فلكلورياً مع الأفعى والشيطان، تستوجب “المبالغة” في تأكيد عورتها، وخطورتها على مصير الرجل وتهديد مكانته.
لقد حددت قصتنا الأولى، أدوار الرجل والمرأة اجتماعياً ودينياً وسياسياً، فكاد أن يقتصر حضورها باعتبارها جزءاً من “المتاع” الرمزي للرجل ـ كما أوضح بورديو ـ فهي ليست صاحبة القرار والمبادرة، بل تقبع في مؤخرة البيت والمطبخ تبكي على خطيئة أمها الأولى، لا تستقبل الضيوف ولا تخرج إلى الشارع، ولا يسمع أحد صوتها الذي يهمس إلى الأبد بكلمات الشيطان وفحيح الأفاعي، بل أيضاً لا يجب أن يشم أحد رائحتها.
كل هذا الحجب، يُعلي من “قيمتها” في مساومات وصفقات الرجل، وأي تمرد على ذلك، ينتقص مباشرة من رجولته وشرفه، ومكانته الدينية والاجتماعية ورأسماله الرمزي. ولن يسمح الرجل بذلك أبداً، فعليه بكل جينات الرجولة المكتسبة، أن يحكم حصارها، وأن يكون جاهزاً في أية لحظة لدفنها حية على أية هفوة. فلا عجب أن بالغ العرب قديماً في وأدها مولودة، حتى قبل أن ترتكب أية خطيئة، فالقصة الأولى أخبرتهم بوضوح أنها ستكبر ويقيناً سترتكب الخطيئة أو توسوس بها، لتجلب العار على رجالها! وقناعة الأب الجاهلي بوأد طفلته وإماتتها بيولوجياً، هي نفسها قناعة الزوج المتأسلم بوأد امرأته في ملابس سوداء لا تظهر منها أي شيء، وإماتتها رمزياً. فهو يتمنى أن يصبح جسدها لا مرئياً. ويشعر أنه يجر خلفه بخطوات كياناً مثقلاً بالخطيئة الأولى.
تلك قصتنا التي حددت مصيرنا، وعلى أساس تمييزها الثلاثي، تعاظمت مكتسبات الرجل في المال والإرث والحياة الاجتماعية والوجاهة السياسية وتفصيل القوانين والأعراف، لضمان استمرار هيمنته الذكورية باعتبارها حقيقة بيولوجية وحكماً إلهياً. فيما أصبح أي تمرد تقوم به المرأة على تلك الهيمنة، ولو كان مجرد خاطرة “جريمة” تستوجب التنكيل بها.
لقد تشربت المرأة من قصتها الأولى إحساساً عميقاً بالذنب، وضرورة التضحية، إلى درجة أن حيل الهيمنة الذكورية، أصحبت راكزة في جيناتها النفسية وخريطة الروحية، فهي أول من يدافع عمن يدينها ويستغلها، ويحتقرها باعتبارها مجرد موطئ لشهوته. وهي أول من يجب أن يضحي من أجل سمعة أبيها وأخيها وزوجها، وأول من يرضى بأي “فُتات” اقتصادي أو اجتماعي يلقيه الرجل على مائدتها، إن لم يتركها تنال ما يتبقى من مائدته.
إن العلاقة تجذرت عبر آلاف السنين على مفهوم “الاستغلال” لا “الشراكة”، فحقوق ومكتسبات الرجل أضعاف حقوقها، فمثلا من حق الرجل أن يقود السيارة ثم بعد عشرين أو خمسين عاماً يمكن النظر إذا كان هذا الفعل “العادي” للرجل، ليس من عمل الشيطان بالنسبة للمرأة، ومن حق الرجل أن ينتخب أو أن يصبح عضواً في البرلمان، ثم بعد مائة سنة ننظر في إمكانية أن تنال المرأة هذا “الشرف” الرجولي.
تقريباً تحرر الرجل من خطيئة أبيه الأولى، أو أصبح لا يبالي بها كثيراً، وكأن آدم وحده هو من يتحملها، وبالتالي كل ممارساته مدعاة للفخر والشرف.. أما المرأة فلا يُسمح لها أن تتحرر من خطيئة أمها الأولى،لتظل إلى الأبد تدان وتعاقب على جريمة حواء.
كيف ستكون هناك “شراكة” إذا كان الخطاب يكرر نفسه دائماً: أنت لا تستحقين، أنت أفعى، أنت حبل الشيطان، أنت عورة، أنت خطيئة، أنت تنساقين وراء رغباتك؟! وعلى المرأة أن تبذل جهداً مضاعفاً كي تثبت للرجل أنها ليست كذلك، وأنها حارسة أمينة على شرفه المهدد بوجودها ذاته!
ليست الصورة قاتمة تماماً، ففي حضارات وثقافات موازية، للدين الإبراهيمي، هناك أنماط مختلفة للعلاقة. كذلك، ومن خلال التعليم والاشتغال على الصور النمطية المتوارثة، وثورات المرأة نفسها، وحداثة القوانين، تعدلت العلاقة بدرجة ما نحو “الشراكة” لا “الاستغلال”.
لقد كتبت يوماً ما عن المرأة “حاملة مفتاح الحياة”، عندما أدركت أن وجودي كله لم يكن سوى كلمة لامرأة، شمعة أشعلتها لي امرأة، مفتاحاً وهبته لي. أحب أبي لكنني مدين أكثر بحب أمي لي، كما كنت أحب جدي لكنني مدين أكثر لجدتي التي لم تهبني الحب فقط، بل علمتني أبجدية الحكاية.
إن أجمل ما فينا كبشر، تلك الشفرات السرية التي رضعناها من امرأة ما ـ وليس الرجل ـ ولا أدري من قال إن الإبداع أمومي، هو كذلك بالفعل، فالمرأة هي الخصوبة والفكرة والحرية والمحبة.. هي الكلمة والحضارة والسماء وأمنا الأرض والطبيعة والثقافة والكرامة والعدالة. إن اللغة في جوهرها ـ وبمعزل عن إكراهات الرجل وتوظيفه لها ـ تمنح المرأة قوتها الرمزية، فهي تكاد أن تكون أصل كل وجود، وسبب كل ارتقاء. وما “لا يؤنثن” لا يعول عليه.
ولا داعي أن نستغرب أن كل المجتمعات التي أكدت على حضور المرأة روحاً وجسداً، وعلى الشراكة لا الاستغلال والتمييز، هي الأرفع شأناً، أم تلك التي وضعتها في مكانة مهينة واستغلتها أسوأ استغلال، وحمّلتها صليباً مثقلاً بكل أخطاء النساء والرجال، فهي تعيد إنتاج جهلها وتخلفها إلى الأبد.