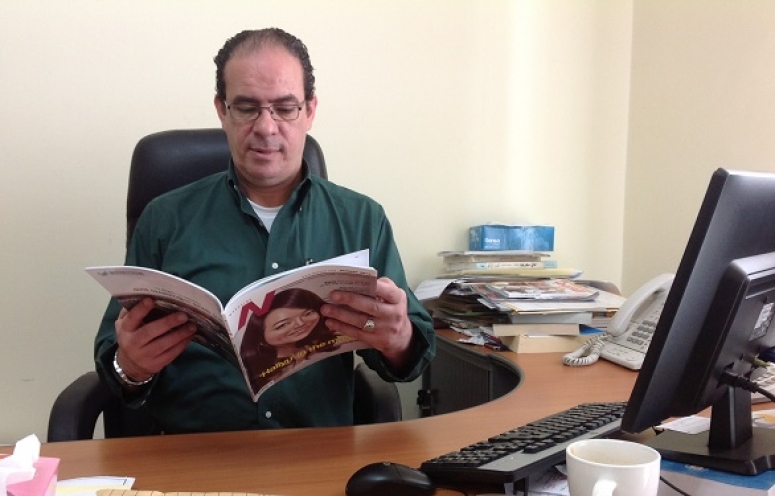إبراهيم فرغلي
لديّ قناعة قديمة تتعلق بأنّ الكتابة في أثناء الفعل نفسه لا تتوجه أبداً إلى قارئ، ولا ينبغي أن تتوجه إليه، بينما تصبح حقاً لهذا القارئ، بمجرد تغيّر الوسيط من المخطوط إلى الكتاب المنشور. وهنا تتغيّر الظروف تماماً، ويصبح من حق القارئ الافتراضي أن يمارس سلطته، تلقّياً ونقداً، على النص المكتوب. أما قبل ذلك، فالكاتب لا يكتب إلا لنفسه فقط. بين عدد ممن صاغوا هذه الفكرة في أشكال مختلفة، يقول الكاتب الإسباني أغوستين فرنانديث ماييو: «أنا أكتب لنفسي، وأظن أن الكتابة للقارئ خطأ، وينبغي ألا ننسى أن أعظم احترام للقارئ هو تجاهله والكتابة كأنه غير موجود. كما من الغباء أن تكتب لإرضاء شخص ما، والحال ذاته مع الكتابة لإغضاب شخص ما».
أغوستين فرنانديث ماييو ــ وفقاً لما عرفت ــ هو فيزيائي وكاتب ممن ينتمون إلى تيّار أدبي يعرف بجيل ما بعد البوب After Pop، أو جيل نوثيا. ويبدو أنّ هذا التيار قد بُنيت تسميته على ثلاثية روائية بعنوان «نوثيا» لأغوستين. ووفقاً للمعلومات الشحيحة التي توفرها شبكة الإنترنت، فالثلاثية، والتيار الذي تمثله بطبيعة الحال، تتضمن أسلوب كتابة مختلفاً نسبياً، مبنياً على الشذرات، والنهايات المفتوحة.
المهم، ما أقصده هنا بشكل عام، أنّ مثل هذه التجارب الأدبية التجريبية أو الحداثية، لا تنشغل بفكرة القارئ كثيراً، لأن القارئ بالمفهوم العام ليس مهتماً بموضوع التجريب ووسائل أو أساليب الكتابة الحداثية. القارئ العام يهتم بمضمون، ويهتم كثيراً بما ينعكس مما يقرأ على تجاربه الخاصة، وقلة من القراء هي التي تمنح نفسها الفرصة لدخول العوالم التي تتعرف إليها عبر القراءة بأفق مفتوح، وتتلقى تجربة الكاتب بالقدرة نفسها على الانفتاح على عوالمه، والقراءة ثم إعادة القراءة لتبين مستويات المعنى وطبقات السرد. الغالبية من القراء، في الحقيقة، تدخل إلى النصوص بخبراتها وأذواقها، وقد لا تكون هذه الخبرات بالضرورة مصقولة، ولا الذوق الأدبي قد تشكّل بعد، ووجود قراء كهؤلاء في وعي الكاتب خلال الكتابة لا يمكن أن يجعله ينتج إلا ما يتصور أن يرضي تلك الذائقة.
لكن عدم الانشغال بالقارئ لا يعني ـــ وهذا بديهي ــ أن يطبع الكاتب من كتابه نسخةً وحيدة ليحتفظ بها لنفسه، أو حتى أن يكتب المخطوط لنفسه ويضعه في الدرج، وإنما الكيفية التي ينبغي بها «تجاهل» فكرة وجود القارئ تماماً خلال عملية الكتابة.
غالبية من يعارضون هذه المقولة لا تنتبه لمعنى كلمة «تجاهل»، التي تعني «إزاحة» وجود القارئ. وأظنّ أنّ هذا أمر طبيعي، وفقاً لتقديري الشخصي لاعتبارات أحدّدها في ما يلي:
أولاً: إنّ الكاتب عندما يكتب كتابه الأول، يكون قادماً من مجهول وذاهباً إلى مجهول، لا يعرف قرّاءه، ولا هم يعرفونه. وأقصى ما قد يتوصل إليه هو قارئ افتراضي لا ملامح محددة له. وهو يبدأ كتابه وينتهي منه بلا قدرة على تحديد أو معرفة القارئ المحتمل لهذا النص. على الأقل، هذا تصوري الشخصي عندما كتبت كتابي الأول. وتالياً لأنّ بعض الكتّاب، وأنا منهم، يفضل أن يستمر على هذه المسيرة كأن كل كتاب جديد هو كتاب أول، لا وجود لقارئ افتراضي له.
هذا التجاهل في الحقيقة ضروري جداً لإزاحة سلطة لا تليق بفعل الكتابة. ماذا يريد الكاتب من قارئ مرتقب أو محتمل؟ أن تعجبه الكتابة؟ وإذا لم تعجبه؟ وكيف سيعرف الكاتب أن الكتابة ستعجب القارئ أو لا تعجبه؟ فالذوق الأدبي العام شاسع في تباينه واختلافه. ولا يمكن أن تجد إجماعاً على كاتب من الكتّاب؛ بمن في ذلك أكثرهم رسوخاً في تاريخ السرد والأدب وحتى الفكر أو أيّ من فروع الإنتاج الكتابي.
القارئ أيضاً قد يتمتع بأخلاق محافظة وذوق أدبي شبيه، بينما الكاتب يريد أن يعبّر عن آفاق جديدة بحرية تامة، وأن يسبر غور المجتمعات والنفسيات والأفكار والأسئلة، ومجرد افتراض وجود قارئ كهذا كفيل بفرض رقابة ذاتية، سواء عن وعي أو حتى بلا قصد على حساب حرية الكاتب في التعبير عما يبتغيه، بلا رقابة مسبقة، وعلى حساب حريته في المغامرة أو اقتراح أنماط أو أساليب أو لغة جديدة.
كما أنّ الكثير من القراء يبحثون عن إجابات لأسئلتهم، يبحثون عن اليقين، وبعضهم يبحث عما يدغدغ حواسه، ويثير مشاعره وبعضهم قد يبحث فقط عما يسلّيه.
ومرة أخرى، لا أعتقد أن الكاتب الذي أعنيه، قد يولي هؤلاء القراء اهتماماً، لأنه غالباً لا يملك إجابات بل يطرح المزيد من الأسئلة، وأيضاً لا يملك يقيناً بقدر ما يملك طاقة شك تشككه في الحقائق كافة لأنه لا يبحث عن يقين بقدر ما يبحث عن الحقيقة.
هناك قراء أيضاً يمارسون القراءة بوصفها نوعاً من السلطة أو الوصاية، يمتلكون صكوكاً أخلاقية يمنحونها لمن يرون في كتابته المحافظة، مثلاً، تماشياً مع أذواقهم، أو صكاً أدبياً لأن تصوراتهم عن الأدب تتماشى مع نوع ما يقرأون من نصوص. وهؤلاء لا ينبغي أن يضع الكاتب في اعتباره أي حساب لهم من الأساس.
وحتى على مستوى استيعاب بنية ما بعد الحداثة مثلاً من قارئ لم يتمرّس إلا على النصوص الحداثية، قد يؤدي ذلك بالكاتب إلى اجتناب تجربته ما بعد الحداثية ليحظى بقبول ذوق القارئ الحداثي، وهكذا.
ولا يعني ذلك أن القارئ مجرد نوع من المسخ الذي لا أثر له على الكاتب، بل إنّ الكاتب يتوجه إلى قارئ بالضرورة، وإلا ما كتب، أو بالأحرى، ما نشر. لكن الفكرة أن وجود القارئ وجود لاحق جداً، ولا ينبغي أن يبذل الكاتب جهداً في تخيّل هذا القارئ أو تصوّر أنّه يكتب ليرضيه أو ينال إعجابه، أو حتى ليتسبّب في إغضابه، لأن هذا الهدف يخرج عن الهدف الحقيقي للكتابة ممثلاً في اختبار الكاتب لأفكاره، لأسلوبه، للأسئلة التي يطرحها، لطبيعة الطرح الذي يبتغي أن يطرحه أمام نفسه قبل غيره.
القارئ هو الذي يمنح النص الحياة، بل إن استمرار حياة أي نصّ مرهونة بوجود القارئ، لكن خلق العمل من صنيع الكاتب، وعملية الخلق لا تحتاج أبداً إلى قبلة الحياة لأن هذه القبلة المطلوبة للنص بعد الانتهاء منه قد تعمل ضد عملية الخلق. فالقراءة عملية تأويل وتفسير ومنح الصيرورة للأفكار، وهذا كله لا يمكن أن يحدث قبل أن ينتهي الكاتب من فعل الكتابة بشكل تام متحرّراً من السلطات الرقابية كافة، ومن بينها سلطة القارئ ووجوده الافتراضي.