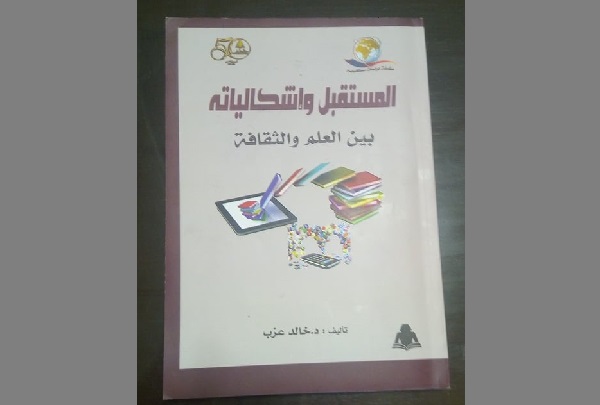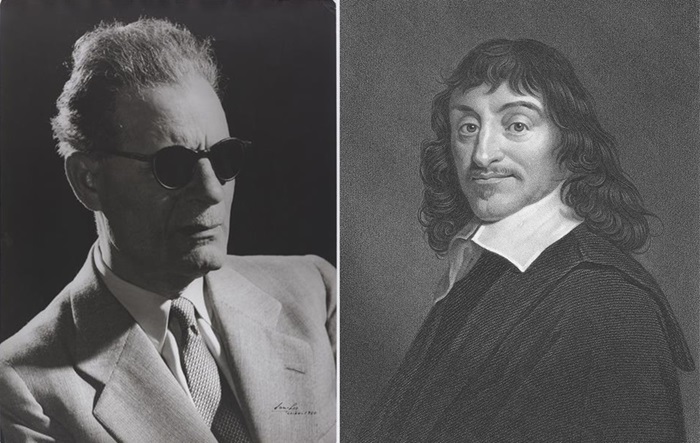حميد بن خيبش
“الحكايات تُحَف الجنة.” مالك بن دينار
مثلما يقف الشعب باعتزاز على الأرض التي حررها بدماء أسلافه وبطولاتهم، فإنه يستلهم كيانه وهويته، ومُثُله وقيمه من ثقافته الشعبية التي تشكلت على مدار أزمان غابرة، لتصبح ذخيرته الحية، وعملته الحقيقية المتداولة في حاضره وغده.
ولأن الحكاية الشعبية جزء أصيل من تلك الثقافة، ووسيلة كل شعب لحفظ ذاكرته وخياله المشترك، فإنها لقيت عناية كبيرة لما تعكسه من تجارب حياتية، وأحلام ومخاوف، وآمال تلتمس التعويض في عالم مثالي. كذلك كانت الحكاية الشعبية حتى وقت قريب، قبل أن تداهمها التكنولوجيا بترسانة هائلة من وسائل الترفيه والتسلية، وتنزع عن الجدّات ثياب الحكواتي!
إن وظيفة حفظ التاريخ والذاكرة لا تمنع الحكاية الشعبية من أن تظل إنتاجا حيا ومتواصلا، ينسج من خلالها العقل البشري عالما مثاليا يطمح لتجسيده في واقعه، ويستدرك من خلاله نقائص المجتمع وخطاياه. تلك الاستمرارية رهينة إلى حد كبير باستثمارها كمدخل بيداغوجي، واعتمادها أداة ناجعة للتعلم، وتمرير القيم الأخلاقية، وتأسيس جمالية الحكي داخل فضاء تعلمي تفاعلي.
لهذا الفن القديم خصائصه ومرتكزاته التي تميزه عن سائر الأجناس الأدبية؛ حيث تتمتع الحكاية الشعبية ببساطة البناء والأسلوب، وبلغة خاصة ومتميزة تحقق الإيحاء والإثارة الفنية المطلوبة. للحبكة فيها دلائل نفسية وقيمية يصل دويها إلى أعماق المستمع. متحررة من خصوصيات الزمان والمكان والشخوص، مما أتاح لبنائها وتركيبها أن يكتسب سمات العالمية. هكذا تنقلت حكاية “سندريلا” من خلال ثلاثمئة وخمسة وأربعين نصا مختلفا، عبر رقعة تمتد بين روسيا وإيرلندا، فهي في إيطاليا “سينيرنتولا”، وفي فرنسا” سندريلون”، وفي ألمانيا” اشينبويل”، وفي المجر “بوبلوث”، وفي روسيا” جيرنوشكا”، بينما يرقى تاريخها في الصين إلى ما قبل سنة 800 ميلادية تحت اسم” يه هسين”، قبل أن تأخذ في الشرق لقب “ست الحسن”.
تقوم الحكاية الشعبية على سرد مباشر يروم الإقناع والتأثير، ويتخذ من المغامرات الخيالية والأحداث الغريبة موضوعا له. وقد تكون الأحداث حقيقية، غير أنها مُزجت بآمال الناس وأحلامهم وخلاصات تجاربهم، فحررتها من صلتها المباشرة بالواقع لتعتمد على الخوارق والعجائب، وتضفي على الطبيعة الإنسانية المتشابهة في كل مكان وزمان، أزياء محلية متنوعة. ولذلك التشابه العالمي تفسيراته، من بينها الترجمة، والنشاط التجاري بين البلدان، بالإضافة إلى تحركات الجموع البشرية الموسومة بالهجرة.
داخل هذا العالم الوهمي والعجائبي الذي شيدته عقول البشر، تجد الطفولة تعبيراتها الأولية للارتباط بالواقع الاجتماعي، وتستمد ثروات لغوية وتربوية ونفسية. وما إن يستأنس الطفل بالحكي الذي يثير الغرابة ويستحث فضول الاطلاع، حتى يبدأ في التقمص اللاشعوري لآداب مجتمعه وقيمه الأصيلة؛ وبذلك يتحقق نمو شخصيته وإحساسه بهويته وانتمائه.
ينتقل الطفل من المرحلة الواقعية (ثلاث إلى ست سنوات)، حيث يكون قد استوفى مطلوبه من الخبرات المكتسبة في بيئته المحدودة، إلى مرحلة توصف بالخيال المنطلق أو الحر. وهنا يُبدي الطفل استعدادا ذهنيا لتأليف صور تحاكي واقعه أو ترتفع عنه بما يتناسب مع أحلامه وآماله. وتتم تغذية خياله عبر الحكاية الشعبية، باعتبارها أقرب نص أدبي يتيح له الولوج إلى دائرة معارف الجماعة أو العشيرة.
تفسح الحكاية مجالا رحبا لخياله كي يتطلع إلى عالم جديد، ويستوعب قيما وخبرات ومواقف، عن طريق حكي يعتمد التبسيط ويتحاشى الخوض في التفاصيل. ولأنه يتلقاها شفهيا، فإن الإلقاء غالبا ما يكون مصحوبا بقدر من التمثيل وتلوين الصوت، بشكل يتناسب مع الشخصيات والأحداث. وقد يعمد الراوي أو الحكواتي إلى إشراكه في أحداث الحكاية، فيُسند إليه دورا، أو يوجد شبها بينه وبين إحدى الشخصيات، ليصبح الحكي فضاء لتجريب ميوله ومواهبه.
تتنوع الحكاية الشعبية بتنوع مضامينها، مما يسمح للطفل بتعزيز كفاءته في التعامل مع الصور والرموز، ويُنمي خبراته ومعارفه. فالحكاية العجيبة التي تهيمن عليها الظواهر الخارقة، من سحرة وجن وعفاريت، تحقق بُعدا تنفيسيا حين ينتصر الأخيار على الأشرار.
وأما الحكاية الخرافية فتعرض حادثة مجسدة لمغزى أخلاقي، ويكون أبطالها في الغالب إما حيوانات أو جمادات أو ظواهر طبيعية، ويتم أنسنتهم بإضفاء الخصائص البشرية عليهم، مع التركيز على الموقف الأخلاقي المباشر.
بينما تهدف الحكاية الدينية إلى تعزيز انتماء الطفل لدينه والقيم الحارسة لمجتمعه، من خلال أحداث بعضها جرى في تاريخ واقعي فعلي، والبعض الآخر تم تعديله وإضفاء هالة من القداسة عليه للتأثير في النفوس، وتمرير صيغ وعظية ورسائل تعليمية أخلاقية.
وتتسم الحكاية المرحة بالقصر الشديد والتركيز على حدث واحد مفرد. وهي لا تحمل درسا تعليميا أو وعظيا، لأن هدفها هو النقد الاجتماعي من منظور ساخر، والثورة على الإشكالات التي تواجه الإنسان في واقعه المعيش.
بفضل اللجوء إلى المتخيل يتحرر الطفل من الضغوط والتناقضات التي يراها في الواقع. بل تذهب الدراسات حول القوة الشفائية للحكاية إلى أن دورها العلاجي يتحقق كلما انسجمت مضامينها مع نفسية الطفل ومميزات شخصيته، وغمرت الفراغ العاطفي الذي قد تُخلّفه اللحظات القاسية. لذا يتم تسخيرها في مدارس كيبك بكندا كوسيلة علاجية للأطفال الذين يشكون من عاهات لسانية، مترتبة عن أضرار نفسية وذهنية، وذلك باعتماد ترسانة من المهارات التواصلية التي تحفزهم للإفصاح عن مشاعرهم وضبط انفعالاتهم.
تستبق الحكاية خطوات الطفل نحو المستقبل، حين تمنحه قدرات فكرية واستراتيجيات محكمة، يوظفها عند الحاجة كأداة توقع أو مخطط للتصرف. ويمكن إجمالها على النحو الآتي:
– التمسك بالقيم الاجتماعية.
– الوقوف على فكرة انقسام العالم إلى خير وشر، وثواب وعقاب.
– بناء المفاهيم الأساسية حول الزمن والفضاء.
– تشكيل اختياراته وأذواقه الجمالية والفنية، وقدرته على الإفصاح والتعبير عنها.
– إذكاء قدراته على الانتقال من دنيا المحسوس إلى فضاء التجريد.
– التشبع بالمشاهد والسيناريوهات المتخيلة التي تُقربه بشكل مسبق من واقعه، وتهيئه للاحتكاك والتفاعل معه. (1)
كما تنماز الحكاية الشعبية بسلطة تأويل العلاقات الاجتماعية، واختراق لاوعي الطفل لتمرير القيم والمثل التي تحدد علاقته بالراشد والجماعة بشكل عام، وذلك من خلال:
– التعامل مع قيمتي الخير والشر بطريقة نفعية لأنها تجسد له سيرورة الكينونة والوجود، وتبعده عن التجريد. فالقيم لا وجود لها في حد ذاتها، ولكن بنتائجها على الإنسان.
– تمجيد البطولة المبنية على فعل الخير لصالح الجماعة، وهذا هو أساس تمجيد الجماعة للبطل ومنحه السلطة.
– انعدام المجانية، فلابد للحصول على الرزق من سبب، ولابد للإنسان أن يشقى ويتعب ليحصل على ما يريد. وهذا رد على ادعاء أن الحكاية الشعبية تنشر التواكل والاستسلام للقدر بين الناشئة.
– المهمات الصعبة التي ينجزها البطل دليل على نجاحه في الترشيد الذي تمارسه الجماعة على أفرادها، لتختار منهم أبطالا يرتقون بالجماعة ويضحون في سبيلها.
– الحكاية التي تحفل بالحيلة تعمل الطفل أن الذكاء ضرورة حياتية وليس ترفا فكريا.
– تقويم حياة الجماعة، وإعادة النظر في العادات والمظاهر السلبية المنتشرة بين الناس. (2)
تتصدى الحكاية الشعبية لواقع تآكلت فيه النظم التربوية والاجتماعية، فتحاول معالجته من خلال إظهار سلبياته والتحذير منها. وتعبر عن رغبة ملحة لاستعادة التوازن الاجتماعي، وتحقيق عالم تسوده العدالة والحب والتسامح. أما على المستوى النفسي فهي تقدم أجوبة شافية عن الوجود والمصير، وتفكك انشغالات الإنسان التي تُعطّل حركته بدفعه لتحقيق رغباته وطموحاته.
ولعل السر وراء انجذاب الطفل للحكاية الشعبية يكمن في أنها تتحدث “إلى” وليس “عن” الأطفال. فهي لا تمارس وصاية كالتي تنتهجها باقي الأجناس الأدبية الموجهة للطفل، ولا تعتبر هذا الأخير مجرد خطاب جاهز ومفتوح لتلقي الوصايا، وإنما هي استثارة جمالية لمشاعرهم ووعيهم الخاص.
يتبين إذن أن الحكاية الشعبية أنسب مدخل تعليمي تتكامل داخله عدة وظائف: أخلاقية، وتربوية، ونفسية، وجمالية، وترفيهية. وهي مقومات تؤهلها للحضور بشكل فاعل في البرامج الدراسية، وإكساب المدرسين منهجية واضحة لتيسير التعامل مع الحكايات، والاشتغال على عناصرها، لإكساب الطفل مهارات لغوية وتعبيرية، وحل المشاكل القرائية والتواصلية التي تعترض مساره التعلمي.
تسهم الحكاية في ترسيخ ثقافة الاستماع والتعبير الشفهي، مما يعزز قدرة المتعلم على التعامل مع النصوص القرائية. وأما الاشتغال داخل الفصل بوتيرة يومية على تفكيكها إلى وحدات وظيفية، من خلال اعتماد تصنيف فلاديمير بروب للحكاية الخرافية، وتعرف بنيتها وعناصرها، فيحقق الاستضمار الذي يُنمي مهاراته الإبداعية، للنسج على منوال الحكايات وإنتاج أخرى على غرارها.
وتؤدي الحكاية الشعبية وظيفة سيكولوجية إزاء بعض الاضطرابات اللغوية التي تُولّد فتورا في بناء تراكيب لغوية صحيحة، أو تعبير الطفل عن أفكاره ومشاعره. وفي تجربة كندية رائدة، تمكنت خبيرة النطق كلير مونيي Claire Meunier، أثناء معايشتها لأطفال يعانون من حالات نفسية معقدة، من تأسيس محترف للحكاية الشعبية، يتضمن تخصيص حصص داخل البرامج الدراسية، تدور حلقاته في فضاء خارج القسم. وعلى ضوء التحليلات النفسية لتصرفات الأطفال وتعبيراتهم عن مظاهر حياتهم اليومية (ركض، صراخ، بكاء، همس..) تمت صياغة حكايات على شكل مسرحيات قصيرة، يؤدي فيها الأطفال أدوارا تنسجم مع شخصياتهم. وركزت المقاربة العلاجية ليس على حبكة الحكاية، وإنما ما تُولّده الأحداث من قناعة بمشروعية تعبير الصغار عن أحاسيسهم العميقة.
ولتسهيل التعلم والاكتساب داخل المدرسة المغربية، طورت مجموعة بحث في الموروث الشفاهي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير سنة 1992، مشروعا تربويا يحمل اسم “سبك الحكاية”. وكان الهدف هو توليد آليات ممارسة إبداعية لدى الطفل في مجال الحكي، بحيث ينتقل من مجرد مستهلك سلبي للثقافات إلى منتج نشط، يعبر من خلال الحكاية الشعبية عن تعددية ثقافته، وعن همومه وطموحاته.
وما ميز هذه التجربة هو انتباهها إلى ضرورة تدريب المدرسين، الذين سيتولون بدورهم الإشراف على تدريب الأطفال؛ إضافة إلى متابعة التلاميذ المبدعين في الحكي حتى تخرجهم من الجامعة، لتكوين رواة محترفين، يشاركون في تظاهرات خارج الوطن.
تتبنى المدرسة المغربية مبدأ الانفتاح على محيط محلي تمثل الحكاية الشعبية إحدى أهم ثمار مخيلته، وعاداته وانشغالاته. هذا المحيط الذي قد يتخرج فيه المهندس والمحامي والطبيب ليؤدي مهامه كتقني، بمعزل عن وعيه ونضجه الثقافي. هذا الوعي الذي تنبري الحكاية الشعبية لتخصيب نظرته لذاته وللآخر، ولتكون صمام أمان ضد كل أشكال التمييز والعنف والتطرف.
إن الحكاية الشعبية التي يجري تهذيبها لتتلاءم مع عقيدة المجتمع وقيمه، ومع ميول الطفل ورغباته وآماله، لهي مكون جوهري من مكونات هويتنا، وتأكيد على خصوصيتنا أمام تجليات غزو ثقافي يهددها بالاندثار.
ــــــــــــــــــــــ
1-الحاج بن مومن. الحكاية الشعبية في التراث المغربي. ندوة لجنة التراث. الرباط 2005
2- د.محمد فخر الدين. الحكايات الشعبية: بنيات السرد والمتخيل. ص27 وما بعدها.