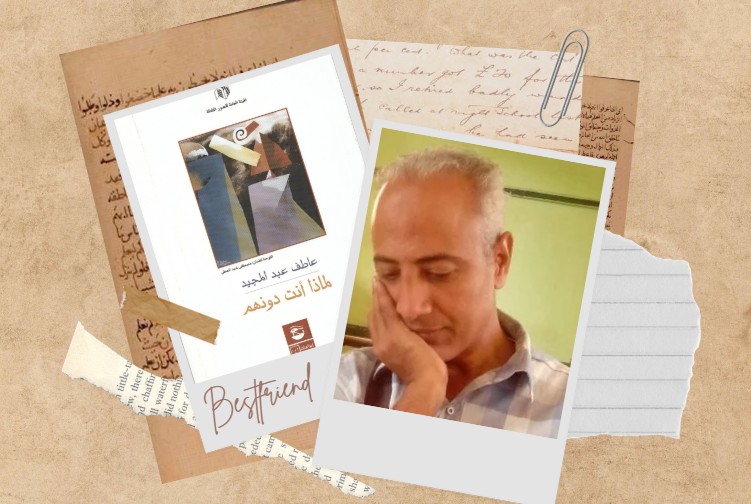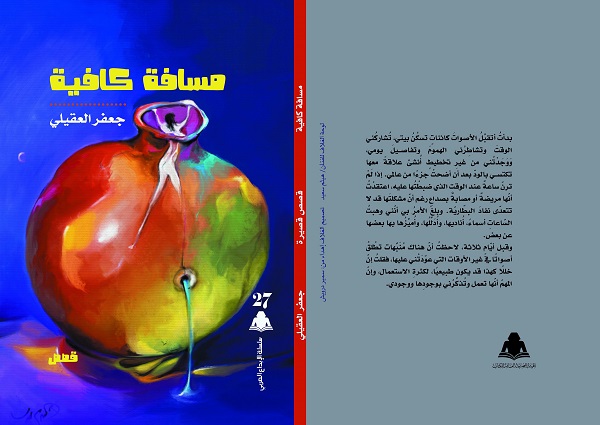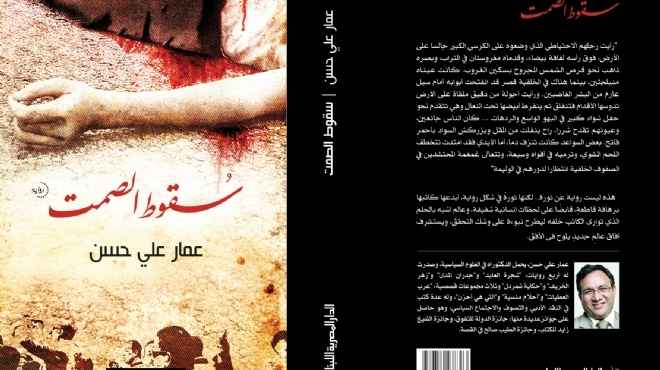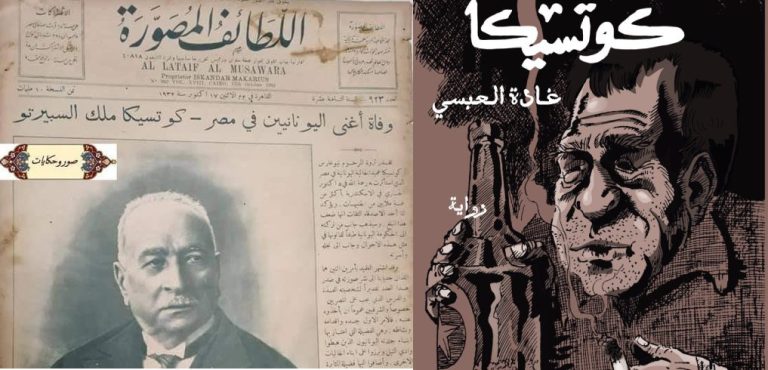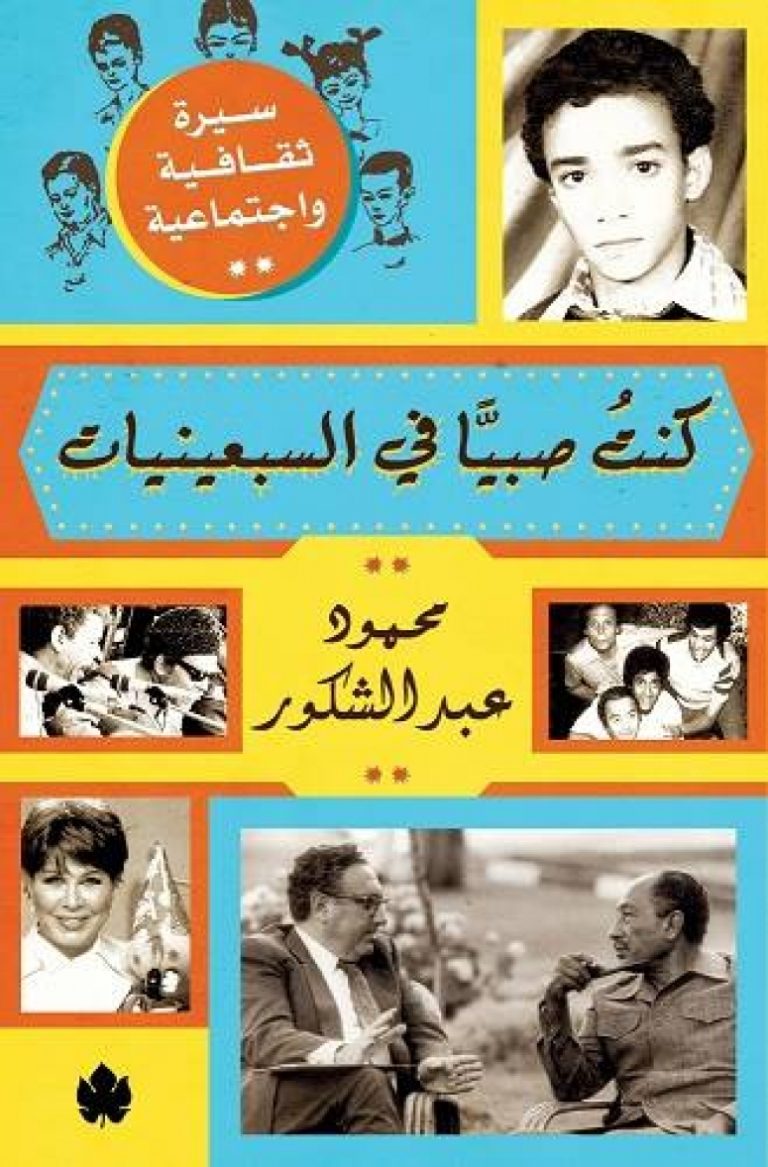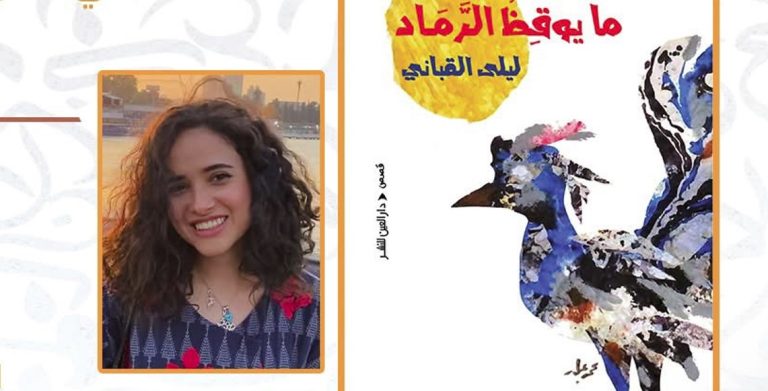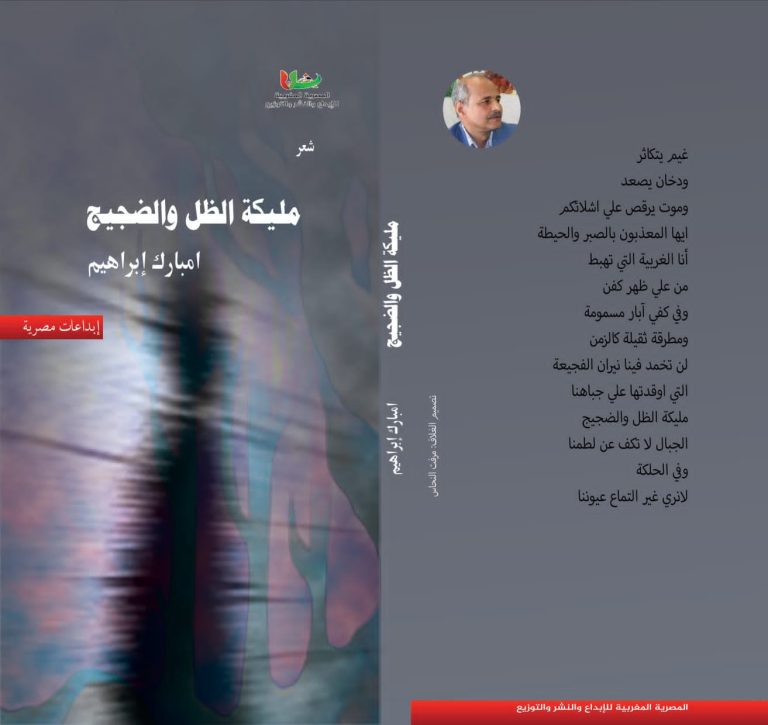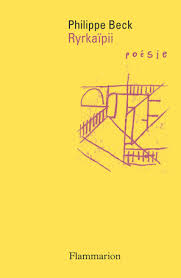أحمد رجب شلتوت
يطل علينا الشاعر “عاطف محمد عبدالمجيد” في ديوانه «لماذا أنت دونهم؟»، بسؤال يفتح فجوة في الوعي، ويصوغ منذ البدء فضاءً من القلق والارتباك. العنوان ليس مجرد استفهام بريء، بل علامة على شعور بالإقصاء أو الاختلاف، وكأنه يضع الذات في مواجهة مأزق وجودي، لماذا أنا أقل؟ لماذا أقف على الهامش؟ لماذا لا أملك ما يملكه الآخرون؟
بهذا الاستهلال يعلن الشاعر عن مشروع شعري يتجاوز البوح الفردي ليغدو مساءلة للهوية والمعنى. إنه ديوان أسئلة، وديوان جروح، والأهم أنه ديوان يفتش في سرّ الخلاص بينما يظل متشبثاً بالخوف، وكأن القصائد جميعها تتحرك على تخوم هذين الحدّين، الخوف والخلاص.
الذات في مواجهة الآخر
في معظم نصوص الديوان، تتجلى الذات بوصفها مركزاً للصوت الشعري، لكنها ليست ذاتاً مطمئنة أو مكتفية، بل ذات مثقلة بالخذلان. يتكرر حضور الآخر في صور متعددة: الآخر الحبيب، الآخر الجمعي (المجتمع/الوطن)، وأحياناً الآخر المطلق (الغيب، الموت). هذا التعدد يجعل الصراع متشعباً، إذ تتأرجح القصيدة بين مواجهة الآخر/المحب الذي يخذل، والآخر/المجتمع الذي يقصي، فضلا عن الآخر/المطلق.
تكشف قصيدة مثل “ليتني أجد الخلاص” عن هذا المأزق بوضوح، حيث لا يعود الخلاص وعداً مؤكداً بل سراباً، فيما يبدو أن الخوف أعمق رسوخاً. هنا تتجسد التجربة الشعرية كرحلة بين الحلم والاستحالة.
بنية اللغة: الكثافة والتشظي
يكتب الشاعر بلغة مشدودة، كثيفة، تنبني على الاختزال والتقطيع، حتى تبدو بعض النصوص أقرب إلى ومضات أو شذرات. الجملة الشعرية قصيرة غالباً، محمّلة بالرمز، متوترة الإيقاع، وكأنها أنفاس متقطعة، هذه البنية اللغوية تعبّر عن توتر داخلي يعيشه الصوت الشعري. إن اختصار الجملة إلى حدها الأقصى، وتركها في أحيان كثيرة بلا تفسير، يكشف عن عجز اللغة أمام التجربة، أو عن استحالة البوح المباشر.
يضاف إلى ذلك أن الشاعر يوظف مفردات ذات حمولة رمزية كثيفة، مثل الخوف، الخلاص، النافذة، الطقوس، الكبرياء، الضياع. وهي مفردات تتجاوز معناها المباشر لتغدو علامات مفتوحة على تأويلات متعددة، تربط بين الفردي والكوني، وبين التجربة الشخصية والأسئلة الوجودية الكبرى.
من التشظي إلى الاحتمال
الديوان لا يسير وفق خط درامي واضح، بل يقوم على التقطع والتشظي. هناك قصائد طويلة نسبياً تنزع نحو السرد، وأخرى قصيرة جداً تقترب من الومضة. هذا التنوع يعكس حال التشظي التي يعيشها الشاعر، ويمنح القارئ إحساساً بأن النصوص ليست سوى مقاطع من حوار داخلي طويل، أو شظايا مرآة محطمة تعكس وجهاً متعدد الانكسارات.
العناوين ذاتها لافتة، مثلا، “طقوس اللا حديث”، “احتمالات”، “كبرياء”، “ضياع”، “أهي القصيدة؟!”. كلها تحمل بُعداً مفهوماً أكثر مما تحمل إحالة مكانية أو زمنية. كأن الشاعر يصر على أن تكون القصيدة مساحة تفكير أكثر من كونها مجرد وصف لحالة وجدانية.
وتسود في الديوان ثيمات أساسية:
يتكرر الإحساس بالخذلان في معظم النصوص. ليس ثمة يقين ولا طمأنينة، بل شعور دائم بأن الآخر – أياً كان – عاجز عن منح الذات ما تحتاجه. في قصيدة “الدمية لا تملك شيئاً”، يطل الإحساس بالفراغ واللا جدوى كقدر محتوم.
أما عن سؤال الهوية والذات، فالعنوان ذاته يلخصه “لماذا أنا دونهم؟” لماذا أنا أقل أو مختلف؟ هذه الثيمة تعود بأشكال شتى: شعور بالنقص، إحساس بالعزلة، بحث عن موقع في عالم لا يعترف بالفرد.
أيضا يحضر البعد الطقوسي في أكثر من موضع، لكن الطقوس هنا لا تمنح الطمأنينة، بل تكشف فراغها أو عجزها عن إنقاذ الإنسان. الطقوس تتحول إلى ممارسة آلية لا تمنح معنى، وكأنها قناع يخفي هشاشة الروح.
وعلى الرغم من أن فكرة الخلاص تتكرر، فإنها لا تتحقق أبداً. القصيدة تحلم بالخلاص لكنها تصطدم دوماً باستحالته. وكأن الخلاص معلق دوماً بين الممكن والمستحيل، لذلك يسود الشعور بالضياع واللاجدوى، قصائد مثل «ضياع» تجسد هذا الشعور بوضوح. الضياع هنا ليس مجرد لحظة عابرة، بل حالة وجودية شاملة. واللاجدوى تتجلى في عجز الذات عن الإمساك بأي يقين.
بين الرمز والتجريد
يتكئ الشاعر على صورة شعرية مكثفة، تنزاح نحو الرمز والتجريد. النافذة، مثلاً، رمز متكرر للانفتاح والعبور، لكنها في النصوص كثيراً ما تكون مغلقة، “لا تُستباح”، مما يكرّس شعور العزلة. أما الكبرياء، فيحضر كقناع للجرح، كأن الذات تستر هشاشتها بالكبرياء كي لا تُفضح هشاشتها الداخلية. هذا الميل إلى الرمز يمنح النصوص طابعاً مفتوحاً، يتيح للقارئ أن يشارك في صنع المعنى. فالقصائد لا تقدم صوراً مكتملة، بل إشارات ودلالات تطلب من القارئ أن يواصل بناءها.
موسيقى داخلية مشدودة
لا يلتزم الديوان بالوزن الخليلي التقليدي، بل ينتمي بوضوح إلى فضاء قصيدة النثر. لكن هذا لا يعني غياب الموسيقى. الإيقاع يتولد من التكرار، من تقطيع الأسطر، ومن الإلحاح على كلمات بعينها، مفردات مثل الخوف، الخلاص، الضياع تعود بإلحاح، لتصنع موسيقى داخلية أقرب إلى النداء أو النحيب المتكرر، هذا الإيقاع النفسي، القائم على التكرار والانكسار، يترجم مأزق الذات التي تدور في حلقة مفرغة، بين السؤال واللا جواب.
جمالية الغموض
الغموض عنصر أساس في هذا الديوان. لكنه ليس غموضاً مفتعلاً، بل غموض نابع من طبيعة التجربة. الشاعر لا يقدّم إجابات واضحة، بل يفتح أبواب الأسئلة. وهنا يتحقق مبدأ النص المفتوح، حيث لا تُقرأ القصيدة بوصفها إقراراً نهائياً، بل بوصفها فضاءً للتأويل. هذا الغموض هو ما يمنح النصوص طابعها الحداثي، إذ يترك مساحة واسعة لمشاركة القارئ في بناء الدلالة.
الشعر كجسر هش
لا يكتفي الديوان بالتجريب الشكلي، بل يوظف الشكل الحر لتجسيد قلق وجودي عميق، كما يمكن رصد أثر الخطاب الصوفي في بعض المقاطع، لكن صوفية الديوان مشوبة بشكوك العصر. فهي ليست صوفية اليقين، بل صوفية الأسئلة. إنها محاولة للبحث عن المطلق في زمن يهيمن عليه الشك.
وتنبني نصوصه على التوتر بين الذات والآخر، بين الخوف والخلاص، بين الرغبة في النجاة والإيمان باستحالتها. إنه شعر يترجم قلقاً وجودياً فردياً، لكنه في الوقت ذاته يعكس قلق الإنسان العربي المعاصر، الذي يعيش في عالم يمارس عليه الإقصاء والتهميش.
إنه ديوان يبحث عن معنى في عالم بلا يقين. وإذا كان العنوان قد افتتح بالسؤال الجارح “لماذا أنت دونهم؟”، فإن النصوص جميعها تتحرك في فضاء هذا السؤال، وكأنها محاولات متكررة لإعادة صياغته من زوايا شتى، لذا يمكن القول إن هذا الديوان بمثابة شهادة شعرية على هشاشة الوجود، وأن يقدم للقصيدة العربية المعاصرة صوتاً يكتب من داخل الجرح، ويقف بالفعل على تخوم الخوف والخلاص.